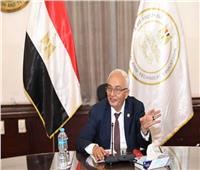هدى عمران
هدى عمران: عدم التواضع يصيب الشعراء بالعمى
الأحد، 12 مايو 2024 - 01:45 م
حوار:
حسن عبد الموجود
تشبه الجملُ الشعريةُ فى ديوان هدى عمران الجديد «كأنها مغفرة» الشفرات المدببة، كأنَّ على الشعر أن يُدمى القلوب، لا أن يداويها.
قصائد عن الحب، وعن القاهرة، وعن العزلة. قصائد تقول لك إن الشعر موجود حولنا فى التفاصيل، وفى العلاقات، يبعث بذبذياته الأثيرية، لكن وحدهم الشعراء مَن يلتقطون موجاته على أثيرهم.
كل محطة شعرية أو قصصية أو روائية لهدى تشبه مغامرة وسياحة فى اللغة وفى المعنى، ولهذا يُنظر إلى ما تكتبه بجدية وتقدير، بدءاً من ديوان «ساذج وسنتمنتالى»، ثم رواية «حشيش سمك برتقال» ثم ديوان «القاهرة»، وصولاً إلى مجموعة «حب عنيف»، وأخيراً ديوان «كأنها مغفرة» الذى يدور حوله هذا الحوار.
أبدأ معك من عنوان ديوانك «كأنها مغفرة».. لماذا جاء فى صيغة أسلوب تشبيه؟
أظن أن هذا العنوان هو الوحيد ضمن عناوين كتبى الخمسة، الذى لم أتردد فيه لحظة. يبدو أننى كنت أعرف منذ البداية مسار ذلك الكتاب، منذ أدركت أن نواته اكتملت وعلىّ الاشتغال عليه. وكانت تشغلنى فكرة محورية حول «الإيمان» وما يرتبط به من معانٍ أساسية داخلى كالحنان والرحمة، وهما مرادفان للمغفرة، التى لا تكتمل، بالنسبة لى، بمجرد التعالى على الألم، لكن بالحنان على الوجود، والرحمة للنفس والآخر. وهكذا انطلقت فى رحلة هذا الكتاب، كنوع من التطهر من الغضب والبكائيات التى طالتنى فى وقت سابق، نحو أسئلة أكثر رحابة تعيننى على تحمل عبء التواجد الإنسانى. ولكى أحقق ذلك أستعين بالشِّعر والإيمان والمغفرة.
اكتشفت قريباً معنى الغفران عند جاك دريدا، وهو لا يرتبط إلا بخطايا، لا يمكن محوها كالقتل مثلاً، وخطايا تسبب العذابات الكبرى فى النفس. حين تستطيع العفو عن تلك الخطايا فأنت «غفرت»، أما دون ذلك فهو مجرد تخطٍ. ومن هنا قد أكون اخترت طريقى، أقصد مغفرتى للعائلة والثورة والوباء والموت والمشى فى مدينة مُفَتِّتة، فى مواجهة صوت الغضب والرثاء على الذات. ويعطينى التشبيه فى «كأنها» رحابة أكبر فى التأويل، قد يعنى ضمن تأويلاته السخرية، عدم اليقين، أو النقصان، أو الضدية تماماً.
لماذا قلتِ فى بدايته إن الشعراء ليسوا أنبياء؟
ربما لأننى حين أقرأ أى شِّعر، أريد معرفة الإنسان الذى يكتبه، رؤيته للعالم ومعرفته المتفردة ولغته التى يتحدث بها، لا أن أقرأ النبوة المتوهمة من ذوات تكتب الشعر.
أفهم ما يمنحه الشِّعر من قوة خرافية للنفس، لكن عدم التواضع أمامه يعمل نوعاً من العمى لدى الشعراء، يحجب عنهم رؤية أى جميل خارج حدود ذواتهم، وهذه أكبر خسارة. النبوة مغلقة على نفسها ولا تقبل أى شىء خارجها، تجعل الشِّعر دينياً ومغلقاً وأحياناً نرجسياً، والأساس فى الشِّعر هو التبصر لمعرفة الوجود والإنسان، والقدرة على رؤية الجمال. وأرى إنكار ذلك نوعاً من الإثم والعار.
تعتبرين أن الشعر يأتى من منطقة المحو.. لماذا؟
بالأساس هذه ليست فكرتى، إنها فكرة أبو خلف الأحمر أستاذ أبى نواس. حين ذهب إليه يستأذنه أن يبدأ فى نظم الشعر، وما كان من المعلم إلا أن طلب منه أن يحفظ ألف بيت من شعر العرب ثم يعود إليه. ولما حفظ أبو نواس الألف بيت ورجع للأحمر، ظناً منه أنه بذلك قادر على كتابة الشعر، طلب الأحمر منه ألا يعود إلا حين ينسى الألف بيت التى حفظها. وبذلك، حين فقط، تتم عملية المحو والنسيان يصبح الشاعر قادراً على كتابة الشِعر. ربما هذه ضمانة جوهرية لابتلاع وهضم الإرث الشعرى، حتى لا تكون الكتابة مجرد استعارة وتقليد.
لكن أيضاً، يبدو المحو عندى كفعل راديكالى ومُزلزِل، يزيل كل يقين استقر فى نفسى، وهو ما يصبح مؤلماً بشكل لا يحتمل، ولا يكون أمامى بُد سوى الوقوف بعد انهيار تام، ومحاولة لملمة النفس، وإعادة تشييد المعانى وكذلك تشييد نفسى من جديد، ووسيلتى الوحيدة الشّعر. هذه العملية قد تكون هى العثور على الإيمان، بعد لحظة كُفر وعمى، وبذلك أستطيع القول إن الشعر قد يكون رحلة إيمان.

«تعبر شوارع القاهرة كأنها تسبح فى بحرٍ ثقيل»، و«فى القاهرة، نرتدى هشاشتنا كمجنون يخرج للعالم». كتبتِ ديواناً كاملاً عن القاهرة حمل اسمها، وها هى القاهرة تطلُّ مرة أخرى، سواء فى التقديم، أو فى القصائد، كهاجسٍ ملحٍّ عندكِ. لماذا؟
انا ابنة القاهرة. صعب علىَّ فهم العالم دونها، هى أداتى لفهم الحياة والعلاقات، وهى مكانى الذى أتحرك فيه. ربما، لم تكن حكمة منى أن أطلق عنوان «القاهرة» على الديوان السابق، وربما كان يناسبه أكثر عنوان «حكمة الجوعى» بما يشتمله على قصائد عن الجوع بشقيه الواقعى والمعنوى.. لكن رغبتى فى مواجهة المدينة، والكتابة من منطقة ثأر جعلتنى أعنون ديواناً عن الجوع باسم القاهرة. لكن هنا فى هذا الكتاب «كأنها مغفرة» لا أتواجه مع القاهرة، ولا أتواجه فى الحقيقة مع أى معنى آخر، بل أرافق كل شىء، حتى العنف، وأحاول التقرب منه بالراحة، وهذا نوع من التسليم وليس العراك. وأنا هنا أتلمَّس حكمة الشاعر بديلاً عن عاصفة الثوار.
العائلة أيضاً تظهر بثقلها كأن الشعر عندك هو محاولة لرسم شجرتها بعد أن تفهمى أفعال أفرادها.. ما رأيك؟
أنا إنسانة صعيدية بالأساس، تربيتُ داخل هيراركية العائلة الصعيدية، تشبعت باللغة والعادات وأسلوب العيش، والعائلة ليست مجرد جذر بل هى مكون أساسى فى وجدانى، حاولت إنكارها كثيراً، وإغضاء الطرف عنها، أو مجابهتها وانتقادها. هذه هى المرة الأولى التى أحاول فيها الانتقال من صوتى الذاتى والشخصى إلى صوت الآخر فى كتابة قصيدة، أن أتأمله وأنتبه له، بالمناسبة أحب تعريف الفيلسوف الهندى «كريشنا مورتي» للانتباه بما يعنى الرصد من غير إدانة.
الانتباه يجلب الفهم، لأنه ليس ثمة إدانة أو تماهٍ فيه، بل رصد صامت. إذا شئت أن أفهم شيئًا، عليَّ أن أرصد الشىء، لا أن أنتقده، لا أن أدينه، لا أن أطلبه بوصفه لذة أو أتجنَّبه بوصفه نفياً للَّذة. وهذا يعنى إعطاء نفسى الفرصة للتسامح، وهنا تتحقق المغفرة لأنها تسعى أن تكون غير مشروطة. أنت لا تريد أن تغير هؤلاء الشخوص، لا أفعالهم ولا مصائرهم ولكن تريد أن تراهم. وربما تستلزم الرؤية الصفح. جزء من هذه الكتابة المتوجهة ناحية الآخر هى أنانية الفنان داخلي، الذى يريد أن يكبر وينضج، فيتخطَّى صوته الذاتى نحو إنسان آخر – من العائلة مثلاً - قد يمتلك من التجربة ما هو أكبر وأعمق، ومنها أتصل بهذه التجربة وأتصل بالعالم ككل. من هذا المنطلق كان لا بد أن أعيد الكتابة عن العائلة لا بوصفها كياناً مضاداً لفرديتى، لكن بوصفها كينونة خلقتنى على ما أنا عليه، بكل فرادتى ونقصانى.
«البطلة» فى القصائد، إن جاز لى التعبير، قوية، مكتفية بنفسها، وقادرة على الاستغناء.. ما الذى يعنيه هذا؟
قد أتفق معك، فى فكرة القوة، لكنها قوة نابعة من الحنان والإيمان والغفران، لا أؤمن بقوة قاسية، تنغلق على نفسها، ولا تسمح بمكان للآخر. قد يكون الاستغناء هنا شيئاً صوفياً، لتربية النفس، وليس للانفصال عن الآخر، بل بالعكس للاتصال به بشكل حقيقى وصادق، نابع من دافع إنسانى عميق، وليس لمصلحة أو حاجة بعينها. لا أدَّعى أننى مستغنية عن الآخرين، لكنى أسعى للاكتفاء بما بين يدىَّ، وتقدير نعمة الوجود، ونعمة دخولى فى التجربة الإنسانية ووجودى كجزء منها.
الحب مذكور فى الديوان 34 مرة، وهى مجرد ملاحظة لشخص شغوف بالإحصاء. لكنه يأتى دائماً كأنه رغبة فى التحطيم، أو كخطيئة، وكأبٍ للخديعة.. لماذا؟
كلمة الحب فى حد ذاتها لا تعنى لى شيئا بعينه، أو قد تحمل دلالات سطحية، لكنها تكتسب بُعدًا آخر حين تمتزج بمعانٍ أخرى مثل الأبوة والإيمان والتطهُّر والعنف والموت والحياة. وأظن أن الحب بمعناه العاطفى لا الرومانسى شاغل أساسى عندى فى الكتابة، والعاطفة تعنى الاتصال بالآخر فى العمق ومن ثم الاتصال بالوجود، لكن الرومانسية قد تعنى فى شقٍّ منها سطح الشعور وعدم الواقعية أحياناً. أنا لست رومانسية، ومن هذا المنطلق لا أخجل أبداً عن الكتابة حول الحب، بشجاعة أنثوية وفى القلب منها بعاطفة أمومية.

قصائدك شديدة الحدة.. هل كلمات الشعر يجب أن تكون كنصال السكاكين؟
ليس بالضرورة أن تكون لغة الشاعر مسننة، عندك بورخيس مثلاً، يستخدم لغة أقرب للهندسية، لكنَّ الأثر الذى يتركه نصه كبير. أظن أن الشاعر ابن بيئته، وباعتبارى شاعرة عربية، أحمل داخلى تراثاً من الأدب والشعر غير المستأنس، وغير الحداثى، أحاول الحفاظ عليه بطزاجته، مع العمل على تكثيفه وإنضاجه.
وقد ساعدتنى على ذلك تربيتى فى بيئة جنوبية غنية بفن متنوع وجرىء، فى القلب من هذا الإرث لغة حسِّية أحبها ولا أريد لها أن تكون مجرد أداة لنقل النص، لكن أن تكون فى ذاتها جزءاً منه. الشعر فى جزء منه موازٍ لتجربة اللغة عندى، وإذا كنت أحمل معانى غير مدجنة، قد تصل أحياناً إلى التطرف، فيجب أن تكون اللغة بالتالى جارحة، وتؤثر فى مَن يقرأها، كما تؤثر فى شاعرها.
ما أكبر عدو للشعر؟ هل الطمأنينة؟
سابقاً. كنت أتخيل فعلاً أن عدو الشعر، أو عدو الفن عموماً هو الطمأنينة، لكن كفانى ما كفانى من التوتر والسعى نحو ألمٍ أو الدخول فى تجارب غير حنونة. من النضج الآن إدراكى أن عدوى الأساسى، وعدو شعرى وفنى هو اليأس، وعدم استطاعتى إيجاد الإيمان.
من الأقوى بداخلك؟ الشاعرة أم الساردة؟ كيف يتجاوران وكيف يجبر أحدهما الآخر على الإنصات؟
العلاقة بين الشعر والسرد علاقة تجاور وتضامن وليس إجباراً وصراعاً، عندى منظور شعرى عن الحياة، أرى به كل شيء، وأوله القصص التى أكتبها. والسرد عندى يسعى للمجاز، وقد يكون هذا جوهر الشعر. لذلك لم يعد يعنينى سؤال الشعر أم السرد؟ أنا ممتلئة بطاقة الشعر، وأوظفها فى القصص. حتى قرارى أننى لن أكتب قصيدة مرة أخرى، وأن «كأنها مغفرة» هو كتابى الشعرى الأخير، ليس معناه التخلى عن الشعر، أو تخلى الشعر عنى، لكن العكس، لأننى أريد أخذ طاقة الشِّعر لمناطق أخرى أكبر داخل السرد تتخطى الذاتية إلى الخيال والمتعة.
لماذا تستخدمين وصف الكتاب لا الديوان؟
كنت واعية بهذا الفارق وقت أن اشتغلت عليه، ومُصِّرة على بنائه بكيفية تجعله يحمل دلالات عدة، ويعكس شمولية التجربة.
لماذا أصدرت مجموعتك «حب عنيف» فى وقت قريب من صدور الديوان.. ألا يشوش نجاح أحدهما على الآخر؟
أنت تعرف أن عملية نشر كتاب تستغرق وقتاً. وقرار النشر يرجع لدار النشر بالأساس. وتصادف نشر العملين فى وقت متقارب فى دارى نشر مختلفين. لكنى غير قلقة بالمرة من فكرة تشويش كتاب على الآخر. للآن أتلقى مراجعات جيدة جداً عليهما. وكلاهما تجربتان مختلفتان. فمجموعة «حب عنيف» تحتوى على لعبة سردية أحبها، عشر قصص طويلة فى عوالم متداخلة وغرائبية، تتلمَّس فكرة الحكاية بالأساس، ليست مجردة كلياً كالشِّعر، وإن كان كلا الكتابين يدوران فى عالمى الخاص الذى أسعى أن يكون أصيلاً وفريداً.
ما أكبر صفة يمكنها أن تُعبِّر عنك ولماذا؟
ربما صفتا «غريبة» و«حقيقية». إنهما أكثر صفتين أسمعهما من الآخرين عنى .
هل منحتكِ الأمومة أفقاً جديداً فى الكتابة؟
منحتنى الأمومة التسامح واضطرتنى للتمسك بالأمل، والشفقة على الآخر، هل انعكس ذلك على الكتابة؟ لا أعرف، لكن الأكيد أننى أصبحت أكثر مسؤولية، وسعياً لرؤية الآخر فى العمق، وبذل العطاء فى الكتابة وليس مجرد الاستعراض لذات متمحورة حول نفسها.
أخيراً ما أحلامك ككاتبة وإنسانة؟
أتمنى أن تنتهى الحرب فى فلسطين. أن نعيش أياماً هادئة ومسالمة. وأتمنى أن تظل الكتابة بصيرة، وألا تصير عمى أو تكالباً أو هوساً.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 هل مات المركز القومي للترجمة؟
هل مات المركز القومي للترجمة؟
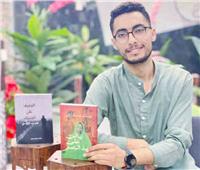 محمد عبد الرازق: لا يخيفنى حصر روايتى فى المنطقة البوليسية| حوار
محمد عبد الرازق: لا يخيفنى حصر روايتى فى المنطقة البوليسية| حوار
 اللغة الشعرية ووضوح الأسلوب فى «التشجيعية للآداب»
اللغة الشعرية ووضوح الأسلوب فى «التشجيعية للآداب»
 جائزة النيل.. سلطان القاسمي وأبوسنة وصابر عرب ومحمد فاضل
جائزة النيل.. سلطان القاسمي وأبوسنة وصابر عرب ومحمد فاضل
 جاهين ونجم وإبراهيم ناجي.. ثلاثة شعراء بعيون الزوجة والابنة والحفيدة
جاهين ونجم وإبراهيم ناجي.. ثلاثة شعراء بعيون الزوجة والابنة والحفيدة
 تشكيل الزجاج.. سيد واكد يعيد تعريف الفن التشكيلي
تشكيل الزجاج.. سيد واكد يعيد تعريف الفن التشكيلي
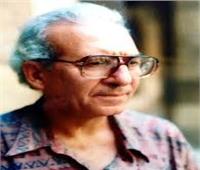 حقوق التشكيليين المهدرة تنتظر تفعيل «الملكية الفكرية»
حقوق التشكيليين المهدرة تنتظر تفعيل «الملكية الفكرية»
 أبو الفتوح: رواية «صاحب العالم» بكائية ساخرة حول انتهاك خصوصية |حوار
أبو الفتوح: رواية «صاحب العالم» بكائية ساخرة حول انتهاك خصوصية |حوار
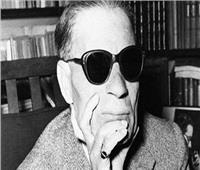 بين طه حسين وكافكا.. تجليات النور وإكراهات الذات
بين طه حسين وكافكا.. تجليات النور وإكراهات الذات