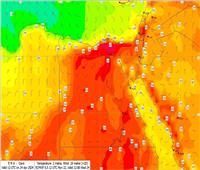إيهاب الحضرى
يوميات الأخبار
بطولات أحلام اليقظة!
الخميس، 20 مايو 2021 - 06:08 م
كثيرا ما كنتُ أتقمص فى خيالاتى صور البطل الذى لا يُقهر، وأحصد الأعداء بالجُملة على طريقة الأفلام الأمريكية، ثم أنام نوما هانئا بعد أن أفرغتُ طاقتى المكبوتة.. فى بطولات وهمية!
عيد الأحزان!
السبت:
مر العيد حزينا ولم تختلف الأيام التالية، خاصة أن أخبار الشهداء لا تتوقف. تتزايد حدة الحزن عندما ينال الموت أطفالا ونساء، يتحمّل العالم كله مسئولية الغدر بهم. لم أعد أحتمل بشاعة الصور، رغم أننى موقن أنها أقل قسوة بكثير من معايشة المأساة واقعيا. أستعيد شريطا من ذكريات الألم، تبدأ منذ طفولة مبكرة عاصرنا فيها بحارا من الدماء، أراقها الاحتلال فى بقاع عربية كثيرة. كبرنا على كراهية كيان صهيونى راهن على أن النسيان آفتنا، لكن ميراث الكراهية انتقل للأجيال الجديدة، بفعل وحشية مُزمنة تُعد جزءا أساسيا من نسيجه، وقناعة راسخة فى تكويننا. حتى بعد انتهاء حروبنا المباشرة، عاش جيلى اجتياحات عديدة، وشاهد المذابح عبر البث المُباشر، فتنامت نقمتنا على العدو، وعاش كثيرون منا فعل المقاومة فى أحلام يقظتهم. كثيرا ما كنتُ أتقمص فى خيالاتى صور البطل الذى لا يُقهر، وأحصد الأعداء بالجُملة على طريقة الأفلام الأمريكية، ثم أنام نوما هانئا بعد أن أفرغتُ طاقتى المكبوتة.. فى بطولات وهمية، تمنحنى متعة الإحساس بقوة أفتقدها فى الواقع!
تتوالى أخبار القصف الوحشي، ونُتابع الشهداء كمجرد أرقام. وراء كل منهم مأساة تنزل كالصاعقة على عائلات بأكملها، نجهل ما يعقبها من صرخات ثكلى وانهيارات معنوية. تبدو على وجوهنا ملامح أسى مؤقت، سرعان ما يتلاشى أمام مشاغل الحياة المتوحشة. تنتابنى حالة غضب من منشورات تستفز المشاعر، بما تتضمنه من معلومات جرى ترويجها قبل سنوات، ويستحضرها أصحاب الفكر المُوجّه، ويُلقون فيها اللوم على الضحية، وكأنها السبب فيما تتعرض له من قصف وقتل وتهجير. إنها آفة أصابتنا منذ عقود، نعتمد فيها على «التنميط»، ونصبّ غضبنا واتهاماتنا على شعب بأكمله، ونُحمّله خطايا فئة قليلة منه. أتابع ما يجرى على «فيس بوك» فيرتفع ضغطي، منشور عجيب يجرى تداوله عن أصحاب المليارات من الفلسطينيين، ويتناسى البعض أن فى بلداننا مليونيرات يتهربون من الضرائب، بينما تُنفق الدولة المليارات لفك كرب «الغلابة»، إنه التناقض البشرى المُنتشر فى كل أنحاء الكوكب، ورغم ذلك هناك من يرددون بوعى أو بدون وعى مقولات سابقة التجهيز، ويتعاملون معها كحقائق رغم هشاشتها، مع أنها لا تصب إلا فى مصلحة العدو الغاشم.
أقسى شيء أن يكون منتهى أمل المظلوم مجرد كلمة تُهوّن عنه معاناته، فى عالم ظالم أصبح يُحمّله مسئولية مأساته!
البحث عن الزمن المفقود
الأحد:
جلس الطفلان مُلتصقين بأمهما. توأم عمره يقترب من الثلاث سنوات. قبل عام كان أحدهما اجتماعيا بدرجة كبيرة مقارنة بالآخر. الآن أصبحا يتفقان فى الميل إلى العُزلة عن المحيطين، لا لسبب إلا أن كليهما مشغول بجهاز محمول يُمسكه. أخبرتنا والدتهما أنهما يقومان بتنزيل برامج من على «يوتيوب»! تنوعّت نظرات المُشاركين فى الزيارة العائلية بين الإعجاب والقلق، ثم مضى الحديث فى سياق الأضرار المُتوقّعة، لكن فى المقابل، أصبحت هذه الأجهزة تحمى الوالديْن من صخب منزليّ غير مُحتمل.
تحوّلات الطفلين نبّهتنى إلى أن آخر مرة رأيتهما كانت قبل أكثر من سنة، شهدتْ قطيعة اختيارية بسبب اقتناع أسرتهما بأن الوقاية خير من علاج غير مضمون لـ «كورونا المُستبد»! شردتُ عن النقاش الدائر. فكّرت فى أن الأيام تلتهمنا لدرجة تُفقدنا الإحساس بالزمن. فى القطارات لن نشعر بالحركة إلا إذا نظرنا إلى شيء ثابت بالخارج، وفى الحياة لا يمنحنا القُرب فرصة رصد تغيّرات المحيطين بنا. العودة بعد البُعد فقط هى التى تتيح لنا هذه الفرصة، لأن الحاضر قد يُطيح فجأة بصورة ذهنية- كنا نعتقدها ثابتة- لشخص ما. إذا قُدر لأحدهم أن يلتقى بعد سنوات طويلة بحبيبة الصبا ربما يصاب بالصدمة، لأنه يكون فى مواجهة امرأة أخرى غير «ست الحُسن»، التى ظلت تداعب أحلامه خلال سنوات الفراق، بينما ستشعر هى بالرضا لأنها قالت له يوما: «إنت زى أخويا»! فالكائن الواقف فى مواجهتها أصبح أكثر تأثُرا بعوامل الزمن واضطرابات الأيام. عموما سيمضى كلا الطرفين فى طريقه وهو يحمد الله على نعمة عدم الارتباط بالآخر! البُعد كاشف بينما القُرب يستر التغيرات، على الأقل يسلب الاختلافات حدّتها، لأنه يجعلنا نتعاطاها بجرعات مُخفّفة، تساهم فى تخفيف صدمة الحقيقة المُرّة!
شاب من كبار السن!
الاثنين:
قبل نصف قرن كان عمرى ثلاث سنوات. المؤكد أن ألعابا شديدة البدائية شغلتْنى وقتها ومنحتنى المُتعة. ربما ينتاب الإحساس نفسه أحد الطفلين بعد خمسين عاما أخرى، عندما يجد نفسه فى مواجهة أجهزة لم يكن يوما يتخيّل أنها ستظهر للوجود، فى ظل تطور تكنولوجى يصعب كبح جماحه، لدرجة أنه سيُحيل أفلام الخيال العلمى غالبا للتقاعد! التكنولوجيا الحديثة ساهمتْ بتطبيقاتها فى إزاحة الفجوة بين الأعمار، كلّنا- أطفالا وكبارا- أدمنّا أجهزة المحمول بتطبيقاتها، وأصبح فراقها شبه مستحيل. أعرف اثنين فقط قررا مُقاطعتها، لكن الصحفى الصديق خالد حجاج استسلم فى النهاية واقتنى جهاز محمول، تعمّد إهانته فى البداية بتركه فى البيت، ليسلب الجهاز أهم سماته وهى حرية الحركة، لكنه اضطُر تحت ضغوط أسرية غالبا إلى استعماله، وأصبح يُشاهد أحيانا وهو يستخدمه فى صالة تحرير «الأخبار». أما الثانى فظل صامدا، وهو الأثرى الكبير أحمد عبد الفتاح عُمدة المُتخصصين فى هذا المجال بالإسكندرية. أصرّ الرجل- الذى يكبرنى بسنوات لا أستطيع حصرها- على عدم اقتناء «الموبايل»، وحتى هذه اللحظة لا يمكن الوصول إليه إلا عبر الهاتف الأرضي! ولا أعتقد أنه سوف يُغيّر رأيه، حتى إذا اطلع على نتائج دراسة بريطانية حديثة، تؤكد أن التواصل على «السوشيال ميديا» ليس شرا مُطلقا، بل أن قضاء ساعات أطول على منصاتها يحمى كبار السن من خطر تدهور الذاكرة والخرف! أقبلتُ على الخبر الذى نشرته عدة صحف قبل أيام من باب الفضول فقط، بوصفى قارئا لا يزال يعيش شبابه، لكنى أصبتُ بالصدمة، عندما اكتشفتُ أن مُصطلح كبار السن يشملني، فالدراسة اعتبرتْ أن أعمار هذه الفئة تتراوح بين 50 و90 عاما! شعرتُ أن الصحف التى نشرت أخبار الدراسة تُخرج لى لسانها، وهى تُشير إلى أن المجلة المُتخصّصة التى نشرت نتائج البحث اسمها.. «علم الشيخوخة»!!
عشق الإسكندرية.. ونزوات الساحل!
الأربعاء:
تتفاوت جاذبية المدن، لكن عددا محدودا منها يظل أكثر قدرة على اقتناص العشاق. إلى الصنف الأخير تنتمى الإسكندرية، التى تُعتبر «ندّاهة» أكثر رومانسية من القاهرة، فالأخيرة ظلتْ لعقود طويلة تُهيمن على أحلام البسطاء، وتتصيّد الباحثين عن انطلاقة فى فضاء بعيد عن الغلاف الأرضى للقرى فى بحرى والصعيد. العلاقة بين العاصمة ومريديها أشبه بزواج المصلحة، أما عروس المتوسط فغرامها أفلاطوني، يظل خالدا حتى لو نافستها حسناوات أخريات على أحبابها.
هذا العام تمر الذكرى العاشرة لهبوطى الأول على سطح الساحل الشمالي. ظلّ المكان بالنسبة لكثيرين غامض الملامح، يسمعون عنه كمحمية بشرية لطبقة بعينها. حواديت من لم يطأونه بأقدامهم كانت أكثر من حكايات من ارتبطوا به واقعيا، فالغموض يفتح أبواب الأحلام، ومن لا يرى.. يملك طاقة لا نهائية من الخيال. نقطة الانطلاق تطلّبت الاستعانة بصديق ينتمى للمكان، كى أتمكن من تجاوز حواجز الرهبة، فالقلق من المجهول سمة إنسانية، يحتاج تخطّيه إلى وسائل مساعدة. كانت «مارينا» منتجعا لفئة بعينها من مشاهير المُجتمع. نقرأ عنها فى صفحات الاجتماعيات بمجلات مُتخصصة، تتفنّن فى استعراض صور جذابة، تفتح بوابات أكثر رحابة للأمنيات. وهكذا جاءت الزيارة الأولى مُحمّلة بشحنة انفعالية ضخمة، تمزج الشغف بالرهبة مع الرغبة فى الاستكشاف، ومنذ الزيارة الأولى انجذبتْ زوجتى وابنى إلى «النداهة» الجديدة. أعترف أننى شعرتُ بسحر المكان، غير أنه لم يملك القدرة على إحداث قطيعة بينى وبين الإسكندرية، فهى الحب الأول والمزمن، لأنها المدينة الطاغية بسحرها وتاريخها وحاضرها. إنه مزيج لا يتراجع أمام سلبيات الزحام الخانق والضوضاء، التى نتسبب فيها كوافدين يُنغّصون عيش أهلها، ويدفعون كثيرين منهم للنزوح عنها كل صيف، بهدف الاستجمام فى أماكن أكثر هدوءا. لهذا تتصاعد حرارة حبى لها شتاء، حيث تخلع المدينة عنها ثوب التكدس، وتغتسل بالأمطار والنوّات التى تزيد فتنتها.
بدأت زوجتى وابنى صياغة حاضر جديد فى الساحل الشمالي، وأصبحا أكثر ارتباطا به، وقاطعا الإسكندرية التى صارت زياراتى لها فردية غالبا، ربما لأنهما لا يرتبطان بذكريات عميقة بها مثلي. مع الوقت تابعنا تحوّلات «مارينا»، فقدتْ بريقها بعد أن اكتسب الكثيرون جرأة مفاجئة، وتمكنوا من اجتياز بواباتها. ومع تزايد مصايف الشركات فرض الزائرون الجدد طقوسهم، مما جعل السكان الأصليين يضيقون بالأوضاع. هناك من اكتفى بالتذمر واجترار ذكريات البدايات، والترحم على زمن الخصوصية المنقرضة، بينما هرب آخرون إلى منتجعات أخرى فى الساحل، رسمتْ لنفسها أساطير جديدة. ارتفاع أسعار وحداتها بشكل مبالغ فيه أدى إلى جعلها حكرا على أبنائها، وغالبا ستظل كذلك لسنوات طويلة قادمة. قد أتمكن من اختراقها ذات مغامرة، لكنى متأكد أن شغفى بالإسكندرية سوف يجعل انبهارى بأى مُنتجع جديد مجرد نزوة.. أو خيانة عابرة!
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة













 نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
 «لست ملاكاً»
«لست ملاكاً»
 وكاد بطل الملاكمة يصفعنى فى الطابور!
وكاد بطل الملاكمة يصفعنى فى الطابور!
 وجها لوجه مع مصطفى أمين
وجها لوجه مع مصطفى أمين
 مكالمة «نص الليل» مع الشهيد أبو عمار
مكالمة «نص الليل» مع الشهيد أبو عمار
 فى الموت والحياة.. عظة
فى الموت والحياة.. عظة
 أنا أقاوم.. إذاً أنا موجود
أنا أقاوم.. إذاً أنا موجود
 مذكرات الدكتور مجدى يعقوب
مذكرات الدكتور مجدى يعقوب
 جمهورية العلم والعدل
جمهورية العلم والعدل