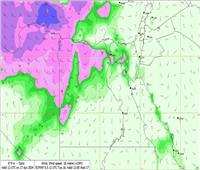ساعات الأسر: محمود الورداني
ساعات الأسر: محمود الورداني
الإثنين، 27 سبتمبر 2021 - 01:40 م
(1)
قبل أن أصل إلى المستشفى، اتصل بى الرائد أيمن قائلا:
“ البقاء لله يافراج بك.. شدّ حيلك.. النقيب سمير معك وعلى العموم إذا احتجت لأى شئ كلّمني..”
هذا الرجل يحيرنى وكلهم يحيّرونني. اتصلت به ولم يرد وأرسلت له رسالة على الواتس ثم على الرسائل العادية ولم يرد، والآن يقول لى البقية فى حياتك! يحيّرنى أيضا أنه لايستقر على إسم ينادينى به. أحيانا سالم بك وأحيانا فراج بك.
عندما وصلنا، أشار النقيب سمير بيده للحارس فهرول الرجل يفتح بوابة المستشفى، وحياه بينما كانت السيارة تمرق للداخل. سامحينى ياعمتي. تأخرتُ عليكِ.
اتصلت بنوسة فأجهشت بالبكاء وهى تخبرنى أنها فى الطابق السفلى حيث ثلاجة الموتى. قادنى النقيب سمير إلى خلف المبني. عبرنا بوابة، ثم أسرعتُ فى أول ممر صادفني، ورحت أقرأ اللافتات على الأبواب. الباب الأخير.. توقفت مترددا قليلا قبل أن أستجمع شجاعتى وأدفعه برفق.
كانتا واقفتين مستندتين على الجدار أمام منضدة عليها جثمان عمتى ملفوفة فى أكفانها. التفتتا نحوى ثم سارعتا بالدخول لحُضنى تبكيان بحُرقة، ولم أتمالك نفسى فأفلتت دمعتين وأنا أضمهما.فاجأتنى نوسة:
«ياحبيبتى يا أمى.. أين ندفنها ياسالم؟.. كنت أعرف منذ أيام أننا سنحتار فيها..حاولنا واستقصينا أقاربنا القدامى ولم نصل لأى خيط»
أجبتها مشدوها:
«أين ندفنها؟.. كيف؟ لاأفهم.. »
أجابت فريدة:
«يا أبيه.. ( هكذا كانت تناديني) أهلنا لانعرف لهم طريقا ولامقبرة»
أكملت نوسة:
«هل تعرف أنت لهم طريقا.. وحتى أهل أبى فى السويس لانعرف لهم طريقا ولامقبرة»
فعلا.. لاأعرف لهم طريقا ولامقبرة. أبناء عمى الثلاثة تفرّقوا فى دنيا الله الواسعة بعد أن مات أبوهم ولحقت به زوجته، وزوج عمتى أهله فى السويس ولاأعرف عنوانا أو رقم هاتف له.
أنا فى مشكلة فعلا. إكرام الميت دفنه. ماذا أفعل؟ يجب أن أدفنها الآن. تضاعف همّى وغضبى وقلة حيلتي. هل أكلّم أحلام الآن؟ وماذا أقول لها. أبوها عندما مات سافرتُ مع جثمانه إلى سوهاج، وفعلت الشئ نفسه مع أمها.
كان فى الحجرة البيضاء التى نقف فيها ثلاثة نسوة من العاملين. ناولتهن نقودا لم أعدّها، وتراجعت إلى الجدار حيث كان هناك ثلاثة مقاعد متجاورة. جلستا عن يمينى ويساري. هالنى أننى لم أفكر مطلقا فى أن يوما سيأتى وأموت مثل سائر الناس وأحتاج لمقبرة. لم يشغلنى هذا الأمر ولم أشتر مقبرة رغم عروض كثيرة سواء من المؤسسة أو النقابة. فعلا لم أفكر للحظة فى أن الناس يموتون ويحتاجون لمكان يتم إخفاؤهم فيه! الآخرون يمكن أن يحدث لهم ذلك.. أما أنا فلا!
رنّ هاتفي. كانت رجاء هى التى تطلبني. فكرّت فى أن أغلق الهاتف، إلا أن الفكرة ومضت فى ذهنى فجأة. ترددتُ حتى توقف الجرس دون أن أحسم هذه الفكرة المفاجئة، بينما بنتا عمتى تتعلقان بعينى وأنا أهرب منهما مشيحا بوجهي. وجدتنى أنهض مبتعدا عنهما، بل وخرجت إلى الردهة عبر الباب لأطلب رجاء على الهاتف. بادرتها قبل أن أسمع صوتها:
« إلحقينى يارجاء.. باختصار.. لاأعرف أى مكان لأدفن عمتى يارجاء.. إلحقيني..»
لم ترد على الفور ونهشنى القلق عندما طال الوقت دون أن تجيبني، ثم رفعت صوتها قائلة:
« حاضر ياسالم بك.. إكرام الميت دفنه.. حاضر.. سأتصل بك بعد أقل من نصف ساعة.. البقية فى حياتك وربنا يجعلها آخر الأحزان
سأتصرف أنا»
 .
.
عدتُ لمكانى ومددت ذراعيّ وضممت، البنتين. كانتا تبكيان بلا صوت وشعرتُ بهما تهتزان. قلت أخيرا:
«خلاص.. لاتقلقا..فى خلال نصف ساعة. سنخرج من هنا..سأمرّ على خزنة المستشفى وألحق بكما..»
وجدتُ النقيب سمير جالسا على أحد مقاعد المدخل، وعندما رآنى تبعنى إلى مكتب الاستقبال. وعلى الرغم من أنه كان يرتدى ملابسه المدنية، إلا أن الجميع كان ينصاع، ويُسرع فى وضع نفسه تحت تصرفه منذ دخلنا من البوابة. تمت الإجراءات والحسابات والأوراق المختومة فى يسر وسلاسة، بينما كان هو يُجرى اتصالاته للحصول على تصريح الدفن.
وبالفعل.. بعد أقل من نصف ساعة اتصلت رجاء لتقول لي:
«على رأسى ياسالم بك.. تشرّفنى ياريّس.. أنا عملت اتصالاتى بسرعة.. العين هاتكون جاهزة بعد ساعتين.. عندنا فى تُربة العائلة فى طريق الفيوم.. تُربة أبويا.. حضرتك كمّل إجراءاتك وصلّوا عليها الله يرحمها..وعندما يصلنى لوكيشن المدفن سأرسله لك وستجدنى فى انتظارك هناك.. مع السلامة ياسالم بك.. البقية فى حياتك».
(2)
أخيرا سأستمتع ببعض الحنان والنَفَسْ الطيب فى البيت. لم يكن مسموحا لى استقبالها فى المطار كما تعودنا، وبالطبع لم يكن هناك داع لاستئذان الرائد أيمن، فأنا أعلم جيدا أنه لن يوافق. راحت لها أروى وطفلاها واستقبلوها فى المطار، ثم بادرت غادة بالاتصال بى فور وصولها، ولم تتوقف قفشاتها وقَلشها على الجميع: أمريكا ومصر وبيتنا وأمها وأروى وأنا والجو الحار المترب، منذ اللحظة الأولى. انطلقتْ كمدفع سريع الطلقات، ولم تعطنى الفرصة للرد عليها. وأنهت مكالمتها بأن لديها الكثير تريد أن نتكلم فيه بعيدا عن الهاتف. سارعتُ بإغلاق السماعة فأنا أعلم جيدا أنه لايمكن الاطمئنان للسانها المنفلت. فى قرارة نفسى كنت سعيدا بقلشها المتواصل، والسخرية الدائمة التى تطال الجميع، بما فى ذلك لجنة القيادة العامة. لم يكن يهمها شئ، ولم تستجب قط لتحذيراتي.
نامت حتى اليوم التالي. استيقظتْ فقط لتسلّم عليَّ عندما عدتُ آخر النهار. اتصلت بى فى اليوم التالى عدة مرات، وأكدّتْ أنها طبخت بنفسها” الأكلة اللذيذة” كما نسميها والتى نحبها أنا وهي.. صينية بطاطس بالدجاج فى الفرن محموشة ووجهها محروق كما نحبها، وكان هذا معناه عودتى على الغداء، وهو ماكنت أنتويه إكراما لعيونها حتى بدون الأكلة اللذيذة.
كنتُ أتجول.. لا.. كنتُ أجرّ قدمى المعقورة من الصالة إلى المكتب إلى حجرة النوم مندهشا جدا. كنتُ فى بيت..كان هذا البيت فيه طفلان، ابنا أروى، ولم يكن أبوهما موجودا كالعادة، فهو ليس على وفاق مع أروى، وطالما سمعتُ قصصا منها عن خلافاتهما التى استمرت مثلما استمر زواجهما.. وهكذا كانت هناك أروى وأحلام وغادة ورائحة بيت وعطر صينية بطاطس بالفراخ فى الفُرن عملتها غادة. لذلك كنتُ مندهشا جدا. اختفت رائحة المواعين الوسخة المكتومة، وحلّت رائحة غادة وهرج الولدين وزعيقهما وجريهما خلف غادة وجدتهما وصياحهم جميعا.
هذا هو النَفَسْ الطيب الذى خلا البيت منه منذ شهور. حتى أحلام بدا لى أنها تغيّرتْ، عاد صوتها وانفلاتها بل وتطوحها ولينها وقد سابت مفاصلها وبان جسمها وهيئتها. تخففتْ. قلّت كثافتها وتضاءل حجمها. عادت لارتداء قميص نومها الخفيف نصف العاري، وها هى تنقل الصينية الفخار الكبيرة بسطحها المحمّر، بل البنى المحروق تعلوه قطع الدجاج المحموش برائحة جوزة الطيب والقليل من الجنزبيل والفلفل الأسود. وتعود لتنقل الَسلَطة الحامية والأرز المفلفل وصينية أخرى للأرانب المحمّرة بلونها الذهبى نصف المحروق أيضا كما نحبها أنا وغادة.
كانت أحلام كأنها أتت من زمن آخر، على الرغم من آثار مرور السنين وتجاعيد الرقبة والكتفين وتهدل الصدر الذى كان مايزال على الرغم من ذلك وافرا مشرعا. جلستْ فى آخر السفرة بين الصغيرين آسر وياسر لتتولى إطعامهما، بينما كانت غادة على يمينى وأروى على يساري. كأننا أسرة وكأن هذا بيت. بل استعدتُ للحظات جسم أحلام القديمة التى اعتادت على ارتداء مالا يكاد يسترها، مادامت فى البيت ومادمنا فى الصيف. دائما كانت قمصان نومها الخفيفة المشلوحة تمنحها إغواءًا فى زمن ما. لدهشتى الشديدة خُيّل لى أنها التقطتْ ماشعرتُ به، وعبر وجهها مايشبه ابتسامة.
كأننا اشتركنا معا فى استعادة زمن قديم، كانت فيه عِشرتْنا معا قادرة -على الأقل من جانبها- على الغفران والتسامح، وكانت هناك دائما مساحة تسمح باستعادة الصفاء وممارسة الجنس باستمتاع وشغف على الرغم من المعارك المتواصلة. أدركتُ الآن بقوة أننى بتُّ غير قادر على التسامح مطلقاً. أدركتُ الآن أكثر من أى وقت مضى أيضا فداحة الخطأ الذى ارتكبته باستمرار وجودنا معا، وضعفى وجُبنى وعجزى عن الانفصال لأسباب أدرك الآن كم كانت واهية. كنت مندهشا وأنا أنظر إليها وهى مستغرقة مع الولدين تدللهما ليأكلا، وعندما تلتقى عيوننا تحوّل نظرتها سريعا ويلوح مايشبه الابتسامة على وجهها وهى تنسحب بعينيها. وهكذا، قلتُ لنفسي، كان يمكن احتمال الحياة، على الرغم من الإحن المتبادلة والرغبة الدائمة فى الشجار، والتدحرج نحوه بإصرار لاتدرى سببه. كان ذلك فى زمن سابق، قبل نجوى وحدائق نجوى وبحرها وسمائها وعُشنا فى جليم. أما الآن، فهو عبث وتضييع للوقت والجهد وتعلّق فارغ وأجوف بأمنيات تافهة. هى حتى ليست أمنيات ولا أوهام بل هى لجاجة واستهبال. ربما كان هذا ممكنا فى زمن ما، فى فسحة من الوقت، أما الآن... أبدت غادة تذمرها ضاحكة من خلوّ المائدة من الملوخية التى حُرمتْ منها فى أمريكا، ومادمت عملت لنا أرانب يا أحلام، هكذا كانت تنادى أمها، وتنادينى طبعا بسالم، فالملوخية لازمة وضرورية..هكذا أضافت ضاحكة.. أنتِ لاتسمعين الكلام أبداً!
«اعتدلت أحلام ونظرت غاضبة إليها قائلة إنها اشترت الملوخية فعلا» وطلبت منك ياست هانم تقطّفيها وتخرّطيها.. وانتِ لاقطفتِ ولا خرّطتِ وطول النهار لعب مع أولاد أختك..»
أما أروى فقد شاركت أختها فى تأنيب أمها ضاحكة وأضافت: «هيَّ انتِ ياأحلام كده..تلعبى طول النهار ياست هانم وتقولى علينا بنلعب!!»
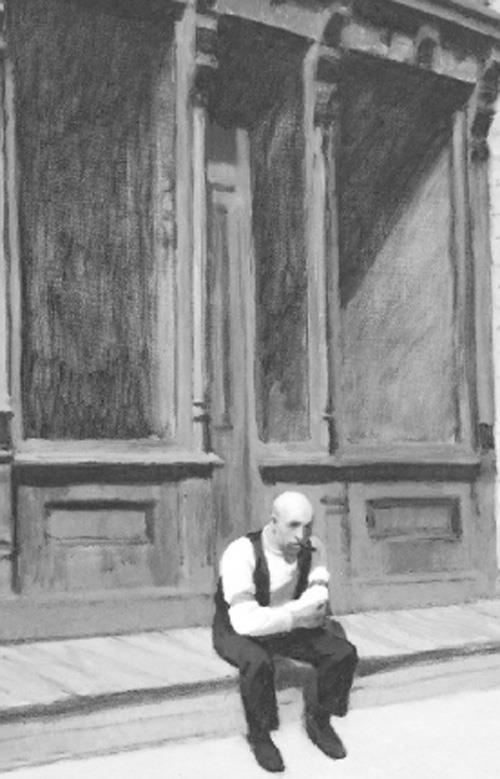
وهكذ لم يكن النَفَسْ الطيب يخلو من اللجاجة والاستظراف.
قلتُ لنفسي: كأن عمتى علية لم تمت ودفنتها فى مقبرة غريبة. ولولا النقيب سمير الذى تولى كل شئ، كل شئ، عندما رآنى منهارا، ولولا رجاء بنت الحلال، التى وجدتها هناك فى انتظارى فى طريق الفيوم، فى مقابر عائلتها بسيارتها ومعها شقيقها الذى عرّفتنى عليه، وقد فُتحت العين وتم تجهيزها بالفعل، لولاهما ماكان ممكنا أن أسترعمتي. لم أكن قد بكيتُ منذ سنوات، وهفوتُ بشدة، وهم يهبطون بها إلى جوف الأرض، أن أبكى دون جدوى. كنتُ أعلم جيدا أن البكاء والنحيب والصراخ ومناداة عمتى ورجائى لها ألا تتركني.. كنتُ أعلم أن كل هذا سيصفّينى ويريحني، لكننى لم أستطع. سنوات وسنوات مرّت عليّ دون أن أبكي، بل لاأستطيع أن أتذكر آخر مرة بكيتُ فيها، ومتى تحجرت مشاعرى وبلغت مبلغا من القسوة التى تحرمنى من نعمة البكاء.
على الرغم من هذا فإن الطعام كان طيبا، بعد كأسين من النبيذ الأحمر احتسيتهما أثناء إعداد المائدة.
فيما بعد، لم أخبر أحلام بموت عمتي، بالطبع لم أخبر أروى، وحتى غادة لم أخبرها بعد عودتها. قلتُ فقط لنجوى فى التليفون. لحظتها انفجرتُ أنا فى البكاء والنحيب، وانتبهتُ فى اللحظة الأخيرة خائفا من أن تستيقظ أحلام وتسألني، فأعجز عن تفسير هذا النحيب. كتمت ألمى ونحيبي. سيطرتُ على مشاعري، لكننى لم أتمالك نفسى فى نهاية الأمر، و مضيتُ أنشج بهدوء ثم استسلمت للبكاء، ولشدّ ما أدهشنى ما شعرتُ به من راحة، بينما نجوى تطيّب خاطري.
(3)
لم أتردد لحظة واحدة فور أن تلقيت الخبر. أجّلت افتتاحيتي، وفكّرت على الفور فى واحدة جديدة استعيد فيها العنوان القديم” حياتى فداء للوطن” وأغيّر الضمير:وبدلا من حياتي، أكتب حياتنا.
كان ناجى الزهيرى قد تلقى تهديدا بالقتل من التنظيم ذاته ليلة أمس، بعد أسبوعين من تصعيده ووضع إسمه مديرا للتحرير على ترويسة الجرنان اليومي. تساوت الرؤوس وأمرت لجنة القيادة العامة بتأمينه، وتلقيتُ أنا واحدة من أقسى الضربات، بعد أن كنت قريبا من الوصول للنهاية المرتقبة. باختصار ووضوح أصبح هناك مرشحان لرئاسة المؤسسة: أنا وناجى الزهيرى الذى هبط بالمظلة، أو أنزلته لجنة القيادة العامة، أو جناح مازال مجهولا لى فى اللجنة، وحشرته فى ترويسة الجرنان اليومي، ومازاد الطين بللا على رأسى تهديد تنظيم الأنصار باغتياله ثم صدور الأمر بتأمينه. أكثر من هذا، لقد فقدتُ ميزتى التنافسية وانفرادى على مدى أربعة شهوربالحماية الخاصة.
الحقيقة أننى فوجئت ولم يكن فى حساباتى مطلقا أن تتغير موازين القوى بينى وبين ناجى الزهيري، ولم يكن هو نفسه فى حسباني، منذ حسم اللواء الفولى الصراع بينى وبينه قبل أربع سنوات، عندما توليت بناء الوطن وانطلقتُ بها، مخترقا كل التوقعات، وحققتُ نجاحا تكلل بالتهديد باغتيالى ثم تأمينى قبل الزهيرى بأربعة شهور.
الصحيح هو ما استقررتُ عليه.
يجب ركوب الموجة وامتصاص الصدمة وعدم الاستسلام لمحاولات تصفيتى من جانب ضباع الداخل ومن يساندهم فى اللجنة، بل ومن جانب ذئاب الخارج الذين أصدروا بيان التهديد باغتيالى من قبل.
وهكذا عكفتُ على تغيير الافتتاحية التى كنت قد كتبتها فعلا، استبعدتها تماما ودبّجتُ واحدة جديدة، استعدُت فيها عنوانى القديم الذى كنت قد استخدمته فور صدور بيان التنظيم بالتهديد بقتلى قبل أربعة شهور، مع إجراء تعديل بسيط لكنه ضروري: حياتنا فداء للوطن بدلا من حياتى فداء للوطن.
بادرت بتوجيه التحية لرفيق السلاح الذى تشرّف بالانضمام إلى جنود الوطن المخلصين المستعدين للشهادة، وأحد أبناء بناء الوطن، الكاتب الكبير ناجى الزهيري، الذى هدّده التنظيم المجرم بالقتل، وأكدّتُ أن كل العاملين فى بلاط صاحبة الجلالة الصحافة، وليس أبناء بناء الوطن فقط على استعداد لفداء بلادنا بدمائهم، بل يتمنون نيل هذا الشرف. وعلى الرغم من أنه لم يكن واضحا السبب المباشر فى غضب تنظيم الأنصار على الزهيري، إلى حد إصدار بيان يتضمن التهديد بالقتل، ألا أننى أسرفتُ فى جمل مرسلة، تعلّمت أصولها من عمى ممدوح، الذى أمضى عدة عقود يكتب عمود الرأى السياسى لأكثر من صحيفة، دون أن يصدر عنه فى الحقيقة رأى محدد، وبكفاءة جعلته أحد كبار الأسطوات فى هذا الفن. نسجتُ على منواله كلاما، كله إشادة بوطنية الزهيرى وشرف الزهيرى ومواقف الزهيرى والمعارك الضارية التى لم يتوقف عن خوضها دفاعا عن الوطن دون أن أذكر شيئا محددا. وأشرتُ إلى أن الزهيرى أحد أنجب أبناء عهد الاصطفاف، ولنا أن نفخر- هو وأنا- بأننا فى طليعة المقاتلين الجاهزين للشهادة. وهكذا أضفتُ إسمى لأذكرّ من نسى، ومن طرف خفي، بأننى سبقتُ الزهيري. وانتهيتُ إلى القول أننا- الزهيرى وأنا- نعاهد القيادة السياسية على مواصلة رسالتنا حتى لو كان الثمن هو حياتنا، فحياتنا فداء للوطن.. وهكذا اختتمتُ افتتاحيتى بجملة تتضمن العنوان نفسه، عنوان الافتتاحية، فى لعبة لايتقنها إلا المحترفون، وقد اشتهرتُ أنا بها فى مقالاتى وافتتاحياتي.
أكثر من هذا، وعلى الرغم من أن الزهيرى الكلب (إبن دولة الاصطفاف كما أطلق على نفسه) لم يكلّف نفسه ويتصل بى عندما تلّقيت التهديد ذاته ونلتُ الشرف نفسه من قبله، على الرغم من ذلك بادرتُ أنا بالاتصال به. قلتُ له إننى أهنئه بهذا الوسام والشرف الذى ناله.. وما إلى ذلك من كلام، ثم قفزت على الفور إلى ذهنى فكرة بدت لى جذابة:أخبرته أننا فى بناء الوطن سنصدر ملفا حول هذا الحدث الحافل فى العدد القادم، ودعوته بهذه المناسبة للإسهام معنا بما يراه مناسبا، فالملف الذى نعده مفتوحا، بمعنى أنه قد يستغرق صفحات العدد بكامله، وقد قمنا بالفعل بتأجيل مواد العدد الحالى التى كانت جاهزة للطبع، وبدأنا فى عدد جديد يسعد بناء الوطن أن تستضيفه فيه.
طبعا كنتُ أعلم جيدا أنه لن يسهم معنا، وبالتأكيد سيفسح له الجرنان اليومى المجال للاستحواذ على أى عدد من الصفحات، وهو نفسه سيقوم باستكتاب وجوه بارزة، وسيقيم حفلا صاخبا يستمر إلى ماشاء الله ليهيل التراب على الشرف الذى نلته قبله.
ومع ذلك الشغل شغل والأصول أصول.

كنتُ قد بادرت بإبلاغ رجاء بالدعوة لاجتماع فى الثانية عشرة ظهر اليوم، وقبله طلبت منها أن تتصل بالولدين الشاطرين كريم وهبة وطارق حسان وتستقدمهما فورا، فأبلغتنى أنهم موجودان بالفعل فى مكتبيهما. جاء الشابان معا، وهى بداية جيدة، تفتح شهية الواحد للعمل ولم أستفض فى الشرح والكلام الكثير فهما مدربان ويعرفان شغلهما جيدا. غادرانى فطلبت فايز وهبة مديرالتحرير، وعقدتُ معه اجتماعا مصغرا اتفقنا فيه على الخطوط العريضة. لاحاجة للقول إن علينا أن نتجنب تكرار ما نشرناه فى الأعداد التى أعقبت التهديد الذى تلقيته، ووزعنا الشُغل حتى لانطيل وقت الاجتماع المقرر اليوم، وسوف يقتصر على إبلاغ المحررين بالتكليفات.
وبعد أن غادرني، فكّرتُ فى منقذى الذى طالما سندنى ووقف فى ظهري، وهو أرشيف عمى ممدوح. سأسهر الليلة معه وأستخرج منه كنوزا جديدة تختلف عن أمراء الدم وتاريخ الدم وتنظيمات الدم ومآلات الدم، وغيرها من الملفات التى استخدمناها عدة مرات بصياغات وتحويرات مختلفة.
الشغل شغل والأصول أصول على الرغم من أن كل هذا التعب سيصب فى مصلحة الزهيرى الذى كان يردعليِّ من طرف أنفه، عندما كنت أهنئه منذ قليل، إلا أن المهنية ومصلحتى الشخصية أيضا تقتضى إيلاء هذا الحدث كل اهتمام، حتى لو وصل الأمر إلى تخصيص كل صفحات العدد القادم له.
اتصلت برجاء التى فتحت الباب بسرعة. رمقتنى قليلا قبل أن تقول:
«ولايهمك ياسالم بك.. المهم صحتك.. أنا شايفة رقبتك محتاجة للكريم.. ناولني( الجزال) لوسمحت..»
فتحتُ الدرج وناولته لها، وباليد الأخرى رحتُ أفك زرار القميص العلوي، فتقدمت هى وأبعدت يدي. تولّت المهمة مائلة عليَّ أشعر بها تلامسنى بجسمها.. سحر يارجاء.. أصابعك سحر يسرى فى جسمي.
أغمضتُ عينى وملتُ برأسي.
(4)
أرتبك وأتخبط وأفقد الاتجاه فى اليوم الذى تغيب فيه رجاء عن المكتب، وهو أمر من النادر حدوثه فى الحقيقة. اتصلتْ بى وأنا فى السيارة فى طريقى للمجلة لتعتذر..إبنها ارتفعت حرارته فجأة فى الليلة الماضية، ثم أصيب بإسهال ولم تنفع معه السوائل والمخفّضات، واضطرت للذهاب به للطبيب ولم تغفل طوال الليل، ومازالت مستيقظة.. إلى آخر ذلك. أنا أصدقها فهى لا تتأخرعنى مطلقا، خصوصا فى هذه الأهوال التى أعيشها وتعيشها معى فى بناء الوطن منذ أكثر من شهر، لذلك طمأنتها وتمنيتُ للولد أن يعود للشقاوة والمشاكل الصغيرة التى كان يثيرها فى كل مكان يحلّ فيه، حسبما كانت تحكى لي. طلبتُ منها أن تبقى بجانبه حتى تتأكد من شفائه، ولاتحمل همّا للمكتب، وانتهيتُ إلى أننى سأتصل بها فيما بعد لأسأل عليه.
لم يفتنى بالطبع مابدا على وجوه أفراد الأمن والاستقبال، عندما هبطتُ من السيارة أمام باب المؤسسة من تجاهل.. هل هو تجاهل؟ هل هو عدم اهتمام أم أننى أتخيل هذا؟ هؤلاء الناس لايتصرفون من دماغهم، وليس ضروريا أن يتلقوا اوامر محددة بشأن التعامل معي، لكنهم يشمّون رائحة المغضوب عليهم.. يتشممونها من بعيد، ويتصرفون وفقها. ولكن هل أصبحتُ أنا بين يوم وليلة من المغضوب عليهم؟ ماذا فعلت؟ طبعا من الوارد جدا أننى واقع، وسوف أقع، تحت تأثير الهلاوس وكوابيس اليقظة. وفكّرتُ فى صالة الطابق الأخير، تلك التى يُلقى بها من يرتدون البيجامات مبكرا، وينتقلون إلى هناك، يجلسون قليلا ويقلّبون فى الصحف، ثم يدخنون ويشربون القهوة، وبعد ساعة أو اثنتين على الأكثر، كما لاحظتُ، يعودون أدراجهم يسيرون الهوينى دون ان يحفل بهم أحد. يستقلون المصعد حتى الطابق السفلي، ويتلفتون حولهم وهم فى طريقهم إلى الخارج. فكرتُ أيضا أن حتى نهاية كهذه تبدو بعيدة المنال بالنسبة لي، وإذا كان البادى هو تصعيد ناجى الزهيري، سواء للمجلة أو الإصدار اليومي، فإن الإجراء الممكن اتخاذه بشأنى مازال غامضا.
على الأرجح أنا لست من المغضوب عليهم، قد تكون لجنة القيادة العامة وفقا لشواهد عديدة، رأت أنه من الأنسب ان تتوقف عن دعمي، وتستقبل الحصان الجديد، وهو ماجرى مع آخرين، بل ومعى عندما توليتُ بناء الوطن، فقد تم استبعاد سلفى ماهر سلامة وارتدى البيجامة مبكرا لإخلاء المكان لي. وربما تكون اللجنة الآن تقلّب الأمر على وجوهه لتحسم أوضاعى الجديدة، حسبما جرى وشاهدته مع آخرين كانوا ملء السمع والبصر، ومع ذلك فإن لى وضعا بالغ الخصوصية: أنا أول من تلقى تهديدا بالاغتيال فى هذا البلد، ومازلتُ معلّقا فى رقبة القيادة العامة رغم أنفها.
وبدا لى أن أن ماكنتُ أعتبره بالأمس توفيقا من السماء، ومكافأة مستحقة ومنتظرة على خدمتى وتفانيى لسنوات وسنوات، عندما صدر القرار بتأميني، بدا لى هو العقبة الوحيدة أمام خروج آمن أستحقه أيضا، مادام لامناص ولا مفر من الخروج. صحيح أنه غير متوقع، لكنه بات بعيد المنال وأتمناه. فكّرت أيضا فى أن الدنيا لن تسعنا معا أنا وناجى الزهيرى تحديدا، فالسباق والثأر بيننا قديم، ومنذ سنوات كنا معا نتزاحم على باب المجلة حتى حسم اللواء الفولى السباق لصالحي، والآن..
لماذا كل هذه الهلاوس ياسالم فلم يحدث شئ محسوس حتى الآن؟وكلها إشارات تحمل المعنيين معا فى الوقت نفسه. الدنيا تسعكما أنت والزهيري. نعم.. من الممكن أن يتركوك فى بناء الوطن، ويقومون بتصعيد الزهيرى لرئاسة المؤسسة، وليس من الضرورى أن يكسروني، على الأقل فى الوقت الحالي، فما زلت حتى الآن فى عُهدة لجنة القيادة العامة، ربما لايعتبروننى الآن فى معيتها، لكننى فى عُهدتها، وإذا قام تنظيم الأنصار بقتلى فسوف تكون فضيحة لهم قبل أى شئ.
عدتُ أتمنى الخروج الآمن الذى يكفل لى أنا وحبيبتى نجوى المريضة والبعيدة عنى الآن، حياة هادئة ورخية، وأغمض عينيّ وأنا فى حُضنها. نجوى مريضة. نزلة البرد الصيفية الرذلة اللزجة، طرحتها أرضا وعصفت بها منذ ثلاثة أيام. أتصل بها يوميا مرتين، ولا أشعر من صوتها بأى تحسن، بل على العكس بدا لى أن حالتها تسوء. والرائد أيمن أذن من طين والأخرى من عجين مهما اتصلت به، وعندما استجاب بعد إلحاح منى فى الرد عليَّ، طلبتُ منه السفر للإسكندرية لساعة واحدة، فأجابنى بتأفف واضح أنه سيسأل ويجيبنى بعد ان يتلقى ردا، ثم زفر بقوة وأغلق السكة، قبل أن أتمكن من إبلاغه بمرض نجوى وضرورة سفرى لها.
خرجت من المصعد وحيدا، فقد تركنى النقيب سميرعلى الباب. دخلت مكتبى أدوس على قدمى المعقورة بخفة. لم يغادرنى الآلم على الرغم من مرور أسابيع على عقرة الليل الغادرة. أفتقد رجاء وزقزقتها وقربها مني. جاءت القهوة، وأشعلت سيجارة بعد توقف دام أربعة أيام، واستسلمتُ للدوار والتحليق. فكّرتُ فى أن الأرقام التى قرأتها فى التقرير الأخير الذى وصلنى من “ التوزيع” حول حركة العدد الصادر لتوّه من بناء الوطن مثيرة للإحباط والخوف. لقد فقدنا مايزيد كثيرا عن الألف نسخة، وكنا قد فقدنا نحو ألفى نسخة فى الشهور الأخيرة، على الرغم من كل مابذلناه من جهود أسطورية. لم نقصّر.. بل على العكس أبدعنا واخترعنا، ولو كان القراء أحجارا صماء، لانتفضوا وتسابقوا للاستمتاع بما قدّمناه من وجبات ترضى كل الأذواق. ماذا أقول؟
أنا وزملائى لم نقصّر، وأنجزنا أعدادا تشهد على الشطارة والتفاني.
من جانب آخر، عليَّ أن أعترف أن المهرجان المصاحب لتهديد ناجى الزهيرى بالاغتيال، فاق وتجاوز ما جرى لي. حتى أنا وبناء الوطن شاركنا فى السيرك المنصوب، ولم يكن ممكنا لنا ألا نشارك طبعا. استولى الزهيرى على أغلب صفحات الجرنان اليومي، واستكتب المتنفذين، أو كتب باسمهم بعد اسئذانهم طبعا. ومع ذلك، أشهد أنه شاطر وحرّيف. يخترع كل يوم، كل يوم، مادة جديدة ويشتغل عليها، ومعه اثنان من أمهر الديسكمانات. زاملتهما من قبل وأعرف جيدا إلى أى مدى يمكن لهما أن يصلا، فجَلَدهما على الشُغل مثلا كان يمتد لساعات: أحمد زين وماهر داود، أما شطارتهما فهما لا يُعلى عليهما.
كل هذا ليس مهما ياسالم. أنت تهرب مما ينتظرك. هناك ثقب أسود يوشك على ابتلاعك، وهاهو الزهيرى أو الثقب، يهمّ بالقفزعلى الغنيمة التى كنت قاب قوسين، كما يقال، من تلقيها بين ذراعيك، وهى حق لك وتساوى جهودك وتفانيك.
المهم أن تمنع نفسك ياسالم من ارتكاب الحماقات. لقد كنت، ويجب أن تظل، مَثَلا للانضباط والإخلاص للجنة القيادة العامة، وكنت مضرب المَثَلْ، واللجنة من جانبها أولتك عنايتها، ولطالما أغدقت عليك.. اللجنة لن تنساك ياسالم..
ومع هذا، فكّرتُ فى التسلل للطابق الأخير وإلقاء نظرة خاطفة على مستقرى المنتظر، ثم العودة بسرعة قبل أن يلمحنى أحد. لكن قيامى بهذا يستلزم ركوبى المصعد من طابقي، الرابع، كما أنه يستلزم أيضا مرورى على الطابق السحري، حيث مكاتب الرائد أيمن ومن معه، حتى لو كنت مستقلا المصعد.
فكّرتُ فى الليلة الماضية فى التسلل والهرب لساعات إلى الإسكندرية، بل وهبطتُ فعلا إلى المدخل، لكننى تذكرتُ أنه يُغلق، وكل ساكن معه مفتاح، حسبما تقرر بعد فرض تأميني. هل تجرأتُ حقا وهبطت إلى المدخل؟ وإذا كنتُ قد هبطت بالفعل، فهل ركبت المصعد من طابقى للطابق السفلي؟ لاأتذكر.. الحقيقة أننى بدأتُ فى فقدان الذاكرة، وهو أخطر مايمكن أن يصيبني.على العموم ربما كنت أبالغ كعادتي.
اتصلت بى الآن غادة. احتجتُ وقتا لأتذكر أننا كنا اتفقنا على أن تمر عليَّ هنا فى بناء الوطن لتودعنى قبل سفرها عائدة إلى واشنطن، فقد غادرتُ البيت فى الصباح، بينما كانت هى قد أمضت ليلتها الأخيرة عند أروى، واتفقنا أن تمّر مرورا خاطفا، قبل أن تواصل إلى المطار. قالت إنها تأخرت على موعد الطائرة، وأضافت كلاما لم أتبينه جيدا، لكننى فهمتُ أنها تودعنى فى التليفون، وأنها فى طريقها للمطار بالفعل.
طلبتُ قهوتى الصباحية من البوفيه، وهى المهمة التى كانت تتولاها رجاء يوميا، واستطعتُ بعد لأى تأجيل السيجارة الأولى لأشعلها مع ارتشاف القهوة.
(5)
على الرغم من أن الصورة لم تكن ممهورة بخاتم ابراهيم فاروق، إلا أننى شعرتُ بإحكام التصميم والمنظور الذى يميّزه، ولطالما برع فيه فى صور أخرى ممهورة بخاتمه، آلت لى جميعها بعد أن تسللت بأرشيف عمى ممدوح إلى بيتى غداة رحيله. لطالما تأملتها، وأعدتُ تأملها، بل وأتيح لى نشرها مرة واحدة إبان الفوضى فى أحداث 25 يناير قبل سنوات طويلة. وظلّت قريبة منى ألقى نظرة عليها بين الحين والآخر.كانت الصورة جانبية للضباط الثلاثة الواقفين كل منهم بجوار الآخر، وتجلّت براعة المصور فى إظهار الملامح الواضحة للبروفايل، للمنظر الجانبى لكل واحد منهم، وقد رفع ذراعه ومدّه على استقامته، وهو يقبض على الطبنجة ويصّوب فى اتجاه الهدف، فلكل منهم هدف انتصب على مسافة قريبة فيما بدا أنه صالة صغيرة للتدريب على ضرب النار، ويفصل بين كل ضابط وآخر حاجز شفاف.
كانوا متشابهين على نحو من الأنحاء بسبب ارتداء كل منهم لنظارة غامقة، وبسبب سدادات الأذن السوداء التى تغطى آذانهم وتحيط بها جيدا. سمحت اللقطة البارعة حقا فى أن يكون لكل منهم مساحة مساوية للآخر، كما سمح بأن تراهم متتالين واضحين الواحد تلو الآخر.كل واحد ملامحه واضحة بالقدر نفسه، ولاأحد طغى على الآخر. كانوا كأنهم فى نزهة، والحبور الممزوج بقدر من السخرية القاسية بادٍ على وجوههم.
الضباط الثلاثة كانوا من مجلس القيادة، بل من أبرزهم. أولهم صلاح سالم الذى كان معروفا بجنونه المطلق واشتهرت عنه واقعة خلعه كامل ملابسه ورقصه عاريا فى جنوب السودان، ليتشبه بأبناء الشعب حتى يكتسب ثقتهم ويصوّتون للوحدة مع مصر، عندما كان مسئولا عن ذلك الملف، ملف السودان قبل انفصاله عن مصر. كان صلاح سالم فى مقدمة الصورة يرتدى بوكسر، نعم بوكسر كاشف وفاضح لنصفه السفلي، وعلى أذنيه كاتم الصوت، وقد مدّ ذراعه مستقيمة والطبنجة فى قبضته يصوّب نحو هدف حرصت الكاميرا على إظهاره. بجواره يقف جمال عبد الناصر رئيس مجلس القيادة، ببنطلون وفانلة داخلية بحمالات يصوّب نحو الهدف، وبجواره الضابط عبدالحكيم عامر الذى كان قد رُقّى لتوه وأصبح قائد الجيش، يصوّب بدوره ضاحكا وقد ارتدى شورت. كان هو الوحيد الذى يضحك وقد ضيّق مابين عينيه.

لم أستطع أبدا أن أجيب على السؤال أوالأسئلة التى طرحتها الصورة: هل كان هؤلاء الضباط الذين كانت مهمتهم وطبيعة عملهم تحتّم عليهم أن يكونوا مدربين على القتال، وهم الذين كانوا قد قاموا بحركتهم الناجحة قبل سنوات، هل كانوا مدربين أصلا؟ وإذا كانوا غير مدربين، فلماذا اجتمع هؤلاء الثلاثة تحديدا للتدريب فى ساحة غامضة كتلك؟ هل كانوا قد قرروا التآمر وحدهم مثلا، وهم الذين كانوا يحكمون البلد آنذاك؟ وماهى ظروف التقاط صورة كتلك بغض النظر عن إحكام التصميم وبراعة اللقطة؟
على أى حال، لطالما تأملت هذه الصورة النادرة، ولطالما حلمت بامتلاك طبنجة أدافع بها عن نفسي، بعد أن تخلى عنى الجميع. ولشدّ ما أقلقنى اختفاء الصورة فجأة بعد أن كانت أمامى طوال الوقت. وعلى مدى عدة أيام، فلم أعد قادرا على أن أتذكر بدقة أين تركتها، كنت أبحث وأنقّب وأنبش فى أوراق الأرشيف وأدراج المكتب وخلف مقعدى فى المكتبة بمجرد عودتى دون جدوى. نهشنى القلق، ولم يكن بوسعى تحمل المزيد بعد أن توقفتْ نجوى عن الرد على هاتفها، عندئذ اضطررت للاتصال بابنتها دينا، ولم تردّ دينا. ظللت أفعل هذا على مدى الأيام الثلاثة الماضية: أتصل بنجوى فلا ترد، فأتصل بدينا فلا ترد. فى نهاية الأمر، عثرت على الصورة بالمصادفة، أما نجوى ودينا فلم يرد عليّ أحد منهما.
(6)
رسمتُ الخطة كاملة فى ذهني، وحرصتُ على ألا أترك أى مجال للمفاجآت. تسللتُ فى الليل إلى المؤسسة، وصعدتُ على السلّم الجانبى حتى الطابق السحرى بين السابع والثامن، واتخذتُ طريقى إلى مكاتب أمن لجنة القيادة العامة. رحتُ أبحث هنا وهناك حتى وجدتُ قضبانا خشبية محفورة فى الحائط تحفل بأسلحة من كل نوع. رشاشات وطبنجات وبنادق، لكن الأكثر غرابة أننى وجدتُ سيوفا وخناجروقنابل متنوعة، قدّرت أن بعضها قنابل يدوية معدة للانفجار، بينما قدّرت أن بعضها الآخر قنابل مسيلة للدموع. احترتُ قليلا ثم حزمتُ أمرى وأخرجت طبنجة أستطيع أن أتحكم فيها فى كفي.
وفى الصباح، انتظرتُ مدة كافية بعد أن مرّ الوقت الذى اعتاد النقيب سمير المرور عليّ فيه، تأكدتُ من أنهم قد اتخذوا قرارهم بالفعل وسوف أرتدى البيجامة وأبقى فى العراء لتعقرنى الذئاب بعد أن نهشتنى الضباع.
اتصلت بالنقيب سمير فلم يرد، فاتصلت بالرائد أيمن ولم يرد أيضا..
وبينما أجلس على المقعد الذى اعتدت الجلوس عليه فى الصالة ضجرا ملولا بسبب تأخر النقيب سمير، ازاحت أحلام الستار الذى يفصل بين الصالة وبين الجزء الداخلى من الشقة وراحت تنظر لى مليّا. أطالت النظر دون أن تتكلم. رفعتُ عينى إليها. بدت غامضة قليلا فى العتمة الخفيفة، ثم راحت ملامحها تتضح رويدا. كان هناك مايشى بالتشفى ربما، أو السخرية فى عينيها ووقفتها المائلة. طال صمتها، وطال وقوفها أيضا. بدّلت وقفتها، لكن عينيها ظلتا مصوّبتين نحوي. تتقصع وتتعولق لكن جسمها لايطاوعها بالطبع ولايساعدها على إتقان محاولة الغواية الساخرة، فكانت تشبه القرد على نحو من الأنحاء. عندئذ وجدتنى أخرج الطبنجة من جيب بدلتى الداخلى بجوار صدرى وعاجلتها بطلقتين متتاليتين. خُيّل لى أنها ابتسمت بسمة أكثر تشفيا قبل أن تسقط بجوار الباب.
نهضتُ بهدوء وأمسكت بحقيبتى بعد أن أعدت الطبنجة إلى جيبي.ولشدّ ما أهشنى أنها كانت ساخنة جدا بل ولسعتنى الفوهة عندما لامستها. خطوت فوق أحلام حريصا على ألا أحتك بها، ولسبب ما ألقيتُ نظرة على حجرة النوم، ثم عدتُ أدراجي. أغلقتُ باب الشقة خلفى بعد أن تجاوزته. ركبتُ المصعد إلى الطابق السفلي. كان المدخل خاليا والمقعد الذى كان حارسى دائم الجلوس عليه فارغا. أين ذهب هو وزميله الذى اعتدتُ إن أرسل له هو وزميله على مدى عدة شهور وجبات محترمة من مطعم شهير هنا فى كومباوند العهد الجديد؟ فتّشتُ فى المدخل، وخرجت لأبحث بعينى حول المبنى.. وهكذا تأكدت أننى ارتديت البيجامة وتم الاستغناء عنى دون أن يبلغنى أحد من كل هؤلاء الكلاب بما ينتظرني.
لمحت سيارتى التى كنت قد تركتها لأحلام منذ تأمينى أمام البيت. مازلت أحتفظ بمفتاحها. ركبتُ وقدتُ ببطء واستمتاع. حتى الآن أنفّذ بدقة الخطة التى كنت قد رسمتها، باستثناء قتل أحلام التى بادرت هى بالتحرش بى فأرديتها ونالت جزاءها.
وصلتُ المؤسسة ووجدت مكانا أركن فيه سيارتي. أعرف طريقى جيدا. ركبتُ المصعد إلى الطابق الثالث حيث مكتب ناجى الزهيري. عبرت من أمام سكيرترته وفتحت الباب. كان جالسا إلى مكتبه يشتغل على لابتوب مفتوح أمامه. فتح فمه يكبح ابتسامته الساخرة التى كان يخصصها لى كلما قابلني. طلقتان متتاليتان أجهزتُ بهما عليه. ولما رأيته يسقط مضرجا فى دمائه فعلا، أى أن الدم كان يتدفق من دماغه ويغطى صدره، استدرت عائدا، وأنا أكثر حرصا هذه المرة على ألا تلسعنى ماسورة الطبنجة.
استقللتُ المصعد إلى الطابق السابع لأنفّذ الجزء التالى من خطتي. انتويتُ وخططتُ من قبل للصعود للطابق السابع الموعود، بعد أن أنهى مهمتى فى الطابق الثالث، لقتل كل من الرائد أيمن والنقيب سمير. ولما لم أجد أيا منهما، ولاغيرهما، فقد كانت المكاتب خالية، استدرتُ عائدا مرة أخرى. تصاعد الألم واشتد وأنا أدوس على ساقى المعقورة، وأصلّب رقبتى التى كانت تؤلمني. أبطأت من سيرى قليلا وحاولت تثبيت رقبتى ومنعها من الاهتزاز مع حركة جسمي.
حتى الآن أسير وأتصرف حسب الخطة فيما عدا أحلام، ولكن هى التى بادرت بالهجوم وإظهار الكراهية والتشفى فاضطررت اضطرارا لقتلها، بينما لم أستطع تنفيذ الجزء الخاص بكل من الرائد أيمن والنقيب سمير، فهما لم يكونا موجودين.
عدت أقود بالبطء نفسه نحو نفق شبرا. قطعتُ هذا الجزء من شارع رمسيس بكل ثبات وسط الزحام.. لا ليس زحاما.. أنا فى حرب وعادم وصراخ وزمامير وكلاكسات واختناق من جراء درجة الحرارة المرعبة التى تلسع المقعد وعجلة القيادة وتابلوه السيارة. تتوقف جيوش السيارات والموتوسيكلات قدّام الإشارات، وعندما تفتح وترى اللون الأخضر، تزحف كل تلك الوحوش، فأزحف معها وانحرف يسارا عند مستشفى الهلال، ثم يمينا إلى النفق حيث أتنفس قليلا، وأنحدر مع انحدار النفق، وأعاود الصعود مع صعوده. هل هذا نفق شبرا العظيم الذى كان يملأ الدنيا نظيفا على الدوام بحاراته الواسعة للترام وحارات أخرى للباص والملاكى والأجرة والدراجات والموتوسيكلات؟.. ضاق وضاق وبدا كأنه دودة تتلوى والزحام يخنقها.
هالنى عندما توقفتُ هنا وسط هذا الذى كان أوسع ميدان يربط بين شبرا وسكة حديد الصعيد وكوبرى باغوص وغمرة من ناحية، وبين السبتية وجزيرة بدران وروض الفرج من ناحية أخرى.. هالنى أننى لاأثق فى قدرتى على الوصول للحكيم برسوم المجبراتى بالسيارة. لقد تبدّلت الشوارع. ضاقت وضاقت وغيّبها الغبار والحرارة التى ازدادت، وأمست بالغة القذارة والناس يخوضون فى أكوام القمامة فى كل مكان. لن أستطيع الوصول إلى بيته مستقلا السيارة. الحل إذن أن أتركها هنا بالقرب من النفق. وجدت بصعوبة مكانا يسع السيارة بالكاد، وأغلقتها جيدا ومضيت.
كنتُ قد ترددت على الحكيم برسوم مرات عديدة ربما حتى الثانية عشرة. كان يتابعنى ويغيّر أماكن ومواضع الجبائر الخشبية ويفحص الكسر الذى أصبت به ويتابع الالتئام الذى ظل يؤرق أمى وعمتى علية، وكثيرا ماكانت إحداهما تصطحبنى عنوة لأن ساقيّ ظلا غير متماثلين حتى بعد الجبائر التى دأب على تغيير مواضعها على مدى سنوات، لكننى فى نهاية الأمر شُفيت. نعم.. شُفيت. التأم الكسر.. وظلّت هذه الحكاية على لسان عمتى علية وأمى تحكيانها وتعيدان وتزيدان فيها، وكلما ظهر أى واحد يعانى من عظامه، توجهانه للحكيم برسوم المجبراتى الذى تجرى على يديه المعجزات.
انحرفتُ فى أول شارع على يساري، لكنه لم يكن الشارع الذى عرفته فيما مضى. شعرتُ بالخوف. أكره أن أتوه. أتوه فى شبرا؟ كيف؟ شبرا التى أمضيتُ فى حاراتها وشوارعها عُمرى.. كيف أتوه فيها؟ تذكرت طريقا آخر يقودنى للحكيم برسوم. لمع فى خيالى بقوة. عدت أدراجى إلى شارع شبرا. كانت ساقى المعقورة تؤلمني، لكننى كنت مصمما على الوصول، وانتبهتُ إلى رقبتي، وقلتُ لنفسى إن عليّ أن أكون أكثر حرصا فى حركتي، على الأقل حتى أصل إلى الحكيم برسوم الذى سيعالجنى بالتأكيد ويريحنى من ألم طال وماينفك يزداد. تجاوزت المكان الذى كانت تشغله سينما “ دوللي” ذات السقف الذى يفتحونه فى ليالى الصيف، ثم انحرفت يسارا بجوار المكان الذى كانت تشغله سينما الجندول الصيفية. كان مكان السينما قد تحول إلى مقلب للقمامة. تحاملتُ على نفسى وولجتُ إلى شارع فؤاد الوسطانى الضيق، وعندما وصلت إلى سور مدرسة المعلمات، أحسستُ بالارتياح. لم تبق إلا خطوات حتى أصل إلى شارع ابن الرشيد. واصلتُ طريقى مرة أخرى فى اتجاه مزلقان النجيلى الذى تمرّ على قضبانه كل قطارات الصعيد.
ذلكم شارع ابن الرشيد أهم شوارع جزيرة بدران والذى كان يزدان بعربات الآيس كريم على جانبيه ومحلات عصير القصب والمقاهي، لطالما سرتُ فيه بصحبة عمتى علية. هنا استوديو النجوم مازال قائما. لم أتمالك نفسى ووقفت أحدّق إلى الفاترينة الزجاجية علّنى أجد صورتى فى الشهادة الإعدادية أو الثانوية.. إلى هنا اصطحبتنى عمتى علية وأنا على أبواب امتحانات الشهادتين عندما طلبوا منى أربع صور 4×6.
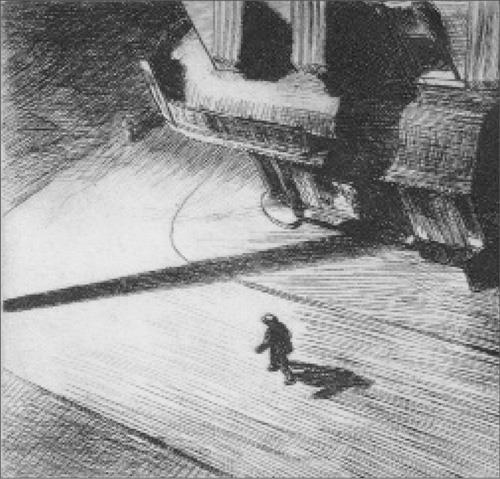
واصلتُ سيرى بصعوبة فقد كان الألم يزداد و يزداد وأنا أنقل قدمى المعقورة على الأرض. غمرنى العرق وشعرتُ به يتفصد من كل جسمي، فخلعت الجاكت وأحسستُ بالطبنجة فى الجيب الداخلي، وفكّرتُ فى أننى لن أستخدمها بعد ذلك حسب الخطة التى رسمتها، وعليّ أن أتخلص منها، ولشدّ ما أدهشنى وأبهجنى إننى وصلتُ أخيرا. لايمكننى أن أخطئ بيته، الحكيم برسوم، الذى يطل فى جانب منه على شارع ابن الرشيد، بينما بابه فى العطفة المجاورة.. وهكذا ولجتُ العطفة فرحا جدا ومبتهجا. توقفت لأخلع الكرافت.. ما هذا الجنون؟ لماذا ارتديت بدلة كاملة فى هذا القيظ؟ ربما لأنى مقبل على تنفيذ أهم خطة فى حياتي، وربما لأنى لم أجد سواها نظيفة أمامي، وكانت رجاء قد نبهتنى كثيرا فى الأيام الماضية لملابسى غير الملائمة التى أرتديها وأغامر بالذهاب بها إلى مؤسسة من المفترض أننى أحد رموزها.
تعرّفت بسهولة على باب البيت فى مدخل العطفة، وعندما دخلت رأيت عددا من النساء يتعاركن وقد أمسكن بتلابيب بعضهن. كن يتشاتمن صارخات يتزاحمن فى المدخل وعلى السلالم الأولى التى تقود إلى الطابق التالي، وأستطيع أن أراها من مكانى على الباب. لم ينتبهن لوجودي، وانخرطن فى شتائمهن المتبادلة ذاكرات أعضاء آبائهن وأمهاتهن الجنسية، يشخرن واصمات بعضهن البعض بفحش، إلا أن واحدة منهن سمراء وجسمها مبلل بالعرق وقد تمزقت ملابسها وكشفت عن ثدييها، لمحتنى بل وتوقفتْ عيناها العسليتان المغويتان عند عينيّ، وبدا لى كأنها مندهشة من وجودى وبدا لى أيضا أنها تبتسم لي. تعجبتُ من أنها لم تُفلت فرصة الغواية التى أتيحت لها، وواصلتْ نظراتها وغمزاتها، واستجبتُ أنا بقدر محسوب حتى لاتعطلّنى عن المهمة التى خططتُ لها، لذلك انشغلت ُبعددهن، وتعجبتُ من اهتمامى المفرط بعدّهن، على الرغم من أنهن كن يراوغنني، بحركتهن وتعاركهن وتنقلّهن واختفاء بعضهن على جانب من السلّم والمدخل الضيق.. على أى حال، ها أنا فشلت فى التوصل إلى عددهن، مثلما فشلتُ فى التوصل إلى أى خيط يقودنى لفهم هذه المعركة المندلعة أمامي. على العموم.. كل هذا لايهمنى.. مايهمنى هو صعودى للحكيم برسوم المجبراتى فى الطابق الثالث.
استجمعتُ عافيتى وأخذت شهيقا وزفيرا جيدا وولجتُ المدخل. شققتُ طريقى أصطدم بأجسامهن وأشم رائحة عرقهن العضوية القوية. ولما كانت وقفتى قد طالت من قبل، فقد كانت عيناى قد اعتادتا على العتمة. حاولتُ قدر الإمكان أن أنأى بجسمى وأسحبه بعيدا عن الاحتكاك بالمؤخرات والأوراك والصدور. بدا لى وكأنهن يفسحن مكانا لي. بدا لى وكأنهن ينتحين ويوسّعن مكانا لي، كأنهن يمكّننى من المرور، وفى الوقت نفسه كن حريصات على أن تستمر معركتهن.
وهكذا وجدتنى واقفا فى نهاية الأمر أمام شقة الحكيم برسوم المجبراتي. مافتننى فى حقيقة الأمر أن الباب كان مواربا، وشعرتُ أن المقادير تقف بجانبي، فلقد أوشكتُ على تنفيذ واحد من أهم أجزاء خطتي، وربما كان هذاهو الجزء الأخير قبل أن أشد الرحال إلى نجوى فى الإسكندرية.
دفعت الباب فانفتح عن الصالة الواسعة التى أعرفها، وعن السجادة المفروشة بلونها البُنّى الفاتح، وفى الركن الأيمن كان الدولاب المعمول من الصاج المطلى باللون الأبيض، وأمامه المنضدة الصاج أيضا، حيث تجلس إليها ابنته “ماري” التى أعرفها أيضا. لم يبدُ أنها عرفتني، فقد تطلعت إليّ بنظارتها البيضاء. أخرجتُ قيمة الكشف ودفعته، فانحنت على الدفتر وكتبت إسمي، ثم طلبت منى الانتظار.
عندما دخلتُ فى نهاية الأمر إلى الحكيم برسوم، فى الحجرة نفسها التى دخلتُ إليه فيها منذ أكثر من نصف قرن، وترددتُ عليه عدة مرات بعد ذلك فى أعقاب سقوطى من الطابق الثالث وأنا فى الخامسة من عمري.. عندما دخلت عليه وجدته كما هو لم يكد يتغيّر. يجلس على مقعد ضخم له مساند ويرتدى طاقية بيضاء تخفى رأسه تماما، كما يرتدى المعطف الأبيض نفسه فوق القميص الرمادي. أشار لى أن أرقد على الفراش العارى إلا من ملاءة متسخة، وانصعت، بعد أن كوّمت الجاكت بجواري. ضغط الجرس فدخلت ابنته ماري. أشار لى فخلعت البنطلون والقميص، لكننى حافظت على عورتى مغطاة، وكنت محرجا جدا من ابنته التى سبق لها أن شاهدتنى عاريا ولاشك عندما جئتُ هنا طفلا.
كان الحكيم برسوم أبيض الوجه باسما وسمينا يتحرك ببطء. انحنى عليّ وفحص ساقى المعقورة أولا. أحسست به يضغط على مكان العقرة جيدا ويحرك الركبة، ثم طلب منى الجلوس وساعدتنى مارى ولامست جسمى العاري، ولم يكن هذا مصادفة أبدا، لكن لم يكن بوسعى أن أستجيب على أى نحو.. الحكيم بنفسه يشتغل فى ساقى فكيف أستجيب؟.. ثم أفسحت مكانها متثاقلة للحكيم الذى تحرك ثم انحنى يتفحص رقبتي.عاد للجلوس على مقعده ذى الذراعين وهو يتنفس بقوة من أثر المجهود الذى بذله فى فحصي.
رفع عينيه لى وقال إن ساقى لن تنفع معها جبيرة، وسيقوم هو باستبدالها لى بساق أخرى، على أن أترك ساقى المعقورة ليتولى إصلاحها فى الورشة، أما رقبتى فسوف يستخدم معها جبيرة عليّ أن أحافظ عليها ستة أسابيع حتى يلتئم الكسر.
ودخلت مارى تجرّ منضدة صغيرة عليها الساق والأدوات والمباضع والجبائر وما إلى ذلك. وهنا نهض الحكيم وانخرط فى شُغله بكل همّة ونشاط ودون أن أشعر بأى ألم. ربما أكون قد استسلمت للنوم.. لا أعرف فى الحقيقة، لكننى انتبهت فى لحظة من اللحظات إلى مارى وهى تساعدنى فى ارتداء سروالى وقميصي. كنت تعبا جدا. نعم كنت مقتولا من التعب وجسمى يوشك أن يغادرنى وأجد صعوبة فى السيطرة عليه، ومن ثم أجد صعوبة فى التعامل معه وتوجيهه. أما ماري، فلشدّ ما أدهشنى أنها تغيرت إلى هذا الحد واستوت شابة جميلة بل وفاتنة، لم تنجح نظارتها البيضاء فى التقليل من فتنتها، خصوصا وأنها لامست جسمى العارى عدة مرات أثناء انشغال أبيها فى إصلاح عطبي.

اللوحات للفنان الأمريكى: ادوارد هوبر
أسندتنى هى واتخذتُ طريقى إلى الصالة وجلست إلى المنضدة الصاج فى الخارج. طلبت مارى أجرة شغل أبيها فدفعتها على الفور. أسندتنى مرة أخرى إلى الباب، وأدهشنى أكثر من أى شئ آخر قدرتى على نزول درجات السلّم وتحكمى فى ساقى الجديدة التى ركّبها لى الحكيم برسوم لتوه. وتذكرتُ أن هذا المكان كان ساحة لمعركة حامية وفظيعة بين جموع من النساء، من بينهن واحدة سمراء بادلتنى غزلاً فاضحاً منذ قليل، لكن المعركة كانت قد انتهت تماما.. تماما.. وهكذا اتخذت طريقى إلى الخارج. سوف أنقلب عائدا إلى شارع ابن الرشيد ثم شارع فؤاد الوسطانى إلى جانب مدرسة المعلمات، وأنحرف فى شارع شبرا حتى أصل إلى سيارتى التى ركنتها فى مكان ما، وأركبها وأقود إلى نجوى فى الإسكندرية.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
 الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني
الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني