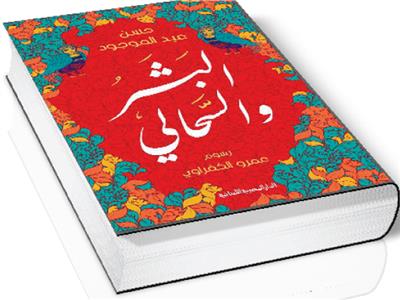
د.نيفين النصيري تكتب : كيف يلتئم العالي من اليشر والسحالي
عن «البشر والسحالي» أو كيف يلتئم العالم؟.. لحسن عبد الموجود
الإثنين، 04 أكتوبر 2021 - 12:36 م
يبدو عامل التشويق غالبًا على مجموعة حسن عبد الموجود القصصية الأخيرة «البشر والسحالي» الصادرة مؤخراً في طبعتها الثانية من حيث اللغة والأسلوب والمضمون يدفعك إلى التسارع فى قراءتها لمعرفة بقية الحكاية، وكثيرًا ما كنت أجد نفسى أمام فقرات تستوقفنى فاقرأها عدة مرات مثل: «الأعمى الأسوأ هو الشخص الذي لم يفقد بصره، ولكنه لم يغادر قريته ولم يعرف سوى نوع واحد او اثنين من الطعام والملابس، والآلهة.
هذا هو الأعمى الأسوأ حظا من كل البشر» (قصة «الكلب أعمى فى الغابة» ٤٦) أو هذه: « فى حياة ماضية بعيدة كنت جداً لهذا الحمار. بل جد أجداده. وقفت أمام سفينة نوح، غير خائف من ألا أجد مكاناً فى السفينة. نوح منظم، لم يسمح لنا بالتدافع. عرفت أنه لن ينساني، إذا نسينى سيحملنى الموج إليه، أو ربما تنبهه الحيوانات الطيبة فى الأعلى.» («الحمار. سعف ذهبى ونبيذ وأحذية قديمة» ١٢١). فتتسم المجموعة بفصاحة اللغة وعذوبة الحكى وعمق الفكرة. وقد يعتقد القارئ لوهلة أن الأفكار مألوفة، ولكن الكاتب يفاجئك بصور غرائبية أو غير متوقعة، صور تشكل نوعًا من الواقعية السحرية حيث تصبح الفنتازيا جزءًا من الواقع، كالمرأة
التى عرفت أنها ستلد قطًا ولم تكن مندهشة وكأن ولادة النساء للقطط أمرٌ طبيعى («القط: نصف نوبة حراسة”)، أو الساحرة التى تنظّف أجساد الأطفال من الدود بينما ينظّف الطبيب دماملهم، أو الجدة التى يعتقد أهلها أنها ماتت، ولكنها تنهض كل مرة فاعتاد أبناؤها موتها («الدودة: حديث دافئ فى المقبرة”)، أو عندما يتخيل الراوى نفسه نبيا ولكنه يقرر تأجيل نبوته لإصلاح ما افسدته السحلية التى مرت على عجين أمه الذى تركته ليختمر، فيقرر استبعاد السحلية من حيواناته المفضلة.
والمجموعة (وبالطبع الكاتب) لا تقبل التصنيف، فتمزج بين القصة والحدوتة والسيرة الذاتية والحكمة والاسطورة والتأملات الفلسفية.
وتدور كل الحكايات حول الكائنات المهمشة المستضعفة التى تعيش فى عوالم موازية معقدة، كالأب الذى فقد بصره وفقد معها ذاكرته أو الشاب الذى ظل يتبول لاإراديا فى سريره حتى الليلة الأولى من زواجه، أو الطفل المولع بالحمير والذى تخيل نفسه حمار المسيح يصل به الى أبواب اورشليم، أو جمعة الذى يحب أكل اللحم نيئاً كأنه حيوان فى غابة، أو الجدات والأمهات اللائى يتناولن النشوق لاختلاس المتعة ولو لثوان، او حتى الفراشات والقطط والكلاب والسحالى والتيس والهدهد، والجميع فى صراع أزلى للبقاء...
وهناك خيط سردى فلسفى يربط بعذوبة وقسوة فى آن واحد المجموعة وهو إبراز جوانب من اللاوعى الإنسانى تتجلى من خلالها طبعه الحيواني، فيمتزج عالم البشر بعالم الحيوان كأن واحدها امتداد للآخر. كالطفل الذى تغادر روحه جسده فى الليل ويتحول الى قط يتجوّل القرية ويرجع لأمه يحكى لها عما شاهده وسمعه عند الجيران وما يحدث بين الازواج فى غرفهم. وفى أحياناخرى تُشيَّد حواجز بين العالمين تُعكس ما قد يحدث بين البشر أنفسهم عندما يخلقون حدودًا وعوائق بسبب العرق أو المكانة الاجتماعية أو الدين: كالجارة المسيحية التى احبت الراوى كما أحبت ابنتها، ولكنها كانت تعرف حدود عالمها وتعرف أن مصير أسرتها معلق دائمًا على خطأ واحد فقط... ويصبح للحيوانات أحيانا خصال بشرية، كما يفضّل بعض البشر التصرف كالحيوانات. فيختلط التحضر بالبدائية: فحفلات التنمر الليلية التى تنصبها الكلاب للبشر والبشر للكلاب كأنهم فى حرب سيطرة على عالم الليل، كما ان «عضة الكلب قابلة للشفاء بينما عضة الانسان مميتة».
وتمكنت الحكايات جميعها من تفكيك وهدم الكثير من الأفكار المسبقة أو الأنساق الاجتماعية المفروضة والخرافات المترسخة في الذاكرة الجمعية وذلك من خلال صوت الراوى (او الراوية) العليم بغياهب النفس البشرية والحيوانية، فتجعلنا نعيد التفكير فى هذه المعتقدات والأفكار والطقوس والتى نتصورها ثابتةً لا تتزعزع، كرغبة الطفل المهووسة لأكل الخنزير، أو قسوة الاطفال عندما يقذفون الكنيسة في قريتهم بالحجارة، أو استغلال الاولاد لعمى والدهم للحصول على نصيبه من اللحم فيصنعون له فتة من الخبز الناشف يخلطونه بالماء أو الشاى («الكلب أعمى فى الغابة”) ووجه الجدة المفارق للمتعارف عليه بالطيبة، والذى يتحول الى وجه غول. وإذا كانت الكلاب تخاف من بطش الأطفال («القتلة الصغار”) لها فهى أيضا تهجم على والد الراوية لأنها تعلم أنه لا يبصر أو ربما لأنها فكرت فى إيذائه على سبيل المرح (كما يفعل الأطفال بالفراشات والقطط والوطاويط النائمة على الأشجار) أو للانتقام من صغار القرية الذين أشعلوا النار فى كلب للتسلية. والحكمة لا تأتى من الجدة أو الاهل كما اعتدنا، ولكن يحثنا حسن عبد الموجود على اكتشافها فى داخل ذواتنا عندما نتأمل الأشياء من حولنا بتأن وتبصّر كما اكتشف الراوى فى قصة «السحلية: مفتاح الجنة» وبشكل تلقائى أن الهدهد لا يأكل إلا بعدما ينادى على حبيبته لتشاركه الطعام، فنتعلم ان «اللذة فى المشاركة والجمال فى اقتسام الشيء وليس امتلاكه» (٣٠). ونعيد التفكير فى علاقتنا المتحيرة والمرتابة بالسحلية بعدما نقرأ فى الحكاية أن فى داخل كل سحلية مفتاحاً للجنة، ولأننا نحن الدخلاء عليها وليست هى فهناك سور وهمى بيننا وبينها. وأهل القرية لا يفكرون فى جمال الذئاب إنما فى خطرها وأنيابها وكراهيتها لهم...
وقد تكون قسوة الحياة أو الفقر أو القهر أو حتى طبيعة الدورة الحياتية هى ما يجعل هذه الكائنات (سواء كانت من البشر أو الحيوانات أو الطيور أو الحشرات) تظهر كما لو كانت مخلوقات قاسية فتتجلى أقبح علّاتها مثل العنصرية أو الطائفية أو الغطرسة. ..
ويحثنا عبد الموجود فى النهاية على تقبل الآخر سواء كانت الجارة المسيحية، أو الاب الأعمى، أو القطة المسكينة، أو الحمار الحزين، أو السحلية الهاربة وإلا لن يلتئم العالم. « ليس من حقك أن تترك جارى بدون طعام رغم أن هذا يعنى ببساطة أن الجميع لن يشبع والجوع يصير فقط نص جوع» (١٥٤). فيحملنا حسن عبد الموجود مسئولية التفاعل والتقارب بين كل الكائنات على الأرض سواء كانت بشرية أو حيوانية أو نباتية لإزالة الحدود والحواجز بينها من أجل الحفاظ على توازن عالمنا الذى اُثبٍتَ انه هشٌ وقابل للانهيار، بل وللتلاشى إذا قمنا بقلقلة هذا النظام الكونى سواء بجهلنا أو عمانا أو قسوتنا أو حتى عدم اكتراثنا.
وقد تكون آخر فقرة فى الكتاب قادرةً على إبراز جمال هذا العمل الادبى حين يتوحد صوت الراوى مع كل الكائنات كالجوقة الإغريقية تعكس امكانية البقاء لو كان التآزر بين كل عناصر الطبيعة مبدأنا:
”قلوبنا عضلات صلبة ودماء، لكنها فى نقاء الثلج، وعطاء الدقيق، وبهجة السكر، وقسوة الجير، وتدفق اللبن، وتواضع الكفن. حياتنا رمادية لكن عقولنا مُشمسة. ننام باكين، ولكننا نستيقظ مشرقين، نوزع الابتسامات على أنفسنا وحيواناتنا، لذا… أرجوك ايتها الفراشات كفى عن التفكير فى قسوة آبائنا، إذ أنها الجانب البعيد منهم. لا تفكرى فى السوء، وانثرى خيرك فى كل مكان، وامنحينا دقيقنا كفافا، حتى ولو كان ذلك لا يحدث إلا فى خيالنا، نحن الصغار، إذ إننا نشيخ لكن خيالنا لا يشيخ أبدا» (١٥٥).
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
 الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني
الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني





















