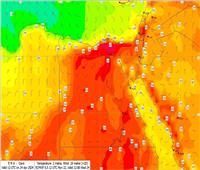يوسف القعيد
يوميات الأخبار
وجـوه من الذاكـرة
الإثنين، 18 أكتوبر 2021 - 07:43 م
أجرى اختبارات لذاكرتى تقريباً كل يوم. أمتحنها. وفى كل مرة تختلف الأحوال عن الأخرى
أكثر ما يقلقنى فى الأيام الأخيرة ذاكرتى. يهددها النسيان. مع أننى باعتبارى فلاحاً جئت من قرية. كانت ذاكرتى أهم ما يميزنى. وكان أصدقائى ومن يقتربون منى يحسدوننى عليها. ويقولون كلمتين فقط للتعبير عن قوتها: ذاكرة فلاح.
لكن من قال إن الحال يثبت على ما هو عليه؟ إن تقدم العمر قضية لابد أن نحسب لها حسابها ونضعها فى الاعتبار. ونعتبرها أهم قواعد سنوات العمر الأخيرة. وهكذا أجرى اختبارات لذاكرتى تقريباً كل يوم. أمتحنها. وفى كل مرة تختلف الأحوال عن الأخرى. أحياناً تكون متألقة متوهجة. وأخرى يسدل عليها ستار النسيان.
ومثلما نقول الذاكرة. لابد أن نقول النسيان. وهو غول رهيب يهدد الإنسان باعتباره الكائن الوحيد الذى له ماضٍ يتذكره ويعود إليه ويعتمد عليه لمواصلة الحياة. لكن من قال إن الأحوال تدوم وأن الأمور تستمر رغم تقدم العمر. إن العبارة المكونة من كلمتين وهما: تقدم العمر، تلخص السنوات الأخيرة.
تولستوى أديب روسيا والذى قال: بعد الخمسين يبدأ الإنسان رحلة العودة للوراء. بمعنى أنه لا يتقدم إلى الأمام. وكلما سمعت عن إنسان فى سن التسعين حسدته على هذا. ولكنى كنت أخجل دائماً أن أسأله عن أحوال الذاكرة. لأننى وقتها لم تكن ذاكرتى تشكو أى ضعف.
وقد عرفت اثنين تعديا التسعين من العمر. المرحومان: محمد حسنين هيكل، ونجيب محفوظ. ولم ألحظ عليهما حتى ما بعد التسعين أى تراجع فى معدل عمل الذاكرة ويقظتها وتنبهها. ولكنها قضية أجيال. لابد أن نحترمها ونعتبرها من القضايا التى لا تقبل حتى النقاش.
تلك وجوه من الذاكرة. كتبتها اعتماداً على عملية التذكار فقط. لم أعد إلى ورقة أو كتاب أو أى مستندات أخرى. كان مستندى الوحيد ذاكرتى. لعله امتحان جديد أجريه لنفسى. لعل وعسى.
عبد الحليم عبد الله
أول أديب قابلته فى حياتى. فى ندوة عقدت فى دمنهور، عاصمة المحافظة التى أنتمى إليها. جاء من القاهرة حيث كان يعيش ليلتقى عشاقه من القراء. وفى ذلك الزمن البعيد الجميل الذى ولَّى ولن يعود مرة أخرى كانت هناك جماهير من القراء. وكان لكل كاتب قُراؤه. الذين يقرأون له ويتابعونه ويحضرون ندواته. فما من أحد فى تلك الندوة البعيدة البعيدة جاء لحضور الندوة إلا وكان قد قرأ لعبد الحليم عبد الله بعض أعماله الأدبية.
قابلته بعد ذلك أكثر من مرة. سواء فى قريته كفر بولين، مركز كوم حمادة، محافظة البحيرة. فأنا بلدياته وذهبت إليه عندما عرفت أنه فى القرية. وزرته فى القاهرة. سواء فى مكتبه بمجمع اللغة العربية عندما كان عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين هو رئيس المجمع. أو فى منزله بحى المنيل بالقاهرة.
ما من حرف كتبه إلا وقرأته بعناية من نوع خاص. وكنت عندما أراه أقول لنفسى: هذا هو الأديب. وأتتبع كل ما يفعله أو يقوم به أو يقوله بأكبر درجات الاهتمام التى يمكن للإنسان أن يبديها تجاه الآخرين. سواء كان يعرفهم أو كانوا جُدداً على معرفته الإنسانية بهم.
بعد رحيله المأساوى حيث كان يستقل سيارة أجرة من دمنهور إلى قريته كفر بولين. وحدثت مشكله بينه وبين السائق. وصاح فيه السائق صيحة مدوية مات بعدها. حرصت أن أكون فى كفر بولين لأمشى وراء جثمانه فى المشوار الأخير. الذى يقوم به الإنسان عادة فى الحياة. كان مشواره الأخير وكان من أوائل مشاويرى. لكنى أتذكر حتى الآن كل خطوة خطوتها وراء نعشه.
عند مقبرته وكنت فى شبابى طرحت على نفسى سؤالاً تراجع كثيراً من حياتى بعد ذلك : لماذا يموت الإنسان؟! اللهم لا اعتراض على مشيئته. ولكن لماذا لم يبق عبد الحليم عبد الله الذى مات فى صدر شبابه وأوائل كهولته فى الحياة أكثر من هذا؟! والأسئلة كانت بدون حدود والإجابات كانت شاحبة وضئيلة. وربما مازالت الإجابات فى نفس شحوبها وضآلتها حتى هذه اللحظة التى أكتب فيها هذا الكلام عن محمد عبد الحليم عبد الله.
باكثيــــــر
عرفته أيضاً فى دمنهور. كان محافظ البحيرة النشيط والهمام. وأحد مؤسسى البحيرة المرحوم وجيه أباظة قد أقام ندوة ثقافية ذات طابع محلى ودولى فى ذكرى الشاعر أحمد محرم ابن دمنهور. ورغم أنى لم أقم فى دمنهور فى ذلك الوقت. فقد حضرت الندوة فى أيامها الثلاثة. وما من جلسة فاتنى حضورها. كان هناك ضيوف من الأدباء والكتاب والفنانين جاءوا من القاهرة أو من خارج مصر من وطننا العربى لحضور الندوة.
التى أصبحت حديقة جميلة من الوجوه الجميلة التى أراها لأول مرة. لم تكن لدىَّ الجرأة لكى أتعرف عليها. لكنى لاحظت أن ثمة أديبا يجلس وحيداً طوال الوقت. لا يكلم أحداً. ولا يقترب منه أحد. وبدافع من الفضول فقط لا غير. توجهت إليه وصافحته وعرفت أنه الروائى والكاتب المسرحى: على أحمد باكثير.
لم يكن اجتماعياً. ويبدو أنه لا يحب الاختلاط بالناس. أو عزوف عن ذلك. وكانت روايته: وا إسلاماه. قد قررتها وزارة التربية والتعليم على الطلاب فى المدارس. وأصبحت كالماء والهواء. رغم أننى بعد أن حاولت التعرف على اسمه بالقراءة. اكتشفت أنه متعدد المواهب. يكتب النص الروائى والعرض المسرحى بل ويحاول كتابة الشعر.
كان قليل الكلام. وكنت بحكم السن ثرثاراً رغم أن خجلى كان يمنعنى من الاستطراد فى هذه الثرثرة. أعطانى عنوانه فى القاهرة. كان يسكن فى حى المهندسين. ولأن ضوضاء المؤتمر منعتنا من التواصل الكلامى. اقترح علىَّ أن أزوره. وكانت زيارة القاهرة التى كنا نقول عنها مصر. باعتبارها تلخص الوطن كله من أحلام العمر الأساسية فى ذلك الوقت.
سافرت بهدف وحيد أن أزوره. وأن أتحدث معه. وأن أستمع إلى الكلمات التى ينتزعها انتزاعاً قبل النطق بها. ولكنى كفلاح فشلت فى الوصول إلى بيته. تهت. كنت أستخدم المواصلات العامة. وربما ركبت أتوبيساً بطريق الخطأ ولم أصل إليه. رغم أن العنوان كان مدوناً فى ورقة. احتفظت بها كواحدة من أهم وثائق العمر. فقد كانت مدونة بخط يده.
وبعد محاولات كثيرة وعندما أصبح الفشل فى الوصول إلى بيته أمراً مؤكداً بالنسبة لى. عُدتُ كما ذهبت ولم أقابل الرجل. وكان لقاء دمنهور اليتيم الذى تم فى زحمة وضوضاء ضيوف مؤتمر أحمد محرم هو اللقاء الوحيد الذى جمعنى به. لكنى حرصت على قراءته. ومتابعة كل ما يكتبه. ورغم أن اللقاء كان عابراً. فقد اعتبرت نفسى من معارفه. رغم أن هذا اللقاء لم يتكرر بعد ذلك أبداً.
لويس عوض
قابلته لأول مرة فى الأهرام. كان هناك دور ربما كان الرابع يجلس فيه رموز مصر: توفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، وحسين فوزى، وعائشة عبد الرحمن. وغيرهم من كُتَّاب الأهرام. كان يسكن فى شارع القصر العينى. وباعتباره أتى من صعيد مصر. فقد كان التسلل لمعرفة وثيقة به من الأمور الصعبة. ولكنى اجتزتها بسهولة ويسر.
كانت له آراء حادة وقاطعة فى الحياة الثقافية المصرية. وفى الأدباء المصريين. وكان يُعبِّر عنها بصراحة ووضوح. كنت أحسده عليهما. وكانت كلماته عن الآخرين محددة قاطعة جامعة مانعة.
اشترى قطعة أرض فى الفيوم. وبنى عليها بيتاً. وكان من أصدقاء الفيوم بالنسبة له: حسين عبد الرحيم الروائى والقاص. الذى لا أعرف الآن ماذا فعلت به الدنيا؟ وبعد أن مل لويس عوض كثيراً من رحلة الذهاب والعودة إلى الفيوم. وباع أرضه وبيته هناك. واشترى شقة فى شارع الهرم جعل منها مكتباً له.
زرته فى شقة الهرم. وتناولنا الطعام أكثر من مرة فى مطعم شهير كان يقدم الدجاج بطريقة مبتكرة. وكان يهوى الجلسات مع الآخرين والحديث. ربما كان لويس عوض من الكُتَّاب القلائل الذى كان يجيد الأمرين معاً. فهو كاتب جيد ومتحدث لبق أيضاً. يهمك أن تستمع إليه. ولا تفقد الرغبة فى متابعة ما يقوله مهما أطال قوله.
ورغم أن معظم المثقفين يتعاملون معه باعتباره ناقداً أدبياً مهماً. كان الناقد الأدبى لجريدة الأهرام وملحقها الأسبوعى. إلا أننى اكتشفت فيه جانباً إبداعياً لا يقل أهمية عن نقده. فهو صاحب ديوان شعرى: بلوتلاند. كتبه فى أيام الصبا والشاب.
واعتبره مغامرة شابة. ولم يعد يقول الشعر بعدها. وكان من الشعر الحر الذى لا يلتزم التفعيلة ولا القافية.
لكنى أعتبر من أهم نزوات عمره الأدبية كتابه: مذكرات طالب بعثة. الذى كانت لديه الشجاعة أن يكتبه بالعامية المصرية من ألفه إلى يائه. وهو كتاب ألَّفه بعد عودته من بعثته فى انجلترا. وذهب به إلى الرقابة ليحصل على موافقتها على طبع الكتاب كما كان متبعاً فى ذلك الوقت. وفى طريق عودته من الرقابة فُقِد الكتاب منه. وظلت المذكرات من مفقودات العمر التى لا أمل فى العثور عليها. إلى أن أتى له به كاتب سكندرى يُدعى كنارى.
وهكذا نشره فى سلسلة كتاب الهلال. كان يرأس تحريرها فى ذلك الوقت الصديق مصطفى نبيل. ورحَّب بالعمل وسارع بنشره رغم قوائم الانتظار. ورغم أن المذكرات عمل جميل تسعد وأنت تقرأه. فقد هوجم كثيراً بسبب استخدامه للعامية المصرية التى لا حد لجمالها. واعتبر أنه محاولة للعدوان على اللغة العربية الفصحى بكل ما تعنيه من دلالات ومعانٍ.
ورغم عذوبة علاقاته الاجتماعية بالناس. فقد كان قاسياً فى أحكامه النقدية. صارماً فى التعامل مع النصوص الأدبية. لا يعرف الحلول الوسط. ويرفض الصداقات القائمة على المصالح التى يخطب أصحابها وده من أجل أن يكتب عنهم وعن نتاجاتهم الأدبية. وقد ظل هكذا إلى أن رحل عن دنيانا.
***
لدىَّ فى متحف الذاكرة وجوه كثيرة أحب الكتابة عنها. ولكن المساحة أوشكت على النفاد. فلا مفر من التوقف. ألم تكن شهرزاد ما إن يصيح الديك: كوكو كوكو تتوقف عن الحكى فى لياليها الجميلة وهى الليالى التى استمتعنا بقراءتها أجيالاً وراء أجيال؟ وهكذا أتوقف عن الكتابة رغم زحام الذاكرة بوجوه الماضى الجميل.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة













 نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
 «لست ملاكاً»
«لست ملاكاً»
 وكاد بطل الملاكمة يصفعنى فى الطابور!
وكاد بطل الملاكمة يصفعنى فى الطابور!
 وجها لوجه مع مصطفى أمين
وجها لوجه مع مصطفى أمين
 مكالمة «نص الليل» مع الشهيد أبو عمار
مكالمة «نص الليل» مع الشهيد أبو عمار
 فى الموت والحياة.. عظة
فى الموت والحياة.. عظة
 أنا أقاوم.. إذاً أنا موجود
أنا أقاوم.. إذاً أنا موجود
 مذكرات الدكتور مجدى يعقوب
مذكرات الدكتور مجدى يعقوب
 جمهورية العلم والعدل
جمهورية العلم والعدل