
علاء عبدالوهاب
يوميات الأخبار
السبت، 23 أبريل 2016 - 09:30 م
من غيره يشدو بعذب الكلام، رافضاً كتم الشكوي، داعياً لعدم الكف عن الحكي، محذراً من «كتم الغناء» لأنه صنو للموت؟
الإثنين :
ليس حنيناً للماضي بلا داع .
أيام البهجة البعيدة تقفز من آخر نقطة في الذاكرة، فيتصور المرء أنه خاطر عارض، ربما ليتوزان الانسان في ظل عوامل تجنح بنا نحو الحزن دون سبب ظاهر، لكن بمزيد من التأمل،تجد الامر علي غير ما بدا للوهلة الأولي.
فجأة تذكرت «مزيكة المركز»، أو تلك الفرقة الموسيقية التابعة لقسم شرطة ميت غمر، التي كانت تجوب الشوارع الرئيسية للمدينة عقب صلاة الجمعة -اسبوعياً- حتي تصل إلي شارع البحر، كما كنا نسمي النيل، حيث يجلس افراد الفرقة في كشك الموسيقي، يواصلون العزف، ومعظم آلاتهم تنتمي الي أسرة النفخ النحاسية، وأحياناً يسعدك الحظ، فتكون الفرقة مدعوة لاحياء حفل خطوبة أو زفاف عقب صلاة العصر.
في تلك الأيام البعيدة المبهجة، كانت «مزيكة المركز» تعزف ألحاناً وطنية في الشوارع وداخل الكشك، ثم تتحول لعزف ألحان عاطفية في الافراح، وفي الحالتين كان الاداء رائعاً، لا تلحظ نشازاً، ولا تضبط أحد العازفين وقد جنح بعيداً عن العزف الجماعي الجميل، ونشاهد رؤوس الأباء والأجداد تتمايل طرباً، وكأنهم سكاري، وماهم بسكاري، ولكنها الالحان العذبة، والاحترافية الراقية للموسيقيين الذين يرتدون زي الشرطة التقليدي، يقودهم موسيقي عجوز برتبة «صول» أي مساعد، يمارس دور المايسترو بتواضع جم، رغم أن أفراد الفرقة التي تربو علي العشرين تأتمر بعصاه في تبجيل ظاهر.
ما لهذه الذكريات تتدفق كالشلال الهادر؟
في البداية لم أجد إجابة سريعة قاطعة، إلا أن تدبر المسألة قادني إلي ما أحال البهجة إلي ألم!
آه.... أنه ما قرأته منسوباً إلي صحيفة باريسية تنتقد أداء فرقة الموسيقات العسكرية المصرية للنشيد الوطني الفرنسي أثناء استقبال الرئيس أولاند!
آااه.... مرة أخري؛ فالذاكرة التي استدعت البعيد، أجدر بها أن تستدعي القريب، إذ الامر تكرر من قبل خلال زيارة الرئيس الروسي بوتين لمصر، ووقع ذات الخطأ!
ماذا يحدث بالضبط؟!
هل يمكن أن يكون بين افراد الفرقة أحد أبناء أو حفدة «مزيكة المركز»؟ وماذا لو أن العمر أمتد بأحد العازفين القدامي ليستمع إلي التوزيع الخاطيء خلال استقبال ضيوف مصر الكبار؟ هل يغفر أم يترحم علي الماضي البعيد؟
....................................
اظن أن أجراس إنذار لابد أن تدوي دون توقف، وأن تدق بشدة ليتوقف هذا التردي عبر برامج تعيد للعازفين لياقتهم الفنية، ليستعيدوا مهارات أجيال سبقتهم ليس في فرق «مزيكة المركز» بالمدن والأحياء ممن شاهدهم واستمتع بادائهم ابناء جيلي، وإنما الاهم أن يستحضروا عظمة تاريخ من سبقوهم بالانتماء للموسيقات العسكرية حتي سنوات لا يفصلنا عنها عقود طويلة.
أحياناً يجلب الحنين لأيام البهجة البعيدة آلاماً وأحزاناً لا يصعب تبريرها!
الحالم حتي النهاية
الثلاثاء :
يا عندليب ما تخفش من غنوتك
قول شكوتك واحكي علي بلوتك
الغنوة مش حتموتك.. إنما
كتم الغنا هو اللي ح يموتك
ومن ذا الذي يقولها غير جاهين الحالم الذي لم يكف عن الحلم، حتي بعد أن انكسر زمن الاحلام، من غيره يشدو بعذب الكلام، رافضاً كتم الشكوي، داعياً لعدم الكف عن الحكي، محذراً من «كتم الغنا» لأنه صنو للموت؟!
ثلاثون عاماً مرت علي غيابه، بينما حلو الكلام وأصدقه يمنحه اضعاف سنوات حياته خلوداً، وإذا كانت دواوينه لم تعد تُطبع كما كانت في وجوده، إلا أن أجيالاً لم تر رسوماته الكاريكاتورية تحفظ رباعياته العبقرية، كما تُردد كلمات أغانيه التي عادت بسطوتها القديمة بعد ثورة 25 يناير.
كانت عاميته في الكتابة أبلغ من فصحي كثيرين تحصنوا بأبراج عاجية، بينما عانق جاهين احلام البسطاء وطموحات الغلابة، وكان شدو العندليب حليم بقصائده شهادة ضمان ضد الزمان وغدره وتقلباته.
....................................
وإذا كان عبد الحليم حافظ جدير بانتاج درامي غزير، وافلام سينمائية تحكي اسطورته، فإن حياة وابداع جاهين يحتاج لأكثر من مجرد مشاهد في مسلسل أو فيلم عن حياة العندليب، أو عن الزمن الجميل حين كان كل المصريين يساهمون في صناعة الحلم، ورسم ملامح المستقبل رغم كل التحديات الصعبة، وكان جاهين خادماً للحلم، مهوناً للصعاب.
جاهين الذي تغني بالثورة، وغني لرمزها عبد الناصر، ورسم علي وجه مصر ما جاش بصدور ابنائها من أحلام وآلام، لا يجب ان ينتظر تخليده بفيلم أو مسلسل يليق بعبقرته اكثر من ثلاثين عاماً.
.. وللأمومة طعم مختلف
الأربعاء :
ألف رحمة علي إمامنا الكبير محمد عبده الذي ينُسب إليه - إذا لم تخن الذاكرة - المقولة المأثورة رداً علي سؤاله عن ما لفت انتباه عندما زار باريس، فقال:
- رأيت إسلاماً بلا مسلمين، ولمّا عدت رأيت مسلمين بلا إسلام!
....................................
تذكرت العبارة حينما طالعت استنكار ممثلة شابه لسؤال محرر فني لها:
- هل عارض أولادك ظهورك بالمايوه في فيلمك الجديد؟
فما كان منها إلا اظهار غضبها في كل حرف أجابت به:
- وما دخل أولادي في الامر؟ كل ما هناك أنني أوضحت لهم أن طبيعة الدور تتطلب أن أرتدي المايوه، وعلي أي حال فإن ذلك لا يجب أن يعنيهم في شيء (!!)
بالطبع علامات التعجب بين القوسين من عندي، وقد تحتاج إلي اضافات لأنها لم تكتف بتلك الاجابة، ففي حوار آخر كشفت أنها لا تعترف بما يسمونه «السينما النظيفة» وأنها ضد هذه التقسيمات!
بالتأكيد كل انسان حر في رأيه، مهما كان صادماً، لكن ما استوقفني ويقيناً توقف أمامه غيري ان «النجمة الشابة» ليست الوحيدة التي تتبني تلك الرؤية، لكن هناك طابور طويل ينتظم فيه من لهن الرأي نفسه، وبرضه هن أحرار ، لكن بالمقابل هناك في الغرب الذي نراه يهجر الاخلاق، ويقدس الذات الفردية الانانية، ولا يعني نجماته إلا البريق علي الشاشة وليذهب الأولاد للجحيم، نستيقظ علي خطئنا في التقدير والرؤية، فما درجنا علي ترديده لا أثر له في الواقع، لكنها أوهامنا التي نُسقطها علي مشهد لا ندري أبعاده، مؤكد أن بين نجمات الغرب من يشاركن نجماتنا حماسهن، إلا أن كثيرات يتلألأن في أفلام عالمية يتحمسن لرأي مختلف تماماً.
طبعاً لن أسرد اسماء ومواقف تؤيد ما أذهب إليه، لكن نجمة بنجمة، ومن أعنيها هنا هي ايميلي بلانت الفنانة الانجليزية التي كلفتها الأمومة الابتعاد عن التعري والأدوار العنيفة، وتقول بالحرف وهي بانتظار طفلها الثاني:
- اريد أن أكون قدوة حسنة، وأري أن مشاهدا لعري ليست ضرورية لأنني لست في الثانية والعشرين من عمري.
بالمناسبة ابن ايميلي لا يتجاوز عمره العامان.
إيميلي تبلغ من العمر 33 عاماً، وبين نجماتنا من تجاوزت الستين، وربما السبعين ربيعاً ومازلن حريصات علي ادوار الاغراء والعري، ولا يعني هذه أو تلك خجل الاحفاد بالجامعة من الظهور علي الشاشة كاسيات عاريات.
هذا غير من ضحين بالامومة بالاساس من أجل نجومية سوف تغرب شمسها يوماً ما.
وكله كوم واولئك: النجوم الرجال المعجبانية الذين يباهون برفض كلمه: «جدي» علي شفاه الأحفاد كوم آخر!
....................................
صدق من قال: اللي يعيش ياما يشوف، واللي يمشي يشوف أكتر!
مدرسة «في المشمش»!
الخميس :
ودعتني في الصباح بابتسامة طغت علي كل ملامح وجهها، ثم عادت آخر النهار وذات الملامح يكسوها غضب عارم!
صباحاً.. كانت تدندن بالأغنية الشهيرة لصباح الفرحانة بابنتها:
حبيبة أمها.. يا اخواتي بحبها..
يا اخواتي يا اخواتي بحبها.. دي حبيبة امها
حبيبتي بكرة تكبر وتروح المدرسة
ويقولوا بنتي شاطرة ونمرها كويسة
سبحان مغير الأحوال، عادت ابنتي الوسطي وعلامات الاحباط بادية علي الوجه الذي خاصمته الفرحة!
- خير يا بنتي
ومن أين يأتي الخير؟
- يالطيف يارب، طمئنيني، في أي مدرسة قدمتي أوراق أيسل؟
مدرسة «في المشمش»!
- هل هذا وقت مزاح؟
صدقني يا أبي لا أمزح، بل ان الغيظ يكاد يفتك بي.
- لا أفهم ماذا تقولين؟
تصور أن اختبارات القبول للكيچيهات تحتاج إلي مرتبي ومرتب أبيها في شهر، وعلينا ألا نأكل أو نشرب، أو نفعل أي شيء آخر سوي انتظار النتيجة!
- أرجوك لا تبالغي في الامر
أبداً، بل العكس انني أهون عليك!
- مزيد من الايضاح.. ممكن؟
الابليكيشن فقط تتراوح بين 500 وألف جنيه، هذا بخلاف بضعة آلاف تبرعا إجباريا لو ابتسم لنا الحظ وقبلتها إحدي المدارس التي لهفت المبلغ مقدماً، ولا تسأل عما دفعت إذا لم تقبلها!
- بسيطة قدموا شكوي في المنطقة التعليمية لفضح من يتاجر في التعليم بهذه الطريقة البشعة.
من يصدقنا، ونحن لا نملك ايصالاً يثبت ما نقول.
- إنها عملية نصب لابد من فضحها.
علي فكرة مازلنا في انتظار الاصعب، فالمصروفات نار، وتحتاج لجمعيات بالدولار.
يعني إيه بالدولار؟
ألا تعلم أن المدارس المتميزة تطلب مصروفاتها بالدولار؟
....................................
لم أجد أي رغبة في الاسترسال في هذا الحوار العبثي، ووجدتني أردد في سري:
- إذا كان الامر كذلك في «كي چي وان» يا ست أيسل، فماذا يتطلب الالتحاق بالابتدائية.. سرقة بنك مثلا؟!
المنتمي أبداً
الجمعة :
إذا حاولت أن تلخص محمد عبد المقصود في كلمة، وأنت تزعم معرفة حقيقية بمفتاح شخصيته، فلن تجد سوي وصفه بـ «المنتمي».
كان منتمياً للمعصرة التي ولد فيها، وكانت سبباً في معاناته من تلوثها، لكنه ظل ابناً وفياً لهذه الضاحية، محباً لكل ما فيها، غير ناقم عليها!
كان منتمياً لأسرته، لا يري في أي من اعضائها إلا أحسن ما فيه،
كان منتمياً لكليته، وكأن جامعة القاهرة لا تضم وراء اسوارها إلا كلية الاعلام.
ومن الكلية إلي الدفعة كان اعتزازه بالدفعة الاولي التي انتمي لصفوفها، فيشعرك أنها الدفعة الوحيدة التي تخرجت منها.
ومن الدفعة إلي «الأخبار» عشقه الاكبر، حيث كانت الجسر الذهبي الذي قاده للانتماء لمهنة نذر حياته لها، متفانياً، لا يبخل بوقت أو جهد أو صحة حتي آخر نفس في صدره المتعب.
الجميل في انتماء عبد المقصود أنه كان في غير تعصب، بخلاف أولئك الذين يعني الانتماء لديهم تعصباً بغيضاً ينفر مَن حولهم، لكن انتماءه كان من ذلك النوع الذي يجمع ولا يفرق.
....................................
صادف يوم وفاته راحة عمل في «كتاب اليوم»، ولم أعلم بالخبر المفجع إلا متأخراً، وفاتني أن اشارك زملاء العمر في رثاء أحد أجمل وأشطر رموز الجيل بطبيعته ووداعته وقيمه التي ظل قابضاً عليها في زمن توارت فيه المباديء،ولم يكن أمامي سوي الانتظار لأكتب عنه تلك السطور بقلب دامٍ ودمعة حبيسة، وذكري تدوم في القلب لعبد المقصود المنتمي أبداً لكل ما هو جميل عل ذكراه تكون زاداً يعيننا علي مقاومة ما كان يبغضه رجل تجاوز الستين، لكن ظل قلبه في نقاء طفل لم يبلغ السادسة.
ومضات:
من يخشي الماء خوفاً من الغرق، ربما مات ضحية الظمأ
أخطر ما في شيخوخة النفس، التجاعيد الكامنة تحت الجلد.
استعمال أفعل التفضيل في لغة قوم، يفضح مالا تستطيع ابلغ الكلمات ستره.
الموهبة هبة، من لا يعنيه رعايتها، كافر بنعمة ربه.
بعض الجُهال يري أنه الاجدر بحماية العقلاء من أنفسهم!
المرأة ، المرآة، مَن اشتقت اسمها من الأخري؟
الغيرة احياناً ما تكون تعبيراً عن حب للذات، لاعشق للآخر.
من يباهي ببريق الوحل، يعتمد الانحطاط أسلوب حياة.
الكلمات الدالة
مشاركه الخبر :
الاخبار المرتبطة
 الوطنية للصحافة: الأحد القادم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمعاش مارس 2024
الوطنية للصحافة: الأحد القادم صرف مكافأة نهاية الخدمة لمعاش مارس 2024
 مي رشدي: قانون "رعاية حقوق المسنين" يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع
مي رشدي: قانون "رعاية حقوق المسنين" يؤكد اهتمام الدولة بكافة فئات المجتمع
 العربية للتصنيع تتعاون مع شركة سعودية لتصنيع سيارات كهربائية وتصديرها للخارج
العربية للتصنيع تتعاون مع شركة سعودية لتصنيع سيارات كهربائية وتصديرها للخارج
 حزب الحركة الوطنية يستعد لانتخابات المحليات والشيوخ والنواب.. ويعقد دورات تدريبية
حزب الحركة الوطنية يستعد لانتخابات المحليات والشيوخ والنواب.. ويعقد دورات تدريبية
 عضو بالشيوخ: الدولة حريصة على تحسين ورفع مستوى المعيشة للأطقم الطبية
عضو بالشيوخ: الدولة حريصة على تحسين ورفع مستوى المعيشة للأطقم الطبية
 وزير التعليم: المعلمون القوة الدافعة للتعلم.. ولدينا آلية دقيقة للاختيار
وزير التعليم: المعلمون القوة الدافعة للتعلم.. ولدينا آلية دقيقة للاختيار
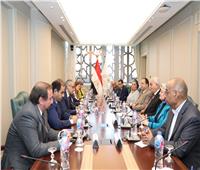 حجازي: نحرص على علاج ضعف مهارات التعليم الأساسية من خلال برامج علاجية
حجازي: نحرص على علاج ضعف مهارات التعليم الأساسية من خلال برامج علاجية
 وزير التعليم: المشروعات البحثية تساهم في تنمية قدرات الطلاب
وزير التعليم: المشروعات البحثية تساهم في تنمية قدرات الطلاب
 رضا حجازي: نبذل جهودا كبيرة لتطوير قطاع التعليم
رضا حجازي: نبذل جهودا كبيرة لتطوير قطاع التعليم



















