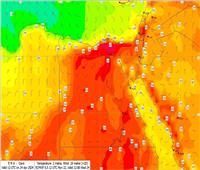محمد العزبي
يوميات الأخبار
عيد ميلاد بلا شموع!
الأربعاء، 09 فبراير 2022 - 06:35 م
كتب: محمد العزبي
لم تكن أمى تعرف القراءة والكتابة ولكنها حاربت حتى نتعلم
ولكننى أنا الذى خذلتها وأفسدت عليها فرحتها بدخولى كلية الطب لأكون أول دكتور فى قريتى.. اختطفنى شيطان الصحافة!
بعد أيام لن أحتفل بعيد ميلادى بعد أن بلغت من العمر أرذله.
لن أطفئ الشموع فقد ضاع منى البصر..
ولن أقرب التورتة بعد أن أصبح دمى سكر زيادة..
ولن أستقبل أحداً فقد تركنى الأهل والأصدقاء - إلا القليل - وحيداً فى الدنيا..
أستاهل!
لن أبكى فقد جفت الدموع..
ولن أرد على من يسأل: عندك كام سنة ؟...؛ فقد مضى العمر يا ولدى ولا يبقى سوى ذكريات مع التكرار والنسيان «وانت قلت لى نفس الحكاية كتير يا جدو !!»
دخلت الدنيا من أوسع أبوابها؛ وأريد أن أدخل الجنة من أى باب.
غالطنا الحكومة فى شهر - وياريتنا غالطناها فى عشرين أو تلاتين سنة - ذلك أن تاريخ ميلادى يوم ٢١ فبراير حتى وقعت فى يدى ورقة مكتوبة بخط جميل وحبر أحمر أشبه بلوحة فنية أبدعها ابن عمى «الشيخ راغب» وكان ناظر المدرسة الوحيدة فى قريتنا «العزيزة» مركز المنزلة دقهلية.. للأسف ضاع هذا المستند منى مثلما ضاعت أوراق وصور افتقدتها كثيراً..
أما الحكومة فقد غالطتنى بتغيير اسمى.. كان تسجيل المواليد زمان يتم عن طريق العمدة فى القرية؛ وربما شيخ الحارة فى المدينة؛ وأحيانا لا يسجل على الإطلاق حتى لا يطلب للتجنيد.. أرسلت جدتى لأبى إلى العمدة اسم «محمد بهاء الدين» فاختار: «محمد جاد الحق»!
أما تاريخ الميلاد الذى تأخر ليصبح ٢١ فبراير فيوم مفترج؛ إذ كان أيضا يوم الإضراب العام الذى دعت إليه اللجنة العليا للعمال والطلاب ضد الاحتلال البريطانى لمصر رداً على مذبحة كوبرى عباس عندما خرج طلاب الجامعة ينددون بالاحتلال وأعوانه - يعنى الحكومة - وكانت المفاجأة فتح الكبرى وهم فى منتصفه فسقط الكثيرون فى النيل.
كما أنه كان يوم ميلاد على ومصطفى أمين وعندما كنت جالساً مع مصطفى بيه قلت له بدون مناسبة: على فكرة أنا مولود يوم ٢١ فبراير رفع رأسه عن الورق الذى أمامه وابتسم ابتسامة خفيفة وقال: «يمكن»!!
* قد تكون المشكلة أننى انتقلت من برج «الجدى» إلى برج «الدلو».. مع أننى لا أؤمن بالأبراج!
** مات أبى وعمرى خمس سنوات فلا أعرف عنه إلا أنه كان أستاذا فى كلية «أصول الدين» بالأزهر الشريف نسكن هناك ونشترى بيتا فى شارع الفواطم فى الدراسة وكان الحى زمان أحد معاقل جماعة من المماليك يتنافسون وأحيانا يتحاربون مع مجموعات أخرى منهم.
لم تكن أمى قاهرية وإنما جاءتها بعد زواجها من الشيخ ابن قريتها الذى يعمل ويعيش فى القاهرة؛ أما الإجازة ففى «العزيزة» وظل ذلك قائما بعد وفاته..
كان الرأى ألا نعود فمن يقدر على مصاريف المدينة فما بالك بدخول المدارس حتى ولو كنا نسكن فى البيت الذى اشتراه أبى رحمه الله ونتقاضى معاشا هزيلا ولا نعرف أحدا فى القاهرة سوى صديقه وزميله فضيلة الشيخ «محمد على سلامة» الذى رفض بشدة أن يدفن أبى فى مقابر قريتنا ليكون أول من يدفن فى مقبرة جديدة بناها الشيخ سلامة هى الآن على شارع صلاح سالم - كما قالت لى أمى وأنا أسألها صغيرا لماذا دفنتى أبى هنا فقالت: دموع الشيخ أبو سلامة.. وقد ظل الرجل على الود حتى وفاته..
وقد أعطانى ابنه الدكتور عزت المدرس بكلية الهندسة دروسا مجانية فى علم الجبر الذى كنت بليدا فيه؛ وهو الدكتور «محمد عزت سلامة» الذى اختاره جمال عبد الناصر محافظاً لأسوان أثناء بناء السد العالى ثم وزيراً للصناعة.
الهرب من قصر العينى
لم تكن أمى تعرف القراءة والكتابة ولكنها حاربت حتى نتعلم وندخل الجامعة أنا وأخى أحمد.. ولكننى أنا الذى خذلتها وأفسدت عليها فرحتها بدخولى كلية الطب لأكون أول دكتور فى قريتى.. اختطفنى شيطان الصحافة!..
كثيرون فعلوها وأشهرهم «صلاح حافظ» الدى أصبح رئيسا لتحرير مجلة روزاليوسف وقد ترك دراسة الطب وهو فى السنوات الأخيرة من الكلية ربما عطلته أيضا سنوات السجن والاعتقال السياسى الطويل..
.. و «يوسف إدريس» الذى كان يجلس مثلنا فى البوفيه ولكن صامتا سارحا فى ملكوته.. ربما كان يفكر فى إحدى قصصه التى صنعت مجده الأدبى بصدور كتابه الأول «أرخص ليالى» و»نوال السعداوى» التى كانت تخطب فينا تحريضا على التظاهر إلى جانب زعماء الطلبة من الإخوان ولم تكن منهم كما اتضح لقرائها وللعالم كله بعد أن اشتهرت مصريا وعالميا كمفكرة وكاتبة وأديبة؛ مهمومة بقضايا المجتمع مثل ختان البنات وزواج القاصرات!
وبقيت متابعا لها معجبا عن بعد؛ حتى اختارها الله إلى جواره.
ولأننى غاوى حديث السجون منذ جربت الاعتقال على خفيف فقد احتفظت بما كتبته وراء الأسوار على ورق تواليت وبأقلام حواجب استعارتها من نزيلات عنبر الدعارة. فكانت «مذكرات فى سجن النساء».
ضمت الحبسة التى أمر بها الرئيس السادات واشترك فيها وزير داخليته اللواء النبوى إسماعيل:
الكاتبة الصحفية «صافيناز كاظم». الدكتورة «أمينة رشيد» أستاذة الأدب الفرنسى. الصحفية السياسية «فريدة النقاش».. وأستاذة الإعلام الدكتورة «عواطف عبد الرحمن».. والدكتورة «لطيفة الزيات «.. والزميلة «فتحية العسال».. والثائرة «شاهندة مقلد».
وكانت لكل واحدة منهن مؤلفات عن تجربة السجن: «حملة تفتيش» و»الباب المفتوح» - تحول إلى فيلم سينمائى بطولة فاتن حمامة - و»سجن النسا» - مسلسل تليفزيونى - و»السجن: دمعتان ووردة».. وحتى رواية «صفصافة». عن شجرة فى قرية صعيدية لا تهزها ريح أو معتقل.!
ولا تصدقونى عندما كتبت يوماً:
متعة أن تدخل سجن النساء نزيلاً. أو زائراً. أو شاويشاً. ولو لليلة واحدة!!!... لا أعادها الله.
يوم مقتل الجنرال
فى ذاكرتى دائما يوم مقتل اللواء «سليم زكى باشا» رجل الداخلية القوى؛ وقواته تحاصر المتظاهرين فى كلية الطب: ألقى مجهول قنبلة من فوق قتلت الباشا على الفور ولم يصب أحد غيره لأن الشظايا انتشرت بين ساقيه إذ كان يرتدى بالطو ثقيلاً جداً.. ولم يعرف من الذى ألقاها.. هاجت الداخلية والحكومة والسراى الملكية؛ واقتحمت القوات كلية الطب تلقى القبض على الجميع وتأخذهم إلى قسم السيدة زينب للتحقيق معهم فلما فاض بهم أخذوا الطلبة إلى قسم الدرب الأحمر ثم إلى باقى أقسام البوليس..
حظى أننى استجبت لمن ينادى: امشى بس يقودنا إلى باب حديدى صغير يفصل ما بين الكلية ومستشفى قصر العينى ينتظرنا اثنان من شباب الأطباء معهما بلاطى بيضاء يعطون كل طالب واحداً يلبسه ويسرع بالخروج من الباب الرئيسى للمستشفى.. عرفت أن اللذين دبرا الأمر هما الدكتور «فؤاد محيى الدين» الذى أصبح رئيسا لوزراء مصر؛ والثانى نسيت اسمه إذ تركز نشاطه على العمل النقابى.
عندما أعلنوا وفاتى
لم تغفر لى أمى إجهاض حلمها فى أن أكون طبيباً حتى ذهبت إلى بورسعيد صحفياً تحت التمرين فى مجلة آخر ساعة بعد العدوان الثلاثى على مصر - انجلترا وفرنسا وإسرائيل - واحتلال المدينة العزيزة علينا ولى فيها أهل وأصدقاء.. سافرت إليها مطمئناً فإذا بها حرب وخطر وخالية إلا من الفدائيين وصوت الرصاص..
عشرة أيام قضيتها فى كر وفر مهدداً فى كل وقت يأخذنى الحماس لبداية صحفية مبشرة مع أن رسائلى من قلب حرب فى كل شارع لم ينشر منها سطر واحد.. اشتد الخطر فقررت السفر إلى قريتى عبر بحيرة المنزلة فى مركب شراعى مختفياً عن العيون نصل إليه مشياً فى الماء مشمرين ملابسنا..
واصلت رحلتى بالديزل الذى يمشى الهوينى فوصلت مع غروب الشمس لأجد دارنا ممتلئة بسيدات.. جالسات وواقفات حزينات فأدركت أنهن يقدمن العزاء لأمى فى وفاتى فكان ظهورى مفاجأة..
انصرفن وأخذت أمى تبكى بشدة.. وسرعان ما ابتسمت وقالت أنا مش زعلانة منك بس تدخل كلية تانية فى الجامعة؛ وهذا ما حدث.
ضاع منى يوم مولدى. نسيته ونسيه أقرب الناس؛ فلم تعد هناك تورتة؛ وأنا عندى سكر مع أننى أموت فى الحلويات
.. هكذا سرحت فى حكايات ربما لم تكتمل فتذكرتها من بعيد بدون ترتيب..
حتى كل سنة وأنت طيب لم أعد أسمعها مع أنها ببلاش!
.. قالوا زمان: اللى يعيش ياما يشوف. واليوم أقول بعد الستة على ستين: اللى يعيش ما يشوفش!!
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة













 نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
 «لست ملاكاً»
«لست ملاكاً»
 وكاد بطل الملاكمة يصفعنى فى الطابور!
وكاد بطل الملاكمة يصفعنى فى الطابور!
 وجها لوجه مع مصطفى أمين
وجها لوجه مع مصطفى أمين
 مكالمة «نص الليل» مع الشهيد أبو عمار
مكالمة «نص الليل» مع الشهيد أبو عمار
 فى الموت والحياة.. عظة
فى الموت والحياة.. عظة
 أنا أقاوم.. إذاً أنا موجود
أنا أقاوم.. إذاً أنا موجود
 مذكرات الدكتور مجدى يعقوب
مذكرات الدكتور مجدى يعقوب
 جمهورية العلم والعدل
جمهورية العلم والعدل