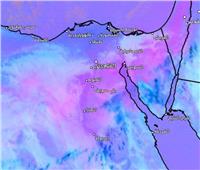الروائية والبروفيسورة الهولندية مينيكه شيبر
إسراء النمر تكتب .. «مينيكه شيبر» في مصر
الأحد، 04 ديسمبر 2022 - 02:03 م
زارت الروائية والبروفيسورة الهولندية مينيكه شيبر (1938) مصر الأسبوع الماضي، حيث استضافها كل من المعهد الهولندي الفلمنكى في الزمالك، ومكتبة الإسكندرية، لتلقى محاضرتها عن كتابها المهم «تلال الفردوس.. تاريخ الجسد الأنثوي بين السلطة والعجز»، الصادر عام 2020 عن دار صفصافة، بترجمة عبد الرحيم يوسف، وهو الحدث الذى لم يلق أي اهتمام في القاهرة، فكان أغلب الحاضرين في المعهد الهولندي من الأجانب، وهو ما جعل مينيكه شيبر تشعر كأنها لم تغادر أرضها، وعندما اقتربتُ منها، استقبلتني بابتسامة واسعة، ووجه مرحب، فكنتُ المصرية الوحيدة الحاضرة، المصرية المُحجبة التي تخشى أن تُقلب عليها ذكرياتها الأليمة مع المحجبات.
وفي إحدى سفرياتها إلى تنزانيا، التقت مينيكه شيبر على ظهر عبَّارة بثلاث نساء يرتدين عباءات سوداء طويلة، كان الجو مليئًا بالرياح، وأصيبت إحداهن بدوار بحر، فبادرت شيبر بالاطمئنان عليها، ودار بينها وبين النساء حوار طويل، انتهى بقيامهن بتوبيخها بسبب ملابسها ورأسها العاري.
وإخبارها بأن مصيرها سيكون حتمًا نار جهنم. حاولت شيبر التي كانت ترتدى ملابس محتشمة أن تعترض بأن الله سيريد معرفة ما إذا كنا أشخاصًا صالحين، أكثر من رغبته في معرفة نوع الملابس التي كنا نرتديها أثناء حياتنا، لكن دون جدوى، وأصرت النساء بقوة على الاعتقاد بأن الجنة ستفتح أبوابها فقط للواتي غطين أنفسهن بشكل تام.

وترى شيبر، أن «هؤلاء الذين تربوا على فكرة أن النساء المحجوبات هن فقط المحتشمات، يحتاجون إلى أن يطرحوا عنهم فكرة أن العُرى والعفة نقيضان، إضافة إلى أن الجسد المغطى ليس ضمانة على الاحتشام.
وكما تثبت السُّنة القديمة في رجم الزانيات حتى الموت، وهناك حكمة تراثية من التاميل تتسائل بسخرية عما إذا كان حجاب واحد كافيًا لستر عفة المرأة، أو بكلمات نظريتها الغربية: الرداء الديني لا يصنع راهبًا».
وفكرة أن مظهرنا في المجال العام أصبح بطاقة شخصية يقرؤها الآخرون من النظرة الأولى باعتبارها نصًا عن النوع والعرق والمهنة والدين.. إلخ، هو ما أرادت شيبر طرحه فى كتابها «المكشوف والمحجوب.. من خيط بسيط إلى بدلة بثلاث قطع».
وحيث تقودنا بعين أنثروبولوجية ثاقبة عبر آلاف السنين تجاه ارتداء البشر للثياب وخلعهم لها، وتتوصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يكن لكلمتى «عارى» أو «مستور» معنى إلا عندما امتلك الناس بالفعل ثيابًا يمكنهم ارتداؤها وخلعها، فلم يكن هناك أحد عاريًا عندما لم يكن هناك وجود للملابس.
لكن ما الذى أرادت شيبر قوله في مصر؟
وقبل أي شىء، لا بد من توضيح أن المحاضرة التى ألقتها فى القاهرة، هى ذاتها التى ألقتها فى الإسكندرية، وأن شيبر تخاطب الجمهورين الأكاديمى وغير الأكاديمى. ولذلك فهى لم تحاضر فقط فى الجامعات والمعاهد العلمية (من بيركلى إلى بكين، ومن بريتوريا إلى ستوكهولم).

بل ألقت محاضراتها أمام جماهير واسعة الاختلاف، مثل صانعى السياسات فى لاهاى أو بروكسل، وأمام ألف امرأة فى مركز أمستردام للمؤتمرات، وأمام نساء يهوديات فى معبد يهودى بلايدن، وجمهور من المسلمين فى مسجد بنيروبى، وداخل بيت شاى فى بكين.
وقد جاءت شهرتها بشكل عام من دراساتها حول أدب المرأة، وبالنسبة لنا فى مصر، فقد عرفناها عام 2008 عبر كتابها «إياك والزواج من كبيرة القدمين: النساء فى أمثال الشعوب»، الصادر عن دار الشروق، ترجمة كل من: د. هالة كمال ود. منى إبراهيم، ثم توطدت معرفتنا بها عبر الثلاثة كتب التى ترجمها عبد الرحيم يوسف، والتى لم نذكر منها: «ومن بعدنا الطوفان.. حكايات نهاية البشرية».
بدأت مينيكه شيبر محاضرتها قائلة: «على الرغم من الاختلافات الثقافية الكبرى، ثمة تشابهات مُذهلة بين الناس: فنحن نتشارك نفس الأجساد والوظائف الجسدية، باستثناء الأجزاء القليلة التى تميز جسديًا بين النساء والرجال.
وعبر تاريخ الإنسانية يجرى تيار سلطة وعجز كلا الجنسين، رغم أنه قليلًا ما كان لدى النساء تأثير واضح على التراث المكتوب. وقد لعبت الأساطير بطريقة ماكرة دورًا رئيسيًا فى تاريخنا، لدرجة أنه نادرًا ما تجرى مساءلة هذه الأساطير.
وإن بدأنا من سؤال ماذا نتشارك، سنكون أقل ميلًا لدعم التراتبيات، لأننا كلما أصررنا على الاختلافات، وكلما قارنا، كلما خلقنا تراتبيات تصر على الأولوية والتفوق».
وأوضحت أنه منذ زمن سحيق، وعلى أساس الاختلافات بين الجنسين، تأسس نظام ما زال يحدد بقوة نصيب الرجال والنساء، وأن هناك تيارًا لا يمكن إيقافه من التعليقات الذكورية على أجزاء من الجسد الأنثوى الجامح وغير الخاضع للسيطرة، بينما جرى كنس الأفكار الأنثوية حول هذه الأجزاء تحت سجادة الأبدية. فقد كانت المعلومات المُستقاة من النساء حول جنسهن نفسه نادرة حتى القرن الأسبق.

ولاشك أنه كانت لديهن أفكار عن أجسادهن (وعن أجساد الرجال)، لكن حتى وقت قريب، كان لآرائهن تأثير ضعيف على العلاقات الاجتماعية، وكانت المعرفة التى لديهن إما تتم مصادرتها فى صمت من قِبل الجنس الآخر، أو يتم تقديمها كمعرفة غير احترافية، فأغلب ما قيل وكُتب عن الجسد الأنثوى يعود فى الأصل إلى مصادر ذكورية أو تلوَّن بوجهات نظر ذكورية.
وإضافة إلى ذلك، كانت الأبحاث حول المجتمع البشرى طوال قرون تنطلق من وجهات نظر واهتمامات ذكورية. أما الاهتمام بوجهات النظر الأنثوية على المستويات المحلية والوطنية والعالمية فهو حديث نسبيًا: «نحن لا نعرف ماذا كانت تقول النساء أو يعتقدن فيما بينهن.
وفقد كتبوا القليل نسبيًا ولم تجذب تقاليدهن الشفهية الانتباه إلا منذ سبعينيات القرن العشرين. قبل ذاك الوقت كان هناك عادةً اهتمام أقل بالإسهامات الأنثوية مقارنة بإسهامات الذكور فى المجتمع، غالبًا لأن معظم الأنثروبولوجيين كانوا رجالًا استراحوا ضمنيًا لفكرة أن أمر النساء ليس مثيرًا للاهتمام».
وفى كتابها (تلال الفردوس)، حرصت مينيكه شيبر على أن تلقى نظرة واسعة المدى على القصص والأفكار المتعلقة بأجزاء الجسد التى منحتها الطبيعة للنساء فقط. مبررة ذلك بقولها: «نحن واقعون فى أسر تقاليد تربطنا بأسلافنا على نحو أوثق مما نعتقد. ولكى نصل إلى معنى الحاضر.
ونحن بحاجة إلى فهم الماضى»، فدون أى صلة بينها ابتدعت الثقافات قصصًا ظهرت فيها ربة قوية أو الأرض الأم متجلية فى كل الأحياء. كان جسد الأرض راقدًا ممتدًا حتى الأفق.
وكل ما هو موجود كان يخصها أنجبت وأطعمت الحياة كلها دون أى تدخل أو مساهمة من إله رجل. ليس فقط النباتات والأشجار والحيوانات هى التى خرجت من قنوات ولادتها، بل الكائنات البشرية الضئيلة.
وذكرت شيبر أن المفهوم الأساسى لـ «الإله» فى اللغة الصينية كان يعنى «القدرة على الحمل بالأطفال». وبمرور العصور اختفت تمامًا فكرة «الولادة» من المعنى القديم، وفى الأساطير الصينية ربما لا يقل عما هو موجود فى بقية أنحاء العالم- انتهى الأمر بالإلهة الأم إلى دور خاضع كشريكة لإله ذكر، أو تغيرت هى نفسها لتغدو شخصية ذكر.
وفى الحكايات تحول الإنجاب -أى خلق الحياة بالولادة- إلى ابتداع: أى خلق من اللاشىء بواسطة كلمة أو إيماءة، أو من مواد مختلفة بواسطة العمل اليدوى الخلاق. فى هذه العملية من التحول أخذ الإله السماء الخالق زمام المبادرة من الإلهة الأرض التى شرعت فى كل شىء قبل ذلك وحدها. انهارت سلطتها وأحيانًا كانت تؤمر بالانكماش حرفيًا.

و«كانت الأرض أكبر من أن يضمها السماء بين ذراعيه. فقال: رغم أنك زوجتى فإنك أكبر منى. كيف يمكننى أن أنالك؟ اجعلى نفسك أصغر. أذعنت الأرض وبفضل قدرتها على التكيف جاءت إلى الوجود الجبال والوديان. أصبحت الأرض صغيرة وتمكن السماء من ممارسة الحب معها. ومن ممارستهما للحب جاءت إلى الوجود كل أنواع الشجر والعشب وكل المخلوقات الحية». (هروسو، الهند).
وعلقت مينيكه شيبر على هذا الاعتقاد قائلة: «هذا بالضبط ما تفعله نساء كثيرات: يجعلن أنفسهن أصغر شكلًا من الرجال الذين لا يلدون/ يمنحون الحياة. فالطرف الذى يمنح الحياة يكون فى الغالب أقوى من الطرف الذى يتلقاها.
فيمكن رؤية القوة العظمى للإلهات فى الصور والأساطير المبكرة التى تبجل الخصوبة الأنثوية بطرق شتى؛ من ربة الثعابين إلى ربة البحر أو ربة القمر أو ربة العذارى أو ربة تصنع البشر من الطين. حيث كان المفتاح الأصلى للغز الحياة هو الأنوثة، قبل أن ينتج الحياة خالق ذكر وحده تمامًا أو يخلق الحياة بفضل أنشطة تناسلية/ خلقية أخرى».
وقد ظل خلق الحياة -تواصل شيبر- موضوعًا هامًا فى كل مجتمع، لكن فحوى القصص تغير. مع توابع مذهلة بالنسبة للطرق التى كان يتم بها تمثيل خلق الحياة. «وجدتُ أنه فى مئات الأساطير عن خلق البشر.
ويقوم إله ذكر بخلق الرجل قبل المرأة، وغالبًا ما تُخلق المرأة من مادة أقل جودة، من أمثلة هذه الأساطير: «أخذ هينيجبا بعض التراب وصنع الرجل منه. ثم أخذ مزيدًا من التراب وصنع المرأة منه. الرجل أقوى جسديًا من المرأة لأنه خُلق أولًا، وهذا قبل أن تهُن قوة الأرض بخلق كائن بشرى منها أولًا.» (كووتو، نيجيريا).
وفى حالات كثيرة يخلق كائن علوى ذكر رجلًا كاملًا أولًا، وبعد ذلك يخلق أنثى من جزء غير هام من جسد ذلك الرجل الأول، مثلًا إصبع قدم أو إبهام. أو ينعم على الرجل الأول بأن يصنع لنفسه زوجة من بوله أو من قطعة لحم من فخذه، تفاصيل صغيرة تتضمن رسائل من التراتبية الجنسية لدرجة أنه يصبح من الصعب اعتبارها جميعًا محض مصادفة.
تقول مينيكه شيبر: «يمكن للمرء بالطبع المجادلة بأن كونك خُلقت لاحقًا لا يعنى بالضرورة أن تكون أقل مرتبة، على العكس: قد يتبين جيدًا أن هناك جهدًا إبداعيًا ثانيًا أكثر اكتمالًا من الجهد الأول. ومع ذلك، أصبح الظهور فى المركز الثانى معادلًا للأقل قيمة». ومن المدهش أن كثيرًا من الرجال لديهم رغبة قوية فى التحدث بطريقة سلبية عن أجساد النساء.
وذلك نتيجة خوفهم وقلقهم المستمر من أن تتمتع النساء بالقوة ومن ثم يفرضن سيطرتهن على المجتمع، وقد أثارت الجرعات الزائدة بطول قرون من التعليقات السخيفة، لدى كثير من النساء حساسية مُفرطة تجاه النقد الهدام. فلا عجب أن صناعة الإعلانات اليوم حريصة على الاستفادة من الحاجة الأنثوية القديمة لنظرات الاستحسان، وهى حاجة مازالت الأمهات يمررنها ضمنيًا إلى بناتهن.
وترى شيبر أن الإخفاء الإلزامى العام للجسد الأنثوى فى التقاليد الأبوية، والتكشف المثير للجسد الأنثوى كموضوع للشهوة الاستهلاكية فى مجتمع الحاضر الاستهلاكى، هما وجهان لعملة واحدة اسمها عبودية المظهر.
وكلاهما يصرفان النظر عن المواهب والإنجازات الأنثوية الأهم فى الفنون والعلوم، فى الألعاب الرياضية والتقنيات، وفى مجالات أخرى عديدة أُعلن أنها مفتوحة فقط للرجال. مستشهدة بقول جون برجر: «يعمل الرجال وتظهر النساء. ينظر الرجال إلى النساء.
وتنظر النساء إلى الطريقة التى يُنظر بها إليهن. لا يحدد هذا فقط العلاقات بين الرجال والنساء، بل أيضًا العلاقة بين المرأة ونفسها. المراقِب داخل المرأة ذكر؛ والمراقَبَة أنثى. وهذا يحولها إلى شىء، وبمزيد من التحديد إلى شىء يُنظر إليه: إلى منظر»، ويأتى رد فعل النساء القلقات باللجوء إلى التدخل الجراحى كى تتأقلم أجسادهن مع نسب مثالية مُفترضة وخيالية.
وتتساءل: «لماذا نُسلم أنفسنا رجالًا ونساء عن طيب خاطر لعبودية المعلنين الذين حلت علامات الدولار مكان عيونهم، والذين لا يهدفون إلا إلى كسب مليارات الدولارات بفضل خنوع الجسد الأنثوى؟ هناك دائمًا خيار آخر وهو أن نتجاهلهم ببساطة!».
والأساطير والثقافة الشائعة والإعلانات بحسب شيبر تُقدم نظامًا اجتماعيًا مرغوبًا، وتُبقى الناس فى القبضة المحكمة لحكاياتها، «وتؤكد فى العادة نظامًا يكون الرجال فيه هم القادة، بالرغم من أنهم ظلوا مُعتمدين على النساء من أجل النسل.
ولم يؤد هذا الاعتماد فقط إلى السيطرة على نشاط الأنثى الجنسى، بل كذلك إلى حاجة ذكورية بالغة للتعويض فى الأمور السياسية والثقافية والدينية. وإلى ميل بارز إلى إقصاء النساء من المناصب التى لم تكن الاختلافات النوعية فيها غير ملائمة كليًا
.و لم تقم الميثولوجيا والثقافة الشعبية وحدهما بذلك، بل قام الفلاسفة واللاهوتيون أيضًا بالتحذير من أن جسد الأنثى يمكنه أن يخل بالنظام المنصوص عليه ويسبب الكوارث».
وفى القصص نجد تنويعة من المخاوف والاضطرابات الذكورية الهائلة بسبب الظاهرة المذهلة المتمثلة فى قدرة النساء على الولادة. تجلت هذه المخاوف فى السلوك الذكورى، كما يمكن ملاحظته على نطاق العالم فى آليتين أساسيتين: (1) من ناحية التقليل من النساء بكافة السبل.
وإخبارهن أنه بسبب دم الحيض والولادة لم تكن لديهن أى مواهب أخرى: لا عقول ولا مواهب فنية. ومن ناحية أخرى (2) آلية تحذير الرجال أحدهم للآخر من قوة النساء المدمرة. بالطبع، تناقض الآليتان إحداهما الأخرى، لكنهما نجحتا بشكل مشترك فى إبقاء أغلبية النساء فى مرتبة أدنى.
وأدى الانشغال القهرى بالمظهر إلى حلقة مفرغة: حيث تتنافس النساء مع أجسادهن لجذب انتباه الرجال. فلقد اختزلت النساء أنفسهن، من أجل الحفاظ على الذات، إلى أشياء، حيث لا توجد تقريبا أى خيارات لتحسين مصيرهن غير أن يبدين جذابات جنسيًا ويجدن زوجًا. وبمجرد تحقيق هذا، لا يبقى فى الحياة شىء صغير يحرزنه إلا أن يلدن نسلًا يُفضَّل أن يكون من الذكور.
وقد صادفت شيبر هذا التوتر الأبدى بين التحكم فى النساء والخوف منهن أثناء كتابتها لـ «تلال الفردوس». فثمة آلاف من الأمثال الشعبية تساعد على تهدئة الخوف الذكورى بمفاهيم نمطية عن الزوجة النموذجية، باختصار ينبغى أن تكون أصغر منه حجمًا وعمرًا.
وكذلك أقل موهبة وأقل تعليمًا، ويجب أن تتطلع إليه بتواضع، وتلزم الهدوء وتنصت، ولا تعارض زوجها أبدًا، فهناك مثل عربى يقول: «النساء يسألن الأسئلة، والرجال يقدمون الإجابات». فمازال الرجال المتزعزعون يحبون الالتزام بهذا النموذج. وكلما شعروا بالإحباط، يتحول الخوف بسهولة إلى غضب، ويتصاعد غالبًا ليصل إلى العنف اللفظى أو البدنى.
فى الوقت نفسه، تدعونا مينيكه شيبر إلى أن نضع أنفسنا مكان هؤلاء الرجال بتاريخهم ووضعهم: «كرجل ربما سمعت وتمثلت أشياء محقرة من شأن النساء طوال حياتك، وتظل تتلقى التحذير بأنهن غير موثوق بهن ولا بد من التحكم فيهن بصرامة، لأنه بغير ذلك ستندلع الفوضى. ويجعل هذا من الصعب الاقتراب من الجنس الآخر بدون تحيزات.
وعلاوة على ذلك إذا اقتنعت لقرون أن هناك شخصًا جاهز الصنع فى نطفتك وأنك الشخص الذى يضعه فى الرحم، فستؤمن بشكل آلى طبعًا بأن النساء يسهمن بالقليل أو بلا شىء فى المجتمع، وبلا شىء جوهرى فى حملهن كذلك».
وقد حظيت أحادية المنظور الذكورى بحماية إضافية فى المجتمعات أو الطوائف الدينية التى لم يكن مسموحًا فيها للنساء حتى بالتلاوة أو التعليق علانية على الكتب المقدسة والنصوص الرسمية والأنواع المرموقة: الأساطير، الملاحم، وأحيانًا حتى الأمثال. مثل هذه القواعد زادت فى تقليص الإسهام الأنثوى فى تشكيل التقاليد. ففى بعض الثقافات والأديان مازال غير مسموح للنساء بتلاوة، ناهيك عن تأويل، النصوص المقدسة أو عالية المكانة أو قيادة الطقوس الدينية. مثلًا: الكنيسة الرومانية الكاثوليكية حيث لا يمكن إلا للرجال أن يصلوا إلى منصب الكاهن أو البابا.
وعلى مدار القرن العشرين، اكتسبت النساء حريات لم يكن بمقدور جداتهن وأمهاتهن إلا أن يحلمن بها. ولم تعد الخبرات الأنثوية بأجسادهن وأجساد الجنس الآخر كتابًا مُغلقًا، والخبر الطيب هو أن الحدود التى كانت فيما مضى مرسومة بصرامة بين الرجال والنساء بادئة فى الاختفاء. فالعلاقات بين الجنسين تتغير ومساحات التحول بينهما أصبحت أكثر ازدحامًا.
وختمت مينيكه شيبر محاضرتها قائلة: «إن الاختلافات الجنسية فى بعض الأماكن، تغدو ذات حمولة اجتماعية أقل. وأينما كان هذا صحيحًا، لا يعود الناس مضطرين إلى التظاهر بأنهم فائزون عنيدون أو خاسرون غاضبون. كما تتخذ العلاقات أشكالًا جديدة وتُولّد الحاجة إلى اللقاء على قدم المساواة انفتاحًا متبادلًا.. لقد لعبت إذًا أجزاء الجسد الفريدة لدى النساء دورًا حاسمًا فى هذا الإرث.
وكانت الحاجة الذكورية للأجزاء التى تفصل النساء جسديًا عن الرجال دائمًا عظيمة، ولا يوجد أى نقص فى تعليقات الذكور عليها، ويفيض المدح الذكورى للنساء بمشاعر مختلطة تتراوح بين السلطة المُطلقة والعجز المُطلق، بين البهجة وبين انعدام الأمن وانعدام الثقة والخوف. وكتاب «تلال الفردوس» عن هذه المشاعر الملتبسة نحو أجزاء الجسد الأنثوى الحيوية والمرغوبة والمحسودة والمفترى عليها».
اقرأ ايضا | هدى الهرمي تكتب : أصوات مزّقها السِّياج
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
 الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني
الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني