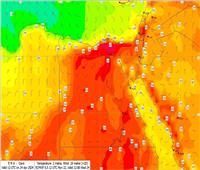سناء مصطفى
يوميات الأخبار
«حق رقبتى»
الأربعاء، 29 مارس 2023 - 08:43 م
ليس خطأ يا صديقتى أن تطبخى، وليست نقيصة من قيمتك أن تجلسى أمام مرآة غرفتك كى تتزينى
فى جلسة ضمت مجموعة من السيدات طرحت إحداهن على رفيقاتها سؤالا: ما قولكن فى الحملة التى أطلقها البعض يدعون فيها إلى تنازل الفتاة وأسرتها عن بند الشبْكة، والاكتفاء بشيء رمزى، من باب تيسير الزواج على الشباب فى هذه الأيام الصعبة؟
أدْلتْ كل واحدة برأيها، وكانت الأغلبية مستنكرة لتلك الدعوة، واسترعى سمعى جملة نطقت بها إحداهن: «كيف أتنازل عن حق رقبتى؟»!
رحت أتساءل بينى وبين نفسى: هل ترى المرأةُ أن حق رقبتها يساوى بضع جراماتٍ من الذهب؟ هل تعتبر أن الزواج صفقة تبيع فيها رقبتها للزوج، وأن الشبكة هى الثمن الذى ارتضته لنفسها فى هذه الصفقة؟! يا له من ثمنٍ بخس إذن! هل رقبتكِ رخيصة إلى هذا الحد؟! شىء مؤسف ألا تشعر المرأة أن حاجتها للزواج لا تقل عن حاجة الرجل إليه، والأكثر أسفا هو إحساسها أن الزواج فى مجتمعنا لا يمنحها هذا القدر من الاستقرار والأمان والسعادة الذى يجعلها راغبة فيه مقبلة عليه حتى وإن لم تُطَوَّق رقبتها بعقدٍ أو معصمها بأسورة أو إصبعها بخاتم ذهبى.
كنت أسمع كثيرا من النساء جملة: «أكلنى لحما ورمانى عظما»، وأتعجب: ألم يُشبع الزواج لديهن حاجة إنسانية أو غريزة طبيعية؟ ألم تسعد هذه الزوجة أو تلك مع زوجها بلحظة دفء وحنان ومحبة؟ ألم يشاركها ذات فرحة، أو يربت على كتفها ويمسح دمعتها ذات حزن؟ ألم تسعدها ركلة جنينها، وكفُّ رضيعها وهو يداعب وجهها ضاحكا مطمئنا؟ ألم تشعر بلحظة سعادة وهى تربى صغارها وتبنى أسرتها وتقيم مجتمعها؟ ألم تجد فى كل ذلك شيئا تسعد به وتراه يستحق أن تقدم رقبتها لتهنأ به أكثر مما تهنأ ببضعة جرامات من الذهب؟!
تذكرت كتابا مهما للكاتبيْن المثقفيْن «أشرف البولاقى» و"عمرو الشيخ" بعنوان «المرأة فى العقل العربي» يستدعيان فيه الموروث الدينى والثقافى والاجتماعى الذى أنتج كثيرا من سياقات المرأة، ويناقشان من خلال الطرح والحوار كثيرا من قضايا المرأة فى عصرنا الراهن.
تذكرت الكتاب لأن الكاتبين يتحدث كلاهما فى أكثر من فصل من فصوله عن تصور المرأة عن نفسها، وعن وضعها فى المجتمع وطبيعة علاقتها بالرجل دون الانسياق وراء الآراء التى تتبنى مظلومية المرأة.
يقول الأستاذ أشرف البولاقى فى أحد فصول الكتاب: «إذا كنا متفقين على أن المرأة نفسها راضية ومقتنعة، بل ومستمتعة، بأفضلية الرجل، وبأنها أدنى منزلة ومقاما، فكيف يرجى أملٌ فى تغيير الذهنية أو العقلية؟!»
ويقول أيضا: «أرى وأرصد أن نساء كثيرات حريصات على تكريس تهميش المرأة وإقصائها، وهو أمر ليس مفهوما عند المرأة نفسها، لكنه يظل متعلقا عندها بالسلطة الذكورية التى يفرضها التراث والرجل والمجتمع».
إن المرأة مقتنعة وراضية أنها أدنى منزلة، لدرجة أن تبيع رقبتها للطرف الأقوى، وهو الزوج، وتقبض ثمنها الذى ارتضته نظير أن يستمتع بها هى «المحبوبة، والمرغوبة، والمعشوقة، والمطلوبة»، ولا تتوقف لحظة لتتساءل: ولماذا لا أكون أنا المُحِبة، والراغبة، والعاشقة، والطالبة التى تستحق الحياة وتستحق أن تتذوقها مع شريك يسعد بها وتسعد به؟
يقول الأستاذ عمرو الشيخ فى فصل آخر من الكتاب: «ليس خطأ يا صديقتى أن تطبخى، وليست نقيصة من قيمتك أن تجلسى أمام مرآة غرفتك كى تتزينى، وليس عيبا إن رأيتِ أن دورك أن تكونى ربة منزل بالمعنى التقليدى المتعارف عليه.
لكن الخطأ والنقيصة أن تصدقى أنكِ الأقل وترضين بذلك. قوتك فى قوتك. فى احترامك لذاتك، واحترام الآخرين لكِ. قوتك فى اكتمالك، حين تفيقين من وهم أنكِ نصف وتبحثين عن نصفك الآخر. أنتِ واحد صحيح مكتمل.. ستعيشين مع واحدٍ صحيح مكتمل. الزواج استمرار للحياة ذاتها، وأنتما شريكان متكافئان فى هذه الحياة».
أتذكر أبى- عليه فيوض رحمة الله ورضوانه - حين سأله المأذون يوم كتابة عقد زواجى: كم مؤخر الزواج؟ نظر إلى زوجى قائلا: اللى يقول عليه الدكتور حسن.
قال أبى يومها جملة لا أنساها، وظل زوجى يذكرها له ويضرب به المثل: أعطيتك ابنتى، وهى أغلى من كنوز الدنيا جميعها، فهل أفكر بعدها فى مهر أو مؤخر أو ذهب؟!
هكذا عشتُ حياةً، وأقمتُ أسرة، وعرفتُ قيمة نفسى، وغلاوة «رقبتى» فقدرتها حق قدرها.
زينب عبد الموجود
على لسان زينب عبد الموجود (حماتى) عليها رحمة الله ومغفرته ورضوانه: ماذا تساوى المرأة من دون الرجل؟ إن نفَسَ الرجل فى البيت خمرٌ. كان زوجى يشقى فى أرضه ويحرثها ويزرعها، ويجنى فى نهاية الموسم مما حصدت يداه، وكنت الزوجة التى تغربت عن أهلها وقريتها، وعاشت فى بلاد أخرى وبين أهلٍ آخرين، شقيتُ كما شقى، وحرثت وزرعت كما فعل زوجى لأننى اعتبرت بيتى وأبنائى هم أرضى وحرثى.
يا ابنتى من توكل على الله كفاه. أنجبتُ أربعة عشر طفلا، مات منهم أربعة. لا أتذكر أن أمى حضرت معى ولادة أى منهم سوى الأول، وعلى غير عادة النساء فى قريتنا والقرى المجاورة لم أذهب للولادة فى بيت أبى ولا مرة.
بعد ساعاتٍ من ولادة طفلى الثاني، وكان الوقتُ مبكرا، حلبتُ الجاموسة، وعجنتُ العجين، وأوقدتُّ الفرن، ثم رصصتُ الخبز فيها، وتركته حتى ينضج.
فى هذه الأثناء وضعتُ الفطير الأبيض فى السلطانية وسكبتُ عليه اللبن الساخن ونصف كوب من السمن البلدى، وغطيته قليلا حتى يلين، ثم أكلته. أرضعتُ طفلى، وأخرجتُ الخبز من الفرن، وغطيته، ثم نمتُ فى سريرى وبجوارى الطفلُ. حين جاءت الجارات فى الصباح، وحتى لا يصيبنى أنا وطفلى الحسد، أخبرتهن أن أمى كانت معى، عجنتْ وخبزتْ، وأعدتْ لى الإفطار، ثم سافرتْ إلى بلدتها لأن أخى مريض.
عزاء الستات
فى معظم بيوتنا الجنوبية يختلف عزاء السيدات تماما عن عزاء الرجال. فى عزاء الرجال تُفتح المنادر ويتم تجهيزها، ويُفرش الكنب وتُرص الكراسى، ويقف الرجال على جانبى الطريق لاستقبال المعزين الذين يدخلون بكامل هيبتهم، ولا يبقون إلا بضع دقائق ينصرفون بعدها تاركين المكان لآخرين.
أما عن عزاء السيدات فحدث ولا حرج: تقوم نساء الدار بفرش عدد من الحُصُر (جمع حصير)، وقد علاها التراب، ويضعون عددا قليلا من الكراسى تحسبا لوجود سيدة كبيرة فى السن، أو أخرى مريضة لا تستطيع الجلوس على الأرض، أو أخرى لا تستطيع السجود أثناء الصلاة فيضعن لها الكرسى لتصلى عليه.
تنظر كل سيدة تأتى للعزاء إلى الكراسى القليلة الموجودة فى المكان، ويأخذها الحرج من الجلوس عليه. هذا لا يعنى عدم المقدرة على توفير عدد كاف من الكراسى فى المنزل، بل هو مغالاة فى مظاهر الحزن من باب: «ناقص كمان تقعدوا على الكراسى، واحنا حزانى ومهمومين».
من الذى فرض هذا على النساء؟ لم يدخل رجل على النساء مثلا وأصدر فرمانا بعدم جلوسهن على الكراسى لأن هذا لا يصح، بل إن النساء أنفسهن هن اللاتى فرضن ذلك على أنفسهن وعلى غيرهن ممن يأتين للعزاء وضيّقن واسعا. لا أحد أكثر ظلما للمرأة من المرأة.
أسوأ مكان فى الجحيم
نختار أحيانا أن نقف على الحياد حتى نجنب أنفسنا وأحبتنا أمورا لا ينبغى الخوض فيها، ومواقف لا جدوى فى مواجهتها، ويحدث ذلك أحيانا لأننا لا نمتلك الحقيقة المطلقة، ولا يمكننا أن نشير واثقين إلى صدق تحيزنا لطرف أو موقف مقابل الآخر.
لكننا فى لحظة ما، حين تتخذ الأمور منحى ينافى الخير والفطرة الإنسانية السليمة، يصبح الوقوف على الحياد هنا خيانة لأنفسنا وضمائرنا ومعتقداتنا، فنضطر حينها إلى مخالفة ما روضنا أنفسنا عليه، ونتذكر قول المناضل والزعيم الأمريكى مارتن لوثر كينج: «إن أسوأ مكان فى الجحيم مُخصَّص لأولئك الذين يقفون على الحِياد فى المعارك الأخلاقية الكُبرى».
بينما أستعد لمغادرة بيت أبى بعد زيارة قصيرة، احتضنتنى أمى ذلك الحضن الدافئ الذى تذوب فيه همومٌ، وتنصهر داخله انكسارات، ثم مدت إليّ يدها بكيس صغير قائلة: هذا بيض بلدي؛ أنتِ لا تحبين البيض الزراعى الذى لم يعد يباعُ فى المحلات غيره.
أمى نبيةٌ
ليس كالأم نهرٌ، وليس كمثلها جبل. تنساب بين كفيها حيوات، وتتفتت على كتفيها جلاميد. نغدو من جنتها بطانا، ونعود إليها خماصا، لا نتوب نحن عن التمرد، ولا تملّ هى من الدعاء.. كيف أخبر أمى أننى منذ أن صادتنى بين أنيابها الحياةُ، نسيتُ ما الذى أحبه؟ لم أعد أتذكر إلا أننى بعيدا عن فردوسها عدمٌ، وأننى منفيةٌ فى البرارى لا أهتدى إلى جدارٍ إلا بضوء كلماتها فى سماء قلبى.
نبية يا أمى أنتِ، لم تبلغى رسالة، لكنكِ فى طلعة كل صباح تشرقين على الكون كشمس حانية تقول: هل من وحيد يأتنس بى فيأنس؟ هل من تائه يرنو إلى قلبى فيهتدى؟ وهل من شقى أدمت قدميه حاجات ورغبات يدق بابى فيسعد؟
أنا يا أمى وحيدةٌ، وشاردةٌ فى صحارى نفسى، بكِ وبدعائكِ آنس، وأسعد، وأهتدى.. كل عام نحن بخير بأمهاتنا، حقول الله الناضرة فى كونه الممتد منذ أن أشرقت حواء من ضلع آدم فكانت نورا ودفئا وحياة.
لو كنتُ غيرى
هل كان حلمًا أن أعيدَ إلى الظلال ظلالها
وأحارب الفوضى التى تجتاحنى باسم الفضيلةِ
دون أسلحةٍ لديّ سوى جنونى؟
خلف سربٍ من طيور الماءِ أركضُ
وحده ظلى يرتق ما تبقى من حبيبٍ فى خطاى
أشير للنبع البعيدِ
أنِ انتظرني
ريثَما أبتاعُ حلوى للملائكة الذين – كما فعلتُ-
يصدقون رسائلَ الماءِ
انتظارا للوصولِ إلى النهايات السعيدةِ
ربما لو كنتُ غيرى.. ما أشرْت.
شاعرة وأديبة - قنا
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة













 نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
 «لست ملاكاً»
«لست ملاكاً»
 وكاد بطل الملاكمة يصفعنى فى الطابور!
وكاد بطل الملاكمة يصفعنى فى الطابور!
 وجها لوجه مع مصطفى أمين
وجها لوجه مع مصطفى أمين
 مكالمة «نص الليل» مع الشهيد أبو عمار
مكالمة «نص الليل» مع الشهيد أبو عمار
 فى الموت والحياة.. عظة
فى الموت والحياة.. عظة
 أنا أقاوم.. إذاً أنا موجود
أنا أقاوم.. إذاً أنا موجود
 مذكرات الدكتور مجدى يعقوب
مذكرات الدكتور مجدى يعقوب
 جمهورية العلم والعدل
جمهورية العلم والعدل