
حمدى أبوجليل
حمدى أبوجليل يكتب : نصوص
الجمعة، 23 يونيو 2023 - 02:16 م
اسمى «حمدى» اسم لا يليق ببدوى مثلى.. ولا معنى له تقريباً، إلا إذا قسمته نصفين: «حمد» وتعنى الامتنان لله، والياء تؤكد هذا الامتنان، وهذا لا يدع مجالاً للشك فى أن البدو تواطأوا لتقرب لله على جثة اسم المسكين الممعن فى الخشوع، والذى لم يحدث مطلقاً أن سموا به أحداً قبلى.
إذن البدو كانوا يعانون من حالة امتنان وشكر ومسكنة وخوف بلغت ذروتها بوصولى، وبما أنهم لا يستسلمون لتلك الأحوال التى تدفعهم إلى تحسين مؤقت لعلاقتهم بالله إلا فى أوقات الكرب، فلاشك أن تاريخ مولدى صادف ظروفاً غير ملائمة لم يقووا على نارها سوى بالاستعانة بالله.

ضمن حكايات أمى عن وقائع ولادتى لم يتوقف خيالى سوى أمام حبات العرق الغزيرة التى غطت وجهها أثناء ولادتى، ربما طمعاً فى إضفاء نوع من المهابة على ولادتى، رغم أن المسألة عادية جداً، فوجود حبات عرق، حتى لو كانت غزيرة، أمر طبيعى جداً على وجه امرأة تلد طفلاً، خصوصاً إذا كان ذلك فى شهر أغسطس أحر شهور السنة.
ترى ما هو الكرب الذى جعلهم يضحون باسمى إرضاء لله؟!
زمان الجدب وخيانات المطر والمراغى وجفاف الآبار وتيه الصحارى انطوى إلى الأبد، حين خضعوا لمشيئة الله تماماً وجمعوه حمداً كثيراً، أظهر جلياً فى استقرارهم الدائم على حواف المدن.. فلا ترحال أو معاشرة اللهم إلا قائمة طويلة تحمل أسماء الأسلاف مستقرة فوق الأماكن البارزة فى بيوتهم، ويرددونها مصحوبة بنغمة موسيقية أسيأنة إلى أن يصلو إلى آخرها.. أصل الشجرة الذى لا يخفون فخرهم بأنه هو ولا أحد سواه من فعلها وأدمى قدمى رسول الله فى الطائف.
ترى لم الامتنان والحمد والأمور مستقرة تماماً هكذاً؟!
فلاحة الأرض - التى يتقنوها الآن - نقى من ويلات الشجاعة ومداهما الخلاء، ومن إدماء قدمى الرسول.. أى رسول.
أهو «الامتنان والحمد» رغبة فى الثبات، كمن يصفعك صفعة قوية على قفاك، فشيدى أمتنانك وشكرك له، بينما دموعك تتطاير من عينيك حتى لا يفعلها مرة أخرى؟!
غير لائق بالمرة أن أصل إلى أننى مجرد ابتسامة شكر واجهت صفعة قوية وصاحبت انهمار شلالات دموع.
ملامحنا دائماً تخضع لشروط أسمائنا، وبكلمات أخرى: تراث أسمائنا يتدخل فى نسيج مستقبل شخصياتنا، أنظر مثلاً إلى كل الذين أسمهم «عبدالمنعم» تجد معطمهم يتقنون تلك الانحناءة التى تناسب المتسولين.
لذلك من فضل ألا نتعجل فى إطلاق أسماء على أبنائنا - جزافاً - بمجرد ولادتهم كما فعلها آباؤنا.. يجب أن نتروى قليلاً ونتركهم هكذا خفافاً يمرحون بدون أسماء حتى تتضح ملامحهم تماماً، ويصبحون قادرين على التحول فى الحياة بحرية مطلقة بعيداً عن ثقل الأسماء.
فها أنا - وفاء لشروطى اسمى - لا أثق فى قيمة ما أقول أو أفعل، ولا أقدر على مواجهة سخافات صاحب منزلى ورؤساء العمل، وأخفض صوتى ورأسى كبنت بدوية فى ليلة عرسها، حين يباغتنى أحدهم بالسؤال عن اسمى، الذى بدوت جديراً به تماماً، كأى شخص مسكين باغتته صفعة قوية على قفاه بالضبط.
كان بالإمكان أن يسمونى «حمدّ» بحدف الياء، خصوصاً وأن العديد من أجدادنا لهم هذا الاسم، وهو سيحقق - بالطبع - الامتنان المطلوب بشكل لائق وعجرفة ترضينى وتناسب سليل من أدمى قدمى رسول الله.
ولكن يبدو أن ذلك ليس مطلوباً على الإطلاق، فالأمر معد له جيداً وبعناية فائقة، ففضلاً عن أن حذف الياء يجعل نسبة الصفعة للبدو بالذات مبهمة فإن تشديد الدال سيخفى صوتها الذى لابد أن يكون مدوياً.
أبى سأجعله أباً أسطورياً، سأخفض صوتى أمامه، ولن أرفع عينى فى وجهه، سأرتبك وألقى سيجارتى المشتعلة تحت السرير حينما أسمع صوته، وأترك نارها تلتهم السرير.. حتى أحكى لأصدقاء - كما حكواً لى دوماً - أن أبى ضبطنى وأنا أدخن فارتبكت وكانت الكارثة واحترق السرير، لا سأقسم لهم أنى وضعت سيجارتى فى جيبي، ففضلاً عن أن البدو ليس لديهم سرير أصلاً، فإن وضع سيجارة فى جيبى سيرسخ مشهد الارتباك، وسيطيل حالة ارتجافى أمام أبى مما يجعل من هيبته حقيقة حارقة.
سأعالجه من أوجاع الروماتيزم عند أفضل الأطباء، أليس كل الآباء يعانون من الروماتيزم؟ سأرتكب أخطاء فادحة فى حق الناس حتى يشكونى إليه.. طوال عمرى وأنا شخص مسكين لا أرتكب أخطاء فى حق أحد، ليس لأنى ولد طيب مطيع، ولكن خوفاً من رعشة المهانة التى أحسها تضغط بقسوة على قلبى حين يشكونى الناس لأمى.
سأخجل منه، نعم سأخجل منه، سأعوض حرمانى من الخجل الجميل طوال ثمانية وعشرين عاماً. سأقفل أزرار قميصى، وسأتخلص من كل بنطلوناتى الضيقة، بل سأرتدى جلباباً فضفاضاً يخفى معالم جسدى، وسأقص شعرى قصة كلاسيكية جداً. ورغم أنى لا أعرف لماذا يخجل البدو من حلق ذقونهم أمام آبائهم فلن أحلق ذقنى أمامه، وسأزيل شاربى تماماً حتى أبدو أمامه ولداً صغيراً.
أليس هو أبى الذى اخترته لنفسى بحرية مطلقة؟ كل الأبناء الأصلاء يولدون مفروضاً عليهم آباؤهم سواء كانوا طيبين أو أشراراً، حتى اللقطاء فرض عليهم آباء يخجلون منهم!!
أنا الوحيد صاحب شرف اختيار أبيه بمزاجه، قمت بحصر شامل لكل أصدقائى الذين يكبروننى فى الطول والسن والهيبة، «الهيبة».. هذه يصعب قياسها، ولكن يكفى أن أحددها أنا، وتوافر لى عدد هائل من الرجال الطواول المسنين يتمتعون بقدر لابأس به من الهيبة، ثلاثة فقط هم الذين توافر فيهم شرط ملامح البدو وقسوتهم، الذى حرصت عليه، ولأن خيمتى البدوية المهيبة لا تتسع سوى لواحد فقط اخترته هو، ليس من أجله، فمسألة أنه يستحقها، أو لا يستحقها لا تشغلنى، ولكن لأنى بعد ثمانية وعشرين عاماً، وعدد هائل من الإحباطات والإهانات، وبعد انتزاع خيمتى البدوية الميمونة من نجع البدو، واتخاذها مكاناً محترماً فى قلب ميدان التحرير، أكتشف أننى أحتاج رجلاً وقوراً أحترمه.
كيف أقول له الكلمة التى اخترته لها؟!
كيف أنطقها؟!
كيف أجعلها تلتصق بشفتى التصاقاً حقيقياً لا شبهة فيه؟!
المعلم بكر مقاول الأنفار كان يميزنى عن جميع أنفاره، ويوفر لى يومية أو يوميتين كل أسبوع بأجر مرتفع، ورغم أنى أحبه بالفعل وحاولت مراراً أن أقولها له، إلا أننى فشلت تماماً، فى كل مرة أقف أمامه مباشرة وأخفض صوتى بشكل لافت، وأضع يدى اليمنى فوق اليسرى كمن يتهيأ للصلاة، وعندما أتأكد من أنى أخذت سمات الأبناء المطيعين أمام آبائهم، أردد الكلمة فى سرى مرات عدة، وبعد أن أحس سهولة وليونة حركتها فوق لسانى، أحاول بكل قوتى زحزحتها فوق شفتى، ولكنى أجدها ثقيلة كما الصخر، وقاسية كما السنوات الطوال، وأحس بها تندفع مرتدة إلى أعماقى وتغوص فى ركن دفين لا أعرف كيف أصل إليه وأجدنى أحادث بكراً كما يحادث شيخ قبائل البدو فلاحاً مسكيناً فى النجع، منادياً عليه باسمه كاملاً «بكر قرنى بيومى» ، مجرداً حتى من صفة «معلم» التى يعزها، ربما لأن بكر اكتفى بأن يجعلنى أحبه فقط. وربما لأنه لم ينس مطلقاً - كما نسيت - أنه فلاح من نجعنا على رغم أنه أصبح مقاولاً لعدد هائل من الأنفار أنا واحد منهم!!
هل معاناة الاختيار وتمتع صديقى بملامح البدو سيزحزحان هذه الكلمة من ركنها المستقر فى أعماقى؟
شكل هذه الكلمة ورونقها وايقاعها فى كل اللهجات توحى بأن هناك طقوساً معينة مصاحبة لنطقها، وإلا حدث خلل يفقدها مهابتها. البدوى حين ينطق «يأتى» ترتفع عيناه إلى السماء مع وجود لمسة ابتهال وخضوع واضحة. هل أناديه كما ينادى البدو آبائهم «باتي.. باتي.. باتى»؟
ولكن بداوتها ستطرح مشكلة أنه فلاح وأنى بدوى وهذا يدمر رغبتى فى قولها من الأساس.. أمى كان يجب أن تأخذ بالها وتحسب حُساب أنى ربما أحتاج لهذه الكلمة يوماً. وتدربنى عليها كما تفعل كل الأمهات مع أبنائهن.
«أبى .. أبى .. أبى» سأناديه بها هكذا «أبى»، هذه أيضاً لا تصلح، فرغم أنها تختال مزهوة فوق الألسنة إلا أن فصاحتها قاسية وروتينية مثل موظفى الحكومة، وستنزع عنها طفولتها وسذاجتها وتسللها مثل مواء قط.
أما «بابا» فلا أعرف لماذا أخجل منها بالفعل، وأحس بأنها يمكن أن تطلق على أى إنسان سواء كان كهلاً أو طفلاً، وأبتسم حين أسمع أى واحد ينادى بها رجلاً وقوراً يشبهه!
هل أجمع كل أصدقاء طفولتى وأعاود ضربى الشرس لهم، حين كانوا يصمتون ذلك الصمت المؤلم، عندما أصرخ فيهم أن يدلونى على رجل - أى رجل - لكى أناديه بنفس هذه الكلمة المهيبة التى تختال على شفاههم حين يرون آباءهم؟ هل يمكن أن يدلونى عليه هو.. هو بالذات؟!
أمى لم أقصد، كانت مجرد رسالة تافهة من تلك التى ترسلها هيئة المعاشات لها كل عام لسببين أولهما يرجع إلى رغبة مشروعة فى مشاركتها المعاش وثانيهما التأكد من أنها مازالت تمارس الحياة.
خلال الأربعون يوماً التالية لموت أبى، التى دربتنى على إتقان مظاهر الحزن الذى ولد هيستيرياً ومضحكاً، ومع تمام الأربعين أصبح أكثر تمهلاً ووقاراً وكآبة، وبدوت قادراً ومستمتعاً وجديراً باستبدال اسمه البدوى المصحوب بصعوبة فى النطق باسم «المرحوم» السهل الجاذب لنظرة الطفل كما تجذب أكوام القمامة أفواج الذباب.
فى تلك الأربعين الغابرة حين كنت أخجل من الضحك على الأهمية الطارئة التى صاحبت «المرحوم».. كانت رسائل هيئة المعاشات تأتى متوالية.. محذرة ومتوعدة: «أى محاولة الزواج معناها انقطاع المعاش» كنت أخجل من قراءة هذه الجملة وأطمئن لهفتها بكلام يؤكد استمرار المعاش كانت لا تصدق منه حرفاً واحداً.
بعد أن انتقلت الرسائل إلى المرحلة الموسمية، خفتت حدتها، بل إنها فى سنوات كثيرة كانت لا تبخل على أمى بالتهنئة بالأعياد المختلفة، ربما لأنها فقدت الأمل فى مسألة الزواج، وتهيئ الجو جيداً لأمر جديد وحاسم يكون انقطاع المعاش معه أمراً حتمياً، كان ذلك عارياً تماماً أمام طريقة صياغة التهانى التى كانت لا تعنى سوى التنبيه بزيادة سنة جديدة.. خطوة واسعة ومؤثرة فى طريق آخرها انقطاع المعاش.
يبدو أن أمى انتبهت للمؤامرة جيداً، فقد أخذت تهمل الخطابات التى تتأكد من أنها موجهة إليها، عن طريق تلمس حروف اسمها فلا تعرف سواه، تبلل إبهامها وتمرره ببطء شديد فوق الاسم المكتوب على الخطاب، حرفاً حرفاً، ولما تنتهى رحلة إبهامها فوق آخر حرف تتأكد فوراً من أن الخطاب موجه لها، أو لي، فإذا كان لها تلقيه بإهمال فى أى ركن قريب منها ولا تنظر إليه مطلقاً، ولكن ذلك الإهمال لم تصبر عليه طويلاً، ففجأة جمعت كل خطاباتها ورصتهم فوق بعض بحرص شديد، ومع وصول كل خطاب جديد من هيئة المعاشات تعدهم مرات عديدة مرات عديدة وتخطئ فى العدد وتسألنى «أنا عمرى كام؟»!
تزامن مع ذلك «العد» الذى تخطئ فيه دائماً اختصار ملحوظ فى أشيائها، والمساحة التى تتحرك فيها داخل البيت.
مع كل خطاب تضمه إلى قائمة الحساب، وتمدده فوق إخوته، تستغنى مباشرة عن حاجة من حاجاتها وتطويها فوق الخطابات.
أو تغلق حجرة جديدة من حجرات بيتنا الواسع، بدأت المسألة بالحجرات الأقل أهمية، كحجرات البهائم والفرن والتبن والفراخ، وبأشيائها التافهة، كأكواب الشاى والأطباق والملابس القديمة والبطاطين، ثم سرعان ما شملت قرارات الاستغناء والطى الأشياء والحجرات الأكثر أهمية، فأغلقت أمى حجرة الجلوس، الصالة، والباب الأمامى للبيت، وطوت - إلى غير رجعة - «الطرحة» الطبيعى التى أتى بها خالى من بلاد الحجاز، التى كانت تفخر بطراوتها وبركتها دوماً.
وبعد أن ازدحمت الأشياء المستغنى عنها، وبعد أن خصصت أمى لها حجرة بمفردها - أسمتها «حجرة صاحب النصيب» - اتجهت أمى إلى تكهين أشيائها الاستراتيجية، وقصرت استعمالها على طبق واحد من نوع «الألمونيا» القديم هو الذى بقى من جهاز عُرسها.. تطهر فيه طعامها على الكانون، وتنظفه جيداً وتملؤه من الزير وتشرب حتى ترتوى وبالباقى يكون الشاى الذى يشرب من الطبق مباشرة، كل ذلك فى الحجرة الوحيدة التى ظلت مفتوحة من حجرات بيتنا العشرين، تنام فيها، وتأكل وتعد الخطابات.. وتستحم، وتفعل كما يفعل الناس، وتعانى من أوجاع الروماتيزم، وتشتاق إلى أى جنس حياً وميتاً، وتتهيأ لاستقبال الزائرين الذين لن يأتوا مطلقاً.
أمى لم تقيد فى سجلات المواليد المصرية كما أبناء جيلها، فقد ولدوا فى الفترة التى كان البدو يعتدون بعدم انتمائهم إلى وطن، وكانت الحكومات - بلؤم شديد - توافقهم وتميزهم على ذلك. وكنت أطمئن نفسى بالعدد القليل العائش من أندادها، ومع موت كل واحد منهم كنت أسألها هل المرحوم من عمرك؟!
وكانت ترتبك حيت تقول بتهدج «لاااا» وبعد أن تتأكد أنها ضغطت ضغطاً جيداً على «لاااا» تضيف «أكبر».
موت آخر «شيخ عرب» كان يناديها باسمها مجرداً من صفة «حنى» جعل الاعتماد على الشواهد التاريخية فى تحديد عمرها أمراً حتمياً. سألتها عن ثورة ١٩١٩ وسعد زغلول، ليس لأنها مهتمة بالتاريخ الثورى المصرى ولكن لأن أحد أبناء عمها كان ضمن قادة هذه الثورة، وقطع البدو فيها أسلاك التليفونات وقضبان السكك الحديدية، وهجموا على مراكز الشرطة، وقتل ثمانية منهم برصاص الإنجليز، حين قلت «الإنجليز»، أبدت دهشتها وقالت:
- «عارفتها الثورة، مهنكش إنجليز».
- «أمال هم اهجموا على المركز ليش»
«نين ما الحكومة وواحد اسما «سعد زغلول» خذوا «حمد الباسل» وحطوه فى السجن هجم «البوادى على المركز، وقصوا قضبان لقطار».
لاشك أن إسهاماتها التاريخية هذه دمرت حجة دامغة كنت أكسر بها عيون أبناء الفلاحين أثناء المشاحنات، متفاخراً بأجدادى البدو، معتقداً بأنهم ثاروا من أجل تحرير الوطن من المستعمر، غافلاً عن أن ثمانية منهم ضحوا بحياتهم طائعين مجرد سجن أحدهم:
«وغيابهن عنك يهشمن فى غيرك.
طول المدى لا موتن لا شابن»
لا أعرف لماذا تغنت أمى بهذا الشعر، ألتؤكد إسهاماتها التاريخية؟ أم لأنها حسبت مثلى عدد السنوات التى تفصل بين مولدها الافتراضى قبل ١٩١٩ وعام ١٩٩٨.
«أم تراها استحسنت مثلى إقامة هدنة عشر سنوات كاملة مع متوسطات أعمار الإنسان المحصورة بين «الستين» و«السبعين» واقتنعت مثلى أن عمرها ستين عاماً بالضبط.. حسبت الحسبة بدقة وقلت: أنت من مواليد ١/١/١٩٤٨ كان ذلك مريحاً ورائعاً، عشر سنوات كافية ليس فقط لتغيير العالم، بل إبادته، فابتسمت ابتسامة مصحوبة بهزة واثقة للرأس: ظننتها إشارة لتشغيل العمر الافتراضى الذى حددناه، ولكن عندما انتبهت إلى أن الفرق بين «٤٨» و«٩٨» خمسون عاماً فقط، أيقفنت أن افتراضى أفرط كثيراً، فى التفاؤل، وأن هز الرأس بثقة هو الفعل الوحيد الذى تواجه به تزويج بنات البدو للفلاحين وآلام قدميها، وسخافات أخى، وتجاعيد وجهها، ورسائل هيئة المعاشات.
لم أقصد رسالة عادية قرأتها بملل، ولم أنتبه إلى فراغ خانة «الميلاد» من «ساقطة قيد» إلا وأنا أضغطها داخل المظروف، وخانتنى بلادتى فى الحساب، وتشبث التاريخ بشدة «١/١/١٩٠٠».
ووجدتنى غير قادر - بالمرة - عن الكف عن تحسين تجاعيد وجهها، والارتباك حيت تغط فى نوم عميق، ولا أعرف لماذا بدت عادية ولم تهز رأسها عندما قلت مداعباً «١/١/١٩٠٠»، تراها لم تصدقنى، أو ربما حفظت - بالملامسة - أرقام التاريخ كما حفظت حروف اسمها بالضبط.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 طارق الطيب.. ليالى الفن فى فيينا حازم المستكاوى ومعمار الحروف
طارق الطيب.. ليالى الفن فى فيينا حازم المستكاوى ومعمار الحروف
 «عملك مردود إليك».. رسالة حازم المستكاوي في وداعه للعالم
«عملك مردود إليك».. رسالة حازم المستكاوي في وداعه للعالم
 من بغداد إلى القاهرة مدن وخلفاء
من بغداد إلى القاهرة مدن وخلفاء
 محمد سليم شوشة: خاتم سليمي رواية عن الحب والإرهاب وتزاوج الحضارات
محمد سليم شوشة: خاتم سليمي رواية عن الحب والإرهاب وتزاوج الحضارات
 نيفين النصيري تكتب: شيء ما أصابه الخلل.. تمرد الراوى
نيفين النصيري تكتب: شيء ما أصابه الخلل.. تمرد الراوى
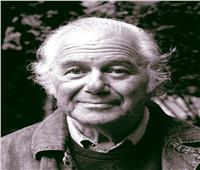 أحمد الزناتى يكتب : أذكار فى أوانها جاكوب نيديلمان وتأملات عن المعنى والمسؤولية
أحمد الزناتى يكتب : أذكار فى أوانها جاكوب نيديلمان وتأملات عن المعنى والمسؤولية
 منصورة عز الدين تكتب :تونى موريسون كمحررة أدبية
منصورة عز الدين تكتب :تونى موريسون كمحررة أدبية
 صقلية .. الحلقة المفقودة فى تطور عمارة القاهرة
صقلية .. الحلقة المفقودة فى تطور عمارة القاهرة
 القاهرة في مرأه باريس
القاهرة في مرأه باريس





















