
محمد سليم شوشة يكتب : دكاكين تغلق أبوابها
محمد سليم شوشة يكتب : دكاكين تغلق أبوابها
الخميس، 06 يوليه 2023 - 01:49 م
تأتى رواية دكاكين تغلق أبوابها للروائى المصرى القدير كمال رحيم الصادرة مؤخرا 2023 عن دار العين بالقاهرة امتدادا لمشروعه الروائى المهم والمتنوع الذى تترابط وحداته عبر روح شعرية عامة تمثل هوية صوته السردى المتميز، وتعكس فكره المتسرب بنعومة فى الخطاب الروائي، ومعالجاته العميقة لإشكالات وقضايا اجتماعية على قدر كبير من الخطورة، يقاربها بأسلوب هامس وسرد روائى ساخر يركز على إنتاج أكبر كم من الجماليات، وينبع من تبيئر ذاتى ورؤية فردية دافئة تبتعد عن الصخب أو الصوت المباشر فى الصدح بالأفكار والقضايا والإشكالات والأزمات الاجتماعية والتاريخية التى يجسدها أو يحاول مقاربتها بعمق فى إبداعه.
ترتكز هذه الشعرية السردية على عدد من المرتكزات والدعائم التى تشكل جمال هذا الخطاب الروائي، وتعكس خصوصية الصوت السردى واختلافه أو قدر مغايرته عبر ما يحمل من الدفء والملامح الإنسانية، وأبرز هذه المرتكزات هى الطبيعة الساخرة أو الصوت الساخر القادر على الهزل والسخرية من الأشياء وتحويل عناصر هذا العالم الروائى ومفرداته من شخصيات وحيوانات وطيور وحتى البيوت إلى كائنات عجيبة أو غريبة تثير الضحك وتنتج المفارقات. والطريف والأكثر جمالا أن هذه السخرية تصبح غير محدودة لامتدادها إلى المواقف الدرامية المفصلية والأزمات الكبيرة ونقاط التحول فى الحدث، وأحيانا ما تمتد هيمنتها إلى بعض المشاهد والمواقف الحزينة أو المؤلمة، فهى سخرية تبدو جزءا من طباع الإنسان المصرى وتكوينه العميق، بل ربما لا تتجلى إلا فى أوقات الشدة، وكثير من مواقف الشجار والصراع وحتى الموت والعزاء يحولها الخطاب الروائى لكمال رحيم إلى مواقف فكاهية ساخرة كما يتعامل معها الإنسان المصرى فى الواقع.
والحقيقة أن هذا ليس مقصورا على روايتنا هذه بل نجده فى أغلب رواياته، فنجده يتجسد فى مشاهد العزاء ونصب سرادق العزاء فى القرية عبر ظلال شخصية عبيط القرية أو البهلول الأبله صاحب البركات والكرامات الخفية كما هو حاصل مثلا فى رواية قهوة حبشي، أو فى مشهد حصار منزل زكريا فى هذه الرواية التى نحن بصدد قراءتها؛ دكاكين تغلق أبوابها، وأحيانا فى بعض مشاهد الحرب أو الأزمات الشديدة كما فى رواية بورسعيد 68. وهذا النمط هو سخرية من نوع خاص فى المجتمع المصرى وليست السمت العام من السخرية لدى الإنسان المصري، بل هى سخرية ترتبط بطبقة اجتماعية معينة، فهى سخرية أهل الريف والفلاحين وتأتى ضمن طريقتهم فى التندر والهزل والمحاكاة الساخرة، وتتشكل لغة هذه الأساليب الساخرة من بيئتهم وعناصرها من الحيوانات والطيور وأنماط الملابس وأوصاف البشر وهيئتهم وطباعهم أو سلوكهم الحركى والكلامي.
تجسد وتصور هذه العين المتندرة الساخرة صورة شاملة ومتكاملة للريف بعناصره المختلفة، فتصور الحيوانات والطيور وتدخلها فى لعبة السخرية أو توظفها أحيانا لوصف البشر عبرها أو رؤية الشخصية الروائية فى ضوء من حضور ظلال هذه الحيوانات، فهذه الرواية مثلا تطرح تصويرا طريفا للعجائز بشكل خاص وتضعهم فى طرف مقابل من المعادلة مع على الصبى الذى يروى هذه الحكاية أو تأتى عبر وعيه ورصده وصوته السردي، فيكون عجائز القرية وربما الكبار جميعا أحيانا فى مقابل الطفل أو الأطفال عموما فيما يشكل نموذجا من العصبية القائمة على تحالفات الفئة العمرية، حين يستخف الكبار بالصغار أو يستهينون بهم أو يكون هناك شكل خفى أو متوار فى الأعماق من الصراع ونمط من ألعاب المراوغة والتحايل، وهى حال بذاتها طريفة لأنها تعدُّ تمثيلا عميقا لعالم الأطفال وأكاذيبهم التى يتحصنون بها فى مواجهة عالم الكبار وتكليفاتهم أو أساليبهم، فنجد مثلا على يستخدم الدجاجة أو القطة لتصوير نفسية العجوز دميانة وحالتها، وهى صور ابنة البيئة التى يكون الناس فيها حريصين على أقواتهم أو مولعين بالحرص عليها، فتتجسد بعض ملامح العجوز عبر عصبيتها من قطة الجيران التى تصبح أكثر من مجرد حدث عابر، أو مراقبتها لدجاجتها وهى تبيض حتى تتم العملية على هامش مشهد حياتى عميق يقتحم فيه الطفل عالم الآخر دينيا ويكتشف أنهم لا يختلفون كثيرا عن غيرهم ويحاول أن يؤكد هذا لأقرانه الذين يرفضون فكرته. فهذه المشاهد الساخرة العابرة تصبح ذات قيم دلالية ونواتج جمالية مهمة انطلاقا مما تمنح الأحداث من نبض حياتى وابتعاد عن الاصطناع، فترفع وتيرة الإيهام وتساعد على تشكيل نموذج إنسانى حقيقى يتسم بالحيوية والاكتمال، والأمر ذاته فى توظيف كلاب القرية على نحو طريف وجميل، فى مشهدين يمكن الوقوف معهما طويلا للبحث فى الأثر الجمالى لهذا التوظيف؛ الأول هو مشهد الكلاب وهى تتبع مسيرة الأطفال الذين يوصلون القسيس وهيب إلى بيت المعلم لبيب الذى جاءهم من البندر ليعطيهم العظة الدينية فيه، فيكون المشهد فارزا لأنواع وطباع مختلفة من الكلاب بين نابح بعصبية واستغراب وآخر يتآلف مع الناس ويمضى مع المسيرة الصغيرة التى يحولها الوصف الساخر إلى ما يشبه الموكب.
وكأن هذا النوع من الكلاب يحرس المسيرة أو يتعاون ويتفاهم مع البشر أحيانا، وفى تصورنا ورؤيتنا لهذا البناء السردى نرى أن هذه المشاهد والإشارات التفصيلية المرتبطة بالحيوانات ليست من قبيل التزيد أو الإسهاب، بل هى مكمل لملامح اللوحة الكلية الحقيقية للريف بما يصوره بكامل تفاصيله وأبعاده ونبضه، وكذلك لتجعل من الحيوان مجالا للإسقاط، فتبدو هذه الحيوانات كائنات موازية للبشر، بين هادئ مسالم وآخر أحمق عصبى عنيف، بين منفتح على الآخر يتفهم الجديد، وآخر يتسم بالانغلاق والحدة والعنف تجاه كل جديد على نحو ما يمكن أن يلمح الخطاب الروائى عبر هذا المشهد.
والنموذج الثالث من توظيف الحيوانات نجده مع الكلاب أيضا فى أحد مشاهد النهاية وردة فعل بعضها تجاه الملابس الغريبة للست (عساكر)، فى تعليق ساخر من السارد الذى يميز هذه الكلاب التى نبحت عليها بعنف لكونها كلاباً لا تعرف من الملابس غير الجلباب البلدى أو بعض هذه الأشياء المعهودة من ملابس أهل القرية، ومثال هذا التوظيف الفنى البديع للحيوانات نجده فى تصويره لأنواع الحمير واختلافها بين الوظائف ما بين حمير للسباخ وأخرى يستخدمها الأعيان وكأن هناك طبقية للحمير أو الحيوانات عموما موازية للطبقية الاجتماعية أو للنسيج الاجتماعى والإنسانى فى القرية، وهذه الأوصاف والمشاهد هى تدريجيا ما تجعل شخصية على أقرب للمستكشف العارف بإحاطة تامة بأسرار القرية وتفاصيلها، وكل هذا يمثل تمهيدا للحظة الذروة الدرامية التى تتجسد فى مشهد إبعاده عن القرية وتشبيهه بالسمكة التى تخرج من البحر، وكم يبدو عالم القرية فى منظور هذا الطفل عالما معقدا ومتشابكا وبعيدا عن السذاجة التى يمكن تصورها، فهذه الشمولية فى الرصد التفصيلى بين البشر والحيوانات وتفاصيل الأماكن والبيوت تجعلنا فى حالة تجاوز تام للنمطية السابقة المعهودة فى السرد الروائى العربى عن الريف التى رصدته بوصفه عالما ساذجا وسطحيا أو محدودا فى تفاصيله وأفكاره وتوابعه المختلفة.
عبر هذه التركيبة السردية الهامسة وهذا العالم الروائى الذى يتدفق إلى وجدان المتلقى بنوع من التسرب الهادئ، نجد أننا فى النهاية أمام تصوير عميق للمجتمع المصرى فى الستينيات وأوائل السبعينيات، حيث تتشكل صورة ربما لا أكون مبالغا إن قلتها إنها الأكثر دقة حتى الآن فى تصوير المجتمع المصرى فى أمراضه ومشاكله وسلبياته وإيجابياته، وتصور لنا هويته الجماعية بدقة وتشعب كبير دون مجهود، اعتمادا على تكثيف المشهد وتكثيف اللغة كذلك.
وتتشكل هوية المجتمع المصرى فى هذه الحقبة عبر تصوير من أكثر من زاوية واستحضار لأكثر من بعد من أبعاده، فهناك البعد الاقتصادى المتمثل فى الطبقية واقتصاد الأعيان وفى مقابلهم اقتصاد المزارعين الفقراء وأحوالهم فى المعيشة وأنواع مزروعاتهم وتفاوتهم المالى وتجهيزهم لأفراحهم وزيجاتهم، وتصوير للأطعمة والمأكولات وحالتهم من الملابس والبيوت والحرف أو المهن المختلفة، وكذلك فئة المرتحلين بحثا عن الرزق من قرية إلى أخرى أو من الصعيد إلى الدلتا، والحقيقة أن تصوير هذا البعد الاقتصادى بشكل هامس وناعم وينتشر فى العمل بما يصنع منه روحا خفية تسرى فيه ليس مقصورا على هذه الرواية تحديدا إنما يحضر بشكل دائم تقريبا فى الخطاب الروائى لكمال رحيم فنجده فى قهوة حبشى وفى بورسعيد 86 أيضا وفى أيام لا تنسى كذلك.
وإلى جانب الهوية المرسومة عبر البعد الاقتصادى والمادى نجد بعدا آخر أكثر أهمية فى تحديد الهوية الجماعية أو المجتمعية فى تلك الحقب أو السنوات التى تدور أحداث الرواية فيها، ونقصد هنا الهوية الدينية أو العقدية أو الانتماء الديني، والحقيقة أن هذا البعد هو الأكثر أهمية وهو الأكثر حساسية ولا أبالغ أن أقول إن التعامل معه كاشف عن تفرد سرد كمال رحيم وقدر ما جمع فى روايته بين العمق الفكرى والجمال الأدبي، إذ إنه فى تصويره لإشكالات الاختلاف الدينى لا ينزلق إلى قتامة المباشرة والجفاف فى مقاربة هذه الإشكالية.
ولا يستسلم للاستخلاصات والنتائج الجاهزة القائمة على الإدانة لأحد الأطراف وتبرئة الآخر فى نوع من الاستسهال أو التسرع، بل يقارب الصورة الدينية بكل ما لها من التعقيدات والتفاوت والتنوع بين السماحة والتعايش وبين التعصب والجهل ويرسم حدودا تكاد تكون جماليا ومخلصة للحقيقة فى المقام الأول، وجمالها ربما يكون نابعا من صدقها الإنسانى وحساسيتها المرهفة فى تصوير البشر من الداخل، فنجد أنه يصور النسيج الإسلامى بتنويعاته بين السطحية المتعصبة أو القائمة على التعميم والفهم المغلوط والتهويلى من الآخر، وبين الفطرة السوية المتسامحة القائمة على التعايش والتركيز على الجوهري، فإذا كان قد قدم نموذج الشيخ سطوحى بما لديه من فهم سطحى يؤدى به إلى التعصب والفهم الشكلانى للمرويات والنصوص الدينية، ويمكن أن نلمس للاسم هنا دلالته أو تلميحه عن هذه السطحية والفهم الظاهري، فإنه قد قدم كذلك الشيخ عليش بما جسد من روح الفطرة الدينية السليمة والتعايش والمحبة والتركيز على الجوهر، وكما النموذج الدينى عبر هذه الثنائية لنمطين من الشيوخ أو رجال الدين، فقد قدم وطرح نموذج الإنسان العادى غير ذى الصلة بالدين بمعناه العلمى أو ذلك النموذج المنفكّ أساسا من النصوص، وهو نموذج للتدين الشعبى العام، وهو نسق أو نمط احتوى كذلك بشكل عفوى وطبيعى على النموذجين المتعارضين، فمن هؤلاء العامة الشعبيين من كان متسامحا متعايشا ومنهم كذلك من كانت عصبيته الدينية مؤسسة على فطرة التعصب القبلى عموما أو العصبية التى أساسها الجهل والفطرة العنيفة بالأساس.
وكما صورت هذه الأشعة السردية التى هى أقرب إلى أشعة جهاز السونار الكاشفة عن هوية الجنين صورة فصيل دينى معين أو هوية دينية معينة فقد صورت كذلك الهوية الدينية المقابلة بالشكل الناعم ذاته وبالميل إلى الوفاء للحقيقة أو لملامح الواقع أكثر من الاستجابة لنمط درامى سابق أو جاهز، فليس هناك ميل إلى تبرئة كاملة لطرف أو إدانة لطرف آخر، بل ثمة بحث نفسى عميق ومقاربة دقيقة لاشتغال الأفكار والمعتقدات وعملها فى النفوس، وثمة بؤر سردية كثيرة يمكن رصدها لتصوير هذه الملامح من الجهل أو التعصب أو التواطؤ والعكس من التسامح أو التفاهم، ويمكن أن نلاحظ تقاطع وتشابك البعدين الاقتصادى والدين معا بما يجعلنا أمام صورة نفسية حقيقة فى أقصى درجات العمق؛ وهذا هو الأقرب لطبيعة النفس الإنسانية التى تختلف فيها الحاجات والرغبات، ويكون التداخل بينها كلها.
فنجد مثلا مشتريا يريد التسويف أو الخصم فيزج بالأمور الدينية فى مسائل البيع والشراء على نحو ما نجد فى مشهد الرجل المسلم الغريب الذى جاء للشراء من دكان فهيم وعدلى المسيحيين الوافدين إلى القرية، وكيف أنه بشكل طبيعى تشكل النموذج المقابل أو المناقض لهذا النموذج من مسلم آخر ساند عدلى وناصره فى الحق واستبعد فكرة توظيف البعد الدينى فى أمر اقتصادى وحصر الأمر فى أنه بيع وشراء، وكذلك الأمر بالنسبة للعائلات المسيحية التى تواطأت هى الأخرى ضد عدلى وفهيم أبناء دينهم حرصا على مصالحهم المالية مع أهل القرية.
والأكثر تفردا وجمالا فى هذا السرد الروائى المتميز الطامح لتجسيد هوية المجتمع المصرى فى تلك الأزمنة أنه يقارب المسكوت عنه أو ما تخفيه الصدور والقلوب ولا يمكن أن تنطق به الألسن، وهنا نجد الخطاب الروائى قد قدر على مقاربة مستويات مختلفة من اللغة، أو تصوير اللغة المنطوقة نفسها بطاقاتها الإيحائية أو قدرتها على أن تحمل معانى متعددة فى الوقت نفسه، بأن تقول الجملة أشياء كثيرة غير ظاهرها.
وهنا تتحدد خصوصية الإنسان المصرى وعبقريته فى استخدام اللغة فى هذه القضايا شديدة الحساسية حيث الكلمة يمكن أن تشعل حربا ويمكن أن تنهيها كذلك، والأكثر جمالا هو زاوية رصد هذه اللغة من منظور الطفل على الذى يصبح فائق الحساسية ومرهفا فى غاية الرهافة فى دمج معطيات لغة الجسد وملامح الوجه مع معطيات اللغة المنطوقة وقراءة ما بين السطور، ويتضح مثال ذلك فى قراءته وتعليقاته على لغة فهيم حين زارهم فى البيت عقب مشكلة عدلى والشاب المسلم الذى تحرش بها وحصارهم فى البيت.
بل إنه ليمكن القول بأن الخطاب الروائى فى هذه الحال يصبح قادرا على استنطاق كل شيء فى هذا العالم الروائي، ويخرج بدلالات ورسائل من حركة الشخصية وأفعالها وسمات المكان وصفاته أو سلوك البشر وأقوالهم، بما يصور فى النهاية نسيجا اجتماعيا معقدا أو فى أشد حالات التركيب والتعقيد بما يجعله ثريا وغنيا بالملامح والتفاصيل والسمات، لنكون فى النهاية أمام عالم درامى حافل بالصراع الهادئ الذى يتم طرحه كما لو أنه سنن كونية معهودة أو معتادة، وتصبح له بنيته الدرامية القائمة على الشد والجذب والتفاوت والتحول بين الحب والكراهية وبين السماحة والتعصب، بين الجهل والعلم أو المعرفة، بين الغباء والذكاء وغيرها الكثير من الثنائيات والمعانى المتضادة التى تصنع عالما حقيقيا جديرا بالمتابعة والقادر على الاستحواذ على عقل المتلقى ومشاعره.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 طارق الطيب.. ليالى الفن فى فيينا حازم المستكاوى ومعمار الحروف
طارق الطيب.. ليالى الفن فى فيينا حازم المستكاوى ومعمار الحروف
 «عملك مردود إليك».. رسالة حازم المستكاوي في وداعه للعالم
«عملك مردود إليك».. رسالة حازم المستكاوي في وداعه للعالم
 من بغداد إلى القاهرة مدن وخلفاء
من بغداد إلى القاهرة مدن وخلفاء
 محمد سليم شوشة: خاتم سليمي رواية عن الحب والإرهاب وتزاوج الحضارات
محمد سليم شوشة: خاتم سليمي رواية عن الحب والإرهاب وتزاوج الحضارات
 نيفين النصيري تكتب: شيء ما أصابه الخلل.. تمرد الراوى
نيفين النصيري تكتب: شيء ما أصابه الخلل.. تمرد الراوى
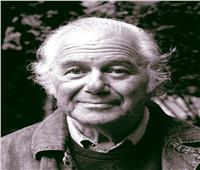 أحمد الزناتى يكتب : أذكار فى أوانها جاكوب نيديلمان وتأملات عن المعنى والمسؤولية
أحمد الزناتى يكتب : أذكار فى أوانها جاكوب نيديلمان وتأملات عن المعنى والمسؤولية
 منصورة عز الدين تكتب :تونى موريسون كمحررة أدبية
منصورة عز الدين تكتب :تونى موريسون كمحررة أدبية
 صقلية .. الحلقة المفقودة فى تطور عمارة القاهرة
صقلية .. الحلقة المفقودة فى تطور عمارة القاهرة
 القاهرة في مرأه باريس
القاهرة في مرأه باريس





















