
حسلم فخر يكتب : أربعة عشر شهراً فى الأسر
حسلم فخر يكتب : أربعة عشر شهراً فى الأسر
السبت، 08 يوليه 2023 - 01:40 م
فى رواية نجيب محفوظ «الشحاذ»، يصف أحد الشخصيات لصديقه تجربة السجن بقوله: «اليوم بسنة فى قرفه، والسنة بيوم فى تفاهتها». أظن أن هذا الوصف ينطبق تماماً على سنة الحجر والإغلاق ، كان أطول الأعوام وأقصرها فى نفس الوقت ، تشابهت أيامه كحبات الرمل ، يحمل كل يوم قدراً متزايداً من القلق والتوتر والاضطراب وعدم اليقين. ويمر كسابقه بسرعة السلحفاة. كان عاماً ثقيلاً أودى بحياة الملايين من البشر وفرض على الباقين حياة تتأرجح بين الرعب والاستهانة؛ وبين الخوف والرجاء. فى ذلك العام الطويل القصير انهارت أساطير وانكشفت أكاذيب واختفت مسلمات وتغيرت الدنيا بشكل لم يخطر لنا ببال.
البداية
مثل كثيرين فى كل أنحاء العالم، تابعت الأنباء التى تتردد عن وباء وشيك بقدر من الاستخفاف والتشكك. فيروس كورونا معروفة للعلماء منذ سنوات . تتحور وينشأ منها فيروس جديد كل سنة تقريباً. فلماذا كل هذه الضجة؟ وكانت نظرية المؤامرة مخرجاً سهلاً من كل هذه التساؤلات الحائرة ، لابد أن وراء هذه الضجة المصطنعة مصالح معينة تستهدف بث الذعر فى نفوسنا تحقيقاً لأغراض أنانية تخصها.

لكننى عملت طوال عمرى فى منظمة دولية. وأعرف عن تجربة شخصية مباشرة مدى خوف الموظفين الدوليين وحذرهم من المبادرة والمغامرة بإبداء رأى قاطع فى أى موضوع، وتفضيلهم الراسخ لأمان الأقوال الرمادية المائعة التى يمكن تأويلها على أكثر من وجه، ويمكن لأى جهة أن تفسرها على هواها. لذلك، عندما أعلن المدير العام
ل«منظمة الصحة العالمية» بكلمات لا لبس فيها ولا غموض، أن فيروس كوفيد-19 قد تحول إلى جائحة عالمية، تبددت كل شكوكى ومحاولاتى لرؤية الأمر كمؤامرة يدفعها الجشع، ولم تعد تساورنى أى ريبة فى حجم الخطر الذى يواجه البشرية. تبخرت كل أوهامى عن التقدم العلمى الذى حبس عفاريت الأوبئة فى صفحات كتب التاريخ. هاهو الوباء يعود بكامل قوته فى عالم يتنقل فيه الناس من بلد لبلد بمنتهى السرعة والسهولة التى تيسّر مهمته فى الفتك بنا، أو تحويل حياتنا إلى كابوس مرعب.

يؤمن الجميع بالمكانة الكبرى التى يحظى بها العلم والعلماء فى المجتمعات المتقدمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة. كان ذلك الوهم هو أول ضحايا الوباء. خرج دونالد ترامب رئيس أكبر دول العالم وأقواها وأكثرها ثراءً ليعلن أن الوباء مجرد «خدعة» اختلقها الحزب الديمقراطى حتى يخسر الرئيس الانتخابات المقبلة. ثم عاد ليسلم بوجود الفيروس ويقلل فى نفس الوقت من شأنه زاعماً أنه «مثل دور الأنفلونزا العادى الذى يشفى منه الناس فى غضون أيام قليلة».
وأكّد أنه سينتهى بحلول شهر أبريل «بما يماثل المعجزة». عندما أوضحت له أعداد الوفيات مدى خطورة الوضع، بدأ يشارك فى المؤتمرات الصحفية اليومية التى يعقدها الأطباء المتخصصون لإطلاع الشعب على آخر التطورات، ويخرج باقتراحات خرقاء غير مسؤولة، ويرفض وضع القناع على وجهه، ويقاطع العلماء باقتراح أساليب علاج لايمكن وصفها إلا بالجنون، ويهذى بشكل مستمر لساعات بخليط من تكذيب العلم ولوم الحزب المنافس وتحميل الصين مسؤولية الوباء. شيئاً فشيئاً تم تسييس ما كان يجب أن يكون موضوعاً طبياً علمياً بحتاً، وتحول إلى ساحة للتناحر والإعلان عن مواقف سياسية.

إن ارتديت القناع وحافظت على المسافة الآمنة بينك وبين الآخرين، فأنت مؤيد للحزب الديمقراطي ، ورفضك الالتزام بالاجراءات الاحترازية يعنى أنك مؤيد لترامب. بدلاً من احترام الرأى العلمى المدروس، والفرض السريع للإغلاق والحجر الصحي، انقسمت البلاد وتباطأت الحكومة الاتحادية فى اتخاذ التدابير اللازمة، ثم نفضت يدها من الموضوع بكامله وتركت لكل ولاية أن تقرر بنفسها ولنفسها ما تراه من احتياطات لاحتواء الوباء، وكأن الفيروس سيحترم التقسيمات الإدارية. تنكرت الولايات المتحدة للعلم واستخفت به، وكانت النتيجة تفشياً مخيفاً للوباء وتزايداً مذهلاً فى أعداد الإصابات والوفيات. انهار نظام الرعاية الصحية، وانهارت معه أكذوبة مكانة العلم والعلماء فى بعض الدول المتقدمة. لكن ذلك لم يكن آخر الانهيارات.
فى أكثر من فيلم أمريكى فى الثمانينيات، تكرر مشهد دخول مهاجر جديد (غالباً منشق سوفييتي) إلى السوبر ماركت الأمريكى لأول مرة. تمسح الكاميرا منظر الرفوف المكدسة بالسلع والأطعمة فى مهرجان من الألوان. تقترب الكاميرا من وجهه المذهول من هذه الوفرة التى لم يتخيل لمثلها وجوداً من قبل. ثم يأتى (فلاش باك) يعود به إلى الأرفف الخاوية فى محلات موسكو والطوابير الطويلة التى تنتظر بصبر عظيم لشراء أى شيء يتصادف توفره فى ذلك اليوم. ثم تعود الكاميرا لتركز على وجهه المنبهر المدهوش.هكذا كانت صورة أمريكا فى أذهان الناس: الثروة والرفاهية والوفرة التى لا تعرف حدوداً.

عندما تم الإعلان رسمياً عن وقوع الجائحة وفرض الإغلاق التام والحجر الصحي، اندفعت جحافل من الناس فى غارات تشبه هجمات الجراد على كل محلات الأطعمة والاحتياجات المنزلية. الطوابير طويلة ولا تنتهي. تعامل الناس مع بعضهم بعدوانية مفرطة. الكل يخطف شيئاً من يد شخص آخر. يتدافعون بجنون مبعثه الهلع والخوف من المجهول نحو ما تبقى من سلع، أياً كانت، على الرفوف التى تتناقص محتوياتها بسرعة خيالية. تقع اشتباكات بالأيدي. وبحكم قانون العرض والطلب الذى تقدسه السوق الأمريكية، ارتفعت الأسعار فى غمضة عين وأصبح ورق التواليت وفوط المطبخ وعلب التونة وكذلك المطهرات ومواد التنظيف سلعاً ترفية لا يقدر على اقتنائها إلا الأثرياء. وفى ساعات قليلة أصبحت رفوف المحلات نسخة طبق الأصل من الصورة التى رسمتها السينما الأمريكية لمحال الاتحاد السوفيتى السابق، خاوية، جرداء، ليس فيها أى شيء على الإطلاق. انتهى وهم الوفرة أمام أول تحد حقيقى يواجه الاقتصاد الأمريكى.

انشغلت قنوات التليفزيون بالإعلان عن أحدث التطورات وأكبر المشاكل غير الصحية التى تنتظرنا خلال فترة الإغلاق. وبالولع الأمريكى بالإحصاءات، أعلنت وسائل الإعلام أن آخر استقصاءات الرأى قد بينت أن متوسط الاحتياطى النقدى المتوفر لدى الأسرة الأمريكية العادية لمواجهة الطوارئ لا يزيد عن أربعمائة دولار؛ أى مبلغ يكفى بالكاد لإطعام أسرة من أربعة أفراد لمدة أسبوع أو عشرة أيام على الأكثر. ولو استمر الإغلاق الكامل وتوقف الكثيرين عن العمل لفترة طويلة، ستعرف الولايات المتحدة جوعاً يكاد يقترب من حد المجاعة. هكذا كشف الوباء القناع عن وهم ثروة أمريكا ورفاهيتها.
نجونا بمعجزة من هذه الأزمات وشُحّ المنتجات، وهمجية التطاحن والتدافع، والاضطرار للخروج والتعرض لخطر العدوى، بفضل دولاب الخزين الذى سماه أبناؤنا تندراً «بقالة ماما». من الطبيعى فى طاحونة العمل اليومي، أن تقوم أى أسرة عاملة بتبضع احتياجاتها مرة واحدة فى الأسبوع توفيراً للوقت والجهد. لكن دولاب الخزين فى بيتنا يختلف عن ذلك، فهو يمتلئ دوماً بأساسيات تتجاوز بكثير احتياجاتنا العادية؛ علب فول وتونة، وأكياس من المكرونة والأرز والدقيق، وبطاريات من مختلف الأحجام، وأدوات تنظيف كثيرة، وفرش ومعاجين الأسنان، وعلب الصلصة وزجاجات الزيت، وغيرها كثير من السلع الضرورية. كنا دوماً نسخر من اهتمام ربة أسرتنا وعامود خيمتنا بتوفير كل هذه الأشياء دونما داع حقيقي. وكنت أقول لها مداعباً:
أنتِ تعيشين حياتك بنفسية السنجاب المذعور من حلول الشتاء الوشيك.
فترد بجدية
الاحتياط واجب.
مم نحتاط بالضبط؟
نحتاط مما لا نعرفه.. نحتاط من المجهول ..
عندما وقع المجهول الذى لم نعرفه ولم نتوقعه، لم نجد أنفسنا مرغمين للخروج من البيت وتعريض أنفسنا للخطر المخيف إلا فى أضيق الحدود. كان لدينا ما يكفينا لأسابيع. نأكل من خيرات «بقالة ماما»، ونخبز العيش بأنفسنا فى مطبخنا الصغير، ونواجه فترة الإغلاق التى لا يعرف أحد طولها بقدر من الأمان والطمأنينة. لكن لابد لكل شيء من آخر. وهناك احتياجات بسيطة مثل اللبن والبيض والخضراوات الطازجة التى لا يمكن تخزينها ولا تجدى معها احتياطاتنا من المجهول. ولذا، بعد أسابيع من القبوع فى أمان البيت، وجدنا أنفسنا مرغمين على المخاطرة بالخروج منه،رغم الخوف من فيروس شديد الضآلة لا يُرى بالعين المجردة، يأتى بميتة وحيدة محزنة بعيداً عن أعين ورفقة الأحباب ولمسة أياديهم المُطمئِنة، ثم الدفن دون أن يصحبك أحد إلى مستقرك الأخير، فى كل خطوة رعب لا يخفف منه إلا الوهم الإنسانى الأبدي: «هذا لن يصيبنى ولن يحدث لي».
فى بداية الكابوس، كانت ولاية نيويورك، ومدينة نيويورك تحديداً، أكبر بؤر تفشى الوباء وأكثرها خطورة. مع الانهيار شبه الكامل لنظام الرعاية الصحية والنقص الحاد فى غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس التى تمثل الفيصل بين حياة المرضى وموتهم، جاءت إجراءات الإغلاق الكامل والحجر الصحى شديدة الصرامة والقسوة. لم يستثن منها إلا العيادات الطبية والمستشفيات ومحال بيع الاحتياجات الأساسية لكن دخولها أصبح خاضعاً لقواعد متشددة وجداول زمنية وفُرِضت حدود قصوى على عدد الداخلين إلى أى منها. أصبح علينا أن نقف طابوراً طويلاً متباعداً حتى يصيبنا الدور للدخول، بحيث يتساوى عدد الداخلين مع عدد من خرجوا من المحل لا يزيد عنه فرداً. ولأول مرة فى تاريخ أمريكا، وضعت المحلات حداً أقصى على عدد السلع التى يمكن لكل فرد شراؤها.
وصلت الحصص التموينية، التى لا تعرفها إلا المجتمعات التى وصفت نفسها لفترة من الزمن بالاشتراكية، إلى الولايات المتحدة بفضل وباء الكورونا!
خلال تلك الفترة، بدأت حركة الاقتصاد فى التعافى النسبي. وعادت بعض السلع للظهور على استحياء فى بعض متاجر الاحتياجات الأساسية رغم صعوبات النقل والتحرك بين الولايات. ولم يعد الحصول على بعض الأشياء التى اختفت من السوق أمراً مستحيلاً وإن ظل بالغ الصعوبة وخاضعاً لضوابط عديدة.
لا تعرف برونكسفيل -القرية الصغيرة التى نعيش فيها- خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل. لم يكن لدينا خيار إلا الذهاب إلى السوق لشراء احتياجاتنا أو اللجوء إلى خدمة (الاستلام على الرصيف). تذهب إلى موقع المحل على الانترنت، تنتقى ما تحتاجه من سلع مع عدم تجاوز الحدود القصوى المفروضة، تأتيك رسالة وفاتورة على هاتفك المحمول، تضع الكمامة وتلبس القفازات البلاستيكية، تذهب إلى السوبر ماركت وهناك تجد شخصاً واقفاً على الرصيف وأمامه العديد من الأكياس.

تفتح الرسالة الواردة على المحمول وتقف على بعد مترين منه، يصوب ماسحة ضوئية نحو التليفون ويحدد لك الأكياس الخاصة بك. تنتظره حتى يبتعد، تحمل مشترياتك بسرعة وتعود إلى السيارة وبعدها إلى الأسر فى البيت.
بعد ما يقرب من شهر من الاحتجاز داخل المنزل، قررت أننى بحاجة إلى الخروج منه وإلا أصابنى الجنون. كنت أريد أن أرى بشراً آخرين ولو من خلف قناع يخفى وجوههم. كنت أريد أن أطمئن أن العالم ما يزال موجوداً. فقررت الذهاب إلى السوبر ماركت متبعاً كل الاجراءات الاحترازية ومسلماً أمرى للمقادير. وضعت الكمامة على وجهي. بعث الخروج إلى الشارع ملثماً كاللصوص على استغرابى الشديد. وكان ملمس القماش الملتصق بأنفى وفمى غير مألوف بالمرة.
نظارتى جزء من وجهى ولا أكاد ارى شيئاً بدونها. الجو فى أواخر مارس فى نيويورك شديد البرودة. بعد أول خطوتين خارج البيت، اكتشفت أن زفيرى المحبوس تحت الكمامة يرتدّ إلى عدسات النظارة الباردة ويتكثف عليها قطرات دقيقة من بخار الماء فتغيم الرؤية أو تنعدم. أعجز الوباء نظارتى عن القيام بوظيفتها التى لا أطمئن للدنيا بدونها. سواء لبستها أم لم ألبسها، لا أكاد أرى شيئاً.
عند عودتنا إلى البيت قمنا بعملية تطهير محمومة. أولاً مسحنا الأكياس الخارجية بالمعقمات والكحول. ثم مسحنا محتوياتها واحدةً واحدة بنفس المواد. تركنا المعاطف والأحذية فى الجراج. وأخيراً خلعنا الكمامات والقفازات البلاستيكية. رد الفعل الطبيعى والتلقائى أن يتحسس الواحد وجهه بعد خلع القناع. تصرخ زوجتي: لا تلمس وجهك. اتجهنا إلى الحمام لنغسل أيدينا بالماء الساخن والصابون لفترة لا تقل عما يستغرقه غناء أغنية أعياد الميلاد الشهيرة «سنة حلوة يا جميل» من أولها إلى آخرها مرتين متتاليتين. ثم عدنا للجلوس فى مقاعدنا أمام التلفزيون.
بعد فترة لا أذكر طولها بالتحديد أحسست بالاختناق، وضاق صدرى بالتنقل من غرفة لأخرى داخل البيت كالأسد الحبيس، فقررت أن آخذ سيارتى متجهاً إلى «مدينة النور» الحقيقية؛ مانهاتن مدينتى الحبيبة التى قضيت فيها سبعاً وعشرين عاماً من عمري. تهللت لمرأى براعم الربيع الخضراء تكسو الأشجار.
لكن فرحتى لم تدم كثيراً. لم أتخيل فى أسوأ كوابيسى أن تصبح مانهاتن مدينة أشباح. الشوارع التى لا يخف زحامها نهاراً أو ليلاً شبه خاوية. الطريق الذى كنت أقطعه فيما يزيد عن الساعة لم يأخذ منى هذه المرة إلا أقل من عشرين دقيقة. المحلات والمطاعم والمكتبات والمقاهى والحانات التى تشغل الطابق الأرضى من كل مبانى مانهاتن كلها مغلقة. شبابيك ناطحات السحاب العملاقة التى يشع منها النور طول الوقت أصبحت مظلمة. على أبواب دور السينما والمسارح والمتاحف لافتة موحدة تقول بأحرف سوداء جافية «مغلق إلى أجل غير مسمى». الشاشات هائلة الحجم التى تبث الإعلانات والأخبار وأرقام البورصة فى «تايمز سكوير» مطفأة. ضاعف هذا الخواء من القلق والتوتر اللذين خرجت للتخلص منهما. لكن الصمت كان أكثر ما بعث الرعب فى نفسي. مانهاتن لا تعرف الهدوء فى الأحوال العادية. ضجة حركة المرور، وصخب أبواق السيارات، وعويل عربات الشرطة والإسعاف والمطافئ لا ينقطع للحظة. ولعجلات المترو الذى يجرى تحت شوارعها الرئيسية أربعاً وعشرين ساعة فى اليوم هدير يصاحبك فى كل خطوة تخطوها.
وفجأة .. لم يعد هناك أى صوت على الإطلاق. مجرد صمت مخيف مدوّى يصمّ الآذان ..
«سنة حلوة يا جميل»؟
الحظر
أهالى نيويورك معروفون فى أمريكا بحدة طباعهم وصراحتهم الجارحة وقسوة كلماتهم. تخوّف الكثيرون، وأنا منهم، أن يقاوم أهالى نيويورك قرارات الإغلاق وأن يواجهوا الحظر بعنادهم المشهور. ولكن أثبتت الأحداث أنه لم يكن هناك أى سبب أو مبرر لعدم الالتزام بالحظر. فالأماكن العامة كلها مغلقة، إلى أين إذن يذهب من قرر عدم الالتزام بالحظر؟ لم يكن هناك مِن الأصدقاء والمعارف من كان على استعداد لمقابلة أحد أو استضافة أحد فى منزله.
كان لوضوح المعلومات وشفافية قرارات الحكومة أثر كبير فى تجاوب الناس مع التعليمات وإتباعهم إياها بدقة. لم تفرض السلطات حظر التجول ولا لدقيقة واحدة طيلة فترة الإغلاق، ومع ذلك لم يكن هناك من يخرج من بيته إلا للضرورة القصوى كالذهاب إلى الطبيب أو شراء الاحتياحات الأساسية. بدا أن أغلبية أهالى نيويورك (المؤيدة تقليدياً للحزب الديمقراطي) قد أدركوا حجم الخطر الذى يتهددنا جميعاً، وأن واجب حماية الآخرين من العدوى قد أصبح جزءاً لا يتجزأ من حماية أنفسنا. بعبارةٍ أخرى، أصبح كل واحد منا، بتعبير الكتاب المقدس فى سفر التكوين «حارساً لأخيه». وأكثر أشكال الحراسة فعالية هو الابتعاد عنهم قدر الإمكان والالتزام الدقيق بالحظر والتباعد الاجتماعى ولبس الكمامة.
امتد الحظر الذى عاشته أسرتنا من يوم 14 مارس 2020 إلى يوم 15 مايو 2021 أى أربعة عشر شهراً بالتمام والكمال. لم نر أحداً من خارج أسرتنا الصغيرة طوال تلك الفترة. بطبيعة الحال، لم نكن نتوقع أن يطول الأمر إلى هذا الحد، وكنا نتشبث بأمل أن تنتهى المسألة خلال ثلاثة أو أربعة شهور على الأكثر، ولكن الأحداث المتلاحقة خيبت آمالنا وفرضت علينا التعايش مع كابوس بدا فى بعض لحظات الضيق واليأس أنه لن ينتهى أبداً.
كنا ثلاثة سجناء فى نفس البيت، وكان كلٌ منا فى حبسه الانفرادى فى نفس الوقت، ولعل ذلك كان من حسن حظنا. زوجتى تقضى اليوم فى غرفة مكتبها خلف باب مغلق، تلقى المحاضرات على طلابها فى جامعة نيويورك عن طريق تطبيق «زووم» ثم تصحح أوراقهم وترتب دروس اليوم التالى ثم تضعها على موقع معين فى شبكة الانترنت، ولا تخرج من غرفتها إلا بعد انتهاء يوم العمل الطويل.
وكانت ابنتنا على وشك التخرج من الجامعة ولم يتبق لها إلا شهران، قضتهما المسكينة فى غرفتها تتلقى المحاضرات عن بعد، وتقدم ما تكتبه من أبحاث وأوراق مطلوبة للتخرج على جهاز كومبيوتر محرومة من لقاء أصدقائها وأساتذتها. كانت تدرس وتكفكف دموع الإحباط وخيبة الأمل. مثل كل زملائها كانت تنتظر اليوم المشهود؛ يوم حفلات التخرج، يوم ارتداء الروب الجامعى والقبعة، وتلقى شهادة تخرجها من يد رئيس الجامعة.
كان من المتوقع أن يكون حفل تخرج دفعتها ذا طابع خاص ومتميز لوقوعه عام 2020؛ ذلك التاريخ ذو الرقمين المتطابقين الذى لا يأتى إلا مرة واحدة كل قرن من الزمان. وخلال السنتين الأخيرتين من دراستها كانت تعمل كمتدربة فى شركة كبيرة. أُعجِب المسؤولون بجديتها وانضباطها فى العمل فوعدوها بوظيفة معهم فور تخرجها.
فى نفس الأسبوع تقريباً، تلقت خبر إلغاء حفل التخرج وخبر تعليق الشركة لأعمالها إلى أجل غير مسمى. حزنت حزناً يفوق الوصف، وبدأت فى استئناف ما تبقى من دراستها على مضض شديد ودون أى قدر من الحماس خلف باب غرفتها المغلق، ولا تغادرها إلا بعد انتهاء اليوم الدراسى الطويل. لعل خيبة أملها والحالة النفسية والعصبية المترتبة عليها كانت من أصعب ما مررنا به خلال ذلك العام الطويل.
أما أنا، فكنت أقضى يومى فى الصالة منهمكاً فى ترجمة كتاب تاريخ أكاديمى شديد التخصص. أستيقظ فى الصباح، أشرب قهوتي، وأذهب إلى مكانى الثابت على الكنبة محاطاً بأكداس من الكتب والأوراق. حددت لنفسى عدداً من الصفحات يجب أن أنهيه كل يوم مهما كانت حالتى النفسية. ولم أكن أغادر مكانى إلا بعد انتهاء يوم العمل الطويل. تصادف أن كان موضوع ذلك الكتاب هو دخول الطب الحديث إلى مصر فى القرن التاسع عشر، وخصص الكتاب أجزاءً مطولة لفرض الحجر الصحى (أو الكرنتيلة كما كان الجبرتى يسميه) أيام الحملة الفرنسية ثم فى الطواعين المتكررة التى نُكِبت بها مصر فى عهد محمد على وخلفائه.
وهكذا وجدت نفسى أعيش معاناة أجدادى فى قاهرة القرن التاسع عشر ومخاوفهم من الأوبئة والحظر والحجر الصحى فى نفس الوقت الذى كنت أصارع فيه مخاوفى الشخصية من وباء القرن الحادى والعشرين فى نيويورك. خففت معاناة الأسلاف من ألمى وضيقي، ناس مثلى ومثلك، يخافون المرض والموت وعدم اليقين، مر هؤلاء المساكين بتجارب مشابهة دون نعمة الانترنت وشاشات التلفزيون والتليفونات الذكية التى تسمح للواحد برؤية الأحباب مهما تباعدت المسافات. كانت ترجمة الكتاب شاقة ومضنية بقدر ما كانت ممتعة ومثرية. وصدق من قال إن من رأى بلاوى الناس (ولو على بعد أكثر من قرنين من الزمان) هانت عليه بلواه.
«رب ضارة نافعة»، ينطبق هذا القول تمام الانطباق على انشغال ثلاثتنا بالعمل والدراسة ومهام الحياة اليومية. كنا نظرياً سجناء فى نفس البيت، لكن روتيننا اليومى لم يكد يلحقه أى تغيير، لم نلتقِ إلا فى موعد العشاء (الوجبة الرئيسية فى هذا البلد)، ووفر علينا هذا الثبات فى الروتين اليومى الكثير من الاحتكاكات والمشاحنات التى كان يمكن أن تحدث لو كان الوضع خلاف ذلك. كُن من تكون، كُن قديساً أو نبياً، لكن لو وجدت نفسك حبيساً بين أربعة جدران لفترة لا تعرف طولها، مع واحد من ملائكة السماء، لوجدت فيه ما يثير أعصابك وما يكاد أن يدفعك إلى حافة الجنون.
صوت المضغ، هزة الساق، السعال، القيام والجلوس دون هدف أو مبرر، الكلام وسط متابعة برنامج تليفزيون، فتح باب الثلاجة فى لحظة مرورك أمامها، تفاصيل تافهة وسفاسف صغيرة، لكنها مع التكرار واستحالة الفرار، تثير الأعصاب إلى درجة الرغبة فى القتل. كان حبسنا الانفرادى (شبه الاختياري) عاصماً لنا فى معظم الأوقات من هذه الأفكار الإجرامية. ومع مرور الأيام، تعلمنا أن نقرأ الحالة النفسية لكل منا من أبسط الإشارات مثل نبرة الصوت أو نظرة العين وأن نعرف متى يحسن بنا أن نتحاشى ذلك الشخص تلافياً لوقوع انفجارات سخيفة تزيد من منغصات الحياة فى عام الحظر الطويل. لعل ذلك التسامح والتفهم كانا من بعض الإيجابيات النادرة فى هذه التجربة الأليمة. ولا يعنى قولى هذا إننا قد نجحنا طول الوقت فى تفادى الصدامات الصغيرة، ولكننى أظن أننا قد تمكنّا من احتوائها فى حدود معقولة يمكن التعامل معها بأقل الخسائر الممكنة.
بعد تناول طعام العشاء، نجلس أمام التلفزيون. فى البداية، كنا نتابع الأخبار باستمرار وبشكل يقارب الهوس. فى أعلى الركن الأيمن من الشاشةعدّاد يُحدّث عدد الإصابات والوفيات فى العالم وأمريكا وكل ولاية على حدة. ننظر إليه بذهول ويزداد رعبنا وهلعنا. بعد فترة من الزمن، اكتشفنا أننا لم نعد نستطيع ولا نرغب فى متابعة الأخبار حفاظاً على توازننا النفسي، فتوقفنا باتفاق غير منطوق عن مشاهدة القنوات الإخبارية وانتقلنا إلى نتفليكس وغيرها من قنوات الأفلام والمسلسلات.
وهنا بدأت الخلافات. كان تحقيق الحد الأدنى من التوافق على ماذا سنشاهد كل ليلة أمراً بالغ الصعوبة. أذواقنا متباينة وتفضيلاتنا مختلفة. المفاوضات مطولة ومضنية ومثيرة للأعصاب. ومع مرور الأيام، ومشاهدة العديد من الأفلام والمسلسلات والبرامج الوثائقية على منصة «نتفليكس» ومنصة «شاهد» العربية، تناقص عدد ما يمكننا الاتفاق عليه ومشاهدته سوياً. فعدنا للانسحاب كلُ إلى مكان مختلف ومنفصل. زوجتى تكرس وقت فراغها لتعلم اللغة التركية، وابنتنا تقضى وقتها فى الحديث والسمر مع أصدقائها عبر شاشة الكمبيوتر والهاتف، وأنا أضاعف الوقت المخصص للترجمة، وعندما يتملكنى التعب والإرهاق ألجأ لهوايتى الأساسية والوحيدة تقريباً: القراءة.
للأسف، لم أستطع قط التعود على القراءة على شاشة الكمبيوتر وأفضل الكتب الورقية. لكن المكتبات مغلقة، ولا مجال للحصول على كتب جديدة إلا من خلال شركة «أمازون». مثل كثيرين داخل الولايات المتحدة، كنت أفضل عدم التعامل مع تلك الشركة بسبب ما تكشف من معلومات عن سوء معاملتها للعاملين فيها وإجبارهم على العمل بأجور متدنية وفى ظروف مجحفة بالغة الصعوبة لا تختلف كثيراً عن العبودية. لكن لابد مما ليس منه بد، وجدت نفسى مرغماً - بامتعاض شديد – على المساهمة فى زيادة ثروة «جيف بيزوس» الفاحشة البذيئة حتى أجد ما أقرأه فى أيام وليالى الحظر الطويلة.
انتهى العام الدراسي، وتزامن بدء عطلة الصيف مع انتهائى من الترجمة، ولم يعد لدينا أى شيء يشبه الروتين أو النظام. انداحت الأيام فى بعضها وتداخلت، لم نعد نعرف لها اسماً أو تاريخاً. أصبح التمييز بين يوم وآخر يماثل فى صعوبته التمييز بين قطرتى ماء أو حبتى رمل. بالتدريج، انقلب نظام الحياة ولم يعد للوقت أى معنى. أسهر حتى مطلع الفجر فى صحبة كتبي، ثم أنام حتى منتصف النهار. أصبح المعلم الوحيد فى حياتنا هو يوما الثلاثاء والجمعة؛ يوم حضور عمال البلدية لجمع القمامة. بخلاف ذلك، لا شيء على الإطلاق.
أنهت ابنتى دراستها بنجاح. بدلاً من حفلات التخرج الأسطورية فى قاعات الجامعة المهيبة، أرسلت لها الجامعة قبعة التخرج فى البريد. لأول مرة منذ بداية الحظر، ارتدينا ملابس رسمية أنيقة ونزلنا إلى حديقة المنزل لالتقاط بعض الصور لها وهى تلبس قبعتها، ثم تخلعها وترمى بها عالياً فى الهواء، ثم تعاود ارتداءها وقد نقلت الزر من جانب إلى آخر علامة على النجاح وبدء الحياة العملية. لم يأخذ الأمر أكثر من ربع ساعة فى صمت تام وبابتسامات مصطنعة مغتصبة. ثم عدنا إلى داخل المنزل بقلوب مثقلة، لندارى خيبة أملنا فى هوايتنا الجديدة.
أنا وزوجتى من هواة الطبخ. مع اختفاء الروتين من حياتنا وتوفر الوقت الفارغ من أى نشاط ذى مغزى، بدأنا نتابع برامج الطبخ فى التليفزيون وعلى الانترنت وقنوات «اليوتيوب»، ثم ندخل المطبخ لنطبق ما تعلمناه. أزعم أننا قد نجحنا فى إنتاج أطباق شهية من مختلف مطابخ الدنيا، وخبزنا أنواعاً مختلفة من الخبز والحلويات. لكن هذه الهواية البسيطة لم تخلُ من منغصات. أنا أفضّل الالتزام بالوصفات بمنتهى الدقة وأستخدم الموازين والمقاييس بالجرام والميلليمتر، وهى لا تحب هذا التقيد الصارم وتفضل الارتجال والتغيير. أدّى ذلك الاختلاف فى موضوع بسيط وغير ذى أهمية على الإطلاق إلى الكثير من المشاحنات، الضاحكة فى معظمها، والتى تطور بعضها، بسبب الضغط العصبى والضيق والملل، إلى زعيق وتوتر وكهربة الجو المشحون أصلاً.
أما مصدر القلق الأكبر فكان الخوف من زيادة الوزن التى ستحدث حتماً نتيجة لهذا التفنن فى صنع المأكولات، مع قلة الحركة وانعدامها تقريباً. فى الانجليزية قول مأثور يصف الموت بأنه الشيء الوحيد الذى يحقق المساواة بين كل بنى البشر. وزعمت بعض الصحف أن الوباء الذى سجننا جميعاً قد أصبح شريكاً له فى تحقيق المساواة. وهذه بطبيعة الحال أكذوبة أخرى يتضح زيفها وتسطيحها للأموربأقل قدر من التدقيق. أى مساواة حققها الوباء والحظر؟ أيستوى من لا يجدون ما يأكلون ومن يخافون السمنة والتخمة من كثرة ما يأكلون؟
مع حلول الصيف تمتلئ حدائق ضاحيتنا الصغيرة بأنواع مختلفة من الحيوانات والطيور المهاجرة. مع الحظر وقلة الحركة فى الشوارع، بدأت أنواع غير مألوفة من الحيوانات فى الظهور فى شوارعنا، حيوانات كنا نعتقد أن مكانها الوحيد هو الغابات لا المناطق السكنية. أنظر من الشباك فأرى ثعلباً يسير دون أى خوف فى شارعنا الصغير ويتشمم صناديق الزبالة بهدوء تام. ذات يوم، تناولنا عشاءنا فى شرفة المنزل. تركنا بقايا الطعام على المائدة لدقائق معدودة، ثم خرجنا لجمعها فوجدنا حيوان ال Raccoon جالساً فوق مائدتنا يلتهم تلك البقايا باستمتاع ولم يولنا أى اهتمام عندما أخذنا فى الصياح والتلويح بأيدينا فى محاولة لتخويفه وطرده بعيداً عن بيتنا.
اضطررنا مرغمين إلى تركه وشأنه حتى ينتهى من طعامه ويغادر المكان فى الوقت الذى يناسبه، لمعرفتنا بمدى شراسته واستعداده للهجوم والعض بأسنانه الحادة التى تنقل مرض السعار. لكن أعجب ما حدث هو زيارة «ذئب البراري» المعروف باسم Coyote . فى يوم من الأيام رأيناه يدخل حديقتنا الصغيرة متبختراً باطمئنان تام. اختار لنفسه بقعة مشمسة لا تبعد عن البيت بأكثر من مترين، ورقد فيها ثم راح فى نوم عميق. لونه الذهبى جميل، وحركته رشيقة وجليلة، لكنه فى نهاية المطاف حيوان برى مفترس ولا يجب تحت أى ظرف من الظروف أن نقترب منه أو نشعره بأى خطر وإلا كانت العاقبة وخيمة.
اقتصرنا على تأمله من خلف النوافذ المغلقة منتظرين أن يصحو من نومه ويتركنا مصحوباً بالسلامة. قرب المغرب قام، تمطى، تثاءب، هز جسده عدة مرات ثم خرج من الحديقة إلى الشارع واختفى عن أنظارنا. فى اليوم التالى وفى نفس الموعد تقريباً، وجدناه داخلاً. رقد فى نفس المكان بالضبط. لم ينم فور رقاده كما كان الحال فى اليوم السابق، بل بقيت عيناه مفتوحتين تتبادلان معنا النظرات. وتقول ابنتي: «إنه ينظر إليّ وكأنه يريد أن يقول لى شيئاً»، قرب المغرب صحا من نومه وخرج من الحديقة ولم يعد بعدها أبداً.
قالت ابنتي: «لقد نظر إليّ نظرة طويلة جداً قبل أن يمشي. أنا شبه متأكدة أن روح أحد أحبائنا الراحلين قد تجسدت فى هذا الكائن الجميل وأتت لتطمئن علينا وتبلغنا أنها ترعانا وتتابع حياتنا من مملكتها السماوية».
بعيداً عن هذا التفسير الميتافيزيقى الشاعرى (الذى أعجبنى جداً)، فقد أثبت عام الحظر والإغلاق صحة قول دعاة حماية البيئة والحياة البرية بأن البشر قد تطفلوا على الموطن الأصلى للحيوانات، وضيقوا عليها حركة العمران أماكن عيشها، وحاصروها فى أماكن ضيقة لا تكاد تكفى لتوفير احتياجاتها، وتنكمش تلك المساحة الضئيلة كل عام بسبب أعمال البناء والتوسع الحضري. وها هى الحيوانات البرية تعود بعد أن توقفت حركة البشر فى الطرق والمدن مطالبةً بحقها فى الحياة والحرية. لكن الوباء سينتهى إن آجلاً أو عاجلاً، ويبقى السؤال الحائر: كيف نحقق التوازن بين أنانية الإنسان وحق شركائنا فى خيرات الكوكب فى الحياة الآمنة المزدهرة؟
تتابعت الأيام، وتغيرت الفصول، ولم يتغير الملل والضيق وعدم اليقين. ذات يوم، تذكرت عبارة قرأتها من عقود طويلة فى كتاب لم أعد أذكر اسمه ولا اسم كاتبه، تقول عن سجين يقضى فترة طويلة فى الحبس: «إنه الآن يكتب يوميات، لأنه لاحظ أن الريح المجاورة لنافذة الزنزانة تداعب السقف بطريقة مختلفة».
فقدت الحماس لكل شيء. لم تعد القراءة تخفف عني. ولم أكن قادراً على كتابة ولا كلمة واحدة، فالكتابة تحتاج إلى قدر من الشغف، وهذا ما لم يعد عندى ذرة واحدة منه. وأصبحت من السهل على الأشياء الصغيرة التافهة أن تثير أعصابى وتدفعنى إلى هاوية سوداء من الاكتئاب واليأس الذى يكتم الأنفاس.
انكسرت الرتابة مرة واحدة عندما قرر ابننا الذى يعيش فى تكساس أن يأتى لزيارتنا. كانت حركة الطيران متوقفة بطبيعة الحال، وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، فلم يكن من الممكن لأى إنسان عاقل أن يخاطر بركوب الطائرة، خاصة من ولاية ذات أغلبية جمهورية تؤيد ترامب تأييداً أعمى، وتجسد ذلك التأييد فى رفض مواطنيها بعناد غبى الالتزام بأى من الاجراءات الاحترازية بما فى ذلك مجرد تغطية الوجه بالكمامة. قاد الشاب سيارته لمسافة 2850 كيلو متراً ومثلها فى العودة ليقضى معنا عدة أيام ويلتئم شمل أسرتنا الصغيرة. وكان ذلك مبعث بهجة ندر مثيلها فى ذلك العام القاسي.
احتفلنا برأس السنة الجديدة أمام شاشة التليفزيون مؤملين فى قادم الأيام خيراً، ومبتهلين أن يكون عام 2021 أفضل قليلاً من سابقه. لم ندرك أن أمامنا خمسة أشهر إضافية يزداد ثقل وطأتها يوماً بعد يوم، قبل أن يُفَك أسرنا نسبياً.
«اليوم بسنة فى قرفه، والسنة بيوم فى تفاهتها»
التطعيم:
ازداد الانقسام والتنكر للعلم حدةً فى الولايات المتحدة فور أن بدأت الأخبار تتواتر عن قرب التوصل إلى لقاح لفيروس كوفيد – 19. كالعادة، كان الانقسام سياسياً ولا صلة له بالعلم. انفجر طوفان من التعليقات والتخمينات والتكهنات وغمر الانترنت وقنوات التليفزيون وصفحات الجرائد. شهدت تلك الفترة انتشاراً غير مسبوق لنظريات مؤامرة لا تدخل عقل إنسان حصل على نصيب محدود من التعليم. فمن حديث عن شريحة ينوى «بيل جيتس» حقنها فى أجساد الناس وتسهّل عليه تتبعهم والتحكم فيهم، إلى كلام عن محاولات السلطات تقليل عدد السكان من خلال حقنهم بعقار يميت كبار السن منهم بالتدريج ويسبب العقم لجيل كامل حتى يتوقف عن الإنجاب.
أو أن المصل مصنوع من أنسجة الأجنّة التى تم إجهاضها بما يخالف التعاليم الدينية المسيحية أو أنه يتضمن مواد مستخلصة من الخنزير بما يجعله حراماً على المسلمين، أو أن التطعيم سيؤدى إلى زيادة الإصابة بالمرض وزيادة عدد الوفيات، والقول طبعاً بأن الوباء والتطعيم جزء من مؤامرة كبرى تواطأت فيها شركات الأدوية العالمية لزيادة مبيعات منتجاتها. أما أطرف تلك الهلاوس فكان القول إن التطعيم لن يجدى نفعاً لأن تكنولوجيا ال 5G للهواتف الذكية تنشر الفيروس وتصيب الناس به سواء تلقوا المصل أم لا.
والكثير من التخاريف المماثلة. بالطبع، كان لدى بعض الناس درجة من التخوف والتحفظ المفهوم والمشروع.: كان من رأى هؤلاء أن البشرية لم تعرف على مدى تاريخها الطويل فى محاولة التحكم فى الأوبئة مصلاُ يتم التوصل إليه، وتجربته، والثقة فيه، واستخدامه على نطاق واسع، والتأكد من عدم وجود آثار جانبية له على المدى الطويل، خلال فترة لا تزيد عن سنة واحدة. وعلى الرغم من مشروعية هذا التحفظ ووجاهته، فإنه يتجاهل حقيقة أن العلماء والأطباء لم يبدأوا من نقطة الصفر فى جهدهم الخارق للتوصل إلى لقاح. فيروسات الكورونا معروفة منذ زمن طويل، ومحاولات التوصل للقاح يقى منها ومن تحوراتها السنوية مستمرة منذ العام 2000 على أقل تقدير. وبالتالى لم يكن عملهم يتم فى ظلمات المجهول بل كانوا يبنون على اختبارات معملية وسريرية دامت لعقدين من الزمان على الأقل.
بطبيعة الحال، أصابتنى كل هذه المعلومات المتناقضة بحالة من البلبلة والخلط الشديدين. فقررت، حفاظاً على ما تبقى من قواى العقلية، أن أصُمّ أذنيّ عنها جميعاً، وأن أتفادى متابعتها والاستماع إليها قدر الإمكان، وأن أستقى معلوماتى التى سأبنى عليها قرار التطعيم من عدمه، من مصدر واحد ووحيد وهو السلطات الصحية المسؤولة عن مواجهة الوباء واحتوائه، أى منظمة الصحة العالمية على المستوى الدولى ومركز مقاومة الأوبئة على المستوى المحلى ورئيسه الدكتور أنتونى فاوتشي؛ أبرز خبراء الأوبئة فى الولايات المتحدة.
عندما تعلن تلك السلطات، أن لقاحاً ما آمنًا وفعالًا فى توفير قدر معقول من المناعة ضد الفيروس، سآخذه دون أى تردد. فمهما كانت مخاطره، فهى بالتأكيد أقل من خطر الإصابة بالكورونا التى أعرف شخصياً عدداً ممن فقدوا حياتهم بسببها. كنت أريد لقاحاً، أى لقاح، يساعد فى إنهاء الحظر ويعيد قدراً من الطبيعية إلى حياتنا المضطربة.
وبحكم افتقارى للمعرفة العلمية والطبية، لم يكن هناك ما يدعونى لتفضيل لقاح على آخر أو الثقة فى لقاح أكثر من غيره على أساس بلد المنشأ أو على أى أساس آخر. ما تشجعنى السلطات الصحية المسؤولة على تلقيه، سآخذه دون تردد أو طول تفكير.
فى اعتقادى أن البشرية ستقضى أعواماً طويلة فى دراسة وباء الكورونا وما ترتب عليه من صعوبات وتحديات كبرى. واحد من تلك التحديات التى لم تحظ حتى الآن بنصيبها العادل من التمحيص، هو المأزق الأخلاقى والضميرى الذى يواجه الأطباء والعاملين فى مجال الرعاية الصحية بشكل عام. عندما عجزت المستشفيات عن تقديم العون لأعداد المرضى المتزايدة، وواجهت نقصاً حاداً فى أجهزة التنفس التى تمثل فى المراحل المتأخرة من المرض الفيصل بين الشفاء والفناء.
وجد أطباء كثيرون أنفسهم أمام اختيار بالغ الصعوبة: عندما يكون عندك عدد من المرضى، ويتوفر جهاز تنفس واحد، فلمن نعطى الأولوية؟ كل روح بشرية ثمينة وغالية وتستحق بذل كل جهد لإنقاذها والحفاظ عليها، إعطاء الأولوية لشخص قد يكون حكماً بالإعدام على آخر. فعلى أى أساس يتخذ الطبيب قرار الحياة والموت هذا؟ على أساس السن مثلاً أم على أساس تقديره الشخصى لاحتمالات شفاء أحدهما؟ وكيف ينجو من هواجس الشك وتأنيب الضمير بعد اتخاذه ذلك القرار الذى يفترض أن يُترَك حصراً فى يد الخالق وحده؟
خلق إعلان السلطات الطبية عن توفر كميات محدودة من اللقاح مأزقاً أخلاقياً مماثلاً. لمن يجب أن تكون الأولوية فى الحصول عليه؟ بطبيعة الحال، كان تطعيم الأطباء والعاملين فى مجال الرعاية الصحية وتوفير أقصى قدر ممكن من الحماية لهم أمراً لا خلاف على أولويته المطلقة. وبعد ذلك، من؟ وبأى ترتيب؟ كان رأيى الشخصى أن تكون الأولوية للشباب، فهم القوة العاملة المنتجة، وهم مستقبل البشرية وأملها فى التعافى والخروج من الأزمة.
كنت آمل أن يتدرج توزيع المصل فى شرائح عمرية متصاعدة، فنبدأ بمن هم فى العشرينات من عمرهم، وننتقل إلى الأكبر منهم سناً حتى ننتهى بمن وصلوا إلى سن الشيخوخة. لكن السلطات كان لها رأى مختلف. فقررت البدء بكبار السن أولاً ثم التدرج نازلة إلى الشرائح العمرية الأدنى حتى تنتهى بتطعيم الشباب. ورغم استفادتى الفردية من هذا القرار وحصولى على التطعيم فى وقت مبكر نسبياً بحكم السن، فما زلت أرى أن هذا القرار قد جانبه الصواب، وما زلت أشعر بقدر من تأنيب الضمير على تلك الاستفادة.
أدّى تسييس الموقف من التطعيم، والتنكّر الغريب للعلم والعلماء، إلى مفارقة غريبة. فى الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، مثل نيويورك، لم تكفِ الكميات المتوفرة من اللقاح لمواجهة الإقبال الكبير من الأهالى للحصول عليه، وخضعت عملية التطعيم لجداول زمنية معقدة وفترات انتظار طويلة. فى حين كانت مراكز التطعيم فى الولايات ذات الأغلبية الجمهورية، مثل تكساس التى يعيش فيها ابننا، شبه خاوية يخرج العاملون فيها متوسلين إلى المارة أن يتفضلوا بالدخول وتلقى اللقاح، ولم تستجب لهم إلا قلة قليلة. تابعنا تلك الأخبار السيريالية ولسان حالنا يقول: صدق المثل الشعبى المصرى «يدّى الحلق للى بلا ودان».
ثم جاء اليوم المشهود الذى طال انتظارنا له. يوم الخامس عشر من مايو 2021. سأحتفل به سنوياً وحدى طيلة ما تبقى من عمرى، بعد أربعة عشر شهراً ويوم من الأسر، التقينا بأصدقائنا لأول مرة. كنا جميعاً من سعداء الحظ الذين تم تطعيمهم، وانقضى على تلقينا للجرعة الثانية أسبوعان أى الفترة التى حددتها السلطات لوصول التطعيم لأقصى درجات المناعة، ومع ذلك حرصنا على أن يكون لقاؤنا فى الهواء الطلق. شاب بهجتى بالتحرر وفرحتى بلقاء الأصدقاء قدر لا يستهان به من الارتباك والتردد والحيرة. هل سنتصافح باليد؟ هل نرحب ببعضنا بالأحضان؟ هل نجلس على مقربة من بعضنا البعض؟ أدركت أننى بعد فترة الحظر الطويلة قد فقدت مهارة التعامل مع الناس والتفاعل الإنسانى وجهاً لوجه. وأننى سأحتاج إلى وقت طويل حتى أستعيد الإحساس بالأمان خارج بيتنا الذى أحسسته سجناً طوال عام ونيف من الحظر والإغلاق.
رفع الحظر
من السابق لأوانه أن نتحدث عن «رفع الحظر» فى نيويورك. ما حدث حتى كتابة هذه السطور (شهر أغسطس 2021) هو مجرد تخفيف للإجراءات المشددة التى عشنا بمقتضاها طيلة فترة الحظر فحسب. لم تعد هناك قيود على دخول المتاجر بشتى أنواعها، ولا أعداد محددة سلفاً للمتسوقين فيها، لكن لبس الكمامة ما زال مفروضاً فى معظم الأماكن. عادت المطاعم والمقاهى والحانات للعمل على ألا يتجاوز عدد ضيوفها 50% من طاقتها حفاظاً على التباعد الاجتماعي.
ترددت السلطات كثيراً فى اتخاذ قرار بشأن إنهاء التعليم عن بعد وعودة الطلاب إلى فصولهم فى المدارس والجامعات، ثم قررت قبل أسبوع واحد أن تعود الحياة الدراسية إلى ما يشبه طبيعتها شريطة أن يلتزم الجميع بلبس الكمامة طيلة اليوم الدراسي، وأن توفر المدارس والجامعات مكاناً مخصصاً لكل طالب لا يغيره بما يضمن الحفاظ على المسافة الآمنة بينه وبين الآخرين. صدر قرار من أيام قليلة بعودة مسارح برودواى إلى تقديم عروضها فى شهر سبتمبر، بعد سنة ونصف من الإغلاق التام، بشرط ألا يدخلها أكثر من نصف العدد الذى يمكنها استيعابه. حتى الآن، لا يستطيع الواحد، أثناء مروره أمام أحد متاحف نيويورك الكثيرة، أن يقرر دخوله فى التو واللحظة ليقضى بعض الوقت فيه.
دخول المتاحف يتطلب حجز موعد محدد على الانترنت قبل الذهاب، وغالباً ما يكون طول الزيارة محدداً سلفاً. أعادت بعض دور السينما التى نجت من الإفلاس فتح أبوابها بنصف طاقتها الاستيعابية. وأعلنت السلطات أن من حق صاحب أو مدير أى منشأة تجارية أو ترفيهية أن يطلب من الزبائن تقديم شهادة التطعيم قبل الدخول. باختصار، ما نعيشه الآن هو «نصف حظر أو شبه إغلاق». لم تعد الحياة إلى طبيعتها تماماً ولكن الإغلاق لم يعد كاملاُ أيضاً.
ما أدهشنى حقاً هو ما حدث لى بعد التخفيف الكبير للحظر. كنت أتصور أننى سأنطلق مثل جواد جامح فور أن تتاح لى فرصة الخروج، وسأذهب كل يوم إلى مكان طال اشتياقى إليه، وسأزور كل الأماكن التى أحبها والتى حُرِمت منها لعام طويل ثقيل. لكن العكس هو الذى حدث. خرجت مرة أو اثنتين، وأدركت بسرعة -كما حدث فى أول لقاء مع الأصدقاء أننى قد فقدت القدرة على التواجد فى مكان يمتلئ بالغرباء. أصبحت رؤية الناس تثير توجسى ومخاوفى وقدراً هائلاً من التوتر.
لم أعد أجد أى قدر من الجاذبية فيما كنت أحبه قبل الحظر، وما توهمت أننى سأختنق بدونه خلال فترة الإغلاق. فقدت قدرتى على التفاعل مع الآخرين. بعض من أثرى تجارب حياتى كانت لقاءات مع غرباء فى قطار أو طائرة أو مقهى، دارت بيننا أحاديث شيقة، وتكاشفنا كأصدقاء قدامى، وحكينا أسرارنا، ثم مضى كل منا إلى حال سبيله.
الآن أصبحت أجد صعوبة بالغة فى بدء أى حديث عادى مع أفراد من خارج دائرتى الضيقة. لم أعد أشعر بالراحة أو الأمان إلا فى المكان الذى التصقت به على الكنبة فى صالة بيتنا لمدة أربعة عشر شهراً. كنت أراه سجناً، وأصبحت باختيارى أراه حصناً وحضناً. أظن أننى بحاجة إلى وقت طويل حتى أستعيد لياقتى الاجتماعية، ومهارة التعامل مع الناس، والقدرة على مواجهة العالم بانشراح ورغبة بالاستمتاع بكل ما فيه.
تأملات ختامية
أعتقد أن تجربة جائحة الكورونا قد أثبتت صحة ما قاله علماء الاجتماع والسياسة على مدى قرون بأن ثقة الشعب فى حكومته هى مفتاح مواجهة الأزمات الكبرى. ومن البديهى أن هذه الثقة لا تأتى من فراغ، وإنما تُبنى بالوضوح والشفافية والمصارحة التامة. فى القرن التاسع عشر، قرر محمد على باشا، بناءً على مشورة علمية طبية من كلوت بك، أن يبدأ حملة تطعيم ضد الجدرى تغطى كل سكان القطر المصري. لكن الشعب لم يكن يثق فى الباشا، ويرى دوافع آثمة وراء كل قرار يتخذه. لذلك، قاوم الناس حملات التطعيم مقاومة شرسة قائلين إن «دق الجدري-كما كانوا يسمونه وقتها» لا صلة له بالوقاية من المرض، وإنه ليس إلا وشماً الهدف منه تحديد الأشخاص الذين يمكن للباشا تجنيدهم فى جيشه (ألا يذكرنا هذا بشريحة بيل جيتس المزعومة؟). بمرور الوقت، اكتشف الناس فعالية التطعيم وبدأوا فى الإقبال عليه طواعية بل والمطالبة به حماية لأنفسهم ولأحبائهم.
وفى غضون أشهر قليلة، تحولت نيويورك من أكبر بؤر تفشى الوباء وأخطرها إلى أقل الولايات فى نسبة الإصابات والوفيات، بفضل الشفافية والوضوح والمصارحة. فى الأشهر الأولى من الجائحة، دأب حاكم ولاية نيويورك على عقد مؤتمر صحفى يومى بمشاركة فريق من الأطباء والمتخصصين. يبدأ المؤتمر الصحفى بعرض أحدث التطورات، وذكر أعداد الإصابات الجديدة، وعدد المتعافين، وعدد الوفيات، وعدد أسرة غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس المتاحة فى مستشفيات الولاية، والخطوات المتخذة لسد النقص، ثم يفسح المجال للأطباء والمتخصصين لعرض آرائهم وإرشاداتهم. قامت الشفافية والمصارحة بدورها فى غرس الثقة فى قلوب المواطنين، فتعاونوا عن طيب خاطر وعن اقتناع مع السلطات فى إجراءات الحظر والإغلاق القاسية، رغم التكلفة الفادحة التى دفعوها من رزقهم وحريتهم لتجاوز الأزمة. وكانت النتيجة نجاحاً باهراً ومبهراً.
الانترنت نعمة ونقمة. لولاها ما كان من الممكن أن يستمر الناس فى دراستهم وعملهم وحياتهم خلال فترة الإغلاق الطويلة. وأتاحت لنا الانترنت ان نتواصل مع أحبائنا فى كل أرجاء الأرض وأن نراهم بأعيننا على شاشات الكومبيوتر مما هوّن ولو قليلاً من وطأة الوحدة والانعزال. ووفرت لنا المواد العلمية ومواد التسلية والترفيه التى أعانتنا على تحمل ملل الأسر داخل بيوتنا. فى نفس الوقت، جاء طوفان المعلومات المتدفق عليها بلا حدود نقمة ولعنة خلال الفترة المضطربة التى عشناها.
لم ينتج عن ذلك الفيضان إلا قدراً متزايداً من البلبلة والتشويش والخلط فى أذهاننا جميعاً. ولعل ذلك يرجع إلى عدم التمييز بين «المعلومات» و«الآراء» و«الشائعات» و«المعرفة». تكاثرت الأقاويل عن مصدر الوباء وسببه، والمؤامرات الكامنة وراءه، وطرق الوقاية منه وعلاجه. وأغلبيتنا ليس لديها المعرفة الضرورية لتبين صحة بعض ما نقرأه من زيفه. أسارع بالقول أننى لست من دعاة الرقابة على الانترنت أو حجب مواقعها.
لكننى أظن أن تجربة عام الوباء قد أثبتت أننا جميعاً بحاجة إلى حملة توعية لتوضيح أن ليس كل ما يُكتَب على الانترنت معلومات يمكن الاستناد إليها والوثوق فيها. فنحن لا نعرف بشكل مؤكد مصدر تلك «المعلومات»، ولا دوافعه الخفية، ولا نستطيع أن نقبلها كـ»حقائق» لمجرد أننا قرأناها على الانترنت.
وعندما يتصل الأمر بموضوع تضاربت فيه الأقوال وأثار حيرة العلماء المتخصصين مثل الكورونا، فلابد أن نتحلى بقدر من التواضع يجعلنا نسلّم بأننا لا نمتلك الأدوات المعرفية الضرورية للتوصل إلى رأى قاطع نبنى عليه قرارات مصيرية تتصل بصحتنا بل وببقائنا ذاته، وأن نترك العيش لخبازه ونستمع للرأى العلمى المدروس الذى يدلى به أهل الخبرة والعلم، ولا نقول لهم: «لكننى قرأت على الانترنت ..» ومن البديهى أننى أتحدث هنا عن العلم التجريبي، علم المعامل والمختبرات، الذى يقوم على الشك ورفض المسلمات واليقين بأى شكل من أشكاله. لا عن «علم» الكتب الصفراء الذى لا يقبل إلا باليقين والمسلمات.
لقرون طويلة، كان «العلماء» يؤكدون أن مصر هى موطن ومصدر كل أوبئة الطاعون التى ضربت العالم. وبالمثل، كانت الهند متهمة فى نظر أولئك «العلماء» بأن كل أوبئة الكوليرا قد خرجت منها. ثم تقدم العلم، وأثبت زيف كل تلك المزاعم بكاملها. فى العصر الحديث، انتقل هذا الاتهام إلى الصين. وبدأ الكثيرون يؤكدون بثقة متناهية، أن كل فيروسات الكورونا قد نشأت فيها وخرجت منها. وطبعاً لم يفوّت أنصار نظرية المؤامرة الفرصة للزعم بأن فيروس كوفيد – 19 مُخلّق فى معمل أبحاث صينى ثم (وهنا تتضارب الأقوال) خرج عن سيطرة الباحثين وانطلق يعيث فى الأرض فساداً ودماراً، أو أطلقته الصين عمداً حتى تدمّر الاقتصاد الأمريكي. منذ عدة أشهر، شكل الرئيس الأمريكى بايدن فريقاً من الباحثين وأوكل إليهم مهمة تقصى أصل الفيروس وكيف تسبب فى كل هذا الخراب.
قدم الفريق ما خلص إليه من استنتاجات للرئيس وقت كتابة هذه السطور. لم يُنشَر التقرير فى الصحف بعد، ولكن ما تسرب منه إلى وسائل الإعلام يقضى بأن الباحثين لم يتوصلوا بعد إلى اى نتيجة قاطعة. ورغم المنافسة الشرسة التى تقترب من حد العداوة بين الولايات المتحدة والصين، فقد رأى هؤلاء العلماء أن الأمانة العلمية تقتضى منهم ألا يلقوا القول أو يوجهوا الاتهامات جزافاً. وإلى أن يتم التوصل إلى مثل تلك النتيجة الحاسمة، لا أجد نفسى مستعداً لإلقاء اللوم على الصين أو اتهامها بالتسبب فى الوباء إلا إذا كنت على استعداد لقبول أكذوبة أن مصر والهند هما مصدر الطاعون والكوليرا.
أما عن العادات الغذائية للشعب الصيني، فقد أكرمنى حظى بالسفر فى جميع أنحاء العالم، ولم أر بلداً يخلو من المأكولات الغريبة التى قد تبدو مقززة فى نظر البعض، وليس ذلك حكراً على الصين وحدها. واحترام التنوع والخصوصية الثقافية يملى علينا ألا نطالب شعب الصين بتغيير ما يأكله دون أن نطالب شعوباً أخرى بنفس الشيء. ولكن إذا أصر الصينيون على الاستمرار فى أكل الخفافيش، فقد يجوز لنا أن نطلب منهم (كما تقول النكتة المصرية خفيفة الظل) أن يضيفوا إليها قطرات من عصير الليمون لعله يقضى على الفيروسات.
فى عامى 1918 و1919 ضربت العالم جائحة الأنفلونزا الأسبانية وأودت بحياة ما يقرب من خمسين مليوناً من سكان الكوكب البالغ عددهم آنذاك 1,7 مليار نسمة. تعداد سكان العالم اليوم 7,8 مليار نسمة، وبلغ عدد وفيات الكورونا المعلن حتى اليوم 4,5 مليون حالة وفاة. وحتى لو قبلنا القول بأن بعض الحكومات تتلاعب بالأعداد وتتعمد التقليل منها، يبقى الفارق شاسعاً بين ماحدث القرن الماضى وما حدث فى أيامنا هذه. بطبيعة الحال، لا يمكننى أن أستهين بحجم الألم والحزن الذى تسببت فيه جائحة الكورونا.
كل وفاة مأساة موجعة لأسرة فقدت أحد أفرادها. وألم الفقد الذى عانت منه أربعة ملايين ونصف المليون من الأسر التى انكسرت قلوبها لا يخفف منه قط أن عدد المتوفين كنسبة مئوية من سكان العالم لا يمكن أن يُقارن بنظيره من قرن مضى. ومع ذلك، ومع الاعتراف بالألم، تبقى الحقيقة هى أن الفارق بين النسبتين المئويتين معجزة فعلية.
والفضل فى هذا يرجع إلى العلم والعلماء الذين كرسوا حياتهم وجهدهم، بتفانٍ يندر مثيله، لفهم الأمراض والجراثيم والفيروسات وغيرها من مسببات المرض. فى عنق البشرية دين هائل لهؤلاء الأبطال الذين لا يعرف أحد معظمهم، ولم يثنهم هذا التجاهل عن مهمتهم المقدسة. المجد للعلم. المجد للعلماء. والرحمة لمن عجز العلم عن إنقاذهم فى اللحظة المناسبة، غالباً بسبب تدخل السياسة والمصالح الاقتصادية الأنانية العمياء فيما يجب أن يكون موضوعاً علمياً صرفاً.
قيل كثيراً إن العالم قد تغير تغيراً جذرياً، وإن عالم ما بعد الكورونا سيكون مختلفاً كل الاختلاف عن عالم ما بعد الجائحة. عندما سمعت هذا القول، تذكرت مقالاً لباحث فى علم المستقبليات قرأته منذ أكثر من عشرة أعوام. للأسف لم أعد أذكر اسمه ولم يسعفنى البحث المتعجل على الانترنت فى الوصول للمزيد من المعلومات عنه. فى ذلك المقال، تنبأ الباحث بأن «المدينة» كما نعرفها الآن كيان وفكرة فى طريقها إلى الزوال. بنى الباحث رؤيته على حقيقة أن المدن، منذ الثورة الصناعية، أماكن يتكدس فيها الناس بغرض العمل والتجارة والتعلم وما شابه ذلك من أنشطة تتميز بها المدن. بطبيعة الحال، ينتج عن هذا التكدس ويصاحبه زحام شديد وزيادة حادة فى معدلات التلوث، وتدنٍ مخيف فى نوعية الحياة وارتفاع شديد فى تكلفتها فى نفس الوقت. وزادت الهجرة الكثيفة من الريف إلى الحضر، خصوصاً فى بلدان العالم الثالث،من تفاقم هذه الأوضاع المزرية.
لكن الباحث كان من رأيه أن التقدم التكنولوجى سيقلل من أهمية التواجد الجسدى فى أماكن العمل، وستتلقف الشركات والكيانات الاقتصادية تلك الفرصة بل وترحب بها لتقليل نفقاتها الثابتة من إيجارات وكهرباء وتدفئة وتهوية وحراسة وأمن وما شابه ذلك، بما يؤدى إلى تعظيم أرباحها خاصة وأنه من غير المرجح أن يُترجم هذا التخفيض فى النفقات إلى زيادة فى مرتبات العاملين.
وفى الوقت ذاته، سيجد العاملون والموظفون أن ما يدفعونه فى إيجار مساكن ضيقة مظلمة لا تدخلها الشمس ولا الهواء النقي، يكفى لإحداث طفرة كبيرة فى نوعية حياتهم لو انتقلوا للعيش فى الضواحى أو الريف، ماداموا قادرين على القيام بعملهم عن بعد بفضل التقدم الهائل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وينطبق نفس القول على المؤسسات التعليمية. ويرى الباحث أن سكان المدن سيهجرونها شيئاً فشيئاً، وتتناقص أهميتها النسبية، وتنكمش مساحتها وثقلها الاقتصادي، حتى تتحول بالتدريج إلى أماكن للترفيه ولتلقى العلاج الضرورى والقيام ببعض المعاملات الحكومية التى تتطلب حضور الناس شخصياً لإتمامها. طبعاً قلت لنفسى بعد قراءة هذا المقال إن ذلك الرجل مخرّف ولا تستحق كتاباته الوقت الذى أضعته فى قراءتها.
ثم جاءت الجائحة وأثبتت بعد نظره ورؤيته الثاقبة. فها هى مانهاتن، المدينة بألف لام التعريف، قد هجرها ما يقرب من ثلث سكانها فى أقل من سنة. فقد أثبتت التجربة الأليمة أن العمل ممكن والتعليم متاح بغير تواجد جسدى فى المكتب أو المدرسة.
وأعرف شخصياً عدداً كبيراً من الناس ممن انتقلوا للعيش فى مدن وقرى أخرى، بل وفى دول أخرى، بتكلفة أقل بما لا يُقارن، وبنوعية حياة أفضل بكثير، طالما أن عندهم كومبيوتر وانترنت يمكنهم من القيام بوظائفهم على أكمل وجه دون الاضطرار لتحمل ضجيج المدينة وضوضائها وتلوثها وأسعارها الباهظة. ويبدو أن هذا التغير سيستمر ويتسارع فى المستقبل المنظور.
لكن شيئاً واحداً لم يتغير، ولا ينبغى له قط أن يتغير. يقول التعبير المستهلك إننا جميعاً، نحن بنى البشر، فى قارب واحد. إما أن نبحر سوياً إلى بر السلامة أو أن تبتلعنا ظلمات الماء سوياً. أثبتت أحداث العام الماضى صحة هذا القول وضرورة أن نتبناه جميعاً بالأفعال لا بالأقوال. لن ينجو أحد منا إلا عندما ننجو جميعاً. ولن ينعم أى فرد منا بالأمان مالم يشعر كل واحد منا بالأمان. لا مفر من أن يكون كل واحد منا حارساً لأخيه، بالمشاركة والتضامن إن أمكن، وبالتباعد والمسافات إذا استلزم الأمر.
للأسف أن الأنانية المفرطة التى تعاملت بها الدول المتقدمة مع مسألة توزيع التطعيمات يبدو منها أنها لم تفهم هذه الحقيقة البسيطة بعد. ورغم ذلك، أسمح لنفسى بارتكاب خطيئة التفاؤل، فدروس التاريخ الكبرى تحتاج إلى وقت طويل نسبياً حتى يستوعبها الجميع.
وأختم هذا الحديث الذى طال بأكثر مما كنت أتوقعه أو أريده، بالعبارة الموجزة البليغة التى يقولها أهلنا فى الشام: «سنة تنذكر .. وما تنعاد».
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 طارق الطيب.. ليالى الفن فى فيينا حازم المستكاوى ومعمار الحروف
طارق الطيب.. ليالى الفن فى فيينا حازم المستكاوى ومعمار الحروف
 «عملك مردود إليك».. رسالة حازم المستكاوي في وداعه للعالم
«عملك مردود إليك».. رسالة حازم المستكاوي في وداعه للعالم
 من بغداد إلى القاهرة مدن وخلفاء
من بغداد إلى القاهرة مدن وخلفاء
 محمد سليم شوشة: خاتم سليمي رواية عن الحب والإرهاب وتزاوج الحضارات
محمد سليم شوشة: خاتم سليمي رواية عن الحب والإرهاب وتزاوج الحضارات
 نيفين النصيري تكتب: شيء ما أصابه الخلل.. تمرد الراوى
نيفين النصيري تكتب: شيء ما أصابه الخلل.. تمرد الراوى
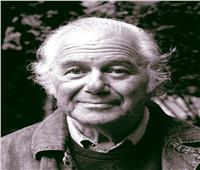 أحمد الزناتى يكتب : أذكار فى أوانها جاكوب نيديلمان وتأملات عن المعنى والمسؤولية
أحمد الزناتى يكتب : أذكار فى أوانها جاكوب نيديلمان وتأملات عن المعنى والمسؤولية
 منصورة عز الدين تكتب :تونى موريسون كمحررة أدبية
منصورة عز الدين تكتب :تونى موريسون كمحررة أدبية
 صقلية .. الحلقة المفقودة فى تطور عمارة القاهرة
صقلية .. الحلقة المفقودة فى تطور عمارة القاهرة
 القاهرة في مرأه باريس
القاهرة في مرأه باريس






















