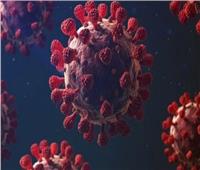د. فاطمة قنديل
فاطميات
السبت، 28 مايو 2016 - 08:01 م
في فيلم «البوسطجي» المأخوذ عن رواية «يحيي حقي»، المكتوبة قبيل»منتصف القرن الماضي»، يطعن الأب ابنته ليغسل عاره حاملا جثتها علي ذراعيه أمام أهل القرية المحتشدين، ومختلسا النظر إليها بعينين يتصارع فيهما الفخر والدموع، بينما يمزق البوسطجي الخطابات، الآتية من المدينة، وينثرها في الهواء، فما جدواها بعد الذبح؟! وما جدواها بعد أن تورط وتواطأ علي الجريمة؟! في اللحظة التي ينغرز فيها الخنجر في قلب الفتاة تصرخ منادية حبيبها، علهما يلتقيان في «مملكة تانية». في فيلم «الطوق والأسورة»،عن رواية «يحيي الطاهر عبدالله»، يعود الخال المتمدن، ليجد ابنة أخته وقد تورطت في الخطيئة، ولأنه رأي الدنيا، يدفنها حية في الرمال، ويمنع عنها الماء والطعام، حتي تعترف بشريكها، حتي يعالج الأمر، دون أن يقتلها، دون أن يُحمّلها «وحدها» المسئولية، لكن ابن العم المتربص يعاجلها بالطعنة، ويسير مزهوا أمام حشد القرية، حين يبكي الخال الابنة وعجزه عن التغيير، هذا هو «الصعيد» الذي عرفناه، واقعا، وممزوجا بخيال الكتاب الحالمين بتغييرالصعيد «الجواني» بتقاليده، بتصوره عن الشرف سجينا في جسد المرأة، وبثأره، لا أظن أن كاتبا- مهما بلغت قوة مخيلته- كان سيتخيل مشهدا تُعري فيه امرأة مسنة، و»تجرس»، و»تضرب» أمام الحشود! «لمظنة» علاقة آثمة يُحمّلها «الرجال»؟! وزرها، بين ابنها وامرأة أخري، لا لشيء إلا لأن خيال الروائيين، والمفكرين، الذي أخافكم فوضعتم صانعيه في السجون، لا يمكنه أن يرصد الواقع دون أن يبث فيه بذرة التغيير، هذا ما فعله إسلام بحيري، وأحمد ناجي الذي خدش الحياء العام! ما حدث علي أرض الواقع يفوق الخيال، لا لشيء إلا لأنه لا ينتمي للخيال، وإنما إلي الفساد، والإفساد في الأرض، ولأننا في «دولة قانون»، نطبق نصوص القانون، بينما يندلع المارد من قمقمه، يحرق ويقتل ويجرد العجائز من ملابسهن في الطرقات، وما خفي كان أعظم! ولأنني أكتم الغضب كما ينبغي لعاقل يشاهد رهطا من المجانين، يتقافز مهللا: «الله أكبر»، أكتم الغضب تلو الغضب، بدءا من «أريد أختي كاميليا» وليس انتهاء، فيما يبدو لي، بتعرية القديسة «سعاد ثابت»، الوحيدة التي طبقت ما تمليه عليها «دولة القانون»، هُدّدتْ فذهبت، كأي مواطن شريف، لتحرير محضر، طمعا في أن تتم حمايتها، ممن من المفترض أن يحموها، لكنهم للأسف التقطوا اللقطات الأخيرة من فيلم البوسطجي، فتواطئوا، وتورطوا في الجريمة، ونثروا التهديدات في فراغ اللاجدوي؛ لم يستطع السيد المحافظ تحديد الفارق بين مشهد أب يحمل جثة ابنته بعينين مغرورقتين بالدموع، وحشد من المهوّسين يعرون المُسنّات ويمتهنون أجسادهن أمام المارة، فاعتبر أن الحادث «أمر بسيط»! السيدة «القديسة»، صرحت بعد «الهول»، في مداخلة مع إحدي القنوات، أنها انتخبت «السيسي» عشان «يحمينا»، و»دعت» له كأي أم تدعو لابنها. وبدورها أصدرت الرئاسة بيانا بعزمها علي معاقبة الجناة، وتم بالفعل القبض علي بعضهم، لكن جناة آخرين لا يزالون علي «مكاتبهم المكيفة»، وستظل الدودة في قلب الشجرة، وسيظل المارد يطير علي أجنحة الخيال المريض من قرية إلي قرية ومن نجع إلي نجع، طالما بقي المحافظ في منصبه، وطالما بقي من تلقوا بلاغ السيدة ووضعوه جانبا في أماكنهم، وطالما ظلت خانة الديانة في بطاقاتنا موجودة، وطالما وضعنا كل هذا الهراء في خانة «الفتن الطائفية»، وطالما تركنا الفضائيات لذوي اللحي ممن يؤججون النار ليل نهار، وطالما عقدنا «الجلسات العرفية»، وطالما احتضن الشيوخ القسس مرددين شعارات: «الوحدة الوطنية»، كأنها لافتة «النهاية» بعد كل فيلم درامي، وطالما صمتنا كي لا نُتهم بالصيد في الماء الذي صار «وحلا»، وطالما قلنا للشخص الوحيد الذي فهم معني القانون، وعمل بمقتضي «دولة القانون»: أنت أمنا وحقك علي رأسنا! فحقها، في الحقيقة، ليس علي رأسنا، ومهما «جودنا» في كلمات الترضية، لن نغسل عارها، لأنه «عارنا»، وسنظل نحمله علي رءوسنا طالما «دولة القانون»، و«المواطنة» في «مملكة تانية»!
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة











 البيت الأبيض: كوريا الشمالية وراء هجمات البرمجيات الخبيثة
البيت الأبيض: كوريا الشمالية وراء هجمات البرمجيات الخبيثة
 شكري:العلاقات المصرية الأمريكية متشعبة وعميقة
شكري:العلاقات المصرية الأمريكية متشعبة وعميقة
 TEST
TEST
 عندما قال عبدالناصر: المهم أن تبقى سوريا
عندما قال عبدالناصر: المهم أن تبقى سوريا
 بوكس
بوكس
 انكشف المستور بعد استعادة الجيش الليبى لمواقع «النفط»
انكشف المستور بعد استعادة الجيش الليبى لمواقع «النفط»
 بدون تردد
بدون تردد
 قضايا وأفكار
قضايا وأفكار
 نهار
نهار