
علاء عبدالوهاب
يوميات الأخبار
السبت، 11 يونيو 2016 - 10:03 م
لابد أنك ادركت متأخرا أن فئران التسريب والغش لا يرهبها من يرتدي «فروة أسد» لأنه اشبه بمن يلبس مزيكا
الاثنين :
هل هي مجرد صدفة؟!
بينما كانت تجري الاستعدادات لاستطلاع رؤية هلال رمضان مساء نفس اليوم، كان علي الجانب الآخر ثمة اجتماع ظهر الأحد لإعلان رؤية من نوع مختلف.
في دار الافتاء كانت الرتوش الأخيرة للإعداد لهذه الليلة المباركة، وفي مقر المجلس الاعلي للثقافة كان الوقت قد أزف، ولم يبق سوي الكشف عن حقيقة مرة
لقد استبقت اللجان المعنية بجوائز الدولة صيام رمضان، بفضيحة من العيار الثقيل، قالت بالفم المليان : نحن مجتمع يصوم منذ دهر عن الإبداع!
أين الخلل؟ من يعلق الجرس في عنق القط؟
ماذا يعني حجب ١٣ جائزة سوي أن المحروسة تصوم عن الإبداع منذ دهر؟
لم تكن المرة الأولي، الامر تكرر، من ثم فلا مبالغة في وصف الحالة! في دورات سابقة لم نصادف حجماً مماثلاً أو مقارباً للكارثة، بل جاء وقت علي الناس شاهدوا فيه توسعاً واضافة لجوائز لم يصادفوها من قبل، فهل كانت الامور حينذاك علي ما يرام، وكان الابداع بخير، ولم يضطر اصحاب الفكر والقلم لصيام إجباري أو اختياري عن الإبداع؟
صاحبي ينبهني عندما رأي علامات الدهشة والفزع تكسو ملامحي: يبدو أنك نسيت..
ماذا تعني؟
- في العام الماضي وصل عدد الجوائز التشجيعية التي تم حجبها ١٧ جائزة.
المطلوب إذن أن نحمد الله ان العدد تقلص؟
- لا، لكن هون عليك، فالابداع ابن شرعي لمناخ عام.
نعم، الا ان الدهشة تظل باسطة جناحيها.
- كيف؟
اقصد ان السادة الذين يستيقظون من العام للعام مرة.. اين كانوا كل هذا الوقت؟ هل يتصورون ان مسئوليتهم تنحصر في فحص ما يُعرض فيستبعدون هذا، وربما يجاملون ذاك، ثم ينفض السامر حتي يظلنا عام جديد؟
- تعني ان ثمة أدوارا من المطلوب ان يمارسوها، تقاعسوا عنها.
بالتأكيد.. لماذا لم يفكر احدهم أن يلعب دور المسحراتي الذي يقرع بعنف علي طبلته، ليوقظ المبدع الكسول، او اولئك الذين ضربهم الإحباط فآثروا الابتعاد عن الحلبة.
- إذا كان لي أن اضيف، فإن دور المسحراتي يجب ان يمتد ليصل الي مؤسسات من صميم عملها أن تهيئ التربة الصالحة للبذور الجيدة، وان تسهر علي رعايتها حتي تربو وتعلو وتنضج و.. و ..
يبدو أنك تفرط في التفاؤل..!
- لماذا؟
أنك تطرح رؤية مثالية، مثلاً تنسي أن بين الشيوخ الذين يحكمون للجوائز من يري خطراً علي نفسه وجيله إن هو بحث عن الجدير بالجائزة حتي وإن لم يتقدم هو!
- يعني من مصلحة هؤلاء تسويق وهم صوم جيل عن الابداع.. إذا فرضنا ذلك، فلماذا يُسمح لهؤلاء بفرض رؤيتهم أو بجعل الصوم عن الابداع وكأنه أمر واقع أو حقيقة قائمة؟
لابد أن تصل هؤلاء رسالة قاطعة: ان ما تدعون إليه أو تسعون لفرضه، فريضة مرفوضة،
- يعني نصوم رمضان، ولا نصوم عن الابداع، أهذا ما تقصد اليه؟
- تماماً، يجب أن يقرع المبدع الحقيقي فوق كل الطبول بقوة، وبكلمات واضحة، إلي كل من سولت لهم ضمائرهم الغائبة تصوير المهزلة المتكررة علي انها نتاج صوم عن الابداع: إن ما يدعون إليه فريضة مرفوضة «بالثلث».
الفئران.. وفروة الأسد!
الثلاثاء :
الحمد لله أنني اجتزت الشهادة الثانوية قبل «زمن شاومينج» بأربعين عاماً.
لم يكن العصر - آنذاك- معقماً، خاليا من الغش، لكن الغشاش، ومن يساعده، مدانان، ولا يجرؤ انسان علي مدح الغشاشين، أو وصفهم بالشُطار، ثم إن حجم الغش لم يرق إلي وصف الأمر بالظاهرة، كانت حالات فردية بالفعل.
كان ذلك في العام ١٩٧٦، الذي لم يفصله وقت بعيد عن واقعة التسريب الشهيرة في ستينيات القرن الماضي، عندما بثت اذاعة صوت إسرائيل امتحانا للثانوية العامة، فلم يتردد جمال عبدالناصر في الغاء الامتحانات، ثم إعادتها، وتوقيع العقاب الرادع علي مرتكبي الجريمة.
رد فعل الدولة حينها، كان كفيلا بألا يفكر كائن من كان في تعريض نفسه لعقاب لا رحمة فيه ولا شفاعة، وجعل كل من تسول له النفس الأمارة بالسوء في الغش أن يفكر ألف مرة قبل أن يلجأ إلي «برشامة» أو «لوزة» تكون ونيسه في اللجنة!
ولأن تكافؤ الفرص كانت قيمته أصيلة، فكان السواد الأعظم من المصريين يرفض الغش، وكان يندر أن تجد من ينصح أولاده عشية الامتحان بتفتيح المخ، والفهلوة مع المراقبين، بل كان معظم الأهالي علي قناعة بأن «لكل مجتهد نصيب».
........................................
مرت مياه كثيرة في النهر، وأصبح الفتي أباً، واختلفت خريطة المجتمع في كل شيء، وارتفعت أمواج الدروس الخصوصية، وفرضت «السناتر» نفسها رقما في معادلة الثانوية العامة، وكان بين نجوم تلك المرحلة من يباهي بأن معظم اسئلة الامتحان في مادته ضمن توقعاته في آخر محاضرة بالسنتر، وظهرت كراسات توزع جهارا نهارا تشي بأن أوراقها تحمل الخلاصة التي لن يخرج عنها الامتحان، بل تبارت الصحف، ومذيعو البرامج التليفزيونية في ادعاء أن ما تقدمه قبل الامتحان بساعات هو الآتي في الاختبار المنتظر!
وبالطبع زادت معدلات الغش، وعرف المصريون طريق الرشوة للمراقب، ورئيس اللجنة، والأكبر منهما لتسهيل الأمور للأولاد، وظهرت موضة التحويلات لبعض أبناء الكبار - سواء أكانوا مسئولين أو اثرياء - إلي لجان بعينها، وغض الجميع الطرف عن هذه المهازل، إلا ما فاحت رائحته فزكمت الأنوف، وفي الغالب كان هناك كبش فداء من الضعفاء.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنني لا أنسي أن ضمن من تقدم للثانوية العامة عندما امتحنتها نجل رئيس المدينة، ولم يوص الرجل بابنه خيرا، وكان يستطيع ذلك دون شك، وعندما أُعلنت النتيجة كان مجموع «النجل» شديد التواضع، فما كان من المسئول إلا أن يباهي بما حدث.. «هيييه دنيا»!
........................................
وتدفقت مياه أكثر في النهر، لكنها كانت نتاج مستنقع آسن، حتي حطت بنا الرحال في «زمن شاومينج» وإخوانه!
في هذا الزمان ارتدت الفئران ثياب الناصحين، ولم يستحوا أن يعلنوا شروطا لوقف التسريب كالاعتماد علي امتحانات القدرات، ووقف التصنيف الطبقي للكليات و... و... وكأن المسربين هم من يملك الروشتة الحقيقية لاصلاح التعليم، فإما الرضوخ لما يقولون، أو تعميم الغش بالعدل!!
هكذا كان الحصاد المر منطقياً، وكانت الدلالة الرمزية لكارثة الغش صبيحة ٥ يونيو ٢٠١٦ واضحة لكل ذي بصيرة، ففي ذات يوم نكسة يونيو ٦٧، تفجعنا نكسة التعليم الكبري بفاصل نصف قرن تقريباً، وفي الاطار العام فإن اخطر أوجه الشبه ما يجمع بين وزير حربية النكسة القديمة الذي كان تعقيبه علي ما حدث: «أما احنا اتخمينا حتة دين خمة»، أما بطل النكسة الجديدة وزير التربية والتعليم الحالي د. الشربيني، فإنه أكد وشدد ألا غش، وان الامتحان في عهده سيكون تحت السيطرة الصارمة التي لا تمنح غشاشا فرصة أن يفكر مجرد تفكير في الاقدام علي فعلته و... و... ومضي في التهديد والوعيد، وبذل الوعود والعهود مرتديا «فروة أسد» ثم بات يبحث عن مبررات واهية وشماعة يعلق عليها «الخمة» التي شربها وتجرعناها معه كالسم الهاري!
د. الشربيني، لم يعد البكاء علي اللبن المسكوب يفيد أحدا، ولا حتي معاليك، ولابد أنك ادركت متأخرا أن فئران التسريب والغش لا يرهبها من يرتدي «فروة أسد» لأنه اشبه بمن «يلبس مزيكا»، وربما لو كانت تلك الفئران قد رأت أمامها قطا شرسا لعملت له ألف حساب.
........................................
قبل شهور قليلة كان الحديث صاخبا عن تطبيق نظام التعليم الياباني في مصر، وكان د. الشربيني متحمسا بالطبع، وما فتئ يذكرنا بأنه تخصص إدارة منشآت تعليمية، وانه عبقرية علمية معملية فذة، إذ إنه درس ثم قام بتدريس علمه، ثم أدار قسما وكلية وجامعة، وادارته للوزارة أمر طبيعي، وبالتالي فإن سهره علي نقل التجربة اليابانية يأتي منطقيا في هذا السياق، فقط أذكر معاليه ان المسئول الفاشل أو الذي لا يستطيع أن يفي بما تعهد في اليابان لا يتردد في انهاء حياته بالانتحار، وبالطبع فإن ديننا نهانا عن الاقدام علي انهاء حياتنا بأيدينا، لكن حياتنا الوظيفية يمكن انهاؤها بالاستقالة، وهذا أضعف الايمان!
نتمني عليك أن تخلع «فروة الأسد» وتغادرنا، ربما أبدلنا الله خيراً منك، فيستطيع أن يُدخل الفئران إلي جحورها، استقل يا رجل يرحمك ويرحمنا الله.
الفانوس يقاوم المحتل
الأربعاء :
كنت أتابع التقرير التليفزيوني عن الفانوس العملاق بسعادة بالغة.. لم يكن التقرير معنياً بعودة الفانوس التقليدي لعرشه في مصر بعد طول غياب، وبعد اقصاء مارسه الفانوس الصيني لسنوات!
صحيح أننا - كأسرة - حرصنا أن يكون ما بين أيدي الاحفاد فوانيس مصرية تماماً كتلك التي حملتها أمهاتهم، لكن ثمة معاناة في توفيرها والبحث عنها، وضمان جودتها، وكان الاسهل طبقاً لنصائح الاقارب والاصدقاء التي تلخصها جملة من ثلاث كلمات:
- الصيني أحدث وأرخص.
كانت نصيحة غير مرحب بها، حتي ولو كان في استمرار الفانوس المصري في بيتنا قدر من المعاناة والغرامة.
........................................
عود علي بدء، ما الذي يدعو للفرحة في حكاية الفانوس العملاق؟
الحق أنه هناك، شامخ في الارض المحتلة، رابض وسط رام الله، يؤكد أن فلسطين عربية، ولو كره الكارهون.
في التقرير المتلفز ما يجعل القلب يرقص طرباً، فالعروبة بخير، وفلسطين سوف تعود لاهلها، وإن طال المدي.
الرمز الرمضاني بارتفاع ثلاثة عشر متراً ينتصب في قلب العاصمة المؤقتة - حتي عودة القدس عربية - وحوله زوار كثر لسان حالهم: الارض لنا..
من السهل أن تلمح وسط الزحام عناق مسلم / مسيحي عبر كلمات يتبادلها رموز الديانتين، ولسان حالهم:
- مهما حاول الاحتلال، ومهما توارث المحتلون جيلاً وراء جيل سياسة فرق تسد، فلن ينالوا غايتهم، وسوف تدحرهم وحدة القلوب العربية، وإن اختلفت الديانة.
فانوس رام الله يتحدث بالكثير لمن يتقن لغة الاشارات:
الأمل في مواجهة الألم..
انوار الفانوس أقوي من وميض اسلحة المحتل..
ارادة صاحب الارض أمضي من إدارة الصهيوني المدجج..
حب الحياة اشد وطأة من كل آلات القتل والبطش..
الفانوس العملاق اعظم من المدفع العملاق الذي تصور صدام حسين ذات يوم انه سوف يحمي نظامه، ويردع أعداء العراق ، لكن رهان الفانوس كان أقوي من رهان المدفع، هكذا انطلقت الرسالة من رام الله.
ربما تناقلت القنوات التليفزيونية المناسبة باعتبارها امراً فلكلورياً، وغاب عنها رسائله الحقيقية من تحد للمحتل، وتطلع لمستقبل تعود فيه الارض لاصحابها، وينتصب في كل ساحة فانوس عملاق يكون بمثابة منارة للسلام والعدل.
كل سنة وفلسطين عربية مقاومة رغم أنف الاحتلال.
صوموا عن الاقتراض
الخميس :
إذا تجاوزنا عن قسوة التشبيه، فإن ما فجرته صراحة النائب احمد السجيني يدعو بالبلدي إلي «النحررة» والغيرة علي اقتصاد مصر ومستقبل اجيالها.
«الاستدانات كثيرة، وكأننا في عصر الخديو اسماعيل» هكذا قال بالفم المليان نائب مهم يترأس احدي اللجان البرلمانية، قد يثير ذلك الغضب او الرفض او حتي الدهشة، لكن ماذا بعد؟
الجملة بقدر ما تضعنا في مناخ الصدمة، إلا انها لابد أن تدفعنا للتفكير الجدي في امتلاك تقييم موضوعي للعوامل التي قادت الي التوسع في الاقتراض، ثم التخطيط لتفعيل آليات للحد من اللجوء للقروض، والاعتماد علي الذات.
الانتاج، الحد من الواردات، زيادة الصادرات، استعادة دورنا علي خريطة السياحة العالمية والادخار.. وما أسهل كتابة الروشتة، إلا أن الصعب فعلاً ما يتعلق بكيفية تحويل الوصفات الجاهزة او السهلة او المعروفة للكافة إلي واقع.
وقبل ذلك كله لابد من اعادة النظر بسياسة الاقتراض، بدلاً من المباهاة بما تجلبه وزيرة التعاون الدولي من قروض، دون أن نسأل انفسنا عن قدرتنا علي استثمارها بما يعظم اقتصادنا الوطني.
وإذا وضعنا تحذير النائب السجيني إلي جوار تخفيض تصنيف مصر الائتماني مؤخراً، فإن آلاف الاجراس لابد أن تدق بقوة لعلنا نفيق من غفلة خطيرة العواقب، لأن الأمرين: التوسع في القروض وخفض التصنيف يصبان في ذات الخانة أي التأثير سلباً علي تدفق الاستثمارات، ليصبح البديل ادمان القروض، وهكذا ندور في حلقة جهنمية، تجعل استنكارنا لمبالغة تشبيه السجيني محل نظر!
كثير هي التوجهات التي تحتاج منا لاعادة تقييم سريع لتعديل المسار قبل فوات الأوان.
نصيحة أخيرة للحكومة علي هامش الشهر الفضيل:
صوموا عن الاقتراض.. أثابكم الله
ومضات
ليس كل من دخل المصيدة جرذاً، ربما كان أدني ذكاءً من كل الفئران!
الفارس الحقيقي لا يحتاج دائماً لامتطاء جواد.
بين الساسة من ينافس نجمات البورنو في لعبة الاستربيتز.
الغضب الساطع، والصمت المشرق.. هل يستويان أثراً؟
أجمل هدية تلك التي لا يسبقها طلب، ولا يعقبها امتنان.
هناك من يتحدث بضمير الغائب، ومن لا يكف عن الحديث بضمير غائب.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 حزب "المصريين" يكرم 200 طفل في مسابقة «معًا نصوم» بالبحر الأحمر
حزب "المصريين" يكرم 200 طفل في مسابقة «معًا نصوم» بالبحر الأحمر
 كل ما تريد معرفته عن رياح الخماسين التى تضرب البلاد الآن
كل ما تريد معرفته عن رياح الخماسين التى تضرب البلاد الآن
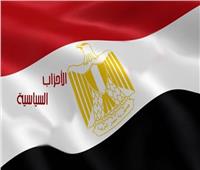 بندوات وتدريبات للمرآة والشباب.. عودة مكثفة للأحزاب بعد "رمضان و العيد"
بندوات وتدريبات للمرآة والشباب.. عودة مكثفة للأحزاب بعد "رمضان و العيد"
 تبدا غداً.. ضوابط وتحذيرات أثناء أداء الأمتحانات الأزهرية
تبدا غداً.. ضوابط وتحذيرات أثناء أداء الأمتحانات الأزهرية
 غدًا السبت انطلاق مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم بجنوب سيناء
غدًا السبت انطلاق مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم بجنوب سيناء
 عمرو القماطي: توجيهات الرئيس هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين
عمرو القماطي: توجيهات الرئيس هدفها تخفيف الأعباء عن المواطنين
 اختتام النسخة الثانية من مؤتمر دستور الأدوية الأمريكي
اختتام النسخة الثانية من مؤتمر دستور الأدوية الأمريكي
 بعد تطويره.. 10 معلومات عن مسجد الصحابة بشرم الشيخ
بعد تطويره.. 10 معلومات عن مسجد الصحابة بشرم الشيخ
 اللواء خالد فودة: جنوب سيناء ستستقبل مسابقة القرآن الكريم العالمية في يوليو القادم
اللواء خالد فودة: جنوب سيناء ستستقبل مسابقة القرآن الكريم العالمية في يوليو القادم




















