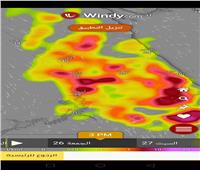إيهاب الحضرى
يوميات الأخبار
أصـوات الماضـى
الخميس، 19 نوفمبر 2020 - 08:21 م
كنتُ حديث العهد بمعرفة الموت، الذى خطف أحد أقربائنا، وقيل لى إنه صعد إلى السماء. الآن أصبح القتل مسلسلا لا ينتهى، وأصبحت علاقتى بالموت أكثر حميمية، ربما لأنه يقترب تدريجيا.
ثرثرة ليلية
الثلاثاء:
على غير العادة كان كورنيش النيل هادئا. مضتْ السيارة بانسيابية على طريق لم أعد أمر به كثيرا، لأنه لا يتقاطع مع نشاطاتى اليومية. أصدقائى غير المصريين يعتقدون أن القاهريين لابد أن يُلقوا التحية على النهر يوميا. يتخيّلون أن ذلك طقس معتاد لمن يعيشون على ضفاف هذا الساحر. قبلها عبرتُ ميدان التحرير المُبهج ليلا، واجتاحتنى ذكريات ثورة غيرت مسارات التاريخ. يعلو صوت فريد الأطرش من مذياع التاكسي: «وحياة عينيكي.. مشتاق إليكي.. عدّا عليا الهوى خد قلبى منى وراح.. وفات لى ما بين ضلوعى يا حبيبى جراح»، تحاصرنى نغمات الماضى بشجن بدأ يُسيطر عليّ، ربما بحكم التقدم فى السن. نخترق المبانى إلى حافة نهر لا يُمكننى أن أرى منه إلا لمحات عابرة. نصل إلى جاردن سيتي، ذلك الحى الأنيق الذى لا أزال أضل طريقى فيه، لأننى لا أستطيع استيعاب جغرافيته. يسأل السائق العجوز بعض الواقفين عن الموقع المُستهدف دون أن نحظى كالمعتاد بإجابة حاسمة. أخيرا وصلتُ لأكتشف عند انصرافى بعد انتهاء موعدى أن المسار سهل، لكن التائه يظل يدور فى حلقات مفرغة حتى يكتشف فى نهاية الطريق أن هدفه كان شديد القرب!
ذكرى الشرقاوى.. تجاهل لا يليق
قبلها بأيام تلقيتُ اتصالا من الإعلامى والكاتب الصحفى أحمد المسلماني. أخبرنى أن مركز الدراسات الذى أسّسه يُنظم ندوة، بمناسبة مئوية ميلاد المفكر الكبير عبد الرحمن الشرقاوي، وأضاف أن أبناء الراحل العظيم طلبوا استضافتى لأكون متحدثا أساسيا، سعدتُ بأنهم يتذكروننى بعد لقاء عابر فى إحدى ندوات معرض الكتاب قبل نحو ثلاثة أعوام، لكن سعادتى كانت أكبر لأن المسلمانى احتفى بالذكرى التى مرت وسط تجاهل لا يليق.
على غير العادة، حرصتُ على قراءة كلمة أعددتُها سلفا، رغم حبى للارتجال، غير أن خوفى من نسيان أحد جوانب تفرّده اضطرنى لذلك. تحدثتُ طويلا إلى أن شعرتُ أننى يجب أن أرحم الحضور من ثرثرتى، مع أن الحديث عن الشرقاوى يُمكن أن يستمر لأيام، فهو الروائى الشاعر المسرحى المفكر المؤرخ، صاحب الرؤى السابقة لعصره، الذى دعا لتجديد الفكر الديني، عبر تقديم قراءات مغايرة للتاريخ الإسلامي. الغريب أن تنوع اهتماماته لم يؤثر على عمله كصحفي، ليس ككاتب فقط، بل حتى فى مجال الإدارة، فقد تسلم مسئولية مؤسسة روز اليوسف ومجلتها الأساسية توزع بضعة آلاف، ليرتفع بتوزيعها إلى 165 ألف نسخة، وفى عز مجده انحاز للشعب، ووصفتْ «روزاليوسف» أحداث يناير 1977 بالانتفاضة الشعبية، مخالفة بذلك إصرار الرئيس السادات على أنها انتفاضة الحرامية. لم يعمد الشرقاوى إلى مواءمات تحفظ له منصبه وصداقته العميقة مع الرئيس الراحل، بل اختار ما انحاز إليه ضميره، ودفع الثمن بعزله من منصبه. وقتها قال له السادات إنه سيختار رئيسين لتحرير «روزاليوسف» و«صباح الخير»، يجعلانه لا يقرأ المجلتين ثانية!
فى نهاية الاحتفالية كانت فى انتظارى مفاجأة سعيدة، حيث فوجئت بالدكتورة داليا عبد المعطى حفيدة الشرقاوي، تؤكد لى أنها تتابع كتاباتى منذ كنتُ فى «أخبار الأدب»، التى كانت من المغرمين بها، لحبها الشديد للكاتب الكبير جمال الغيطاني. وقتها شعرتُ أن السماء تُرسل إلينا وقت الحاجة هدايا ترفع معنوياتنا، وحمدتُ الله على قارئة.. ربما كانت الوحيدة التى تتابعنى فى ذلك الزمن البعيد!
قهوة.. وسط البلد
الخميس:
من نافذة مكتبى يلوح وسط المدينة عن بُعد. بالتأكيد لا أرى تفاصيله المختفية وراء بنايات عالية، لكن ما لا تراه العين تستكمله الذاكرة. دائما تملك الأماكن قدرة على اجتذابي، وعادة ما أمزج تفاصيلها بتاريخ قديم، أو بقايا حنين لماض أكثر قربا. فى الحالتين تتفجر طاقة من الشجن تُضفى على الشوارع فتنة غير محدودة. أجد نفسى فجأة فى شارع 26 يوليو، الذى يحتفظ لدى أجيال أكبر باسمه القديم «فؤاد»، رغم تغييره قبل سنوات طويلة. أعمال حفر المترو أفقدتْه جانبا كبيرا من جمالياته، سيستردها بالتأكيد فى نهاية الأمر. أدخل ممرا بين العمارات الشاهقة قد لا ينتبه له العابرون، غير أن عُشّاق «وسط البلد» يعرفون ممراتها التى قد تبدو سرية لآخرين. أجلس بمقهى لم أرتده لسنوات، الوجوه تغيرت والطقوس لم تعد كما كانت. اختفت الشيشة بتأثير «كورونا»، وانخفض عدد لاعبى «الطاولة» مقارنة بلعبة «الدومينو»، أطلب فنجان قهوة فيأتينى فى كوب غير محدد الملامح، لا هو زجاجى ولا من الورق المُقوّى، أرتشف السائل السحرى وتصيبنى مرارته برعشة، تُعتبر سمة أساسية فى علاقتى بالبُن. أدمنه رغم عدم حبى له! توثّقت علاقتنا بعد إصابتى بمرض السكر. إنه المشروب الوحيد الذى يمتلك درجات للتحلية محددة بحسم. فى أيامى الأولى مع المرض كنتُ أشرب القهوة «سادة»، ثم تجرأتُ وزدتُ جرعة السكر تدريجيا حتى استقرت عند" المظبوطة". أشعر بعدم الرغبة فى استكمال الشرب، غياب الفنجان يسلبنى الجانب الأساسى من المتعة. أقرر الرحيل وقبل أن أنفذ قرارى أفيق على طرقات مجهولة المصدر. أفاجأ بأننى لا أزال خلف النافذة، وعامل البوفيه يحضر قهوة طلبتُها قبل دقائق. أعود لمكتبى وأرتشفها بشغف.. من كوب غير مُحدد الملامح!
أيام مع زاهى حواس
السبت:
تُثبت لى الأيام دوما أن حبى للدكتور زاهى حواس لم ينبع من فراغ. فى نهاية اليوم استحضر ذهنى العديد من الذكريات. إحداها كانت فى الأقصر ذات صيف. وجّه لى الدعوة لحضور فعالية أثرية، وهناك اقتربتُ منه لأطرح عليه سؤالا، فوجئتُ به يرد مُنفعلا، ويؤكد أنه لن يرد على استفسارى لأننى انتقدته فى إحدى مشاغباتى المتكررة. رددتُ بأدب «حاد» أننى سأظل أعبّر عن قناعاتى الشخصية، وسألتُه عن سبب دعوتى للمناسبة ما دام غاضبا لهذه الدرجة، لم يُفكر بل رد بسرعة، مؤكدا أنه لا يمنّ عليّ بهذه الدعوة، وأنها حق أصيل لي، باعتبارى من المتخصصين فى الكتابة عن الآثار. احترمتُ رده جدا لأننى قابلتُ قبله مسئولين آخرين يعتقدون أن الدعوة مكافأة على «حُسن السلوك»! لكن حماس الشباب جعلنى أعلق أنه ما دام مقتنعا بذلك، فمن حقى أن أسأل وأحصل على إجابة، لأن ذلك من أبجديات العلاقة بين الصحفى والمسئول. ثم ابتعدتُ اعتراضا على ما حدث، وبانفعال صبيانى قررتُ ألا أحدثه بقية «السفرية».
مساءً نزلتُ إلى حديقة الفندق حيث يجلس مع الصحفيين الزملاء، حييتهم ومضيتُ باتجاه الباب قاصدا التجول فى المدينة. نادانى عالم الآثار الكبير الراحل د. على رضوان، وطلب منى الجلوس فاعتذرتُ، لكنه صمم واستجبتُ فى النهاية، وبدأ يفكر فى تلطيف الأجواء، غير أنه لم يبذل جهدا كبيرا، حيث بدأ د.حواس يتحدث معى بلطف طالبا منى ألا أغضب. على الفور مرتْ المشكلة الطارئة كسحابة صيف، مثلما مضت قبلها وبعدها سحب كثيرة. كان العالم الكبير يغضب مني، لكنه يظل متأكدا أن كتاباتى لا تنبع من أهواء شخصية، بل تنطلق من وجهة نظر مغايرة.
صباح يوم آخر اتصل بى محتدا ليعترض على تقرير نشرتُه فى «أخبار الأدب»، فبشرتُه بأننى طلبتُ نقلى منها وأنه سيرتاح منى أخيرا، تبدّل صوته العاصف وسألني: «إنت بتهزر؟»، أكدتُ ما قلتُه فاعترض قائلاً إنه لا يُعقل أن أترك هذا المجال بعد أن أصبحتُ من بين قلائل يفهمون تفاصيله، واستمرتْ صداقتنا ومشاغباتى وغضبه العابر مني.
استحضرتُ كل ذلك وترحمتُ على زمن كان المسئول يدرك فيه قيمة الصحفي، ويعرف أن دعوة أى إعلامى لحضور حدث ما، ليس فضلا ممن يجلس على الكرسى لأنه المستفيد الأول من التغطية، ورغم علاقة حواس بوسائل الإعلام العالمية، إلا أنه كان يتعامل مع أصغر صحفى مصرى كأنه رئيس تحرير، طالما كان واثقا من احترامه لذاته ومهنيته.
جرائم قتل
الإثنين:
أطالع الصحف المختلفة. أتوقف طويلا عند صفحات الحوادث، منذ زمن طويل لم تعد القصص البوليسية تستهويني، لكن هذه الصفحات تمنحنى فرصة لتأمل التغيرات التى طرأتْ على المجتمع. تستوقفنى عدة جرائم قتل شهدها اليوم السابق. على رأسها السفاح الذى قتل أكثر من ضحية عبر سنوات ولم ينكشف سره إلا مؤخرا، قتل بدم بارد إحدى زوجاته وشقيقة زوجة أخرى وصديقه وعاملة لديه، ولعل المستقبل يكشف المزيد من جرائمه. يُقبل الكثير من القرّاء على قضيته بنهم، يتداولون أخبارها وسط أحاديث أخرى بعضها هزلي، دون أن يُدركوا أنهم يتحدثون عن جرائم واقعية وليس فيلم «أكشن». لم تعد حكايات الدم تثير سوى عبارات استنكار مصطنعة، يرددها البعض من باب الواجب لا أكثر. الغريب أن اليوم نفسه تضمن أكثر من خبر عن حوادث قتل أخرى، بما يشير إلى حالة عنف استثنائية يعيشها المجتمع المصرى.
أذكر أن أول جريمة قتل سمعتُ بها كانت فى طفولتي. ذات صباح ردد أصدقائى قصة امرأة قتلتْ زوجها فى أحد الشوارع البعيدة نسبيا، قضيتُ أياما بعدها عاجزا عن استيعاب الحادث. كنتُ حديث العهد بمعرفة الموت، الذى خطف أحد أقربائنا، وقيل لى إنه صعد إلى السماء. الآن أصبح القتل مسلسلا لا ينتهي، وأصبحت علاقتى بالموت أكثر حميمية، ربما لأنه يقترب تدريجيا.
عندما يصير القتل مُعتادا يصبح الأمر شديد الخطورة، ليس على مستوى الجريمة فقط، بل نظرا للطريقة التى نتلقى بها أخبارها، خاصة عندما نُحوّلها إلى مجرد حواديت شيقة نتسلى بها فى أوقات فراغنا!
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة













 عالم جائع.. ويشكو كثرة الطعام!
عالم جائع.. ويشكو كثرة الطعام!
 عزف على أوتار الفقد
عزف على أوتار الفقد
 نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
 «لست ملاكاً»
«لست ملاكاً»
 وكاد بطل الملاكمة يصفعنى فى الطابور!
وكاد بطل الملاكمة يصفعنى فى الطابور!
 وجها لوجه مع مصطفى أمين
وجها لوجه مع مصطفى أمين
 مكالمة «نص الليل» مع الشهيد أبو عمار
مكالمة «نص الليل» مع الشهيد أبو عمار
 فى الموت والحياة.. عظة
فى الموت والحياة.. عظة
 أنا أقاوم.. إذاً أنا موجود
أنا أقاوم.. إذاً أنا موجود