
بقلم: د.أسامة السعيد
«فقهاء الحيل».. الفاعل «المعلوم» فى صناعة الإرهاب!!
الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 12:41 م
تروى كتب التاريخ ان أحد «الخلفاء» أراد التهرب من دفع زكاة ماله، وكان عظيم الثروة، لكنه يبخل بحق الفقراء الذى شرعه الله فى أمواله، ولأنه «خليفة» فلا يمكن له تحقيق ذلك إلا بالاستناد إلى سند شرعي، ودليل فقهى يحصنه ضد أى محاولة لاستغلال الموقف من جانب معارضيه.
لم يبذل الخليفة جهدا كبيرا فى العثور على من يعينه على جريمته «الشرعية»، ووجد ضالته فى أحد «فقهاء» زمانه، فلم يجد الأخير مشقة فى إيجاد الحل، فأشار على «الخليفة» بأن يتنازل عن ثروته كلها لواحدة يأتمنها من زوجاته، وقبل أن يحول الحول، تعيد تلك الزوجة الثروة إلى الخليفة، وهكذا دواليك، فلا يحول الحول على المال مطلقا، ولا تستحق عليه زكاة!!
بالتأكيد فرح «الخليفة» بتلك الحيلة «الشرعية»، وسارع إلى تنفيذها، وبالتأكيد نال «الفقيه» عطاءً موفورا لا يتناسب بأى حال من الأحوال مع مقدار الزكاة الذى كان مفترضا أن يستحق على تلك الثروة ويذهب إلى أيدى وأفواه الفقراء والمساكين، فإذا به يستقر فى بطن أحد فقهاء الحيل!
وهكذا ظهرت مدرسة تفننت فى التلاعب بـ»شرع الله»، وتطويعه لمصالحها الخاصة، والتكسب بالأحكام والفتاوى، وبما يتناسب مع رغبات من يقدر اجتهاداتهم حق قدرها (!!)، وقد عرفت كتب التاريخ تلك المدرسة باسم «فقه الحيل».
اليوم يعيد بعض من يصفون أنفسهم بـ»الدعاة» إنتاج وتقديم «فقه الحيل» بصورة جديدة تتناسب ومجريات العصر، وتتلون وفق متغيرات الزمن، ولعل الشهادة التى قدمها أحد أبرز هؤلاء «الدعاة» مؤخرا أمام إحدى المحاكم التى تنظر قضية متهم فيها مجموعة من الشباب بتأسيس تنظيم إرهابى يندرج تحت المظلة الفكرية لتنظيم «داعش» تمثل نموذجا وحالة تستوجب الفحص والدرس والتأمل، فالأمر يتجاوز فى رمزيته ودلالاته مجرد شهادة لرجل أو «شيخ» أو «داعية» – كما وصف نفسه- أمام القضاء، لكنها تستحق أن تكون نموذجا يستوجب التشريح والفهم، وصولا إلى إدراك أحد أبرز الأعمدة الفكرية التى تقوم عليها المنظومة الفكرية لتلك الجماعات المتأسلمة.
«الكذب الحلال»!!

«عن صفوان بن سليم قال: قيل يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا.» صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم».
رغم وضوح ذلك الحديث، ونفى الرسول الكريم صفة الكذب عن المؤمن، إلا أن هناك من يمارسونه بشكل فاضح، محاولين تقديمه على أنه «كذب حلال»، من خلال انتحال الأدلة والحيل لتمييع ذلك «الكذب» وإظهاره مخففا عبر «اللف والدوران» للإفلات من المسئولية، وتبرير التناقضات بين الفكر والعمل، وبين الخطاب والسلوك.
ولعل ذلك التناقض والمراوغة والازدواجية باتت أحد أبرز سمات الخطاب الذى تتبناه القوة المتأسلمة فى عصرنا الراهن، وهناك مئات بل آلاف الشواهد والوقائع التى يمكن تقديمها فى هذا الصدد، لكن نكتفى هنا بالحديث عن قضية جوهرية تفضح بكل جلاء ذلك الفكر الملتوى والإزدواجية المقيت لجماعات التأسلم السياسي، والدور الشيطانى الذى تلعبه فى تليل آلاف الشباب من أتباعهم وأنصارهم بخطاب يدفعهم إلى تدمير الأنفس والأوطان، وعند ساعة الحقيقة «يتبرأ الذين أتُبعوا من الذين اتَبعوا»، ويتنصل أولئك «الدعاة» من كل الأفكار المفخخة التى زرعوها فى العقول الضيقة لهؤلاء الشباب، الذى يجد نفسه وحيدا فى مواجهة المصير المحتوم، ليندم بعد فوات أوان الندم.
لم تكن تلك الشهادة التى قدمها «الداعية» السلفى مجرد كلمات ألقى بها ليبرئ ساحته من أية مسئولية عن الضلال الفكرى لجماعة «داعش إمبابة» بل كانت، وبلا أدنى مبالغة- وثيقة إدانة جديدة بالصوت والصورة وموثقة فى أوراق رسمية على سقوط جديد لهذا الفكر وتلك الممارسات التى تتبناها جماعات «التأسلم» التى تصف نفسها بالسلفية، وعند ساعة الجد تتبرأ حتى من هويتها وسلفيتها!!
وقد قدمت التيارات المتأسلمة على مدى تاريخها العديد من صور ذلك الأداء التمثيلى (المتقن أحيانا، والمضحك غالبا)، فعندما تم القبض على بعض عناصر جماعة «الإخوان» المتورطين فى اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى فى 28 ديسمبر 1948 بعد قراره بحل جماعة «الإخوان»، وكان أحد المتورطين من المقربين من حسن البنا مؤسس الجماعة، لم يتورع الأخير عن ممارسة واحدة من أكثر وقائع الكذب والتدليس شهرة فى صفحات التاريخ، وأصدر البنا بيانا استنكر فيه الحادث و»تبرأ» من الجريمة ومن مرتكبيها مدعيا عدم معرفته مطلقا بهم، وجاء البيان تحت عنوان «ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين» فى محاولة فاشلة لغسل سمعة الجماعة.
وتكرر الموقف بصور متعددة على مدار تاريخ تلك الجماعة الإرهابية، وربما لا يزال موقف إبراهيم منير القيادى بالتنظيم الدولى للإخوان حاضرا بالذاكرة عندما تبرأ قبل عامين من شباب الجماعة الموجودين فى السجون على ذمة قضايا عنف وإرهاب، أو الفارين للخارج، وقال منير ردا على مبادرة شباب الجماعة التى طالبوا الحكومة المصرية بالعفو عنهم مقابل دفع مبالغ مالية واعتزال العمل العام الدعوى والسياسي: «إن الجماعة لم تطلب منهم الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم فى السجون، ومن أراد أن يتبرأ فليفعل».
ذهنية الإنكار والخداع
ويبدو أن ذهنية الإنكار والخداع والمناورة هى واحدة من المرتكزات الفكرية التى يستند إليها المتأسلمون، حتى لو حاولوا إقناعنا بأن ثمة اختلافات فكرية، أو خلافات سياسية وتنظيمية بينهم، فالأساس واحد ولو تنوعت الصور وتعددت أساليب الخطاب.
يبرر قادة جماعات التأسلم السياسى أكاذيبهم بأسانيد شتى، فهناك من يتذرع بمبدأ «التقية»، وآخرون يستخدمون حديث «إن فى المعاريض لمندوحة عن الكذب»، بينما فريق ثالث يميل إلى استخدام أسلوب إدعاء الجهل وعدم المعرفة سبيلا للإفلات من المسئولية.
والمتأمل لتاريخ وفكر وخطاب تلك الجماعات يمكنه بسهولة أن يلمس حجم الكذب والتدليس الذى تمارسه، ويكفى هنا أن نشير إلى واحدة من أكبر الأكاذيب والأساطير التى أسست تلك الجماعات وجودها السياسى بناء عليها، وهى تلك الإزدواجية بين تحريم العمل السياسى فى وقت وفى العديد من الأدبيات التى تعلمها تلك الجماعات لأتباعها، وبين إباحة ذلك العمل السياسى والحزبى فى أوقات أخرى.
والثابت فى أدبيات جماعات التأسلم السياسي، وبخاصة السلفية منها أن العمل السياسى والحزبى «حرام قطعا فى الإسلام»، بل إن أحد أبرز منظرى الحركة السلفية وهو محمد ناصر الدين الألبانى يرى أن «الذين يشتغلون بالسياسة قد تكون عقائدهم خرابا يبابا، وقد يكون سلوكهم من الناحية الإسلامية بعيدا عن الشريعة الإسلامية».
بل ترى السلفية السياسة وفق المفهوم المعاصر «بدعة تقوم على مبادئ كفرية قوامها المراوغة والنفاق والغش»، ولذلك يرفض السلفيون تصنيفهم على أنهم حركة سياسية، وبذلك وقع الخطاب السلفى عموما فى مأزق التناقض، بين تأكيده أن السياسة جزء لا يتجزأ من الإسلام، ورفضه – فى المقابل- خوض غمار العمل السياسى وتوجيه الانقتادات الحادة للإسلاميين الذين ينخرطون فى العمل الحزبي.
وطبعا هذا التناقض تحول إلى أزمة حقيقية عندما قرر السلفيون – بعد 2011- دخول معترك السياسة، وتأسيس الأحزاب، وبقدر الرفض السلفى للحياة الحزبية، بقدر ما جاء الاندفاع والشهوة الطاغية لتأسيس أحزاب، حيث أسست التيارات السلفية بمختلف توجهاتها وتياراتها الفكرية والتنظيمية بعد يناير 2011 عددا من الأحزاب، وصلت إلى 11 حزبا منها: النور،الوطن، الراية، التوحيد العربي، الفضيلة، مصر البناء، الاتحاد من أجل الحرية، مصر الحرة، الإصلاح والنهضة، الأصالة، الشعب.
وكما أقنعوا الآلاف من أتباعهم بأن السياسة حرام، وأن «الديمقراطية كُفر ونظام مستورد يناقض الشريعة»، بل إن تلك الديمقراطية بحسب وصف الألبانى «نظام طاغوت وقد أمرنا بالكفر بالطاغوت، وأن الديمقراطية والإسلام نقيضان لا يجتمعان أبدا»، تحول أئمة الحركة السلفية (الدعوة السلفية على وجه التحديد أكبر تلك الحركات) فى يوم وليلة إلى إقناع أتباعهم بأن الأحزاب ليست حراما، وأن الديمقراطية ليست كفرا، وأن الانتخابات ليست «رجس من عمل الشيطان»، وشاركوا بكثافة فى المجالس النيابية التى كانوا يصفونها بأنها «مجالس طاغوتية لا يجوز الاعتراف بها، لأنها تحارب شرع الله وتحتكم إلى الأكثرية، وهى طريقة غربية من صنع اليهود والنصارى الذين لا يجوز شرعا التشبه بهم»!!
المدهش أن قادة تلك التيارات المتأسلمة لا تعدم الحيلة، ولا تفرغ أسانيدها لإثبات الشيء ونقيضه، فهى تحرم السياسة بنفس الحماس الذى تدافع به لاحقا عنها، وتكفّر الديمقراطية بنفس الثقة والثبات الذى تدعو به أنصارها للمشاركة فى العملية الديمقراطية، وبالطبع المبرر الحاضر والذريعة الجاهزة دائما هى تحول الواقع وتغير الظروف، وكأن ما يقدمونه تارة بوصفه من ثوابت الدين، يصير بكل سهولة تابعا ومطية لتحولات الظروف وتبدلات المصالح، والحقيقة أن ذلك الأمر قد يصلح مع براجماتية السياسة، لكنه أبعد ما يكون عن ثبات ونقاء الدين، لكن المتأسلمين لا يفقهون!
أفكار أخطر من الرصاص
إن الجماعات الإرهابية، التى ينكر بعض شيوخ السلفية معرفتهم بها أو بعناصرها، لم تخرج سوى من بين جحور الأفكار المظلمة التى يروجها بعض هؤلاء، فالأفكار أخطر من الرصاص، وعندما تربى طفلا أو شابا على كراهية وطنه، والحقد على مؤسسات دولته، وتزرع بداخله كراهية جاره فى الشارع لأنه يخالفه الدين، ورفض التعامل مع زميله فى الصف لأنه يخالفه الفكر، وتشرع له استخدام العنف بدعوى التغيير، وتبرر له القتل بزعم الجهاد، وتمهد له طريق الجريمة بوهم الوصول إلى الجنة، فإنك هنا تخلق وحشا، لا تبنى إنسانا.
وللأسف عندما يأتى وقت المحاسبة يقف هؤلاء المخدوعون الصغار فى المواجهة، بينما يتوارى المجرمون الكبار خلف اللحى العريضة، والكلمات الملتوية، والردود الغامضة، متصورين أنهم بذلك نجوا بعد جريمتهم، وأفلتوا بفعلتهم، لكن الله المطلع يعلم أن كل يد حملت السلاح ضد الدولة، أو هددت الآمنين فى أى مكان كان وراءها عقل تم إفساده بأفكار الاستعلاء والتمييز وحشوه بالفتاوى الضالة المضللة التى تهيئ له سبيل الغلو والتطرف، وتصور له أنه مبعوث العناية الإلهية لاجتثاث كل من يختلف معه فى الرأى أو المذهب أو الدين.
الأفكار التى يبثها هؤلاء فى العقول عبر خطبهم وقنواتهم وأشرطتهم وصفحاتهم ويحشون بها عقول شباب من أنصاف المتعلمين وأرباع المثقفين، أخطر ألف مرة من الرصاص الذى يحشو به أولئك المخدوعون أسلحتهم ليخرجوا بعد ذلك على الناس كقطاع الطرق، يهددون أمنهم ويستبيحون دماءهم وأعراضهم بدعوى الجهاد والإصلاح!!
لو كان لشباب الإخوان والسلفيين عقول، لأدركوا أنهم ليسوا سوى ورقة فى لعبة أكبر استخدمهم فيها قادتهم، ولم يتورعوا عن التضحية بهم وخذلانهم ساعة الجد.
لو تأمل أولئك المخدوعون ما يجرى اليوم من حولهم، لأدركوا أنهم لم يكونوا سوى قطعة شطرنج صغيرة وبلا قيمة تحركها أياد لا تعرف سوى التلاعب بمصائر الناس ومقدرات الشعوب، وأنهم استُخدموا فى معركة لا علاقة لها بالدين أو الحق، بل بالسلطة والثروة.
لو تفكر أولئك الضالون فى مواقف من ضللهم وأعمى أبصارهم وقادهم إلى حتفهم، وتدبروا فى تناقضاتهم وتحولاتهم، ومنحوا عقولهم لحظات معدودة للتفكير الحر بعيدا عن سحر الكلمات المنمقة والأحاديث المدبجة، لأدركوا فى أى هاوية ألقى بهم، وأى جحيم إنساقوا إليه؟!
ولو أردنا – نحن شعبا ودولة – أن نواجه الإرهاب ونقضى عليه حقا، فلا ينبغى الاكتفاء بقطع اليد التى تحمل السلاح، أو الأصابع التى تضغط على الزناد، فطالما بقيت تلك «المفرخة» الفكرية قائمة تعيث فى الأرض فسادا، وتعبث بالوعى وتزيف الحقائق، فإن الخطر سيبقى قائما، ودروس التاريخ والواقع أبلغ دليل
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الرئيس يتناول الأوضاع في غزة خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر
الرئيس يتناول الأوضاع في غزة خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر
 ننشر تفاصيل لقاء وزير النقل برئيس الوكالة الفرنسية للتنمية
ننشر تفاصيل لقاء وزير النقل برئيس الوكالة الفرنسية للتنمية
 وزير الصحة يبحث مع شركة «أبوت» نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي للسوق المصري
وزير الصحة يبحث مع شركة «أبوت» نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي للسوق المصري
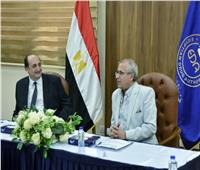 هيئة الدواء المصرية تستقبل ممثلي جمعية المعلومات الدوائية الدولية
هيئة الدواء المصرية تستقبل ممثلي جمعية المعلومات الدوائية الدولية
 الأرصاد الجوية: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا و معتدل ليلًا
الأرصاد الجوية: غدا طقس مائل للحرارة نهارًا و معتدل ليلًا
 التفاصيل الكاملة لجلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي وأمير الكويت
التفاصيل الكاملة لجلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي وأمير الكويت
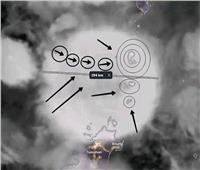 هل تتأثر مصر بالتبريد العالمى الناتج عن بركان روانج.. الأرصاد تجيب
هل تتأثر مصر بالتبريد العالمى الناتج عن بركان روانج.. الأرصاد تجيب
 ارتفاع فى الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس حتى الأحد القادم
ارتفاع فى الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس حتى الأحد القادم
 السكة الحديد: تطوير ورفع كفاءة 6 قطارات إسبانية.. والصعيد الأوفر حظا |خاص
السكة الحديد: تطوير ورفع كفاءة 6 قطارات إسبانية.. والصعيد الأوفر حظا |خاص






















