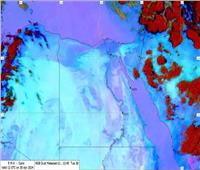أقلام عربية ترسم ملامح الغرب
البداية «تبريز» والذروة «عصفور»
أقلام عربية ترسم ملامح الغرب
الأحد، 22 أغسطس 2021 - 11:54 ص
حسن حافظ
العلاقة بين الغرب والشرق قديمة، ورغم كثرة المحطات التى التقت فيها حضارة أوروبا الغربية بحضارة الشرق العربي، فإن أكثر المحطات التى حظيت بالتسجيل والرواية والنقد والاهتمام، هى الفترة الحديثة، عندما أصبح سؤال الهوية حاضرا وما يمكن نقله من أوروبا من عوامل التقدم والنهضة مهيمناً، فى القرنين الأخيرين، لكن اللافت أن الأدباء وأهل القلم هم من سجلوا هذه التجربة، الصدمة الحضارية والتلاقى بالغرب فى بلاده، وتركوا على مدار مائتى عام تراثا وقارة كاملة فى الأدب العربى باتت تقوم على فكرة النظر للغرب بعيون أدبية، بداية من كتابات رفاعة رافع الطهطاوي، مرورا بالعمل الاستثنائى "عصفور من الشرق" لتوفيق الحكيم، وليس نهاية برواية "عناق عند جسر بروكلين" لعز الدين شكرى فشير.
بداية من شيوخ معممين خرجوا من الجامع الأزهر، مرروا بطلاب علم أبناء المدارس والجامعات، تعددت النظرة للغرب، بين من ذهب لبلاد الإفرنج فعاش بين أبناء أوروبا، ولمس تقدمها وشعر بمدى تأخر بلاده، ومن ذهب وغرضه التعلم ونقل قبسٍ من شعلة العلم الموقدة فى معاقل الدرس فى أوروبا إلى بلاد الشرق العربي، كان البعض يذهب ولديه أسئلته من نوعية لماذا تأخر العرب وتقدم غيرهم؟ ما سر التقدم الأوروبي؟ وهل لديهم عقل زائد أم إنهم بشر مثلنا وأن مسألة التقدم تتعلق بالعلم والأخذ بأسبابه؟ كيف عاشت المجتمعات العربية قرونا فى وهم القوة والتقدم ليستيقظوا على دوى مدافع الاستعمار الأوروبى يخبرهم بأن الزمن قد تغير؟ مثل هذه الأسئلة دارت فى ذهن المثقفين المصريين والعرب الذين ذهبوا لأوروبا على مدار القرنين، بداية من رفاعة الطهطاوى وابن أبى الضياف التونسى وأحمد فارس الشدياق، ثم محمد عبده وطه حسين وتوفيق الحكيم وغيرهم الكثير من الكتاب والمثقفين الذين زاروا الغرب، وأعادوا تصويره فى رحلات وروايات.
البداية كانت مع ابن الجامع الأزهر، رفاعة الطهطاوي، الذى شارك ضمن بعثة أرسلها محمد على باشا إلى فرنسا عام 1824، بهدف دراسة العلوم الأوروبية الحديثة، كان الطهطاوى لا يتجاوز 25 عاما، وجاء سفره بناء على ترشيح من أستاذه الشهير حسن العطار، والذى لمس مع صديقه عبدالرحمن الجبرتى مدى التقدم التقنى الذى بات عليه الغرب بعدما عاشا أحداث الغزو الفرنسى واحتلال مصر لمدة ثلاث سنوات، لذا أرسل العطار تلميذه الطهطاوى ليرى سر التقدم الأوروبي، ونفذ التلميذ المهمة، وعاد لمصر وهو مقتنع بضرورة استلهام النقل المعرفى من فرنسا والغرب، وقد وضع خلاصة رحلته فى كتابه الشهير "تخليص الإبريز فى تلخيص باريز" الذى نشر عام 1834، ليدشن بذلك دون أن يدرى لنوع فريد فى الأدب العربى الحديث، وهو رصد الغرب بأقلام عربية.
فتح الطهطاوى الباب أمام الجميع للكتابة فى العربية عن الغرب الحديث بعد قرون من الانقطاع الحضاري، فنشر التونسى ابن أبى الضياف كتابه الشهير "إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وملوك أهل الأمان"، والذى خصص الجزء الأخير منه لرحلته إلى فرنسا، ونشره عام 1846، بعدها نشر اللبنانى سليم بطرس البستانى رحلته "النزهة الشهية فى الرحلة السليمية"، وتتميز هذه الرحلة بأن صاحبها جاب معظم دول أوروبا الغربية وسجل انطباعاته عنها، ونشرها عام 1856، كما نشر أحمد فارس الشدياق كتابه "كشف المخبا عن فنون أوربا" عام 1867، وفيه يقارن بين فرنسا وإنجلترا والفرق بين المجتمعين، لتتوالى بعدها كتب الرحلات أمثال: "أقوم المسالك فى معرفة أحوال الممالك" لخير الدين التونسى 1867، والذى يتناول فيها أحوال معظم الدول الأوروبية، ورحلة نخلة صالح "الكنز المخبا للسياحة فى أوربا" 1867، وكتب على مبارك "رحلة الشيخ علم الدين" 1882، ومحمد شريف سالم "رحلة أوربا" 1888م، وحسن توفيق "رسائل البشرى فى السياحة بألمانيا وسويسرا" 1891، ومحمد السنوسى وكتابه "الاستطلاعات الباريسية" 1891، ثم ألف أمين فكرى كتابه "إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا" 1892، وفى عام 1900 صدرت كتب: "سياحة مصرى فى أوربا" لعلى أبو الفتوح، و"الدنيا فى باريس" لأحمد زكي، ومحمد بلخوجة "سلوك الإبريز فى مسالك باريز".
ويفسر الدكتور جابر عصفور هذه الظاهرة، تحت عنوان "الرحلة إلى الآخر فى القرن التاسع عشر" ضمن كتاب "الغرب بعيون عربية"، قائلاً إن "الرحلة إلى أوربا أصبحت هاجسا ملحا على الطليعة المثقفة التى تهوست بمعرفة مصدر التقدم وأسراره فى بلاده، وذلك على النحو الذى جعل من النموذج الأوربى النموذج المسيطر على الوعى بوصفه النموذج الواجب احتذاؤه، والإشارة إليه بوصفه الإطار المرجعى فى التقدم"، لافتا إلى أن "الذين تحمسوا إلى أوربا كانوا من العقلانيين بمعنى أو آخر. أقصد إلى أنهم كانوا تلاميذ للتيارات العقلانية التى تبدأ من فلاسفة الإسلام ولا تنتهى عند المعتزلة... ولا شك أن مثل هذه التأويلات العقلانية، فضلا عن غيرها من المأثورات المنقولة التى تحث المسلم على طلب العلم ولو فى الصين، كانت تزيد من رغبة المعرفة، وتبعثها على التحقق، وتؤسس دوافعها على أسس مقنعة لأصحابها أولا، ويمكن استخدامها بوصفها حججا دامغة فى مواجهة الجامدين من أهل النقل الذين ناصبوا الانفتاح على الآخر العداء... وليس مصادفة أن يكون حسن العطار أستاذ رفاعة الطهطاوى منتسبا إلى أهل العقل من مستنيرى المشايخ". ليؤكد عصفور على ملمح مميز للكتابة عن الغرب هو التركيز على فرنسا بسبب هيمنة الثقافة الفرنسية طوال القرن التاسع عشر.
مع دخول القرن العشرين، بدأت الرواية تفرض نفسها شيئا فشيئا على المشهد الثقافى العام، فأصبحت "ديوان العرب" الحديث، ودفتر أحوالهم، لذا لم يكن غريبا أن يصبح الحديث عن الغرب واكتشاف الحضارة الأوروبية، والبحث عن تفاصيل العلاقة بين الشرق والغرب، والبحث عن أسئلة النهضة والخروج من حالة التأخر والتخلف، ما جعل الكتب التى تعبر عن هذه الحالة تنتقل من خانة كتب الرحلة التى تسجل الانطباعات والمشاهدات إلى كتب الرواية التى تعيد نسج التجربة فى إطار عمل فنى قائم على المزج بين الخيال والواقع، بين التجربة الشخصية وأسئلة الشأن العام، فظهرت الرواية الحضارية أو رواية المواجهة، التى تدور حول بحث الكاتب لهويته وهوية مجتمعه فى زمن الاستعمار، والعوامل التى تجعل من الآخر مختلفا عن الكاتب ومجتمعه، والصدام الحضارى بين قيم الشرق والغرب، ووصلت الرواية الحضارية لإحدى قممها بعمل ساحر آسر خرج من تحت يد شاب أرسلته أسرته الغنية لفرنسا لدراسة القانون لكن مدينة النور سحرته، فهام فى مسارحها ومتاحفها ينهل من معينها الحضاري، يعرف الحب ويعانق الجمال فى شوارع باريس، كان هذا الفتى هو توفيق الحكيم، الذى أودع خلاصة تجربته فى روايته البديعة "عصفور من الشرق" 1938، عبر قصة حب بين البطل المصرى وفتاة فرنسية، ليبدو حوار الشرق والغرب حاضرا وبقوة فى هذه العلاقة، التى يخلص من خلالها الحكيم إلى أن علمية الغرب تحتاج لروحانية الشرق لتظل الإنسانية محافظة على وجودها.
افتتح الحكيم بابا عظيما فى الرواية المصرية العربية بروايته "عصفور من الشرق"، فبدأت تظهر الروايات تباعا التى تتحدث فى نفس الموضوع مع تنويع على الحبكة الروائية، فبات لهذه الفكرة حضورها القوى فى الأدب العربي، خصوصاً عند هؤلاء الذين عاشوا فترة فى بلاد الغرب ثم عادوا لبلاد العرب، فكان سؤالهم الشاغل عن العلاقة بين الغرب والشرق حاضرا فى إنتاجهم الروائي، وهو ما ظهر بوضوح فى رواية "أديب 1939، لعميد الأدب العربى طه حسين، التى انتصر فيها لفكرة أن الغرب غرب والشرق شرق ولن يلتقيا، وقدم يحيى حقى رائعته الروائية "قنديل أم هاشم" 1940، التى تحكى قصة الصراع بين العلم الذى يمثله طالب الطب العائد من أوروبا والجهل المنتشر فى الحى الشعبي، لينتهى المؤلف إلى ضرورة التزاوج بين العلم وأدواته والروح وعوالمها، كذلك قدم الروائى اللبنانى سهيل إدريس روايته "الحى اللاتيني" 1953، التى تدور حول سؤال المواجهة الحضارية بين الغرب والشرق.
ومضى على نفس خط الحكيم، الأديب السودانى الطيب صالح بروايته "موسم الهجرة إلى الشمال" 1966، إذ يقدم رحلة الشاب العربى الجنوبى إلى بلاد الغرب فى الشمال، عبر البطل السودانى الذى يذهب ليدرس فى لندن، ليعكس عبر التلاقى بين العالمين حيوية هائلة، ويرجع الناقد الكبير رجاء النقاش هذه الحيوية فى دراسته المهمة عن الرواية والتى نشرها فى كتاب "الطيب صالح عبقرى الرواية العربية"، إلى أن "مشكلة الشرق والغرب كما ظهرت فى الروايات السابقة لا ترتبط بتجربة مريرة مثل تلك التى يعبر عنها الطيب صالح، ذلك أن الشرقى عند هذا الفنان الشاب هو شرقى أفريقى (أسود اللون)، ومشكلة البشرة السوداء هذه تعطى للتجربة الإنسانية عمقا وعنفا، بل وتمزجها بنوع خاص من المرارة.
أما بهاء طاهر فقدم العلاقة بين الشرق والغرب فى أكثر من عمل روائي، أبرزها المجموعة القصصية "بالأمس حلمت بك" 1984، ورواية "الحب فى المنفى" 1995، وكتب صنع الله إبراهيم رواية "أمريكانلي" 2003، والتى يشرح فيها المجتمع الأمريكى وعلاقته بالعرب، كما قدم علاء الأسوانى رواية "شيكاجو" 2007، وهى تدور فى أمريكا أيضا، بما يكشف عن انتقال الثقل الحضارى إلى غرب المحيط الأطلنطى من أوروبا إلى أمريكا، وكيف أصبحت علاقة العرب بها هى الأهم والأقوى، وهو ما تأكد فى رواية "عناق عند جسر بروكلين" 2011، لعز الدين شكرى فشير، والتى تدور أحداثها فى مدينة نيويورك الأمريكية، وهو ما يكشف عن أن الرواية الحضارية أو رواية المواجهة مع الآخر لا تزال قادرة على متابعة المستجدات والمتغيرات الحضارية التى تمر بها المجتمعات العربية فى رحلة اكتشافها للذات والآخر.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 اقرأ في «آخر ساعة»: موسم اللؤلؤ الأصفر
اقرأ في «آخر ساعة»: موسم اللؤلؤ الأصفر
 اقرأ في «آخر ساعة»: 3 قمم تُمهد للنظام العالمي الجديد
اقرأ في «آخر ساعة»: 3 قمم تُمهد للنظام العالمي الجديد
 مؤتمر علمي لتأهيل طلبة الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة
مؤتمر علمي لتأهيل طلبة الصيدلة بإحدى الجامعات الخاصة
 اقرأ في «آخر ساعة»: مصر تحصد الخير
اقرأ في «آخر ساعة»: مصر تحصد الخير
 اقرأ في «آخر ساعة»: ادخلوها بسلام آمنين
اقرأ في «آخر ساعة»: ادخلوها بسلام آمنين
 اقرأ في «آخر ساعة»: حفظ الله أهلنا في السودان
اقرأ في «آخر ساعة»: حفظ الله أهلنا في السودان
 اقرأ في «آخر ساعة»: «دهب الغيطان».. فرحان
اقرأ في «آخر ساعة»: «دهب الغيطان».. فرحان
 اقرأ في «آخر ساعة»: «قيامة» مجيدة ..و«فطر» سعيد
اقرأ في «آخر ساعة»: «قيامة» مجيدة ..و«فطر» سعيد
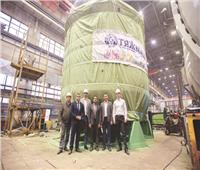 بعد وصول «مصيدة قلب المفاعل».. مصر تبدأ تحقيق «الحلم النووي»
بعد وصول «مصيدة قلب المفاعل».. مصر تبدأ تحقيق «الحلم النووي»