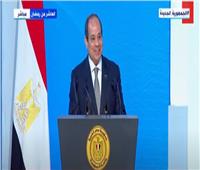إيهاب الحضري
إيهاب الحضري يكتب: «اللى اختشى.. ما ماتش»!
الخميس، 20 أكتوبر 2022 - 05:08 م
هناك من فرّ من منزله بملابسه الداخلية، وآخرون «اختشوا» وفضّلوا انتظار الموت فى بيوتهم، على أن يخرجوا دون ارتداء ملابسهم.
ذكريات الزلزال ليست إفلاسا
السبت:
استفزنى منشور على «فيس بوك»، اعتبرت صاحبته أن استحضار ذكريات زلزال 1992 نوع من الإفلاس. لا أستسلم عادة لمشاعر الاستفزاز، لأننى مُقتنع بأن حرية التعبير حق مكفول للجميع، بشرط التحلّى بالمنطق، لكننى هذه المرة شعرتُ بالضيق، لأن الحديث عن الزلزال لم يكُن من قبيل إعادة تدوير قصة تافهة، أو فرصة لضخ ثرثرة أصبحنا نُدمنها.
لم تشهد بلادنا هذه النوعية من مشاغبات الطبيعة، ولم يعرف مٌعظمنا قبلها من الزلازل إلا هزّات مُتقطعة، أثارت القلق دون أن تُفجّر الفزع، بل أنها أوحت لشاعر غنائى أن يكتب متغزّلا فى حبيبته: «ما تبطل تمشى بحنيّة ليقوم زلزال». كان ربط الرقّة بالزلازل مبرّرا فى ذلك الزمن البعيد، لأنها مجرّد مداعبات خفيفة، مقارنة بما حدث قبل ثلاثين عاما.
كنتُ أغسل وجهى مُستعدا للخروج. فجأة تمرّدت المياه على انسيابها المُنتظم وأخذتْ تتراقص، وشعرتُ بالأرض تتحرك تحت قدميّ. تعالت الصرخات من شُقق أخرى بالعمارة، فأيقنتُ أنها تنهار. بعد لحظات عرفتُ أنه زلزال! وقتها عاشتْ مصر سلسلة ردود فعل عجيبة، هناك من فرّ من منزله بملابسه الداخلية، وآخرون «اختشوا» وفضّلوا انتظار الموت فى بيوتهم على أن يخرجوا دون ارتداء ملابسهم، ولحُسن الحظ جنّبهم القدر النهاية التى خلّدها المثل الشهير: «اللى اختشوا ماتوا». من بين الفارين من اصطحبوا بسرعة حقائب عرفْنا أنها تضم تحويشة العُمر أو وثائق ملكية مُهمة، فأصبحتْ أسرارهم مكشوفة أمام الجيران. الحكايات كثيرة تفوق الحصر، لكنها أصبحت ذكريات يتم استحضارها سنويا، فما بالنا والرقم هذا العام أصبح ذا دلالة. ثلاثون عاما رقم مفصلي، ومن كانت سنّه عشرة أعوام وقتها، دخل فى النصف الثانى من حياته، والباقى من العُمر أقل مما مضى.
فى الليلة نفسها حاولتُ مع أصدقائى التغلّب على الفزع، إنه عيد ميلاد رفيق لنا، تجمّعنا فى منزله، وأحضرنا «التورتة» وتبادلنا المداعبات، معظمها عن اليوم الأسود الذى وُلد فيه ثم أصبح أيقونة للرُعب، لم تنجح ردوده فى وقف تعليقاتنا الساخرة، علتْ ضحكاتنا حتى دخل والده رحمه الله، ووبّخنا بحدة غير مُعتادة منه. تحدّث عمن فقدوا أرواحهم قبل ساعات، وطلب بشكل ضمنى أن «يكون عندنا دمّ»، ونراعى معاناة أسر تذرف الدموع على من رحلوا. شعرْنا بالخجل وصمتْنا، وبمجرد خروجه من الغرفة استأنفنا ضحكاتنا بشكل هامس. أطفأنا الشموع واستمتعنا بأكل الحلوى. أعترف بأنه تصرف صبياني، غير أنه أكثر ملاءمة لشباب خرجوا لتوّهم من مرحلة الطفولة.
الذكرى إذن تستحق الكثير من المنشورات، والإفلاس الحقيقى أن ننسى أحداثا كُبرى تُعد جزءا من تكويننا.
مع الفرعون الذهبي
الأحد:
أتجاوز البوابة الإلكترونية، وأنطلق إلى فضاء اشتقتُ إليه كثيرا. أتطلع للمبنى العتيق، وكالعادة تفرض الذكريات نفسها. لسنوات ظلّت زياراتى له شبْه أسبوعية، قبْل أن تُباعد المشاغل بيننا. كلانا غيرتْه الحياة: ابتعدتُ أنا عن الآثار مهنيا، غير أن شغفى بها استمر، بينما ودّع هو الكثير من أبنائه، متمنيا لهم مستقبلا أكثر إشراقا، فى مقر جديد يليق بحضارتنا المُبهرة.
أبتعد عن مدخله الضخم، وأنطلق إلى باب خفى لا يعرفه الكثيرون كى ألحق بموعدي. أتجاوز ذكرياتى مع المتحف المصري، لصالح واقع لاهث يسلبنى حقّ التأمل. غير أن الماضى فى الحالتين هو سبب حضورى اليوم. أتّجه إلى قاعة توت عنخ آمون فى الطابق الثاني، وأقابل أصدقاء قدامى اجتمعوا على شرف الفرعون الذهبي، للمشاركة فى فيلم وثائقى بمناسبة مرور قرن على اكتشاف مقبرته التى جذبتْ أنظار العالم منذ اللحظة الأولى. منهم من يتحدث عن ملك لم يترك إنجازا يُذكر لأنه مات فى سن صغيرة، لكن مقبرته التى نجتْ من اللصوص احتفظتْ بروعتها، فمنحتْ صاحبها خلودا جعله ينافس العظماء مثل تحتمس الثالث ورمسيس الثاني.
اخترتُ أن أتكلّم عن كواليس الاكتشاف، وما أعقبه من أحداث تُعطى انطباعا بأننا أمام فيلم بوليسي! من بينها اختلاس مُكتشفها هوارد كارتر وشُركاه لعدد من القطع، تُعرض الآن فى عدة متاحف عالمية، والموقف الحاسم الذى اتخذته الحكومة المصرية ضده عام 1924، بوقف عمل البعثة الإنجليزية بعد اكتشاف تلاعبها، ولم يتحوّل الأمر إلى زلزال سياسى يُهدد العلاقة بين مصر وبريطانيا العظمى، لأن لندن خشيت من رد فعل الحركة الوطنية المُتنامية بقيادة حزب الوفد وحكومته.
الأسرار كثيرة، يرجع بعضها إلى فترة الاكتشاف، ويعود البعض الآخر إلى زمن سحيق اتسم بالاضطراب، وتبقى المؤامرات الغامضة عاملا مُشتركا يجمع بين زمنين تفصلهما عشرات القرون.
قاعة الملك مُزدحمة بدرجة لم تشهدها منذ فترة، رغم أن مقتنياته الأساسية انتقلت إلى المتحف المصرى الكبير، أسعد بشغف السائحين الأجانب، وأحلم بيوم يجعل المواطنين أكثر اهتماما بحضارتهم، فعدم إقبال المصريين يوحى بأنه لا كرامة لفرعون فى بلده!
حكايتى مع حزبى المُفضّل
الإثنين:
فى بدايات المرحلة الجامعية، كنتُ شديد الاهتمام بالحياة السياسية فى مصر. أتابع الصحف الحزبية التى يحرص أبى رحمه الله على شرائها يوميا، جنبا إلى جنب مع جريدة الأخبار، وأشتبك مع شباب التيارات المُتعارضة بالحرم الجامعي. وقتها كانت الأحزاب تُصدر جرائدها بشكل أسبوعي، وهو ما منحنى فرصة القراءة المُتعمّقة لمضمونها من الأخبار إلى المقالات. جذبتْنى صحيفة أحد الأحزاب، حتى أننى انتظرتُ بلوغى سن الثامنة عشرة كى أنتمى للحزب. بمجرد أن وصلنا للعمر المُنتظر، انطلقتُ مع أصدقائى فى اتجاهين مختلفين، هرولوا إلى إدارات المرور لاستخراج رُخص قيادة السيارات، وأسرعتُ لمقرّ الحزب لملء استمارة العُضوية. لسبب ما، لم أتمكّن من ذلك يومها، ثم فوجئت بالحزب يتّخذ موقفا مضادا لما سبق أن أعلنه، فاستبعدتُ نهائيا فكرة الانضمام لأى حزب، واكتفيتُ بمناوشاتى الجامعية، التى تمنحنى شعورا بتضخم الذات، لأننى مختلف عن معظم زملائي، الذين ينشغلون بتفاصيل ثانوية، ووقتها أدركتُ أن الكثير من الأحزاب لا تتجاوز كونها مقرا وجريدة!
اليوم أعادتنى «دائرة الأخبار للحوار» إلى الحياة الحزبية، فتحت الجريدة العريقة الباب أمام قيادات الأحزاب، لطرح مقترحاتهم أمام «الحوار الوطني»، واستعراض آمالهم المرجوّة. تحدّث الكثيرون عن تفاصيل مهمة، لكنها اعتمدت بالأساس على مخاطبة السُلطة، آملين أن تمنح الأحزاب قُبلة حياة. شردتُ لفترة ثم طرحتُ سؤالا أغضب البعض، عن عدم إجراء الأحزاب نقدا ذاتيا، يُحلّل بموضوعية ظاهرة عدم وجود الكثير منها على الأرض. لا أعنى التواجد عبر الأنشطة الاجتماعية، بل أقصد الوصول إلى رجل الشارع العادي، ولو حتى على مستوى معرفة اسم الحزب فقط. الردود تنوّعتْ بين طرْح المُبرّرات وانتقاد السؤال، رغم أن سؤالى لم يستهدف الهجوم على الأحزاب، لكنه مجرد إلقاء حجر فى ماء أرهقه السكون.
من حق الجميع أن يُعلنوا مقترحاتهم ومطالبهم، لكن من واجبهم أيضا فتح أبواب النقد الذاتي، فللقضية وجوه كثيرة. أعرف أن نظام أى بلد يحمل الجانب الأكبر من المسئولية، لكن دون أن يمنح ذلك حُججا للبعض تجعلهم يتناسون أدوارهم، ويشعرون بالراحة النفسية بمجرد إلقاء المسئولية على شماعة السُلطة.
رد اعتبار لـ «السناتر»!
الأربعاء:
على «واتس آب»، تلقيتُ رسالة من صحفية مصرية صديقة، تقيم فى أمريكا منذ سنوات، خرجتْ عن سياق التعليقات المتضامنة مع مقال لي، عن فوضى «سناتر» الدروس الخصوصية. كل التعليقات دارتْ فى إطار ساخر، حول ما ذكرته عن صمود هذه المراكز فى وجه الحملات الشرسة لإغلاقها. غير أن الصديقة حنان جاد تساءلت عن السند القانونى لغلْقها والمبرّر الاجتماعى لذلك. صمتتُ بعد أن فاجأنى السؤال، لم أنشغل كثيرا بالسند القانوني، حتى بعد أن أكّدت هى أن الأصل هو الإباحة ويظلّ المنع استثناء، طالما لم يكن فى الأمر جريمة.
فكّرتُ: لماذا نُهاجم هذه الكيانات ونسخر منها، ورغم ذلك نحرص على أن يلتحق أبناؤنا بها؟ الحقيقة أن معظمنا وجدوا فيها ملاذا آمنا، يحميهم من شراسة نفقات الدروس الخصوصية، وتراجُع الخدمة المُقدّمة فى المدارس سواء كانت حكومية أو خاصة. الطلاب أنفسهم اعترفوا بأنهم أكثر قدرة على التحصيل فى «السناتر»، دون أن يكون لكثافة الفصول دخْل فى ذلك، فبعض مشاهير تلك المراكز يقومون بالشرح فى قاعات تضم أعدادا تفوق ما تضمه عدة فصول مجتمعة!
السؤال المفاجىء وضعنى على الحافة بين السُخرية والحيرة، لكن الصديقة منار الرامينى حسمتْ الموقف، عندما ذكرتنى بتصريحات أطلقها وزير التعليم، وأكد فيها أنه سيتم تقنين أوضاع «السناتر»، ومنْح المُعلّم الذى يقوم بالتدريس فيها رُخصة، لضمان سلامة البيئة التى يدرس فيها أبناؤنا. وكالعادة تفجرت موجة اعتراضات على القرار، ولم ينتبه الكثيرون إلى رقم مهول ذكره الوزير، عندما أوضح أن إيرادات الدروس الخصوصية تقترب من 47 مليار جنيه!
كثيرا ما نركب الموجة فى الهجوم على ظاهرة أو الدفاع عن أخرى، لكن استفسارا منطقيا بسيطا، يجعلنا نكتشف أن بعضنا «حافظ مش فاهم».

الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة










 الطرد.. واجب
الطرد.. واجب
 .. ويتلألأ ذهب الغيطان
.. ويتلألأ ذهب الغيطان
 الوظائف للشباب
الوظائف للشباب
 كاريكاتير| الشرطة تعتدى على الطلبة داخل الحرم الجامعى بأمريكا وإعتقال العشرات!
كاريكاتير| الشرطة تعتدى على الطلبة داخل الحرم الجامعى بأمريكا وإعتقال العشرات!
 غارقون فى بحر الطين!
غارقون فى بحر الطين!
 شم النسيم رغم أنف الحشاشين !!
شم النسيم رغم أنف الحشاشين !!
 ألعاب و حيل نفسية ٢ / ٢
ألعاب و حيل نفسية ٢ / ٢
 عالم جائع.. ويشكو كثرة الطعام!
عالم جائع.. ويشكو كثرة الطعام!
 عزف على أوتار الفقد
عزف على أوتار الفقد