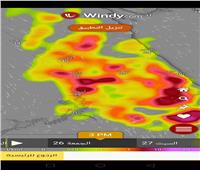إيهاب الحضرى
يوميات الأخبار
تجريف المشاعر!
الخميس، 16 فبراير 2023 - 08:29 م
منذ سنوات هجرتْنى الدهشة، بعد أن اكتشفتُ أن كل شيء ممكن، حتى لو كان غرابا يُغرّد، أو بقرة ترتدى ثوْب غزال!
كتاب من امرأة غير مجهولة
ذات أربعاء قبل أسبوعين:
فى العادة يزيد المظروف شغفى بمعرفة محتواه، لكنّ الكتاب قدّم نفسه لى بدون حواجز لأنه غير مُغلّف. تبتعد به يدى إلى رُكن قصيّ من المكتب. أتذكّر أمرا فترتدّ يدي، أطالع الإهداء الشخصى المكتوب بخطّ يد المؤلفة. لا يُضيف جديدا، لكن الإهداء العام فى صدارة الكتاب يكشف الغموض. أتذكّر ما طلبه الصديق الأكبر عماد المصرى منى قبلها بأسابيع، بالمساعدة فى إيجاد ناشر يتبنّى إصدار كتاب عن زميل عزيز راحل. عندما أخبرتُه بعجزى عن تحقيق رغبته، أرسل لى نسخة بى دى إف، وطلب منى قراءة العمل وإبداء أية ملاحظات عليه. خذلتُه من جديد، غير أنّ تقصيرى له ما يُبرّره، فلا يوجد لدىّ وقت وسط دوامات تسلبنا إنسانيتنا، كما أن المُحتوى نفسه يبدو لى مجرّد طاقة شجن فجّرها الغياب، ولا ينقصنى المزيد من الحُزن. وضعتُ الكتاب جانبا، وظلّ مكانه لعدة أيام، حتى قرّرتُ أن أتصفحه سريعا. لا يهمنى المضمون، فيكفى أن الكتاب عن الصديق العزيز محمد أبو ذكري. لستُ إذن فى حاجة للقراءة، سأجعل الكتاب مُنطلقا للحديث عنه، مع بضع عبارات مجاملة لزوجته الوفية، التى اختارت لنفسها اسما مُركّبا يجمعها مع ابنتهما نور. بدأتُ تصفح الكتاب فعليا، لأجد نفسى أمام مفاجأة لم أكُن أتوقعها.
صبّار أبو ذكرى
الخميس:
اليوم فقط انتهيت من قراءة «زهرة الصبار». ومع أن الانطلاقة نبعتْ من الفضول، إلا أننى التهمتُ الصفحات التى زادت على أربعمائة. أقدّر الحنين، وأحترم طاقات الشجن المُتفجّرة، دون أن يمتلك كلاهما القُدرة على جذبى إلى دائرة المجاملات، لكنّ الكتاب سرق الوقت مني، بعد أن فتح لى أبواب عالم خفى ظللتُ أجهله عن محمد أبو ذكري، رغم قُربنا قبل سنوات طويلة بحُكم الجيرة فى صالة تحرير واحدة.
فى أعوامه الأخيرة تزايدت تنقلاته بين القاهرة والإسكندرية، وباعدتْ بيننا الانشغالات، لكنّه مع كل لقاء يبدو قريبا. إنه هو نفسه، بهجماته اللفظية التى لا تنتهي. تُثير ضيق المحيطين لأنها تستهدفهم، وتستفزّ طبيعتى رغم أنها لم تنلْ منى أبدا. على العكس كان يأخذ وقتا مُستقطعا بين وصلتيّ سخرية، ويُطلق باتجاهى جُملة ثناء عابرة، قبل أن يستكمل قصْفه ضد من لا يُعجبه.
لم يفتح الكتاب عالم أبو ذكرى الخفى فقط، بل ساهم فى الكشف عن أديبة تملك أدواتها، قدّمتْ سيرة ذاتية لنفسها، كان صديقنا المبدع الراحل بطلها المُشارك. استخدمتْ المؤلفة نور الغادة تكنيكات سرد متعددة تؤكد موهبتها، فلجأتْ للحكى والـ «فلاش باك» والمونولوج، لتقود القارئ إلى عوالم شديدة الجاذبية، تأسره إذا لم يكن قد عاش أجواءها، وتُفجر طاقة الذكريات بداخله، لو رأى نفسه طرفا فى قصة تتماس مع الأشخاص والأماكن. قفزت الكاتبة على نقاط الخلاف الجذرية، رُبما لأنها وضعت فى اعتبارها صورة من تكتب عنه، لكن عبارات مُتفرّقة كشفتْ جوانب غموض حيّرتنى فى شخصيته، لأدرك أن هناك تحولات حدثت فى شخصية أبو ذكري، اختفى خلالها الشاعر وسيطر الثائر، مما أفرز حالة صخب نفسى يأكله من الداخل، لأنه فقد أحلامه تباعا نتيجة تمسّكه بمبادئه فى زمن بالغ القسوة. لن يشعر بمرارة ذلك إلا من عاش الحالة وجرّب عُنف توابعها. بين الشعر والثورة اختلافات جذرية، والانتقال الحاد بينهما يؤدى إلى تآكل الروح قبل الانفجار النهائي.
ذات اندماج مع صفحاته، انبعث صوت وردة ليُضفى على أجواء الحكْى طاقة شجن، «ماعندكش فكرة هواك قد إيه بيهدى زمانى هنا قد إيه.. معندكش فكرة رضاك قد إيه.. بيغنى حياتى غِنى قد إيه»، التحمتْ كلمات الأغنية مع حروف الكتاب، التى كانت بالصُدفة تنسج وقتها خيوط قصة الحب الوليدة، فزادت الموسيقى فيض المشاعر الذى منحته لى الكاتبة، خاصة مع تشابه الحالتين. خلال القراءة دمعتْ عيناى.. ابتسمتُ وضحكتُ..
واعتصرنى الأسى، وسط سرد يروى تفاصيل أحداث تتأرجح بين أحزان مُزمنة تقطعها لحظات فرح مشوبة بالحذر، تتخلّل قصة كفاح استمرت حتى آخر قطرة من حياة أبو ذكري. جاء التعبير عنها بأسلوب مُفعم بالشفافية، يتسم بأنه موصل جيد لحرارة المشاعر، ليس فقط فيما يتعلق بالعلاقات البشرية، بل أيضا فى ارتباط الإنسان بالمكان، وتبقى الذكريات الأقرب لقلبي، تلك التى ارتبطت بالإسكندرية، كمدينة ساحرة ينتمى لها بطلا العمل، وتملك القدرة على تفجير براكين لا نهائية من الشجن..
على الأقل فى قلبي. لهذا استوعبتُ شعور المؤلفة بالصدمة، عند عودتها لمنزل نشأتها، بعد شهور من إعادة بنائه، تمعنتُ فى كلماتها: «توقفتُ كثيرا أنظر لهذا المارد دون أن أحرّك ساكنا.. لكنّ فى داخلى صراع لا تراه عيون الآخرين..
فقلبى يقفز بداخلى أشبه بقط جائع يبحث عن ضالته ليُشبع جوع الشهور الماضية». لكن القط الافتراضى سيظل يبحث مع الكاتبة، بعد أن فوجئتْ بزحام وجوه غريبة غزت المكان واستوطنته، لدرجة أنها اتخذت قرارا بعدم العودة لموطن أحلامها..
عقب تحوله إلى مسْخ. بالتأكيد سيكتشف كل منا أن جانبا كبيرا من أماكن ذكرياته تعرّض للمصير نفسه، نتيجة تحولات شرسة تقوم بتجريف أرواحنا دون ذنب جنيناه.
إنها روح أبو ذكرى تقوم بتصدير مواجع أحاول نسيانها، تُؤججها قُدرة أرملته على تفجير الأحزان، التى تتراجع نسبيا أمام وفاء يُثبت أن الرحيل بالجسد لا يعنى نهاية رجل، اكتشف بعد فوات الأوان أنه من ضيع عُمره فى معارك مع طواحين الهواء، لكن عزاءنا أن تلك الطواحين ساهمت بعد رحيله، فى توليد طاقة مُتجددة من الإبداع.
الإبداع بين المدخنة والروبوت!
الأحد:
أعترف دون خجل أننى من قرّاء مجلّة «ميكى»، تعرفتُ عليها وعُمرى لا يتجاوز العشْر سنوات، وفتحت لى أبواب الخيال، عبر شخصيات ديزنى التى لا تزال محفورة فى ذهني، ربما لأننى أحرص على قراءتها وأنا على أبواب الشيخوخة، كهُدنة بين قراءات جادة وعمل لا يخلو من الإرهاق.
تذكرتُها اليوم لسبب لا يرتبط بالذكريات، فقد طالعتُ خبرا عن إطلاق «روبوت»، يستطيع كتابة المقالات، وتأليف الكتب فى ثوان معدودة، بينما يستغرق الكثيرون شهورا وربّما سنوات، للخروج بكتاب واحد ذى قيمة. ما علاقة هذه الثرثرة بمجلة الأطفال الشهيرة؟ الأمر بسيط، لقد استرجعتُ قصة بطلها المليونير البخيل عم دهب، الذى ضاق بنفقات مؤلفى القصص فى دار نشر خاصة به، فقرّر البحث عن مداخن الحكايات بجزيرة نائية، كى تمنحه القدرة على الكتابة بنفسه وتوفير أمواله. لكن هل الهدف من ابتكار الروبوت المُبدع هو توفير النفقات؟ أعتقد أن مخترعيه سيخسرون أموالهم لو كان هذا هو السبب، ففى بلادنا يظلّ المؤلف هو الحلقة الأضعف والأكثر فقرا، فى سلسلة صناعة النشر. الغالبية هنا يكتبون حُبّا فى الكتابة، ويُنفقون عليها غالبا لنشر إبداعاتهم، بينما يظل الناشر على البرّ شاطر، لأنه أصدر الكتاب دون أن يفقد أموالا، والعائد يرجع إليه بينما المؤلف يستجدى فتات ما جادت به أفكاره. لن يجد الروبوت إذن سوقا له فى بلادنا، لأن تكلفة شرائه مبالغ فيها، مقارنة بأية عوائد مُتوقّعة، فى ظل قرّاء ينقرضون رغم كل ما نراه من زحام فى معرض الكتاب، وطوابير للحصول على توقيعات كُتّاب لا تعترف الساحة الثقافية غالبا بإنتاجهم.
استوقفنى خبر الابتكار، غير أنه لم يفتح أمامى أبواب الاستغراب. منذ سنوات هجرتْنى الدهشة، بعد أن اكتشفتُ أن كل شيء ممكن، حتى لو كان غرابا يُغرّد، أو بقرة ترتدى ثوْب غزال!
وإذا كان الروبوت المؤلف قد ظهر إلى الوجود، فقد سبقه أشقّاء آخرون يحاولون شق طريقهم فى مجالات متعددة، كالموسيقى والغناء والطب والهندسة. لكن هل هم حقا مبدعون؟ يعتمد الإبداع فى الأساس على التفكير المُبتكر، وليس على إعادة صياغة مُدخلات البرمجة، فيكون الناتج جافا، أشبه بطبْخة يبدو مظهرها شهيا لكنها دون طعم.
بالمناسبة، هل تذكرون عمّ دهب؟ بعد أن منحتْه المداخن القُدرة على الكتابة، قام بملء مئات الصفحات ودفعها إلى المطبعة دون أن يقرأها، واكتشف عُمال المطابع أنها مكتوبة بلُغة عجيبة تستعصى على الفهم. إنها نتيجة طبيعية لمحاولات التحايل على الإلهام، حتى لو كان المناخ طاردا للإبداع.
غُربة الأدب
فى أحد أروقة معرض الكتاب تجمدّت قدماى بمجرد سماعى العبارة المُستفزة. استدرتُ لألقى نظرة على قائلها. شاب فى العشرينات وصبى يبدو أنه أخوه الأصغر، قال الكبير: «لو ما بطلتش تدوير على الروايات مش هيحصل لك كويس». من المُمكن الوصول إلى تفسير مُقنع لما حدث، بمجرد ملاحظة لحية الشاب، التى تدلّ على توجهاته الفكرية. المشكلة أن الوقائع تتكرّر، بما يدلّ على أن دائرة الخلل تتسع. بعدها بأيام فاجأنى منشور تتساءل فيه فتاة عن جدوى قراءة الروايات، ورجل دين يستنكر دراسة النساء للشعر.
فسّر الأخير استنكاره بأنه لا يصح أن تقرأ المرأة كلاما «قليل الأدب» فى بعض القصائد! يُركّز الشيخ إذن على درء المفسدة، بينما تنطلق الفتاة من مبدأ جلب المنفعة، بالبحث عن معلومات يُمكنها أن تعثر عليها فى مناهج تعليمية تعتمد على التلقين، لكنها قد لا تتوافر فى الروايات.
فى الحالات السابقة كلها، تظل المتعة وإنعاش الوجدان غائبين، رغم أنهما من ركائز هواية القراءة. الخطورة الحقيقية تتمثل فى أن هناك تيارا أصبح ينتصر لتجريف الإبداع والمشاعر معا، رغم أن العالم يحتفل فى اليوم نفسه بعيد الحُب ويوم القصة القصيرة!
للحب.. فى عيده
من كلام الأغانى: وانا جنب منك بحس بأمان.. كإن فإيديا الوجود والزمان.. ومهما يلومونى هقول لك كمان.. إنت ضلّ فصيف أيامى.. وانت نجم فليل أوهامى.. وانت اللحن اللى فأنغامى.. برضه إنت.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة













 عالم جائع.. ويشكو كثرة الطعام!
عالم جائع.. ويشكو كثرة الطعام!
 عزف على أوتار الفقد
عزف على أوتار الفقد
 نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
 «لست ملاكاً»
«لست ملاكاً»
 وكاد بطل الملاكمة يصفعنى فى الطابور!
وكاد بطل الملاكمة يصفعنى فى الطابور!
 وجها لوجه مع مصطفى أمين
وجها لوجه مع مصطفى أمين
 مكالمة «نص الليل» مع الشهيد أبو عمار
مكالمة «نص الليل» مع الشهيد أبو عمار
 فى الموت والحياة.. عظة
فى الموت والحياة.. عظة
 أنا أقاوم.. إذاً أنا موجود
أنا أقاوم.. إذاً أنا موجود