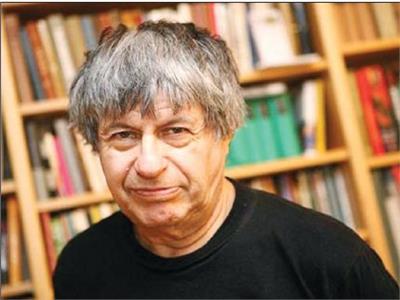
إيفان كليما
إيفان كليما: الأدب والذاكرة
الخميس، 21 سبتمبر 2023 - 01:20 م
لطالما سُئلت عمّا أكتبه حاليًا، لكن لم يسألنى أحد قط عن سبب الكتابة أو عن أهم موضوع على الإطلاق: معنى «الأدب» بالنسبة لى، وما أفهمه بمجرد ذكر هذا المصطلح. لعل الناس شعروا بالتردد إزاء سؤالى عن أسبابى الخاصة للكتابة ظنًا بأن ذلك قد يحرجنى، وتجنبوا السؤال الثانى عن الأدب لأنهم اعتبروه عبثيًا،والحقيقة أن الإجابة ليست واضحة بأى شكل من الأشكال.
جرى الحال منذ بدء الزمان باعتبار كل شيء مكتوب أدبًا، فكل من ليفى وتاكيتوس إضافة إلى شيشرون وفيرجيل كانوا ببساطة منشئى نصوص أدبية، أما الكتاب المقدس فنسمّيه «سفر الأسفار»، ونجد فيه حكايات ميثولوجية علاوة على علاجات حقيقية ويوميات من التاريخ ومجموعات من الأمثال والشرائع وقصائد الحب، كما أن العديد من الأعمال القديمة والقروسطية فى القانون والطب والجغرافيا والرياضيات كانت مكتوبة شعرًا، وفيها يفوق الخيال الواقع من ناحية الكم، ونقرؤها اليوم على أنها أدب دونما اعتبار للعلم فيها، حيث بدأنا مؤخرًا فقط بالتفكير فى فصل الكتابة التقنية التخصصية عن الأدب. كيف لنا أن نصنّف فيضان القمامة الذى يغرق قرائنا كل يوم؟ أين الخط الفاصل تحديدًا بين الأدب وغيره؟ توجد العديد من الخطوط الفاصلة والتعاريف التى يتناول معظمها صفات العمل شكليًا وجماليًا، وقد بلغت محاولات تعريف الأدب أوجها فى التعاريف والنظريات البنيوية التى نجحت بقدرٍ ما فى التفرقة ما بين الأعمال العلمية والفنية ولكنها غفلت عن المحتوى إضافة إلى خصال أساسية تفصل فى الغالب بين الأعمال الفنية الأصيلة والترفيه المحض، فضلًا عن أن البنيويين أولوا قليلًا من الاهتمام إزاء أثر العمل على المجتمع. لم أطرح هذا التساؤل بصدد تسليط الضوء على مشكلة نظرية، بل لأننى كاتب يرغب بوضع أدق تعريف ممكن لما أفعله والمغزى من ورائه.
اقرأ ايضاً| ثربانتس وفلسفة ما قبل ديكارت فى «دون كيخوتة»
طرح مؤسس الفلسفة الكلاسيكية الألمانية إيمانويل كانط قبل مائتى عام سؤالًا بسيطًا فى كتابه «نقد ملكة الحكم» محاولًا توضيح الفارق بين العلم والفن (العلم خلق أثناء الحرية) والفن والحرفة (التى عرّفها ببراعة أنها فن من أجل الربح)، وكان فى نفس الوقت على وعى بضرورة الخصائص الجمالية للعمل إضافة إلى محتواه الأجدر بالتأمل، لكن ما يستحق الملاحظة أنه أولى اهتمامًا شديدًا بدور المبدع – أو «العبقري» مثلما سمّاه – الذى لن يوجد العمل لولاه، ولا أرغب بتحليل التعريف الذى انتهى عنده كانت لظاهرة المبدع ونشاطه، بل تحليل اكتشافه استحالة فهم العمل الفنى (وبالتالى الأدبي) دون وضع صفات مبدعه بعين الاعتبار وتفكيره ودوافعه.
يعيدنى ذلك إلى السؤال الذى طرحته فى البداية: لماذا أكتب؟ نادرًا ما يتساءل الكتّاب عن ذلك، لكن الإجابة تنبئ عن الكثير، وهنا – على سبيل المثال – ما قاله الكاتب اليونانى نيكوس كازانتزاكيس عمّا يدفعه إلى الكتابة: «فى أعماقنا طبقة فوق طبقة من الظلمة: أصوات خشنة ووحوش جائعة كثيفة الشعر. ألا يموت أى شيء إذن؟ ألا يستطيع شيء أن يموت فى هذا العالم؟ الجوع والعطش والبلاء البدائى وكل الليالى والأقمار، ما قبل مجيء الإنسان، ستستمر فى الحياة والجوع فى أعماقنا، ستظمأ معنا ما دمنا نحن نعيش.
لقد لجمنى الرعب وأنا أسمع الحمل المخيف الذى أحمله فى أعماقى، وقد ابتدأ يجأر. ألن أتخلص أبدًا؟... أنا آخر الأحفاد وأحبّهم فى النهاية. وغيرى ليس لهم أمل أو ملاذ. وكل ما يتبقى لهم للانتقام أو الاستمتاع أو المعاناة لا يستطيعون فعله إلا من خلالي. فإن فنيت فنوا معي.» ثم ينتهى هذا الاعتراف الجياش بتعريف لا يقل عاطفة لمهمة الكاتب، إذ يقول «.. فقد تقدمت بثقة وكأننى أعرف وجهى الحقيقى وواجبى الوحيد: وهو أن أعمل على هذا الوجه بأكثر ما أستطيع من صبر وحب ومهارة. أن أعمل عليه؟ ما معنى هذا؟ يعنى أن أحوله إلى لهب، وإن كان لدى الوقت، قبل مجيء الموت، أن أحول هذا اللهب إلى ضوء، بحيث أن شيرون لن يجد فى شيئًا لأخذه.
وكان طموحى الأعظم هو ألا أترك للموت شيئًا يأخذه، لا شيء إلا القليل من العظام.» («تقرير إلى غريكو»، ترجمة ممدوح عدوان، ذهلت أثناء قراءتى هذه الفقرة من مدى قرب كازانتزاكيس مما قد أجيب عليه شخصيًا على سؤال الداعى إلى الكتابة وعمّا أتوقعه من كتاباتي. أتذكر ما أحسست به فى أواخر أيام الحرب [العالمية الثانية]: كنت قد أمضيت معظم ما مضى منها فى معسكر اعتقال، ونجوت من الموت فيما مات تقريبًا كل من حولى ممن يناهزونى سنَا بالإضافة إلى من فى جيل والديَّ وجيل أجدادي. غمرنى وقتها شعور مشابه لما اعترى كازانتزاكيس من حيث كونه قد تولى مهمة أو رسالة: أى أن أكون صوتهم، وصرخة رفضهم إزاء موتٍ محاهم من الوجود. ولعل هذا الشعور كان دافعى إلى الكتابة رغم أنى لا أريد الاستهانة بعامل المتعة الشخصية من الكتابة نفسها وخلق القصص والبحث عن أنسب طريقة لتبليغ ما أرغب بقوله.
عاودنى نفس الشعور بحرية تمثُّل أصوات الآخرين خلال أوقات أخرى بأشكال مختلفة، ففى فترة القمع [فى تشيكوسلوفاكيا]، أثناء تعرضنا للقصف بالأكاذيب، وانعدام كل شيء حقيقى ويهدف إلى ما هو أعلى من الإنسان على أرض الواقع ونهايته إلى النسيان والعدم فى مثل ذلك الزمن، كان المرء يكتب كى يتغلب على مثل هذه الريبة، ويهزم الموت الذى اتخذ عدة أشكال جاعلًا كلًا من الواقع والمصير البشرى والمعاناة والهزيمة والحقيقية تختفى تحت قبضته. وقد غمر نفس الإحساس أغلب الكتاب الذين أبدعوا، أو حتى عاشوا مدة من الزمن، فى تلك الأوضاع القمعية بطريقة أو أخرى، لكننا واصلنا الكتابة لنحافظ على ذاكرة واقع بدا أنه يغرق إلى الأبد فى نسيانٍ مفروضٍ قسرًا، إذ مثلما يقول ميلان كونديرا فى «كتاب الضحك والنسيان» «كل أمة تتعرض للدمار بسلب ذاكرتها أولًا، فتُحرق كتبها، وعلومها، وتاريخها، ثم يكتب شخص آخر كتبًا مختلفة، ويقدم لهم تعليمًا مختلفًا، ويخترع تاريخًا مختلفًا.»، كما صاغ فى نفس الكتاب تعبيرًا ألهمنى، إذ أسمى الرئيس الذى جسد النظام الشيوعى «رئيس النسيان»، فأيما أمة يقودها رئيس النسيان فهى تتوجه إلى الموت. والأمر ينطبق علينا معشر الأفراد مثلما ينطبق على الأمم؛ فالذات مفقودة بفقدان الذاكرة، والنسيان أحد أعراض الموت، ولولا الذاكرة لما صرنا بشرًا.
المقاومة من أجل التغلب على الموت أمرٌ مشتركٌ بين كل الشعوب، ورفض كون الموت نهاية كل شيء ليس إلا أحد المشاعر الوجودية الفطرية، فنحن نقاوم النسيان بمقاومة الموت، والعكس صحيح؛ إذ نقاوم الموت بمقاومة النسيان. وأحد سبل تجسيد هذه المقاومة، بالعودة إلى اعتراف كازانتزاكيس الجياش، هو فعل الخلق، ولا مناص من كون هذا الاعتراف حاضرًا فى ذهن الخالق: المرء يقاوم الموت بالخلق.البيت باللاتينية لهوراس: «خلقت صرحًا أطول عمرًا من البرونز والأهرامات». لهذا يستحيل علينا تجاهل السؤال عن سبب الكتابة والخلق إذ ما فكرنا بمعنى الخلق وقيمته وأصالته.
بعد نهاية الحرب، لم أدرك من حقيقة نجاتى أن واجبى كتابة أعمال واقعية عن الحرب ومعسكرات الاعتقال، بل أننى لم أكتب عنها إلا بضع نصوص. فلا أحد يعبر عن الذاكرة عبر تسجيل ملتزم بتجربة معينة فقط، بل إن التعبير عن الذاكرة مسؤولية تنبع من إحساس باتصال معين مع كل ما سبق ومن عاش من قبل، أى ما يجب علينا فعله إذا أردنا تفادى الانتهاء إلى العدم، وكل من إحساس حضارتنا بالتسارع ووفرة المعلومات بضجيجها من حولنا منذران بأن ينتهى بنا الحال إلى هذا الخواء، إذ ننتزع أنفسنا من جذورنا ونقع فى فجوة زمكانية، وهذا الخطر يتهدد الأدب بل كل الفنون، إذ بدا فى لحظة معينة من التاريخ الحديث فى أعين الكثر أن الذاكرة والتقاليد ليستا إلا عبئًا يجب التخلص منه، بيد أن الكوارث الاجتماعية التى حاقت بالبشرية فى القرن الذى نعيش فيه كانت بعون فن يعبد الأصالة والتغيير واللا مسؤولية والطليعية، ويسخر من كل التقاليد السابقة والمستهلكين والجماهير فى المعارض والمسارح باتخاذ موقفٍ متعجرفٍ يجد المتعة فى صدمة القارئ بدلًا عن الإجابة على الأسئلة التى تؤرقه. ولم يكن رفض الأنظمة الشمولية الأدب الطليعى فى ذلك الوقت باعتباره منحطًا بأمرٍ مهم، بل اتخاذها موقف الطليعة الفنى الرافض لكل من التقاليد والقيم التى تمثلها ولذاكرة الإنسانية، ثم محاولتها فرض ذاكرة مزيفة وقيم مزيفة على الأدب.
بينما يصدر كل بضع ثوان كتاب جديد، لا يغدو معظم الناتج توًا إلا جزءًا من طنين يكاد يصيبنا بالصمم، بل إن الكتاب بات أداة للنسيان. لكن أى عمل أدبى حقيقى يأتى إلى الوجود بصفته صرخة احتجاج من مبدعه على الزوال الذى يبسط سلطته عليه وعلى أسلافه ومعاصريه فى آن، بل على عصره ولغته التى يُكتَب بها، ولا يتصدى لهذا الزوال إلا الأدب.

الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 نهاية روبنسون كروزو
نهاية روبنسون كروزو
 بسمة ناجى.. الأسى وحب العائلة فى قائمة البوكر الدولية القصيرة
بسمة ناجى.. الأسى وحب العائلة فى قائمة البوكر الدولية القصيرة
 بسمة ناجى.. رد سلمان رشدى الفنى على طعنة السكين
بسمة ناجى.. رد سلمان رشدى الفنى على طعنة السكين
 جورى جراهام: نكتبُ كى نتغير |حوار
جورى جراهام: نكتبُ كى نتغير |حوار
 حلا عليان ..قصيدتان
حلا عليان ..قصيدتان
 وليم بوروز.. قصتان
وليم بوروز.. قصتان
 شتيفان تسفايغ كشاعر
شتيفان تسفايغ كشاعر
 د.لميس النقاش.. مجدى نجيب "كأنه طفل"
د.لميس النقاش.. مجدى نجيب "كأنه طفل"
 مختارات من «أفلام قصيرة عن حياة العصافير».. قضية شائكة
مختارات من «أفلام قصيرة عن حياة العصافير».. قضية شائكة



















