
ياسر عبد الحافظ
الثقافة والناس
السبت، 25 مايو 2024 - 02:24 م
فى منتصف تسعينيات القرن الفائت اتخذ محافظ القاهرة وقتها قرارًا بنقل سوق روض الفرج من موقعه الشهير إلى مدينة العبور، وكان ذلك لاعتبارات عدة على رأسها ما يسببه السوق من ازدحام مرورى كثيف يصيب وسط العاصمة بالشلل، إضافة إلى اعتبارات بيئية وصحية ناتجة من عدم قدرة المكان على استيعاب وتخزين الخضراوات والفواكه بالطرق الحديثة.
نقل السوق لم يتم بالسهولة التى يمكن تخيلها من السطور السابقة، من عايش الحدث قد يتذكر ما أثاره القرار من مناقشات وجدل عام ما بين مؤيد ومعارض، من يتمسك ببقاء القديم مع تطويره ومن يقول بأنه ليس أكثر من سوق نشأ فى لحظة تاريخية ما وانتهى الغرض منه، بل وتحول عن الهدف الأساسى له بدخول أنشطة فرعية عليه وبعضها ممنوع قانونًا!
غير أن ذلك لم يمنع نقل السوق وفق القرار، لتهدأ بعده المناقشات ويسود منطقة روض الفرج الصاخبة هدوء كأنه الموت، لم يعد ثمة زحام، ولا باعة جائلون، ولا عربات محملة بالبضائع. اختفى الناس الذين كانوا يأتون من كل محافظات الجمهورية قاصدين تلك المملكة الغامضة التى تأسست على حكايات وقصص وأساطير وصراعات ودماء رصدتها روايات وأعمال درامية، وحل بدلًا من ذلك حديقة ومبنى بريد ومستشفى وقصر ثقافة.
أذكر أنى زرت قصر الثقافة ذاك بعد افتتاحه، كانت هناك ندوة، ثلاثة كتاب أو أربعة يناقشون قضية ما، لكن لا جمهور سوى من جاءوا بصحبة المتحدثين، وأنا وزميل صحفى آخر جئنا لنرى ما أصبحت عليه الأمور. من الفتوات ونداءات الباعة التى لا تنقطع إلى نقاش ثقافى لا أذكر عنوانه لكن انطباعى أنه كان خاليًا من الحياة مقارنة بما كنت أعرفه عن المكان.
لماذا احتفظت بالمشهد فى رأسى مع مرور كل تلك السنوات عليه؟ لأنه فيما كانت المنصة تتحدث يومها وفيما نستمع إليها بلا انتباه لما يقال تقريبًا، دخلت امرأة إلى القاعة بهدوء بالغ، ليست من جمهور الثقافة بالتأكيد بل من جمهور، أو من تجار، السوق المزال. بجلبابها الذكورى وربطة الرأس وبالجسد الفارع بدت وكأنما خرجت للتو من مشهد تمثيلى فى عمل عن السوق، تؤدى مشهدًا تتحسر فيه على مصيره ومصيرها.
وضعت جسدها على أحد الكراسى بلا أدنى اهتمام بالشأن الثقافى الجارى ولا بالمتحدثين الذين أخذتهم مفاجأة دخولها فصمتوا لحظات ينظرون إليها ثم تمالكوا أنفسهم وعادوا إلى ما كانوا فيه، لكنهم ونحن، الجمهور القليل، بقينا نختلس النظرات إليها ونفكر فى ما يعنيه وجودها، لأن هذا عملنا: التفكير، فيما هى تمثل وجهة النظر الأخرى النقيض لمنهجنا.. الحياة المتروكة لحالها لتمضى كيفما أرادت.
بشكل ما غابت التفاصيل المتداخلة المؤدية إلى إزالة السوق وبقى قصر الثقافة وحده كأنه المسئول عما تم، عنصرًا مستفزًا لأهالى المنطقة والمتعاملين مع السوق الذى ذهب وجاء مكانه فضاء ليس مفيدًا لهم فى شيء، يدخله من يتحدثون لبعض الوقت أو يؤدون عرضًا ثم يمضون إلى حال سبيلهم بلا اهتمام، أو ربما بلا إدراك بما يقال عنهم وعن نشاطهم، أن الثقافة أضرت بالناس، لم ينفتح نقاش حول هذا، فبقى المثقفون بلا قدرة على نفى الاتهام، لم تتح لهم فرصة ليقولوا أنهم ليسوا المسئولين عما جرى ولم يشاركوا فيه بل على العكس، لو تحدثوا لقالوا بأنهم يمثلون الناس، يعبرون عن أحلامهم ورغباتهم وطموحاتهم وينقلون أوجاعهم، ربما لا يتمكنون من نقلها بشكل فعال إلى السلطة لأنها ليست وظيفتهم لكنهم يدونونها على الورق، شعرا ونثرًا ورسمًا وتصويرًا ليخلدوا كفاحهم ونضالهم.. لكن هل هذا يكفي!
بالنسبة لى يصلح مثال السوق للنظر فى جدلية العلاقة بين الثقافة والناس فى مصر، كأنهما نهران متعارضان لا ينتج عن تصادمهما إلا ضياع طاقتيهما وكليهما لا يحصل على ما يريده من الآخر فلا المثقف وصل إلى الجمهور الذى يناسب رسالته ولا الجمهور فى المقابل حصل على حصته من الثقافة اللازمة ليمارس بها حياته بفهم أفضل وعلى نحو أكثر وعيًا.
مؤكد بالطبع أن الخطأ يتحمل مسئوليته المشتغلون بالثقافة، والقائمون على إدارة ملفها بشكل أساسى لأنها، أى الإدارة الثقافية، لا تبذل الجهد الكافى فى دراسة متطلبات الجمهور الثقافية، ولا الاحتياجات التى من واجبها تلبيتها، ولا تعى كيفية وضع مشروع استراتيجى لتحقيق الأهداف، ولا خطة لديها للتواصل مع القطاعات المختلفة، سواء كانت رسمية أم خاصة، لصياغة ملامح عمل ثقافى يوازن بين الممتع والضروري، ويستخدم الأساليب والصيغ الثقافية والفنية المتعددة لتوصيل رسالته، وتكون لديه القدرة على تقديم وإبراز المواهب بالشكل الضامن لاستمرار حيوية الثقافة المصرية وعدم تعرضها للجمود كما هو الحال الآن.
يومًا سألت شاعرة من إحدى دول الكاريبى عن النشر فى بلادها فقالت إنه ليس من عادة الشعراء طباعة قصائدهم لأن الثقافة المحلية فى بلادها تقوم على إلقاء الشعر فى مهرجانات جماهيرية مصاحبًا للرقص والغناء بحيث يكون الأمر أشبه باحتفال كرنفالى منه بأمسيات شعرية.
لسنا مطالبين بفعل المثل، لسنا الكاريبي، لن ندمج الرقص مع الشعر مع الغناء، لأنه لو تجرأنا على هذا سيخرج ساعتها من يقول بأننا خرجنا من دائرة الثقافة إلى أمر آخر، وإننا نستخدم الأبنية الثقافية فيما لا يوافق الهدف من إنشائها.
وقد يكون هذا الكلام صحيحًا، المجتمعات ليست متشابهة، وما يصلح فى الكاريبى قد لا يصلح على ضفاف النيل، رغم أنه تاريخيًا كانت الناس تخرج فى الأعياد والمناسبا للرقص والغناء.
وعلى هذا يبقى السؤال.. وما الهدف من الثقافة؟
فى الستينيات، ولمن أراد العودة إلى التاريخ المدون فى الكتب والمجلات الثقافية، كان الأمر يسيرًا، على المثقف والإدارة الثقافية، إلى حد ما مقارنة بهذه الأيام، كان هناك إيمان صلب من الطرفين: المثقف والجمهور، ومشروع واضح: التخلص من بقايا الاستعمار، من الهيمنة والإمبريالية، تحقيق العدالة، بناء الدولة الوطنية والوحدة العربية.
عناوين عامة ورنانة تٌسهل صياغة المشاريع الثقافية وفقها والنزول بها إلى الجماهير فى كل مكان، فى قصور الثقافة، والحواري، والمصانع، ومضت المسألة هكذا إلى أن حدث شرخ فى العلاقة بين الثقافة والناس، وما السبب؟ البعض يقول إنه النكسة التى استسلم المثقف تحت وطأتها ولم يعيده انتصار أكتوبر لحالة الإيمان الأولى، البعض يقول إنه سياسة الانفتاح، وآخرون يقطعون بأنهما معًا إلى جانب أسباب فرعية أخرى راكمت الأحجار لتبنى جدار العزلة بين الثقافة والجمهور. صنعت عالمًا من الشكوك بحيث أنه عندما وصلنا إلى التسعينيات جاء معها جيل يمارس الفعل الثقافى بلا أى طموحات سوى مخاطبة ذاته، وجاء معه جيل من الجمهور يجلس على كراسيه لا ليسمع إنما ليرتاح بعض الوقت من إنهاك حياة لا يجد فى كلمات المتحدثين على المنصة ما يفك شِفرتها له!
ما الذى نريده من ملف الثقافة؟ ليس السؤال مطروحًا بصوت المثقف القديم الواثق من دوره، الذى يخرج فى القوافل الثقافية لنشر الرسائل المعدة سلفًا، بل سؤال مطروح فى زمن لا يمكن فيه تمييز المثقف من الجمهور، وقت أدوات الإنتاج الثقافى والفنى فيه متاحة للجميع، والمثقف فيه متفرج ينتظر دورًا قد لا يأتي!
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
















 30 يونيو.. قصة من داخل الأحداث
30 يونيو.. قصة من داخل الأحداث
 الكتابة للجميع!
الكتابة للجميع!
 فقرة الذكريات!
فقرة الذكريات!
 الحلقة المفقودة في الصناعة الثقافية المحلية
الحلقة المفقودة في الصناعة الثقافية المحلية
 «رفعت عيني للسما».. ماذا وراء قصة النجاح؟
«رفعت عيني للسما».. ماذا وراء قصة النجاح؟
 تكوين.. القراءة.. الحرية!
تكوين.. القراءة.. الحرية!
 من فعل ثقافي إلى جولة ملاكمة!
من فعل ثقافي إلى جولة ملاكمة!
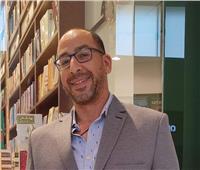 الرواية الفلسطينية وسجانها
الرواية الفلسطينية وسجانها
 ياسر عبدالحافظ ..تجارة النهايات
ياسر عبدالحافظ ..تجارة النهايات








