
ياسر عبد الحافظ
الحلقة المفقودة في الصناعة الثقافية المحلية
السبت، 08 يونيو 2024 - 01:40 م
لسبب مجهول يزداد الهجوم على المبدعين في أوقات بعينها، لدوافع مختلفة وعبر وسائط مختلفة، مقال في جريدة، أو منشور على واحدة من وسائل الاجتماعي، لكن المضمون متشابه، يدور حول التعجب من زيادة عدد الكتاب، الروائيين منهم على وجه الخصوص، واستنكار ما يتم تشبيهه بالتدافع سعيًا، من وراء الكتابة، لتحصيل الشهرة، والجوائز، وهو ما لا يراه أصحاب الهجوم بالأمر الملائم، من وجهة نظرهم، لتصورهم عن فكرة الكاتب. أما المدهش حقًا فإن الهجوم يأتي غالبًا من مشتغلين بالعمل الثقافي!
مؤكد أن الكتابة عمل له جاذبيته الخاصة، لا بد أن كل فرد في مرحلة ما من حياته راودته فكرة أن يكتب، ليس بالضرورة رغبة أن يبلغ الناس شيئًا، بحسب التصور الكلاسيكي عن التأليف، بل فقط للتعبير عن ذاته، لأن الكتابة واحدة من أكثر الممارسات قدمًا واتصالًا بالحضارة، وفضلًا عن ذلك فهي في علم النفس وسيلة مثلى للوصول إلى الأفكار والمشاعر التي قد لا يتمكن الشخص من فهمها أو التعامل معها ومواجهتها بالوسائل التقليدية.
الكتابة أيضًا واحدة من الوسائل الأساسية للتعلم، لأنها تتطلب المعرفة بالمهارات الأساسية لها، ثم بما سبق تدوينه في المجال نفسه، نحن نتكلم هنا بالطبع عن التحول من الهواية، أو من الكتابة كوسيلة علاج إلى الاحتراف، من كتابة للذات إلى كتابة ترى في نفسها القدرة على التواصل مع جمهور أوسع من العائلة والأصدقاء، عبر النشر بالوسائل المتعددة.
على هذا يبدو أننا كمجتمع في حاجة إلى تشجيع عملية الإنتاج في هذا المجال لا الحد منها، وفق الشرط الذي يرى أنها عملية تبادلية دائمة بين الفعلين: القراءة والكتابة، ووفق عملية فرز متوقعة ستنتج لاحقًا مع اتساع الخبرة بها، وبما أنتجه البشر السابقون علينا، والبشر في حاضرنا بلغات أخرى، فالكتابة ليست خرساء بل تملك القدرة على التحاور مع مفردات عالمها ومع الكتابات الأخرى،ووفق هذا يتطور الفن.
على هذا يمكننا أن نفهم سبب كثرة الجوائز في الخارج (مصطلح الخارج هنا يعني الثقافات غير العربية) مقارنة بعدد الجوائز المحدود للغاية لدينا، والسبب الذي لأجله تحول الفن في الـ«خارج» إلى صناعة فيما هنا تتواصل معاناة الكتاب والفنانين، لتنفيذ مشروع فني، للحصول على عضوية اتحاد الكتاب، لإقامة ندوة لمناقشة عمل، للبحث عن اعتراف، عن مردود ما، رحلة تؤول غالبًا بالفشل، بعد العجز عن اختراق جدران الصمت والتجاهل.
في الثقافة الغربية على سبيل المثال الممارسة الفنية واحدة من الحقوق الأساسية للفرد، في المدرسة، الجامعة، عبر المؤسسات ذات الأطياف بالغة التنوع، التي تضمن غالبًا أن الفنان سيجد جهة إنتاج لرعايته، لكنه مع ذلك ليس مجبرًا على هذه الرعاية فقد يفضل الاستقلالية لأنها تمنحه حرية التمرد لهذا يجد في جمع التبرعات سبيلًا أفضل لتمويل عمله، وربما يتوجه إلى الشارع بحثًا عن حرية أكبر، وخلاصًا من القيود كلها.وهو في كل المراحل سيجد قائمة بعشرات من الجوائز، والمئات من المنح، والإقامات، وورش التدريب، واللقاءات مع الجمهور، والقراءات مدفوعة الأجر، وهذا كله ينضوي تحت مشروع ضخم اسمه الصناعة الثقافية أو الفنية، سمه ما شئت، هدفه الأساسي،المتفق عليه بلا بروباجندا، صيانة الإبداع والحفاظ عليه متدفقًا باعتباره الجوهر، الوقود لأي حضارة، ومن دونه تنزوي هذه الروح المتقدة وتذبل.
في ظل هذه السياسات ستصادف فنانين لا يتوقفون عند نوع بعينه من الفن، تجد سيرتهم الذاتية متخمة بالتخصصات والفعاليات والجوائز، من الكتابة الروائية، إلى الشعر، إلى التمثيل والرقص وهكذا، لأنه من الوارد أن يفقد الفنان خلال عمله قدرته على التعبير عبر وسيلة بعينها لكن دائرة الإبداع التي يتحرك فيها توفر له حرية التنقل بين الأنواع ومساحة واسعة للعب، هذا في الأساس التعريف الذي يكاد يُتفَق عليه للإبداع: الحرية.
ووفق هذا لن تكون ثمة مشكلة على سبيل المثال في الانتقال من الشعر إلى كتابة الرواية. لن يقول لك أحدهم إنك خنت الشعر وانتقلت إلى الرواية لأنها الجماهيرية الآن! هذا ما قيل هنا في مرات ضد من تحولوا من الشعر إلى الرواية. لن يكون الإخلاص لنوع وحيد من الفن ممدوحًا أو مذمومًا إلا بحسب ما تم إنتاجه من خلاله.
ما سبق لا يعني أن طريق الممارسة الفنية في الـ«خارج» أبسط مما لدينا، فالواقع أن العكس هو الصحيح، ذلك أن القواعد التي تم التعارف عليها والعمل بها وتناقلها من جيل إلى جيل رسخت المفاهيم الفنية بحيث إن المعايير والاشتراطات تزداد صعوبة يومًا بعد الآخر، لأنه في حال قرر أحدهم اتخاذ الفن عملًا احترافيًا، وليس مجرد وسيلة للتعبير عن الذات، أو علاجًا نفسيًا، فإنه ملزم بحمل عبء تاريخه السابق بأكمله، (لن يعيد اختراع العجلة كما نقول) عليه معرفة: ما الذي وصلت إليه الكتابة على سبيل المثال؟ ما الفرق بين السيرة الذاتية والرواية؟ كيفية استخدام التاريخ والأسطورة؟ إلى آخر ما يدعونه في كليات الفنون الجميلة بدرس التشريح.. قبل أن ترسم لا بد أن تكون عالمًا بتشريح الجسد كما لو كنت طبيبًا، وبعدها تمرد كما شئت. قبل أن تكتب عليك هضم الفائت والبناء فوقه، وهكذا.
في مصر لا توجد قواعد ما، أو أنها تواجدت لفترة وضاعت الآن، المعرفة لم يعد يتم تناقلها عبر الأجيال، ليست ثمة طرائق ثابتة لهذا، المدارس والجامعات تكتفي بالمقررات التعليمية الجافة، أو أنها في أحسن الأحوال منفصلة عن المجتمع، فيما المراكز الثقافية الأساسية جزء من وزارة الثقافة التي هي بالطبع جزء من الحكومة، والحكومات تتغير والسياسات تتبدل معها، وما كان مقبولًا بالأمس ليس مستساغًا اليوم، وفضلًا عن ذلك فإن الفن لا يصنعه الموظفون ولا يمكن تعلمه منهم.
هكذا لا يكون لدينا إلا الجهود الفردية لرواد الفن وهؤلاء لن يكون في مقدورهم تحمل هذا العبء، ليبقى إذًا الفنان وحده، إيمانه بما يفعل السند الذي يضمن أن يقدم منجزًا ما أو تنهكه وعورة المشوار فيتوقف.

عندما تعقد هذه المقارنات بين ما لدينا وما لدى الآخرين تندهش حقًا أن البعض يكتب مستنكرًا أن يكون لدينا كتاب يبحثون من وراء أعمالهم عن الجوائز، أو عن الشهرة، لأن المنطق غائب عن تلك الانتقادات، الصناعات الثقافية في العالم استقرت على هذا المنوال، على أنها صناعات تنافسية، ترعى الفن والفنانين، رغبة في الربح بالطبع، وللاحتفاظ بالتفوق الحضاري، وللترويج لسياسات ما، وللهيمنة على ثقافات أخرى وتطويعها، هذه كلها أسباب معروفة وغير خافية على أحد، والفنان وحده من يقرر الاختيار من بين ما يناسب منطلقاته ودوافعه لممارسة الفن، وعلى هذا يتم صياغة المشاريع الفنية والثقافية.
فما الذي يحكم منطقنا نحن لهذه الصناعة.. أن الفنان نبي، صاحب رسالة! لا مانع بالتأكيد، لكن ما هي تحديدًا طبيعة هذه الرسالة في لحظتنا الراهنة؟ واجبه تجاه مجتمعه، وطنه، قوميته، أم واجبه تجاه الفن ذاته؟ وما المانع في أي من هذه الحالات أو غيرها من تبني أصحاب الرسائل، الفنانين بالمعنى الحديث، ورعاية أعمالهم ونشرها على نطاق واسع.. وإلا فما الذي نقصده عندما نتحدث عن الفن!.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة

















 30 يونيو.. قصة من داخل الأحداث
30 يونيو.. قصة من داخل الأحداث
 الكتابة للجميع!
الكتابة للجميع!
 فقرة الذكريات!
فقرة الذكريات!
 «رفعت عيني للسما».. ماذا وراء قصة النجاح؟
«رفعت عيني للسما».. ماذا وراء قصة النجاح؟
 الثقافة والناس
الثقافة والناس
 تكوين.. القراءة.. الحرية!
تكوين.. القراءة.. الحرية!
 من فعل ثقافي إلى جولة ملاكمة!
من فعل ثقافي إلى جولة ملاكمة!
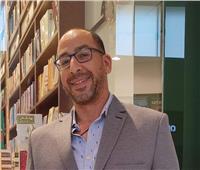 الرواية الفلسطينية وسجانها
الرواية الفلسطينية وسجانها
 ياسر عبدالحافظ ..تجارة النهايات
ياسر عبدالحافظ ..تجارة النهايات








