
بشير الديك يتحدث لـ«محمد الشماع»
بشير الديك: الأجيال الجديدة «مكسلة» تقرأ وتتثقف.. ويعتبروننا عبء عليهم | حوار
الثلاثاء، 21 ديسمبر 2021 - 04:23 م
أجرى الحوار: محمد الشماع
لأنه جزء من الواقع الاجتماعي والسياسي والثقافي في مصر، قبل كونه كاتبا سينمائيا فذا، كان اللقاء بـبشير الديك ثريا غنيا بالأفكار والمعلومات والخبايا والأسرار. ربما أسرار لم يعرفها أحد عن واقع فني يموج بعشق السينما ومؤمن بدورها ومبتغاها في إظهار هموم الناس والمجتمع.
هذا الجيل المنتمي فكريا وثقافيا لهذه الأرض الطيبة، والمكون من الديك نفسه وعاطف الطيب ومحمد خان وغيرهم، استطاعوا أن ينسجوا بالثنائية المدهشة، الكلمة والكاميرا، ثوبا مصريا خالصا يقترب لأن يكون بناءً فلسفيا أكثر من كونه حركة سينمائية مختلفة، فلا تملك وأنت تشاهد أفلاما مثل «سواق الأتوبيس» أو «الحريف» أو «ضد الحكومة» إلا أن تتشبع بحب الوطن والحلم من أجل واقع أفضل، حتى لو كان هذا الواقع الذي يرصده بشير الديك في أفلامه مؤلما مأزوما.
بشير الديك صاحب مدرسة مهمة في السيناريو، لذا فإن الحديث إليه متعة في حد ذاتها.

ما الذي حدث للسينما في مصر؟
في تقديري أن ما حدث للسينما هو ما حدث في كل مناحي الحياة، ولكن بداية التغيير كانت في النصف الثاني من التسعينيات عندما ظهرت موجة «المضحكين الجدد» من الشباب، والتي يؤرخ لها بفيلم «إسماعيلية رايح جاي»، ثم تقديم مجموعة من الأفلام الكوميدية التي تهتم فقط بإضحاك الجمهور، وهذا كان رد فعل واضح لاحتكار ثلاثة أو أربعة نجوم فقط للأعمال السينمائية قبل ظهور هذه الموجة، ربما لشعور الجمهور بالملل والتكرار وكأنه يأكل «أكل بايت».
حدث أيضا وللمرة الأولى أن إيرادات الفيلم المصري بدأت تغطي تكاليفه، بعد أن كان الاعتماد على توزيع الدول العربية والفيديو. كما حدث تغيير حقيقي في شكل الأداء وفي الأبطال وفي الموضوعات المقدمة.
استمرت هذه الموجة إلى أن قامت ثورة 25 يناير، فنشأ حس وشكل آخر للأفكار وشكل مختلف للممثلين، لكن السينما كمؤسسات افتقدت القواعد والأسس السليمة التي تستطيع من خلالها أن يتم التطوير، فإذا كانت ثقافة المجتمع المصري تحولت إلى الاستهلاك بعد الانفتاح الاقتصادي منتصف السبعينيات، فإن تلك الثقافة وصلت إلى مداها القبيح، فتحول كل شيء إلى سلعة لها سعر، وهذا ما أثر على المزاج المصري وتقبله للسينما.
اقرأ أيضا: سِر صناعة الفسيخ في نبروه خلال شهر ديسمبر| فيديو

الكثير من نجوم الأجيال الجديدة يعتقد أن التعاون مع المؤلفين والمخرجين الكبار عبء عليهم .. ما رأيك في هذا؟
هذا صحيح، لكن الطبيعي أن يكون هناك تلاقح بين الأجيال، وهذا ما حدث ويحدث في العالم كله. ما حدث في السينما المصرية ثمة قطيعة بين الجيل الحديث والجيل الأقدم، أسبابها في اعتقادي اجتماعية وثقافية، فالكثير منهم لا يوجد لديه صبر ومثابرة للمناقشة والقراءة وجلسات العمل المتعددة. للأسف لا يوجد لديهم قدرة على النمو الثقافي، لأن السينما ليست للتسلية فقط، بل بها همٌ اجتماعي وسياسي وثقافي، يجب أن يكون متوافرا بشدة، لأن نجم السينما لابد ألا يكون أقل من الأديب أو الروائي.
وعلى الرغم من ذلك، هناك نجوم من هذه الأجيال على قدر كبير من الثقافة ويصنعون سينما جيدة، لكنهم أقلية.
هناك أزمة أخرى خاصة بجيلنا نحن، وهي أننا صدرنا للأجيال التالية فكرة «عالم الفن الجميل»، الذي تكون فيه مصر خالية من الزحام والقبح والبلطجة، وهذا في واقع الأمر عالم افتراضي أيضا، لأن كل مرحلة زمنية لها قوانينها وقواعدها الجمالية الخاصة بها.
اقرأ أيضا: فبركة «السوشيال ميديا».. خبير يوضح طرق الكشف عن الصور المزيفة

لكنك عندما قدمت «سواق الأتوبيس» و«الحريف» مثلا لم تقدم هذا العالم بل قدمت عالما مليئا بالصراعات والأزمات ؟
بالضبط، فهذه رؤية فنية وفكرية، لقد قدمت عالما قاسيا، لكني كنت أبحث به عن فكرة العدالة الاجتماعية، فرصدت مثلا في «الحريف» تحديدًا العالم الصعب القادم، فـ«بكر» نجل بطل الفيلم «فارس» سأله في آخر مشهد: «إنت مش هتلعب تاني يا آبا؟»، فرد عليه الأب: «زمن اللعب خلص»، ليبدأ عصر الانفتاح والاستهلاك في منتصف السبعينيات، وأنا في تقديري أنه منذ 1974 حدث انهيار حقيقي.
محمد خان وعاطف الطيب وعلي بدرخان وأشرف فهمي ونادر جلال وعلي عبدالخالق.. كل هؤلاء مخرجون تعاونت معهم.. فمع أيهم كنت تشعر بأن السيناريو الذي كتبته في يد أمينة؟
عاطف الطيب بالتأكيد. لقد قابلته بعد فيلمه الأول «الغيرة القاتلة»، وأذكر أن الناقد الراحل سمير فريد أطلعني على مقال نقدي له عن الفيلم قبل نشره، قال فيه: «إن هذا المخرج لابد أن يعود إلى معهد السينما مرة أخرى». لقد شاهدت الفيلم وأعجبني فيه قدرته الكبيرة على التعبير بالكاميرا، رغم مستوى الفيلم العادي. كنت أشعر أن هناك مخرج كبير يُولد. التقيته أثناء تصوير فيلم «موعد على العشاء» بالإسكندرية من خلال مدير التصوير الكبير سعيد شيمي، ثم جمعنا الراحل نور الشريف في «سواق الأتوبيس». لقد شعرت معه بتلاقي واقتراب نفسي وروحي، لأنه مصري بامتياز، وابن منطقة شعبية، هذا كله سهل لنا مهمتنا في عمل أفلام مهمة بعد ذلك.
اقرأ أيضا: د.محمد غنيم: مفوضية للتعليم تتبع رئاسة الجمهورية ضرورة حتمية | حوار
أحمد زكي ونور الشريف ونادية الجندي ومحمود عبدالعزيز.. نجومٌ كانوا أبطالا لأفلامك.. فأيهم كنت تشعر بأنه يقدم الشخصية كما كنت تود؟
كنت أتخيل بطلي دائما، فإذا كان شابا فهو أحمد زكي، فهو قابل للتحولات الكبيرة، أذكر أنه في فيلم «امرأة هزت عرش مصر» لنادية الجندي وفي مرحلة اختيار الممثلين كنا نبحث عن ممثل لدور الملك فاروق، فاقترحت أحمد زكي، رغم اختلاف البشرة وحجم الجسم، فهو لأول وهلة سيسبب مشكلة لدى المتلقي، لكن بعد 3 دقائق فقط ستجده الملك فاروق فعلا. بالتأكيد كنت أمزح، لأن زكي لم يكن ليقبل الدور كما كان مكتوبا في السيناريو، لكنني كنت واثقا في أنه يستطيع أن يقوم بأي دور، خصوصا الذي يتميز بانقلابات حادة، مثل فيلم «ضد الحكومة»، حيث انتقل من محامي تعويضات سيء السمعة، إلى شخص يحاول أن يتطهّر. زكي يعرف جيدا أن يعيش الدور والحالة، وأن يؤدي أمام الكاميرا أيا ما كان، وهو ما كان يميزه، ويميز سعاد حسني أيضا.
أما نور الشريف فهو عقل مفكر وفنان ملتزم ومثقف، وهذا يسهّل التعامل معه، ويعطي بأدائه ما تريده بدون شطحات. نور أدواته الخارجية قوية جدا، يعلم جيدا كيف يلبس وكيف يتحرك.
وماذا عن نادية الجندي؟
نادي الجندي «معلمة». هي ممثلة «شاطرة» وجميلة وفوق كل ذلك صديقتي. هي مثل أحمد زكي تقريبا، لكني أعيب عليها بأنها أحيانا ما تكون «over acting»، أي ترتدي ملابس أو إكسسوارات غير مناسبة للشخصية ولطبيعة المشهد الذي يصوّر، لكنها في النهاية إنسانة رائعة، ولن أنسى لها موقفها الداعم لي وقت محنة وفاة ابنى أحمد.
ما الذي كان يميز عاطف الطيب عن مخرجي جيله؟
لا أستطيع القول بأن عاطف الطيب كان مثقفا رفيعا، لكن أهم ما كان يميزه هو أنه مصري أكثر مما ينبغي، ومصري أي ابن الحارة، أو ابن الشارع، بالإضافة إلى أنه كان موهوبا موهبة بسيطة وعميقة في آن واحد، كحال الموهوبين الحقيقيين، فهو لم يكن يستطيع أن يتحدث عن موهبته ويبروزها، لكنه يعرف عندما يختار حجم لقطة في فيلم، يختارها بعناية ودقة وفي اللحظة الصحيحة والمناسبة، كما أنه كان متفهما لأقصى درجة، فلم يكن جاثما على السيناريو، بالعكس تماما كان يحلم مع الكاتب.
كان عاطف الطيب قريبا جدا إلىّ داخليا، خصوصا في طريقة بحثنا عن الطريق الذي نسلكه في صناعة الفيلم. لقد كنا متناغمين، بحيث لا تستطيع أن تمسك النقطة التي ينتهي عندها دور كاتب السيناريو والنقطة التي يبدأ عندها دور المخرج، لأن طريقتنا واحدة في التعبير عن الرؤية.
وصفت «سواق الأتوبيس» بأنه كان «نقلة» في حياتك المهنية.. فماذا كان بشير الديك قبل «سواق الأتوبيس» وماذا أصبح من بعده؟
قبل «سواق الأتوبيس» كنت مشروع أديب، لقد كتبت القصة القصيرة قبل دخولي السينما، ونشرت عددًا منها في بعض المجلات، ولكن حلم السينما ظل يراودني، لأنه عالم مذهل وساحر وقادر على التعبير والوصول إلى ملايين الناس، بدلا من بضعة آلاف هم قراء الأدب في مصر تقريبا.
قبل «سواق الأتوبيس» قدمت أفلام «مع سبق الإصرار» و«موعد على العشاء»، و«طائر على الطريق»، فمارست دور الأديب في كتابة شخصيات وحوارات وعالم هذه الأعمال، إلى أن جاء «سواق الأتوبيس» الذي مثل بالنسبة لي اعتراف مذهل من الجميع.
أذكر أنه عندما أنجزنا النسخة الأولى للفيلم، أخذناها في سيارة عاطف الطيب من المعمل إلى مهرجان الإسكندرية، حيث كان الفيلم مشتركًا في المسابقة الرسمية به، فجلسنا مع القائمين على المهرجان ووجدناهم يتحدثون عن الجوائز ويخبروننا بأن عددا من أفراد لجنة التحكيم قد غادر بالفعل وقبل انتهاء المهرجان، فأخبرناهم بأن فيلمنا لم يعرض بعد، وبالفعل شاهد المتبقون من اللجنة ومنهم أحمد عبدالوهاب وعبدالحي أديب وغيرهم، فأصابهم الذهول.
وقتها النقاد تساءلوا كيف نصنع فيلما مثل هذا يناقش الظروف السياسية والاجتماعية دون أن يكون «دمه تقيل».
وهل معنى ذلك أن الأفلام التي تلت «سواق الأتوبيس» تخليت فيها عن دور الأديب؟
لا بالتأكيد، لأنني أكتب ما أراه، وهذا هو منهج القصة القصيرة، وليست الرواية، التي استخدمت تقنيتها في المسلسلات فيما بعد. فمنهج القصة القصيرة هو المعتمد على التكثيف والإيحاء والتلميح أكثر من الثرثرة والتصريح.
لاحظنا أن خانة القصة في «سواق الأتوبيس» كان مكتوب فيها إلى جوار اسمك اسم محمد خان.. وفي الوقت نفسه كان الفيلم من إخراج عاطف الطيب.. كيف حدث ذلك؟
خان كان يريد أن يصنع فيلما بعنوان «حطمت قيودي»، عن سائق تاكسي يعاني من مشكلات عديدة في بيته، فركب معه شخص ثرثار، فلم يطيقه، ثم يوقف السيارة على أحد الكباري، ويهبط منها ويشعل في السيارة النار بالشخص.
وعندما سألته عما يحدث قبل ذلك أو بعد ذلك قال لي «ما ده شغلك بقى». لقد وضعنا اسم خان لكي نحفظ حقه في الفكرة التي على الرغم من ذلك لم آخذ منها شيئا. وأذكر أنه عندما قرأ «المعالجة» شعر أن الفيلم ليس فيلمه فأعطاه لعاطف الطيب.
أقدمت على تجربة الإخراج في فيلمين .. فلماذا لم تستمر؟
أخرجت للضرورات، فقد بدأت مشواري مع محمد خان وعاطف الطيب في المطبخ، أتواجد في التصوير وأحضر المونتاج وأتحدث في الموسيقى، إلى أن كتبت «سكة سفر» الذي كان يتحدث عن أحلام البسطاء في السفر إلى الخليج فخدعهم نصاب وسفرهم إلى أسوان، حيث كان المفترض أن يخرج هذا العمل المخرج الكبير عاطف سالم، وبالفعل بدأنا في معاينة أماكن التصوير عند بحيرة المنزلة، وورش النجارة في دمياط وغيرها، لكن لظروف ما لم يستكمله، فصممت أن أكون أنا المخرج، لأنني كنت أرى أن هذا الموضوع هو ملكي وملك لطفولتي وعالمي وشوارع القرية التي أعرفها جيدا.
وفي أثناء تحضيري لـ«سكة سفر» جاءني أحد أهالي القرية وأخبرني بأن الأرض التي تمتلكها أمه والتي اشتراها أبوه المتوفي منذ عشرات السنوات بـ 200 جنيه معروض عليها أن تبيعها بمبلغ مليون جنيه، وهي ترفض ذلك لارتباطها الشديد بها، فنصحته أن يقتلها، وعندما أندهش، قلت له أنني سأفعل ذلك في سيناريو فيلم جديد وهو «الطوفان» الذي كان أجهز إنتاجيا من «سكة سفر»، وبالفعل قدمته أولا.
في أوائل الثمانينيات قدمت عملين مهمين وهما «سواق الأتوبيس» ثم «الحريف».. فهما منطقتان متباينتان يمثلان منهجي عاطف الطيب ومحمد خان على الترتيب.. فإلى أي مدى يؤثر منهج المخرج في كتابة الموضوع؟
«الحريف» كان قريبا جدا من عالم محمد خان، فهو عاشق للقاهرة، ربما يكون الشيء الوحيد الذي يعرفه هو المدينة، أما عاطف الطيب فهو يعلم جيدا شخصية عالم ابن القرية الذي تصدمه المدينة.
وهل كان «ناجي العلي» قريبا من عالم عاطف الطيب؟
لم يكن بعيدا عن اهتمامنا وهمنا السياسي. عندما أخبرني نور الشريف عن رغبته في صنع فيلم عن رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، قلت له إنني لا أعرف عنه شيئا، فقال لي «هنجيب لك كل حاجة»، وبالفعل أحضروا لي آخر معارضه وكتابين عنه، وبدأت رحلة طويلة وراء ناجي العلي، فذهبت إلى مخيم «عين الحلوة» في لبنان، حيث عاش طفولته، وإلى صيدا التي كان يعيش فيها، وإلى لندن، ثم الكويت وتونس.
الغريب أن الفيلم كان سيخرجه صلاح أبو سيف، وعندما جلسنا سويا، شعرت أن رؤيته للقضية الفلسطينية مختلفة تماما عن رؤيتي، فضلا عن أن تقدمه في السن كان سيحول دون تقديمه بالشكل المنتظر لأنه فيلم «فيه شقا»، ويحتاج إلى مخرج شاب، وبالفعل أخرجه عاطف الطيب، الذي كان يشعر بالمسؤولية الرهيبة الملقاة عليه في أول وهلة.
كيف كنت ترى الهجوم الشرس الذي قوبل به فيلم «ناجي العلي»؟
لم يكن هذا الهجوم مبررا في الحقيقة، ولكن يبدو أن هناك قصة كتبها الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة اسمها على ما أذكر «القنبلة»، وعرضها على نور الشريف لأن تكون فيلمًا، وعندما رفضها شن الأول عليه هذه الحملة الرهيبة، بحجة أن فيلم «ناجي العلي» يتحدث عن رجل كان يكره مصر، وهذه الحجة رددنا عليها بأن «العلي» كان ينتقد اتفاقية السلام، وأن شأنه في ذلك شأن كثير من المثقفين المصريين أنفسهم.
لقد وصلت الحملة إلى مطالبة البعض بسحب الجنسية المصرية منا. ولكن فجأة توقف الهجوم. وعرفت بعد ذلك أن إبراهيم سعدة كان مع مبارك على متن طائرة في رحلة عودة من إحدى زياراته الخارجية وسأل عن ضجة «ناجي العلي»، فأخبره سعدة بأنه فيلم تدور أحداثه حول رجل يسخر منه ويرسمه كأنه «بقرة ضاحكة»، فقال له مبارك: «يا عم بلاش كلام فارغ»، وبالفعل توقف الهجوم.
إذا استطعنا أن نتلاعب بالزمن وبالأقدار.. ولم ينفذ حتى الآن فيلم «ضد الحكومة» .. هل تتحمس لتقديمها الآن؟
بالتأكيد أتمنى أن أقدمه. «ضد الحكومة» بدأ من مجموعة مقالات كتبها وجيه أبوذكري عن محامين التعويضات، الذين كان يكرههم بشدة، وكتب بالفعل قصة عن محامي قذر جدا وناشيء في بيئة قذرة وكذلك أهله، وعلى الجانب الآخر محامي خيّر، فقلت له: «طب ليه مانخليش الاتنين دول واحد؟»، قال لي «إزاي»، أخبرته أننا نقدم محامي قذر ثم يحدث له تحول فيصير هذا المحامي الطيب، فقال لي: «دي شغلتك بقى».
عندما خرج «ضد الحكومة» إلى النور لم يعجب أبوذكري، لأن همه كان كيفية أن يكره الناس محامي التعويضات، وهنا تأتي أهمية المعالجة السينمائية وبناء الشخصيات والأحداث، فعالم السيناريو مختلف تماما عن عالم النص المأخوذ عنه هذا السيناريو، حتى لو كانت رواية لنجيب محفوظ، فهذا العالم هو ملك المؤلف تماما، لأنه من المفترض ألا يكون مترجما وناقلا بل ممارسا إبداعه على النص الأصلي، حتى لو اختلف الموضوع.
قدمت من إنتاج السبكية فيلمين الأول «امرأة هزت عرش مصر» والثاني «حلق حوش».. احك لنا عن تجربتك معهم.. من الذي اتفق معك؟.. وهل كان لهم رأي في السيناريو أو في اختيار الممثلين؟
فيلم «حلق حوش» تحديدا كان بطولة هنيدي وعلاء ولي الدين وبنت صغيرة، فجاء لي محمد السبكي وقال لي: «مش عارف أبيع الفيلم.. علشان خاطري نخلي الطفلة سيدة كبيرة وتقوم ليلى علوي بالدور علشان الفيلم يتباع»، فاستهوتني الفكرة وكتبت الدور من جديد.
محمد هو من كان يتفق معي لأن أحمد كان مشغولا بالفيديو وليس بالإنتاج. قابلني محمد عندما كان يريد إنتاج أول أفلامهم، وأخبرني أنه يريد فيلما يوافق عليه نور الشريف، فضحكت من هذا الطلب، على الرغم من أن نور صديقي جدا، ولكني قلت له: «مش سكتي يا محمد.. ممكن أكتب فيلم وميعجبش نور الشريف.. عايز تشتغل معايا تشتغل بشكل محترف ويكون الأساس عندك هو الكاتب والمخرج»، إلى أن جاءت فكرة «حلق حوش»، وبالمناسبة كان سيخرجه عاطف الطيب، لكن القدر لم يمهله.
أما مسألة التدخل في السيناريو فهذا لم يكن مطروحا في الأساس، من الممكن طبعا أن يقول رأيه، لكن هذا الباب لم يكن مفتوحا.
إذا عرضت عليك إحدى شركتي السبكي كتابة سيناريو لفيلم من إنتاجهم الآن.. هل سترضى؟
أحمد السبكي صنع أفلاما جيدة، ومنها «كباريه» و«الفرح» وكذلك «الليلة الكبيرة»، وهي تيمة مجنونة حيرتنا جميعا في كيفية تناولها، ومجرد الإقدام على إنتاج فيلم عنها بطولة ويستحق الإشادة، على الرغم من أن كتابتها تحتاج إلى إبداع حقيقي. فإذا أرادني أحمد السبكي فمن الممكن أن أوافق، أما محمد السبكي فمن الصعب، فطريقه واضح جدا.
بمناسبة تيمة «الليلة الكبيرة».. ما هي التيمة التي يحلم بشير الديك بتقديمها؟
كنت أحلم طوال الوقت بتقديم تيمة «البديل»، وتجسدت في أفضل صورها مع المخرج الياباني الكبير أكيرا كيروساوا في فيلم «ظل المحارب». وبالفعل قدمتها في مسلسل يحمل نفس الاسم مع نادر جلال.
وما حكاية المشروع الذي لم يكتمل لفاتن حمامة؟
بعد «سواق الأتوبيس» أبدت العظيمة فاتن حمامة رغبتها في التعاون معنا (أنا وعاطف)، وبالفعل وجدت موضوعا مستوحى من حادثة حقيقية وقعت في صعيد مصر، عن امرأة رأت سيدنا الحسين في منامها، فحملت ابنها رضيعا على كتفها وجاء للقاهرة حتى تلبي نداء الحسين. جاءت بدون أكل أو شرب أو مال، فخارت قواها تماما في الشارع وغابت عن الوعي، وعندما فاقت في قسم الشرطة بعد اتهامها بخطف الطفل، لم تجد ابنها، الذي دخل إحدى مؤسسات الرعاية التابعة للدولة، أما السيدة فماتت في مستشفى للأمراض العقلية.
كتبت المعالجة وسميت الفيلم «الرؤية»، وعندما قدمت هذا المشروع للرقابة، وجدت أن مخرجا آخرا قدمه أيضا وهو هاني يان، فاستأذنني فتركته له، وبالفعل صنع الفيلم باسم «وعد ومكتوب» وكانت بطلته سهير البابلي، ولم ينجح لأنه موضوع قاتم جدا.
فيلم «الكبار» وهو آخر عمل قدمته في السينما الروائية.. وكان من إخراج محمد جمال العدل.. فما الفرق بين العمل مع مخرج شاب من جيل مختلف عن العمل مع مخرجين من نفس جيلك؟
هذا السيناريو كان موجودا عند آل العدل بالفعل، وكان سينفذه عاطف الطيب، فوجده محمد في المكتب، واتصل بي هاتفيا، وقال لي: «فيه فيلم لقيته عند بابا، وعاجبني قوي، وعايز أخرجه.. ممكن؟»، فوافقت لإيماني الشديد به، لأنني شاهدت مشروع تخرجه من معهد السينما، وكان رائعا.
شددت عليه بضرورة أن نلتقي لنناقش بعض تفاصيل السيناريو، لكنني انشغلت بعد ذلك بكتابة مسلسل «ظل المحارب»، وأذكر انه اتصل بي هاتفيًا أول أيام تصوير الفيلم، ولم استطع مقابلته، فأنا اعتبره ظُلم معي في هذه التجربة.
صرحت من قبل إنك كتبت فيلم «الهروب» والذي كتب عليه اسم السيناريست مصطفى محرم.. كيف حدث ذلك؟
في بداية الأمر طـُلب مني أن أصلح سيناريو الفيلم، فرفضت في البداية، لكن عاطف الطيب والمنتج مدحت الشريف تمسكا بي جدا خصوصا بعد رفض نور الشريف للفيلم، فرضخت بشرط أن يأخذوا رأي مصطفى محرم كاتب السيناريو الأصلي، فهو بمثابة أستاذ لي وسبقني في العمل بالسينما، ووافقت ومضيت العقد، وفي نفس اليوم جاء لي الراحل أحمد زكي وأعطاني خمسة آلاف جنيه، لكنني أخذت قرارا بألا يوضع اسمي عليه.
كتبت الفيلم كاملا، لأنني لا أجيد «الترقيع»، لدرجة أن الناقد الكبير سامي السلاموني عندما شاهد الفيلم قال في وجود عاطف الطيب ومصطفى محرم: «ده حوار بشير الديك.. فين اسمه؟».
«الحفار» و«حرب الجواسيس» و«عابد كرمان» أعمال مستوحاة من ملفات مخابراتية.. لماذا تستهويك الكتابة في هذه المنطقة تحديدا؟
في مثل هذه الأعمال يمكنني تقديم حس وطني قوي، من خلال موضوعات تمس الوطن والأرض وتتناول أيضا القضية الفلسطينية، أيضا تستهويني فكرة كيفية كسب الحرب بالذكاء، لأن أهم ما يميز حرفة السيناريو هو كسر التوقع وانتقاء التفاصيل لإثارة دهشة المتلقي.
ولكن أول عمل قدمته في هذه المنطقة بالدراما كان «الحفار» عن قصة صالح مرسي، وللأسف لم يُقدم بالشكل الأمثل إخراجيا، لدرجة أنني لم أستطع أن أشاهد منه سوى أول حلقتين فقط.
أخيرًا كنت تعمل على مسلسل جديد بعنوان «وحش الشاشة» أو «الفتوة وبنت البلد» الذي يتناول سيرة حياة فريد شوقي.. هل نأمل أن يظهر المشروع للنور قريبًا؟
المشروع متعثر الآن، لكن بدايته عندما طلبت مني المنتجة ناهد فريد شوقي تقديم عملا عن والدها، فأخبرتها أنني لا أحب أعمال السيرة الذاتية، وفي يوم من الأيام سمعت هدى سلطان وهي تتحدث في برنامج إذاعي عن تاريخها، فاتصلت بناهد وقلت لها: «أنا ممكن أعمل قصة الحب بين فريد شوقي وهدى سلطان»، وبدأت أعمل من هذا المنطلق، كان في ذهني أن أقدم معرض صور ومقاطع من الأفلام القديمة ومن ذلك العالم السحري، ونعيد تصوير أجزاء من الأفلام التي سنستخدمها، لنرى كيف كان هذا العالم مدهشا وناجحا.
ثم جاءت مرحلة اختيار الممثل الذي يجسد فريد شوقي وهدى سلطان، فكان رأيي أن يكون الجميع من الشباب، وبالفعل تحمست ناهد جدا لذلك، ثم حدث التعثر الإنتاجي والتوزيعي.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 رموز «الحوار الوطني» يتحدثون عن المبادرة الأهم بتاريخ مصر الحديث
رموز «الحوار الوطني» يتحدثون عن المبادرة الأهم بتاريخ مصر الحديث
 إنجازات الصحة| 402 مشروع قومي بالصعيد.. و8 مشروعات بشمال سيناء
إنجازات الصحة| 402 مشروع قومي بالصعيد.. و8 مشروعات بشمال سيناء
 بالأرقام.. طفرات وإنجازات غير مسبوقة بالقطاع الصحي في عهد الرئيس السيسي
بالأرقام.. طفرات وإنجازات غير مسبوقة بالقطاع الصحي في عهد الرئيس السيسي
 محافظ شمال سيناء: إقامة مشروعات تنموية وبنية تحتية بتكلفة 800 مليار جنيه| حوار
محافظ شمال سيناء: إقامة مشروعات تنموية وبنية تحتية بتكلفة 800 مليار جنيه| حوار
 سياسة النفس الطويل.. كيف حررت الدبلوماسية المصرية طابا؟
سياسة النفس الطويل.. كيف حررت الدبلوماسية المصرية طابا؟
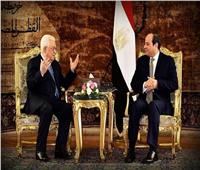 200 يوم من الدبلوماسية والدعم.. مصر صوت الحكمة بغزة
200 يوم من الدبلوماسية والدعم.. مصر صوت الحكمة بغزة
 عيد تحرير سيناء.. شيوخ سيناء يتحدثون في ذكرى استرداد الأرض
عيد تحرير سيناء.. شيوخ سيناء يتحدثون في ذكرى استرداد الأرض
 منظومة التعليم العالي تشهد إنجازًا تاريخيًّا في سيناء في عهد الرئيس السيسي
منظومة التعليم العالي تشهد إنجازًا تاريخيًّا في سيناء في عهد الرئيس السيسي
 خير سيناء.. مليون طن من أجود أنواع الملح في العالم بـ «ملاحة سبيكة»
خير سيناء.. مليون طن من أجود أنواع الملح في العالم بـ «ملاحة سبيكة»





















