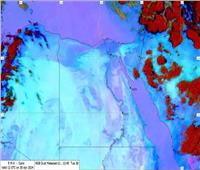صورة أرشيفية
عهود حجازى تكتب : الطبق الفارغ
السبت، 19 أغسطس 2023 - 01:39 م
كان القمر مكتملاً تلك الليلة، أبيض مثل الحلم، وتحته كنا أنا ورفاقى نجوب الليل بالسهر أمام البحر، وعلى يميننا ينطلق عزف جميل لفرقة مغمورة، يحاول أفرادها أن تبدو قدراتهم متماثلة، ولكنّ العازف الجيد كان ملحوظاً لوحده، فى ذلك الوقت الرائق من شهر مايو عام 2022، لمحته داخلاً إلى صالة الطعام الزجاجية، فى الوقت الذى لم يكن متبقياً فى سخانات الطعام سوى بعض الفتات، دخل حائراً ماذا يأكل، وطبقه الفارغ فى يده، يحمله ولا ينظر إلى صوانى الطعام، لكنه كان شارداً، ينظر للأمام وكأنه مجتزَأ من زمن آخر. دخلتُ متصنعة البحث عن قارورة ماء، وعيناى تراقبانه، كان يرتدى ملابس بيضاء تماماً، وكان لونه الأبيض ذائباً فى لون لباسه، كأنه ملاك، لا ينقصه سوى الأجنحة.
وقفتُ أمامه مقاطِعة طريقه فلم يلمحنى، بل أكمل للأمام وعيناه تريان اللا شىء، فاصطدم بى، واستيقظ من سهوه الساحر.
سامحينى.. المعذرة.. كيف لم أنتبه!
كان سماعه لذيذاً، كيف لم ينتبه حقاً؟ هل أنا غير مرئية؟
كدتَ أن تُسقط طبقك الفارغ على ملابسى
أعتذر بشدة.. هل آذيتكِ؟
كدتَ أن تفعل
سرّتنى قوّتى فى جذبه لزاوية الاعتذار لأنها سبيلٌ لمدّ حبل الكلام بيننا، بل وفتح نافذة على الحديث.
هل نأكل معاً؟ هناك طاولة فارغة.
لا أمانع، هل معكِ رفقة؟
لا، ولكن عليك ملء طبقكِ أولاً
آه صحيح.. اسبقينى وسألحق بكِ
من جديد، مشى بطبقه الفارغ، واصطدم بأحد آخر وانفتحت حوارات أخرى، يبدو أننى لست الوحيدة التى تراقبه. لكن لحسن الحظ أنه تذكّرنى جالسة هناك، فأشرتُ إليه، فلوّح لى، وأضاف إلى طبقه ملعقة أرز واحدة، وحبة واحدة من البطاطا المقلية، ثم اتجه نحوى، فاعتدلتُ فى جلستى وابتسمتُ له حين جلس.
لم تكن عيناه لتريا شيئاً بعينه، كانتا تدوران فى المكان ببطء، يطالع السقف والجدران والأشياء التى تعلو رؤوس الناس، لم يكن من السهل أبداً اصطياد عينيه وتوجيههما للتركيز فى عينى.
قلتِ ماذا تعملين؟
أنا صحفية، ولكنها ليست مهنتى الأساسية، لكننى أعرّف بها نفسى.
وأنا طبيب، ببساطة.
أعرف.

كيف تعرفين؟
تبادلنا عدة عبارات، ولمحت ملعقته تتحرك فى طبقه بدون الوصول إلى فمه، كان يحركها بين حبات الأرز المعدودة، ثم ينسى أن يرفعها، ويعود ليحركها مبعداً حبة البطاطا الوحيدة كل مرة.
ما اسمكِ؟ لم نتعرف بعد.
تعرفنا فى حفل سابق.
هل أجريتِ معى لقاء صحفياً؟
بالضبط.
لا أتذكر أننى رأيتكِ من قبل.
كان عمال المطعم قد شرعوا فى إخلائه بطريقة مهذبة، فأزالوا أغطية الطاولات المجاورة، وجمّعوا الأطباق المتسخة وأدوات المائدة من جميع الأسطح، وظلوا يحومون حولنا، وأنا منفردة بتأملاتى مع هذا الرجل الساهى الذى حصلت عليه أخيراً لوقت محدود. حتى اقترب رئيس العاملين منا بهدوء وقال معتذراً بتهذيب شديد بأن علينا الخروج لأنهم يغلقون المطعم.
وقتها شعرتُ بأنّ فرصتى الوحيدة قد ذهبت منى، وبأنّ على اختلاق فرصة أخرى، ولكن متى وكيف، وهل بالوسع اصطياد الملاك من جديد؟
خرجنا معاً، أنا وهو، والأضواء تُطفأ من خلفنا، والموسيقى على البحر تصدح أمامنا، وعيناه ذاهبتان فى البعيد المجهول، أساله عن أشياء ويجيبنى عن أخرى. فاضطررت إلى الإمساك بكفه لكى أعيده إلى البقعة التى نحن فيها، فقال بأنه متعَب من السفر، وسوف يعاود الاتصال بى غداً. قال هذا بثقة تامة مع أنه لا يعرف حتى رقمى.
بعد أسبوع من عودتى إلى ديارى، راسلنى من رقمه الذى أحفظه فى هاتفى باسمه. ظهر اسمه على تطبيق المحادثة حوالى العاشرة مساء، فلم أنتظر إلى الصباح كعادتى حين تصلنى الرسائل بعد الثامنة، بل فتحتها على الفور واستمعتُ إليها بشغف، متسائلة عن الشىء الذى أعاده إلى، وكم استغرقه الوقت حتى يتذكر وعده، ومن أين حصل على رقمى، بل ماذا يريد بعد أسبوع من ذلك اللقاء العابر.
بدأت رسالته الصوتية بعبارات قصيرة يتأسف فيها على سرعة مرور الوقت، وبأنه لم يمهلنا حتى نلتقى مجدداً، متسائلاً عما لو كنتُ الليلة أملك وقتاً لكى نذهب فى رحلة بالسيارة عبر المعالم البارزة فى مدينته الجميلة كما وصفها؟
أعدتُ سماع الرسالة مرات، متلذذة بسماع لهجته ومخارج حروفه، وإدراكه البطىء للأشياء الجميلة الذاهبة، وأفكاره التى يبدأ فيها ولا يكملها، كان فى تعبيره أكثر سحراً من طريقته فى النظر إلى السماء دون أن ينظر.
فكتبتُ له رسالة، ثم محوتها، وآثرتُ أن أسجل له رسالة صوتية أيضاً، رداً على الصوت بالصوت، فلربما كان لا يفضّل الكتابة. وقلت له بنبرة مسرورة بأننى سعيدة بتواصله، ولكننى يا للأسف لم أعد هناك حيث التقينا، بل عدت إلى مدينتى وحياتى، وقد نجدد اللقاء فى العام القادم فى المناسبة نفسها لو أنّ أعمارنا امتدت، وظللنا نحن نحن.
فأجاب كتابةً (أوه) بدون إضافة أخرى، وظللتُ أنتظر تعقيباً على تلك الـ (أوه) فلم يحدث.
بعد عدة أيام، أرسل لى بأنه متأسف لأننى سافرتُ قبل أن نلتقى مجدداً، ووعدنى بأنه سيأخذنى فى تلك الرحلة فى العام القادم، مؤكداً على شعوره بأننا سنلتقى قبلها. ولم أعرف لماذا قال هذا، وأين سنلتقى، وكل واحد منا يسكن بعيداً، ولا توجد مناسبات مشتركة تجمعنا، لكننى سعدتُ باهتمامه، حتى لو كان على سبيل المجاملة، فلا يبدو أنه قادر على جرح شعور عصفور، كان حريصاً فيما يبدو على ما يتعلق بالمشاعر.
فى تلك الفترة من حياتى كنتُ أؤدى عدة امتحانات فى وقت واحد، بعضها يتعلق باستصدار رخصة مهنية وبعضها الآخر بدراستى التى أقحمتُ نفسى فيها دون استعداد نفسى مسبق، فكانت النتيجة اجتماع الأشياء الصعبة فوق رأسى، سيما وأننى امرأة لا تتنفس تحت الضغط وأتنازل عن التحدى بسهولة، لكننى مجبرة هذه المرة على تسلق الجبل واحتمال تقلباتى النفسية الشديدة من أجل استبقاء لقمة العيش.
فى الوقت نفسه كنتُ أُخلى منزل والدى وأعرضه للبيع، هذا المنزل الذى عشت فيه طفولتى وشبابى، وقضيت مع والدى أجمل العمر وأصعبه، حتى حان وقت الشجاعة، فتركانى وحيدة أجوب العالم بضياع تام بعد أن رحلا واحداً خلف واحد.
قاومتُ فكرة مغادرة بيتهما، وبعناد، جددتُ الأثاث وصبغتُ الجدران، كما غيرت من نظام الحجرات واستقبلت ضيوفى الكثيرين فى البيت وتبنيتُ كلباً وقطتين. لكنّ هذه الأشياء كلها لم تكن لتسعد قلبى ولا لتبدد وحشة البيت الذى لم أشعر فيه إلا بفزع الوحدة على الرغم من كل ما فعلته.
كانت مشاغلى كثيرة، وكنتُ أبحث عن بيت جديد للانتقال إليه بمجرد بيع منزل والدى وقبض ثمنه، ووقع اختيارى على شقة واسعة بجدران معظمها زجاجى ومطلّ على المدينة من الطابق السابع، فاتفقت مع البائع أن يحجزها لى بمبلغ مقدّم، واشترط على تسديد باقى الثمن بانتهاء العام الذى لم يبق منه سوى أربعة أشهر، فوعدته أن أفعل، على أن يعيد لى مبلغ الحجز فى حال عجزت عن التسديد إن لم يحظَ بيت والدى بمن يشتريه، فوافق ووقّعنا العقد.
لم أعرف وقتها فى أى بيت أعيش، هل أنتقل بالكامل إلى شقتى الجديدة، مغامِرة بالعودة إلى البيت القديم فى حال لم أتمكن من بيعه، أم أظل هناك بين الأشباح والخوف مع أننى بحاجة ماسة إلى الاستقرار والتركيز من أجل أداء امتحاناتى. ولا أدرى وسط تلك الحيرة لماذا لم يخطر بذهنى سوى رجلى التائه ذاك، فاتصلت به لأسأله، مؤكدة على أنه سؤال بسيط، ولكنه شديد الأهمية بالنسبة لى، ولم أجد من يقرر معى ويشير لى إلى الفكرة الصائبة، مع جهلى التام بما سيقوله فى قلبه عنى ولا عن موقعه من كرة الأرض الآن وعن رفاقه فى ذلك الوقت الذى خاطرتُ فيه واتصلتُ برجل لا يعرفنى ولا أعرفه.
رحّب بى وحالت بيننا دقيقة صمت، فأخبرته باختصار عن المشكلة التى تواجهنى، وبمخاوفى وحرصى على الاختيار خلال فترة قصيرة بدون خسارة كبيرة، وسألته: «ما رأيك»، فقال بعد تفكير وصمت: «أى البيتين تريدين؟» فعرفتُ بأننى هاتفته ليس لاستشارته، ولكن لسماع صوته.
خلال شهرين اقتربنا من بعضنا بصورة سطحية، عرف كل منا عن الآخر المعلومات التى يعرفها كل إنسان يعرفنا، وكنا نتحدث على سبيل تزجية الوقت، ولم يكن أياً منا ليمنح الآخر وقتاً خاصاً، بل نتراسل بهدوء باهِت، مع أننى أعترف ظللتُ أنتظره بلهفة، على الرغم من انقطاعاته الطويلة ونسيانه كل مرة لما تحدثنا عنه آخر مرة، لكنه لم يكن بالنسبة لى أمراً مستفزاً، فبالتأكيد يقابل الكثير من الناس كل يوم بحكم مهنته، ويلقى بالكلام جزافاً مع كل أولئك الناس، فلماذا يولينى أهمية خاصة وليس بيننا ارتباط يُذكر؟
عرفتُ بأنه يقيم وحيداً، وهو الرجل الأعزب الوحيد فى دائرتى الحالية، التى بمعجزة ما لم يعد فيها رجل أعزب واحد، وعرفت أيضاً بأنه مرّ بعدة تجارب طلاق، نعم عدّة وليست واحدة، فخمّنتُ بالطبع بأنّ النساء يردن رجلاً ينظر فى أعينهن وليس فى السماء، لكنه صحح لى المعلومة بأنه كان مَن يطلب الانفصال فى جميع زواجاته. وبعد ستة أشهر من حصولى على رخصتى المهنية احتفلت مع أصدقائى على يخت فى عرض البحر ودعوته للحضور فهنّأنى بصوت مبتهِج وقال بأنه يقيم مؤقتاً فى كندا.
بعد تلك المحادثة تخليتُ عنه تماماً، وأدخلته إلى خزانة اللا مفهوم، وتزوجتُ رجلاً من خارج البلاد، ثم عدتُ بعد ستة أعوام منفصلة، بطفلٍ وتجربة مريرة. وحين رجعتُ إلى بلدى، لم تكن الأشياء هى نفسها التى تركتها عليها، كأننى كنت أعيش فى الجنة وأنظر بملل إلى أهل الأرض، ولكننى بعد خوض الحياة الحقيقية اكتشفتُ بأننى كنت حالمة مدللة، وبأن المعاناة جرّدت قلبى من قشرته الخارجية، فأصبح يخشى كل شىء ويتوجع إن طرقته كلمة.
وبعد عامٍ من محاولات التشافى، تذكرنى أحد الأصدقاء النافذين، فأوصى بى لجهة تدفع مرتّباً جيداً، وحصلتُ على وظيفة ممتازة، كما أنّ ابنى التحق بالمدرسة الابتدائية، فشعرتُ بأنّ الحياة تحاول استعادة ثقتى وتبعث لى بالهدايا. وكنت وقتها أقيم فى شقتى التى اشتريتها فى الطابق السابع قبل الزواج، ولم أجدد فيها شيئاً، كونها كانت شبه خالية من الأثاث، فاخترتُ غرفة لابنى ونزلنا معاً إلى السوق لشراء مستلزماته.
وفى السوق بعد الانتهاء واقتراب الإغلاق، كان الجوع قد نال منّا، فقصدنا المطعم الملحق بمحل الأثاث، ووقفنا فى طابور الانتظار إلى أن يحلّ دورنا. وقتها لمحت ملاكاً أبيض، بثياب بيضاء، يحمل طبقاً عليه ثلاث قطع من البطاطا المقلية، ويمشى خارجاً فى مسار الداخلين.
بكثير من الصبر، تغافلتُ عن وجوده، وقلت لنفسى بأننى لم أر شيئاً، وبأنه لا ينقصنى سوى الاهتمام برجلٍ آخر، وماذا جنيت من الاهتمام سوى المعاناة وطفلٍ صغير. إضافة إلى هذا، كيف أواصل الاهتمام بهذا البشرى ذى الأطوار الغريبة، والذى يمشى كما لو كان على صفحة الماء، ينظر ولا يرى، ويسمع ولا يتذكر..«دعكِ منه.. دعكِ منه».
لكنّ عينى هربتا من رأسى وتأملته بنظرة فاحصة، بعد سبعة أعوام، كان الشعر الكثيف يغطى ذقنه وشاربه، واكتسب بضعة كيلوجرامات على طوله الفارع، لكنه ظلّ قوى البنية وبمظهر شاب، حتى مع الشعيرات البيضاء التى خالطتْ سواد شعره، وظلت مشيته رشيقة أيضاً. وأثناء تأملاتى، وجدته ينظر فى عينى، ولم أعرف لماذا شعرتُ بالحب هذه المرة.
لم يعرفنى طبعاً، ولكنه ابتسم بلطف وأربكته نظراتى، فسألنى بخجل إن كنّا نعرف بعضنا من قبل، فأخبرته باسمى، فقال مبتسماً بهدوء وهو ينقل طبقه من يده إلى الطاولة لكى يصافحنى «أنا سعيد لأننا التقينا». ثم لمح طفلى فسألنى عنه، وإن كنتُ متزوجة الآن، فأخبرته بالانفصال، وبأننى أعيش مع طفلى لوحدنا، ولكن لماذا أتى إلى مدينتنا وهو يعيش بعيداً فى كندا؟
قال بأنه انتهى من دراسته أيضاً، وبأنه يعمل الآن هنا، لكنه يحلم بالعودة إلى مسقط رأسه على الضفة الأخرى من البلاد، مع أنه يحظى بمجتمع من بلدته أيضاً، «ويبقى الحنين للأمكنة بدون حلول». وبهذه العبارة الشاعرية، أخذته إلى قلبى، وغمرته بمشاعر كثيرة، كلها عذبة وملهمة، كأنه طرق باب أمومتى فأصبح مع طفلى طفلاً آخر، وكأننى وقتها كنتُ بحاجة للعطاء ومنح أحدٍ حياةً ذات معنى.
توثقت علاقتنا بتكرار المكالمات التى تطورت بسرعة إلى دعوات لتناول الغداء بعد العمل، وأصبحنا نخرج أحياناً فى المساء للمشى على الشاطئ متجاورين، أشعر به ويشعر بى، وكلّ شى يقوله يفتننى وأحبّه. وكان الوقت الذى نقضيه سوية يمدّنى بالطاقة والهدوء فى يومى التالى ويعيننى على احتمال مشاكل العمل ومهمات الأمومة ويحملنى على غيمة كأننى عدتُ الطفلة المدللة التى تركها والداى خلفهما، فلم أكن أهتمّ للصغائر الكثيرة وأتجاوز من أجل العودة فى المساء ومحادثة ملاكى الأبيض.
وذات نهار سألته عما يعنيه الحب بالنسبة له، فأجاب بأنه يحب الجميع، وكان هذا ما توقعت سماعه لكنه أشعرنى بالإحباط، لذا سألت نفسى عن الذى كنتُ أنتظره من هذا الرجل الذى يبدو سابحاً فى مداره الخاص، مع ذلك يمنحنى معاملة خاصة ووقتاً طويلاً، فلربما أخطأتُ فى اختيار السؤال أو ربما على نفض الأحلام الوردية من رأسى؟
لم أكن سعيدة فى الأيام التالية وأنا أشعر بأنها علاقة ستتوطد على حساب مشاعرى، ثم يتخلى عنى ببساطة لأنه يحب الجميع ولم يكن رجلاً خاصاً لأحد كما قال. فأخبرته بأننى أودّ التوقف هنا، ولم يسألنى لماذا، بل قال بلطف بالغ بأنه يتفهّم، واختفى من حياتى بدون أثر.
بعد أعوام طويلة، وزواجٍ آخر وانفصال، كان ابنى فى سنته الأولى فى الجامعة، ومعى طفلة صغيرة فى سنّ الابتدائية، وكنا وقتها فى عطلة صيفية خارج البلاد، واقفين فى صف الملاهى بانتظار دورنا، حين هتف ابنى بأنّ هذا أستاذه فى الجامعة، التفتُّ معه فرأيت الملاك مجدداً، بثياب بيضاء وشعر أبيض، وبنفس المشية والقوام الرشيق، يقطع الصفوف كأنه يطير، متجهاً نحوى، كان بالفعل يعرفنى هذه المرة.
اقترب بهدوء وفى يده اليسرى طبق ورقى عليه آثار طعام، فصافح ابنى بمودة وصافحنى بعتاب وقبّل الطفلة على رأسها، ثم تساءل مباشرة إن كنّا سنضيع المزيد من الوقت بعيدين عن بعضنا؟
للمرة الأولى كان يعنى ما يقول، فلم أعرف بماذا أجيب وقد اختلطت مشاعرى كلها، واستيقظ قلبى القديم وكأننا لم نبتعد قط. نظرتُ فى عينيه، فابتسم لى، وكوّم الطبق الورقى الفارغ الذى كان بيده فى أقرب حاوية، ثم أخذ كفّى.

الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة











 سعيد محمد المنزلاوى.. وارتحلاها
سعيد محمد المنزلاوى.. وارتحلاها
 عبد الرحمن الأبنودى.. يامنة
عبد الرحمن الأبنودى.. يامنة
 محمد عطية محمود.. ذاكرة العبق
محمد عطية محمود.. ذاكرة العبق
 محمود الرحبى.. سحابة بيضاء منعشة
محمود الرحبى.. سحابة بيضاء منعشة
 نجوى العتيبى .. قصتان
نجوى العتيبى .. قصتان
 وفاء السعيد.. المستقبل كغرفة انتظار
وفاء السعيد.. المستقبل كغرفة انتظار
 المتوكل طه .. غَزّةُ؛ يَجْرَحُهَا المَاءُ!
المتوكل طه .. غَزّةُ؛ يَجْرَحُهَا المَاءُ!
 أمل الفاران.. الدفتر
أمل الفاران.. الدفتر
 عبدالله الدحيلان .. فى مواجهة النص
عبدالله الدحيلان .. فى مواجهة النص