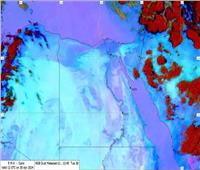إيهاب الحضرى
صراع على الذاكرة!
الأربعاء، 22 نوفمبر 2023 - 10:42 م
فى بداية الأزمة طلبتُ من ابنى شراء زجاجة مياه غازية. بأدب يليق به رفض مؤكدا أنه قرّر مقاطعة كل مُنتج يدعم العدو، وأشار إلى أن والدته تتبنى الموقف نفسه. موقفه جعلنى أشعر أننى أحاول إغواءه بشراء زجاجة خمر!
براءة ذمة للضمير!
الأربعاء:
تقطع السيارة طريقها ليلا. زحام مُعتاد يليق بميدان رمسيس، الذى ينبض فى قلب عاصمة لا تنام. على غير العادة لا تختلس نظراتى من العابرين تفاصيلهم، وأنشغل بتصفّح ما تجود به مواقع التواصل، حيث تضجّ المنشورات بصخب منزوع الصوت.
مؤخرا، تراجعتْ صور مجازر غزّة على «فيس بوك»، ربما بفعْل رقابة غير معلنة من إدارة الموقع، أو لانشغال الكثيرين بتفاصيل حياتهم اليومية.
أميل إلى فرضية الرقابة، بعد أن لاحظتُ تزايد أعداد المنشورات المُموّلة بشكل مبالغ فيه، مقارنة بنظيراتها التى نكشف فيها أدقّ خصوصياتنا. تُلاحقنى أيضا مجموعات الحكايات الفنية بقصص قديمة، أنشغل عنها بقراءة التعليقات، لتحديد مسارات توجّهات البشر.
مُعظمها تدعو بالرحمة لنجوم ماتوا منذ زمن طويل، بجانب تعليقات تتجاهل مضمون المنشور، وتطلب الدعاء لشهداء القطاع. حتى هذه التعليقات تبدو وكأنّها سابقة التجهيز، تعتمد على أسلوب القص واللصق! أسوأ شيء أن نمارس مشاعرنا بآليات رتيبة، وكأننا نُعفى ضمائرنا من حرج الصمت، فنُطلق كلمات بلا روح.
ذِكْر الروح يحيلنى لأرواح تقبضها قذائف غادرة، لا تكتفى بتصنيع الموت، بل تسعى لتغييب الوعْى الجمعى. قبل ساعات اجتذبنى تقرير صحفى، عن خطة يتبنّاها العدو لتغيير الوعْى الفلسطينى. بحيث يقتنع أهالى غزة أن هجمات السابع من أكتوبر هى سبب معاناتهم، ومع الوقت تُصبح المقاومة مُتهما أساسيا فى جريمة الإبادة الجماعية، بينما يحظى الجانى بمظلة حماية من حكومات غربية، تعتمد المصالح منهجا فى تحديد مواقفها.
الحديث عن ازدواجية المعايير صار مُملا، نستحضره كل كارثة إنسانية، ونتداوله فيما بيننا بينما الآخرون يكتبون براءة ذمة لضمائرهم.
بعيدا عن عبارات إنشائية لا تُسمن ولا تُنجى من قتل، أعود إلى الخطة الشيطانية التى تستهدف ذكاءنا.
كالعادة يستفيد العدو من تجارب الماضى، ويرسم مخططاته انطلاقا من واقعتين دمويتين، أنهت كل منهما حياة آلاف البشر، ونجحتْ فى تغيير قناعات البعض.
فى فبراير 1945 تعرضتْ مدينة دريسدين الألمانية لتدمير شامل، وفقدت 35 ألفا من أبنائها، مما جعل بعض سكانها يقتنعون أن النازية هى التى جلبتْ لهم الكوراث.
الأمر نفسه حدث مع ضرْب هيروشيما وناجازاكى بقنبلتين نوويتين، وقتْل 106 آلاف يابانى فى لحظات بمجرد ضغطة زر.
تغيّر موقف اليابانيين فى الحرب العالمية الثانية، غير أننى أعتقد أن وعيهم لم يتبدّل. هناك فى منطقتنا من بدأ تحميل المقاومة مسئولية ما جرى، ولحُسن الحظ لا يتبنى الغالبية العظمى من الفلسطينيين القناعة نفسها، لأن أصحاب البيت المُغتصَب لن يلوموا واحدا منهم، إذا حاول التصدى لمن احتله عنوة.
«زمان كان لينا بيت»
«زمان كان لينا بيت.. واصحاب طيبين.. يبكوا لو يوم بكيت».
من مذياع السيارة يسمو صوت ميادة الحناوى، فى أغنية عاطفية تحكى عن حبيبٍ كان هنا ثم هاجر طوْعيا. من سراديب الذاكرة تتسرّب بقايا قصة قديمة، عن ملابسات كتابة وتلحين الأغنية، أستعين بكائن لم تُصبه آفة النسيان حتى الآن، ومن «جوجل» استكمل ما تآكل مع الذاكرة، يُمكن اختصار التفاصيل فى كلمات بسيطة: أبدعها بليغ حمدى بعد انفصاله عن وردة الجزائرية، وجعلها رسالة تُخلّد ملحمة الفقد. الغريب أن كلماتها فى هذه اللحظة تتجاوز مساحة الرومانسية القديمة، وتنطلق فى أفقٍ إنسانى أكثر رحابة.
تُعبّر جُملة «كان يا مكان» عادة عن ماضٍ بعيد، غير أنها فى ظل الأحداث الجارية اختزلت الزمن فى أيام قليلة. قبل أسابيع كان للكثيرين بيوتهم، وفى لحظات فقدوها وودّعوا أصحابا طيبين، دون أن يتمكنوا من العثور على جثامينهم، وسط ركام حجارة يجتاح شوارع شبه خالية فى غزة، التى تُعدّ من أكثر مدن العالم زحاما.
أفيق على دوى أبواق سيارات، تريد أن تنهش الطريق بعد أن أضاءت إشارة ميدان العباسية باللون الأخضر. غالبا تمضى الأمور بوتيرة مماثلة فى شوارع القطاع..
أو كانت تمضى هكذا، لأن الممرات هناك شبه خالية وسط قصف غاشم، لا يعترف بأبسط قوانين الحروب.
تتداحل فى عقلى شهُبُ الأفكار: تذكرة قطار قديمة تتيح لحاملها الانتقال من مصر إلى غزة، حكايات أمى المتفاخرة بطقم صينى فى جهازها، أحضره أحد الأقرباء من هناك، قبل أن تُصبح المنطقة معزولة بأمر الاحتلال، وصور قديمة تعود لبدايات القرن الماضى، تُوثق لجمال بدائى طازج.
هل أهرب إلى الماضى من الحاضر؟ ربما. إنه «تكنيك» اعتدنا استحضاره مع كلّ أزمة شخصية أو عامة.
لكنّ الهروب حلمٌ مستحيل، والفضائيات تحاصرنا مع مواقع التواصل، بكوابيس مُعلّبة فى صُور، قد لا تكون مؤثرة فى حكومات منزوعة الإنسانية، غير أنها نجحت فى تعبئة ضمائر بشر عاديين بالغضب، فانطلقت المظاهرات فى الغرب مُنددة بمواقف قادتها.
نهاية التمرّد على التاريخ
الخميس:
أتلقى رسالة من ابنى على «واتس آب». على غير العادة لا تتضمّن عبارة تقريرية، يخبرنى فيها بأنه خرج مع أصدقائه، ويعتبر موافقتى «تحصيل حاصل». تنقل الرسالة رابطا دون تعليق منه.
أضغط عليه فيحيلنى إلى حلقة «الدحّيح» عن فلسطين، علمتُ فيما بعد أنها اجتذبت شبابا كثيرين، سبق أن أعلنوا تمرّدهم على مناهج التاريخ المدرسية، ورغم ذلك تابعوا الحلقة حتى نهايتها لمدة تقترب من ساعة كاملة.
تُخبرنى سيدة فاضلة بعد ذلك أن حفيدتها بدأت تقرأ عن تاريخ الصراع، وهكذا يولد الأمل من رحم الألم. عبارة إنشائية تقفز وسط السياق من جديد، كنّا نُرددها كقول مأثور يُخفّف مواجعنا، لكنها هذا المرة تُطل بواقعية سحرية، وتدعمها شواهد كثيرة.
فى بداية الأزمة طلبتُ من ابنى شراء زجاجة مياه غازية. بأدب يليق به رفض مؤكدا أنه قرّر مقاطعة كل مُنتج يدعم العدو، وأشار إلى أن والدته تتبنى الموقف نفسه.
موقفه جعلنى أشعر أننى أحاول إغواءه بشراء زجاجة خمر! وفى النهاية لم أحصل على مشروبى المُفضل. لم أكن أؤمن حتى هذه اللحظة بجدوى المقاطعة، فعلى مدار عمرى الطويل عاصرتُ حملات عديدة انتهت بالفشل.
خلال الأيام التالية حاصرتنى حكايات الأبناء، التى تداولها أصدقاء وزملاء كثيرون، تلميذ فى الصف الخامس الابتدائى يرفض أن يصطحب كيس بطاطس مفضل إلى المدرسة، لأن زملاءه ينتقدون من يتعاطى هذه المنتجات!
طفلة فى الخامسة من عمرها ترفض بشدة أن يشترى لها والدها مشروبا اعتادتْ أن تطلبه، وتقول بحسم عفوى: « لا يا بابا.. ده إسرائيلى».
القصص تتكرّر بصياغة شبه واحدة، وتمنحنى فرحة مُقتطعة بين أشواط حُزن أفرزتْه الوحشية. لا تشغلنى مناوشات مؤيدى المقاطعة ورافضيها. لكل منهم منطق وجيه طالما ابتعد عن التعصب غير المبرر.
الأهم من وجهة نظرى هو المحصلة النهائية: الوعى بقضية ظلت غائبة عن أجيال لم تعاصر حربا، حتى ظنّنا أن المستقبل سيلتهم تضحيات من دافعوا عن الأرض.
حتى لو استسلم بعض أثرياء الحرب لجشعهم، ورفعوا أسعار المنتجات المحلية البديلة، فالمكسب الحقيقى هو عودة الوعى، بعد أن ظن الاحتلال أنه نجح فى تغييبه.
فرحة مُقتطعة!
السبت:
فى قاعة فخمة بأحد فنادق القاهرة رحبتُ بالحاضرين. مناسبة شخصية لن أذكر تفاصيلها، كى لا أشعر أننى أروّج لأمر خاص، غير أن الحدث الفكرى ركّز على جانب مسكوت عنه فى الصراع الأزلى. تبارى الحاضرون فى الحديث عن جرائم الاحتلال فى السطو على تراثنا، وركزتُ فى كلامى على مجازر الحضارة. مع كل مذبحة ننشغل بشلالات الدم، وينصب تركيزنا على الشقين السياسى والعسكرى.
أمرٌ طبيعى لأن أرواح الشهداء ليست رخيصة، والأمر نفسه ينطبق على معاناة المصابين، ومستقبل غامض ينتظر صبية فقدوا آباءهم وأمهاتهم. تشغلنى صور أطفال مُبتسرين يشقون طريقهم إلى حياة غامضة، بعضهم مجهولو الهوية وآخرون يعيشون حالة يُتم مُبكّرة. كلها حالات تصيب القلب بغزّة مزمنة، غير أن الحُزن يجب ألا يشغلنا عن صراع الهوية.
العدو يجيد الرقْص على كل الحبال، وبينما يزرع الدمار الشامل يُخطط للعبث بالهوية. فى كل اجتياح كانت الآثار مُستهدفة، إما بالمحْو أو التزييف. إنه عبثٌ مُمنهج بالتاريخ، لأن الماضى هو أساس الحاضر والمستقبل.
النماذج أكثر بكثير من حصرها فى هذه السطور، لكن ينبغى أن نقبض على عناصر حضارتنا بقوة، حتى لو تعرّضت بعض تفاصيلها للطمْس. أتوقع كارثة حضارية سوف تتكشف تفاصيلها بعد انتهاء العدوان، وقد تختفى مناطق أثرية بالكامل فى غزة وجباليا ودير البلح وغيرها من مدن القطاع، لأنها تُوثق للوجود الفلسطينى عبر آلاف السنين. لهذا أدعو إلى إطلاق حملة لحصر الخسائر، تنتهى بترميم ما نجا من «أحفاد دراكولا»، وتسجيل ما انتهى فى دراسات تجعله خالدا على الدوام.
أخرج من الفندق مع مُنتصف الليل سعيدا بنجاح شخصى، تغمرنى بهجة مؤقتة لأننى أخوض مع غيرى المعركة بكلماتنا. والكلمة سلاح لا يُستهان به فى مواجهة محاولات اغتصاب الذاكرة. على الأقل كى لا تذهب أرواح الشهداء هباء، فى معركة الحفاظ على الوجود. أضحّى بما تبقى من باقة الإنترنت، وأستدعى صوت ميادة: «كان يا ما كان.. الحب مالى بيتنا ومكفّينا الحنان.. زارنا الزمان.. سرق منا فرحتنا.. والراحة والأمان». كم أنت مُعبّر أيها الفن!

الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة











 .. ويتلألأ ذهب الغيطان
.. ويتلألأ ذهب الغيطان
 الوظائف للشباب
الوظائف للشباب
 كاريكاتير| الشرطة تعتدى على الطلبة داخل الحرم الجامعى بأمريكا وإعتقال العشرات!
كاريكاتير| الشرطة تعتدى على الطلبة داخل الحرم الجامعى بأمريكا وإعتقال العشرات!
 غارقون فى بحر الطين!
غارقون فى بحر الطين!
 شم النسيم رغم أنف الحشاشين !!
شم النسيم رغم أنف الحشاشين !!
 ألعاب و حيل نفسية ٢ / ٢
ألعاب و حيل نفسية ٢ / ٢
 عالم جائع.. ويشكو كثرة الطعام!
عالم جائع.. ويشكو كثرة الطعام!
 عزف على أوتار الفقد
عزف على أوتار الفقد
 نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات
نوال مصطفى تكتب: سحر الحكايات