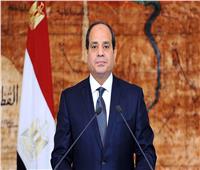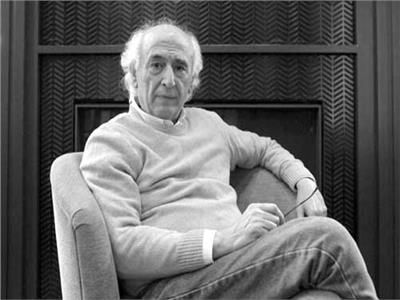
خليل الرز
خليل الرز: رواياتى لا تقرأ قبل النوم!
الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 08:45 ص
حوار: أسامة فاروق
بعد أربع سنوات على الاقتتال فى سوريا، فجأة وجد خليل الرز نفسه على حافة الدمار، فى ضاحية من ضواحى دمشق، بالتحديد فى جرمانا، على مقربة شديدة من إحدى الجبهات المشتعلة فى الغوطة. وبرغم أنها كانت تتعرض يومياً تقريباً للقذائف القادمة من الغوطة، إلا أنها كانت أكثر أمناً ما جعل قسماً كبيراً من مدنيى تلك المناطق ينزحون إليها. ما لفت نظره فى هذه الأثناء التعايش السلمى الحقيقى والتآلف الصادق بين سكان جرمانا وبين الوافدين إليها من النازحين كما لو أن أولاد الطرفين لا يقتتلون على بعد مئات الأمتار لا أكثر!
هذه المفارقة قادته إلى التفكير بكتابة «الحى الروسى».. حى يرفض الدخول فى الحرب، مع أنه واقع على تخومها فردوس مفقود لا يجتمع سكانه حول فكرة، ولا يجمعهم تاريخ طويل «أوصالا حية قادمه من أوطان باليه وعقائد باليه وطوائف باليه وقبائل باليه، تجمعهم الرغبة الأرضية الخالصة بالحياة».. زرافة عمياء، كلب بودول، كلبة أفغانية، وعصفور منسوج من الصوف، مترجم يعيش فى حديقة الحيوانات، وصحفى روسى سابق يعمل مديرا لحديقة الحيوانات، وأستاذ لغة فرنسية وصاحب محل ألبسة، وبطل شعبى وعازفة عود سابقة، وكاتب روسى مغمور، ونونا ابنة عازف الكلارينيت التى تنسج الصوف. يجدون أنفسهم غارقين فى الدمار رغما عنهم، متورطون فى المأساة، يكتشفون مدى ضعفهم وهشاشتهم، يتأكدوا أننا حين نعيش على حافة الدمار «يصبح سهلا علينا، وضروريا أيضا، تعديل وتبديل، وربما حذف كل معتقداتنا الراسخة التى ازدهرت فى خمول السلم الملغوم» يكتشفوا أن حتى الموت فى أيام كتلك يصبح عمل شاق جدا.
-أول علاقتك مع الكتابة كانت بنسخ ديوان «أنشودة المطر» لبدر شاكر السيّاب، أعقبها رسالة كتبتها لنفسك. ما الذى تتذكره من تلك الفترة وكيف كان تأثيرها على تكوينك ككاتب بعد ذلك؟
يبدو لى الآن أن أهمية نسخى ديوان أنشودة المطر للسياب، بتكليف من أستاذى فى الصف الخامس الابتدائى، تكمن فى أننى تحسّستُ فى الديوان، بسليقتى اللغوية البسيطة على الأغلب، لغة تختلف عن لغة القرآن، الذى كنت أتعلم قراءته الصحيحة، بتوصية من أبى، لدى الشيخ بكرى بالرقة فى العطلة الصيفية من كل عام، كما تختلف عن اللغة المستخدمة فى مواد التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية والقراءة المبسطة فى المقررات المدرسية التى كنت أمقتها جداً وأنجح بها بصعوبة، وما كانت معرفتى، فى تلك السن، لتساعدنى طبعاً فى أن أفهم بشكل جيد أهمية اكتشافى ذاك، كل ما شعرت به آنذاك هو متعة قراءة جديدة غامضة دفعتنى بعد فترة قصيرة إلى الذهاب إلى المركز الثقافى فى المدينة لاستعارة دواوين السياب الأخرى، وهنا فوجئت بأن كتب السياب الأخرى لم تثر فى داخلى المشاعر الممتعة الغامضة التى أثارها ديوان أنشودة المطر.
الأمر الذى قادنى، على ما يبدو لى الآن، إلى البحث عن تلك المشاعر فى كتب أخرى لمؤلفين آخرين. ولعل الرسالة التى كتبتها لنفسى، بعد سنوات قليلة، فى وصف حصان محبوس فى إسطبل ضيق جداْ، إنما جاءت، دون أن أدرى وأتعمد، فى سياق استعادة تلك المشاعر المضيئة بأصابعى الخاصة.
-بالنظر إلى محاولات الكتابة الأولى وتاريخ صدور أول الأعمال فى 1994 تقريبا، يتضح أنك دخلت عالم النشر متأخرا إلى حد ما. كيف كانت الفترة التى سبقت النشر.. وكيف اتخذت القرار؟ وهل حققت ما كنت تطمح إليه، أو بمعنى آخر هل اختلف طموحك وقتها عنه الآن؟
نشرت روايتى الأولى «سولاويسى» بعد ثمانى سنوات من كتابتها فى موسكو حيث كتبت أيضًا مسرحيتى الوحيدة «إثنان»، وبدأت بكتابة روايتى الثانية «يوم آخر»، وكان على أن أستقيل من عملى فى إذاعة موسكو وأعود إلى سورية بعد أن اعتقدت أن الأوان قد آن لأحاول تحقيق حلمى الأول فى أن أكون كاتبًا. إن وجود عملين جاهزين للطبع فى درجى وشروعى بعمل ثالث شجعنى جدًا لاتخاذ هذا القرار. أما طموحى، بالكتابة، فمرتبط دائمًا بحاجتى، التى لم تتوقف حتى الآن، إلى تعلم المزيد من مهارات السرد. أعنى أننى تعلمت، مع الوقت والمثابرة، أن أتحسٌس ما ينقصنى، فأحاول فى كل مرة السعى، ما أمكننى، إلى غايات جديدة لم أختبرها من قبل. حتى فى بعض أعمإلى المنشورة تراودنى الرغبة فى إعادة كتابتها من منظور طموح فنى جديد. وسوف أفعل ذلك على الأغلب بين عمل جديد وآخر. وقد انتهيت منذ فترة وجيزة من إعادة كتابة روايتى «سلمون إرلندى» وفق هذا التصور، وصدرت بالفعل لا كطبعة ثانية، بل كطبعة مختلفة.
-تأثرت بـ: تورغينيف ودوستويفسكى وتشيخوف ونابوكوف، أكثر مما تأثرت بالسياب ومحفوظ إلى أى درجة تصح هذه الجملة؟
نعم هذا صحيح. ربما كانت المصادفة ما جعل قراءاتى الروائية الأولى تبدأ بروايات بلزاك وهيجو وستاندال وفلوبير وزولا المترجمة الموجودة آنذاك فى مكتبة المركز الثقافى العربى بالرقة. كان ذلك عندما كنت طالباً فى المدرسة الثانوية. ثم تنوعت قراءاتى العالمية المترجمة خلال دراستى فى جامعة حلب. كانت قراءاتى للرواية العربية محدودة، عندما سافرت إلى روسيا لم أكن قد قرأت من أعمال نجيب محفوظ سوى «عبث الأقدار» و«زقاق المدق» و»اللص والكلاب» و «أولاد حارتنا» ومن كل أعمال حنا مينة قرأت أعمالًا قليلة أهمها كان «الياطر» و«الشمس فى يوم غائم»، بينما كنت فى الفترة نفسها قد أنهيت، على سبيل المثال، قراءة معظم روايات دوستويفسكى وما أتيح لى بالعربية من أعمال تولستوى وتشيخوف وتورغينيف. بعد عودتى إلى سورية تعرفت أكثر على بعض الروائيين العرب، لكن اهتمامى الأكبر ظل متوجهًا نحو قراءة الأعمال العالمية. ولذلك كان من الطبيعى أن أتأثر بمن قرأت. أعتقد أن الرواية شجرة واحدة متجذرة فى كل اللغات التى كتبت بها. أعنى بالرواية هنا ليس موضوعاتها، بل مهاراتها السردية. ولعل أهمية الرواية تنحصر فى كونها فناً هجيناً منذ الولادة، وفى أنها لم تملك قيوداً من التقاليد تعرقل قابليتها للتطور كما فى الشعر والمسرح مثلاً.
ولذلك فإن محاولات تأصيلها فى أى لغة من اللغات التى ترعرعت فيها نوع من الوهم، فقد رافق نشوؤها الثورة الصناعية التى فتحت الحدود بين البلدان والثقافات، القطارات البخارية لم تكن تحمل السلع فقط، بل واللوحات والكتب وطرائق التفكير والتعبير. غير القليل من أعمال بلزاك وزولا كانت تطبع فى باريس وبيتربورغ فى وقت واحد، لقد طور الراوائيون معاً، بلغاتهم المختلفة، مهارات سردية متاحة للجميع. أريد أن أقول إن ما يهمنى أولًا، كروائى، أن أكون جزءاً من تداول وتطوير تلك المهارات المتاحة أكثر فأكثر فى الوقت الراهن إن عن طريق الترجمات أو بقراءة النصوص بلغاتها الأصلية، ومنها العربية بطبيعة الحال.
-لم تكن الرواية العربية بعيدة عن الأحداث التى جرت منذ 2011 فى منطقتنا، لكن ذلك لم يكن محل ترحيب فى كثير من الأحيان، خاصة وأن كثير من الأعمال التى أصرت على ملاحقة الحدث كانت فى أغلبها تسجيل أقرب لليوميات، لذا بشكل شخصى أعتقد أن نصيحة تأجيل التعامل الروائى التى انتشرت وقتها قد أتت بثمارها مع هذا النص «الحى الروسى» الذى لا يلهث وراء التسجيل الصحفى بل يحلق فى فنتازيا واقعية إن صح القول. لدى عدة أسئلة فى هذه النقطة: كيف تنظر للكتابة الروائية المتفاعلة مع الحدث الجارى.. كيف رأيت هذه النوعية من الأعمال؟ كيف ترى الرواية كحامل للتاريخ ومتى فكرت فى التعامل مع المأساة السورية/العربية روائيا؟
أى حدث جرى أو يجرى أو سيجرى هو بالنسبة لى، كروائى، ليس إلا مادةً ما للكتابة، وأهميته لا تأتى إلا تاليةً فى أولوياتى حين أجلس إلى طاولتى وأكتب، ما يأتى دائمًا أولًا بالأهمية عندى هو كيف أحوّل هذا الحدث من حدث واقعى إلى حدث روائى، والفرق واسع جدًا بينهما لأن الأول، فى شغلى، ليس مرجعية للثانى كما يعتقد البعض ويشتغل على هذا الأساس. لكنْ، عندما يكون الحدث كارثة كالحروب، لابد من الانتظار حتى تبرد هذه الكارثة، أو حتى تعتاد عليها، قبل أن تضعها على طاولة كتابتك.
ويضيف، عندما قامت أكثرية الناس السوريين بالثورة على الاستبداد القائم منذ عقود، ثم حين قاد المتشددون هذه الثورة إلى طريق لن تفضى إلى غير استبداد آخر تحت مسمى مختلف، كان على أن انتظر وأراقب وأصمت فترة دامت أربع سنوات، فما كان يهمنى، ككاتب، هو أن أكتب رواية، لا أن أسجل مواقف حماسية كنت أستطيع أن أنقاد إليها تحت ضغط حرارة ما يجرى على الأرض. طبعا هذا لا يعنى أننى، كمواطن سورى معنى بما يحدث، لا أسجل أحيانًا مثل هذه المواقف الحارة، لكنْ خارج عملى الروائى حتماً.
هناك كتاب تناولوا الحروب والثورات بعد أن تحولت إلى أحداث تاريخية باردة تمامًا كما فعل تولستوى فى «الحرب والسلام» التى بدأ بنشرها فى عام ١٨٦٥وكانت أحداثها تجرى على خلفية غزو نابليون لروسيا فى عام ١٨١٢، وكما فعل أناتولى فرانس الذى نشر رواية «الآلهة عطشى» فى عام ١٩١٢ حيث تجرى الأحداث إبّان الثورة الفرنسية التى نشبت سنة ١٧٨٩، لكن المؤلفَيْن كانا حريصين على أن يكونا روائيين وليس مؤرخين، فقد كانت المشاهد التى تجرى على خلفية الحرب أكثر بكثير من تلك التى تجرى فى ساحاتها، والمهارات الفنية الرفيعة فى رسم العوالم الداخلية للشخصيات وفى بناء المشاهد، حتى الحربية منها، وما تتضمنه من الوصف الموظّف والحوار العميق والمفارقات البديعة كانت أهم من تسجيل المواقف الوطنية السياسية السطحية. هاتان الروايتان مثلان مهمان فى كيف يمكن للروائى أن ينجو من فخ التاريخ، وهو الأمر الذى لم ينجُ منه بعض المؤرخين-الروائيين السوريين والعرب.
-عشت فى روسيا وعملت هناك فترة طويلة. هل كان الحضور الروسى فى خدمة الرواية بالفعل؟ الشخصيات والأسماء الروسية الكثيرة داخل الرواية ألا ترى أنها قد تساهم فى تغريب النص رغم أن المأساة عربية خالصه؟
لا توجد مشكلة لدى فى العلاقة بين الشرق والغرب، فأنا لا أنظر إلى الغرب باعتباره آخر. ظل التبادل المعرفى متواصلاً بين شعوب حوض البحر المتوسط على مدى أكثر من ثلاثة آلاف عام حتى على خلفية الحروب التى أسست للإمبراطوريات القديمة على امتداد هذه المنطقة ثم عبر الفتوحات الإسلامية والحملات الاستعمارية. الرواية التى أكتبها ما كنت أستطيع كتابتها، بالصورة التى تبدو عليها الآن، لو أننى اكتفيت بتعلم الكتابة من الكتاب العرب. افتراض ذلك بحد ذاته عمل ينافى طبيعة فن الرواية المؤسس أصلاً على الهجانة، الرواية، كالصناعة، لا وطن لها ولا أفخاذ ولا قبائل، ولا تنتمى لغير جنسها الأدبى، غير الإثنى، المكتوب بكل لغات العالم. أما وجود الشخصيات الروسية فى روايتى الحى الروسى، وفى رواية البدل وفى رواية قادمة أيضًا، فلأن الشخصيات الروسية والثقافة الروسية والأدب الروسى جزء من تكوينى المعرفى كإنسان وكروائى. ثم إننى لا أدّعى هذه الشخصيات لأننى ببساطة عشت معها وعملت معها وكانت، وما تزال، تجمعنى معها علاقات بشرية متنوعة وصداقات على مدى سنين طويلة، فكان وجودهم فى رواياتى نوعاً من استثمار جزء أصيل من حياتى الخاصة التى تشكل المصدر الأهم للمادة الخام التى أعالجها فى أدبى. كما أود أن أؤكد أننى حين كتبت الحى الروسى لم أفكر أبدا فى عروبة المأساة التى جرت أحداث روايتى على خلفيتها، ما كان يهمنى بالدرجة الأولى هو أن أكتب رواية جميلة.
-الحيوانات تلعب درواً رئيسياً فى الرواية، حضورها مختلف أيضا عن بعض الروايات التى قدمت الفكرة من قبل، تظهر كبطل أحيانا وكشاهد فى أحيان أخرى.. أعتقد أن فهم استخدامك للحيوانات يفتح الباب أمام فك رموز العمل وفهمه بالشكل الصحيح، وأنت من جهتك قدمت ما يشبه التفسير لهذا لاختيار، فقلت مثلا أنها –الحيوانات-لا تضع حدودا بين ما تريد فعله وما تتمكن من فعله فى الواقع، وكذلك بين الأماكن التى تراها بعقولها وقلوبها.. وأرسلت رساله مبطنه للقراء بأن يتخلوا عن تلك الحدود التى تسجنهم ليقبلوا ما يحدث لهم وليصلوا إلى طلاقة التفكير.. إلى أى حد تصح هذه القراءة، ولماذا الزرافة بالتحديد ما الذى تمثله؟
يمكن أن تكون قراءتك صحيحة، لكنها، تبعاً لتصميم الرواية، لا يمكن أن تكون القراءة الوحيدة. كثير من تفاصيل الحى الروسى، ورواياتى الأخرى، يقوم على تحيير المعانى المباشرة أو الإيحاءات الأولى التى تنجم عنها. التحيير يمكّننى من العثور على أشياء غير متوقعة يمكن أن تبدو فجأة ضرورية جداً وفى محلها الأمثل. لكن ذلك عمل شديد الرهافة ويمكن أن ينزلق بك إلى لُقَىً غير مناسبة تثقل على الإيقاع، فأنت هنا تمشى على حدود متداخلة تكاد لا ترى غالباً، ولا يمكنك أن تهتدى بشىء آخر سوى حركة أصابعك الحذرة جداً على الكيبورد وحدسك المتمرّس فى تحسّس طرائدك المستترة وقدرتك المتحفزة، فى هذه الأثناء، فى رؤية عملك كله من الأعلى. أما بالنسبة للزرافة فقد كنت أحتاج إلى حيوان ضخم جميل يستطيع انتزاع محبة الناظر إليه وتعاطفه.
وأشار الرز، كان عندى تصور مبكر عن المشهد الأخير فى الرواية فكان يلزمنى مثل هذا الحيوان ليقود مظاهرة الحى الروسى إلى ساحة الأمويين فى قلب دمشق. فكرت بالفرس، لكنْ عندما خطرت ببإلى الزرافة تأكدتُ فوراً أنها الحيوان الأمثل المطلوب، وكان أكثر ما سحرنى بها هو كاريزما وجودها، تشكيلياً، فى مقدمة المظاهرة وعبورها معهم الغوطة المدمرة ثم اختراقها بهم شوارع دمشق حتى تصل إلى ساحة الأمويين. فضلاً عن أن الزرافة حيوان بكر غير معالج روائياً فى كل الأعمال التى قرأتها، فأحببت كثيراً مغامرتى معها، ماذا تعنى الزرافة؟ أو إلى أى شىء ترمز؟ الأمر متروك للقراء وسوف يكون كل منهم محقا فى ما يذهب إليه، أما بالنسبة لى فهى زرافة جميلة لا أكثر.
-بعض القراءات تقول إن الرواية، وإن اتخذت مما يحدث فى سوريا متكأ للسرد، إلا أنها ألقت الضوء على العديد من القضايا والأفكار، كالحياد وسط لهيب الاقتتال، الدور الروسى الثقافى والعسكرى فى سوريا، دور المثقفين والفنانين، الإعلام وتأثيره، مشكلات المرأة، الحاجة إلى البطل الشعبى. كيف تنظر لهذا الأمر، هل هذا دور الرواية؟ هل تؤمن أصلا بتمرير هذا النوع من الأفكار/ الرسائل فى العمل الأدبى؟
من خلال ما كتب عن الحى الروسى فى الصحافة كنت ألاحظ أن البعض حمّل الرواية ما لم يكن قد خطر ببإلى عند كتابتها، وهذه استجابة مشروعة جدًا على الطريقة التى أكتب بها. غير أن البعض الآخر كان يلوى عنق الرواية لكى تتلاءم مع مواقفه السياسية بشكل خاص، فتراه يُغَيّب أشياء هامة فى بنائها لكى يثبت وجهة نظره، وفى بعض الأحيان يجتزئ جملة من فقرة لكى يبنى عليها ما يريد، هو، أن يصل إليه. طبعاً يمكن أن تتقاطع إيحاءات ما فى المشاهد وتفاصيلها مع هذه أو تلك من القضايا أو المشكلات الواقعية، لكنك، إذا نظرت إلى علاقة هذه الإيحاءات بنسيج الرواية بشكل عام تجد أنها تقوم بوظائف تقنية قبل أى شىء آخر. روايتى لا تُختزل بمقولة أو برسالة أو بعبرة لأنها تقوم على الصور. أعنى أنها لا تُحكَى بل تُشاهَد سطراً سطراً، لذلك سوف تخسر متعاً كثيرة جداً إذا اكتفيت بما حُكى أو كُتب عنها.
-تؤكد فى «الحى الروسى» قدرة الرواية كجنس أدبى على تحمل جميع الأجناس الكتابية الأخرى، هل كنت تعنى ذلك وقت الكتابة، بمعنى أنك كنت تود تأكيده وإثباته؟ أم أن شغفك بالأنواع الأخرى ظهر فى النص من تلقاء نفسه؟
أعتقد أن الإفادة من الفنون الأخرى فى الرواية لا تتم بمجرد قرار. فلكى تفعل ذلك تحتاج طبعاً إلى شغفك ثم إلى معرفتك الجيدة بها. إن كل الكتب التى قرأتها والمسرحيات والأفلام واللوحات والتماثيل التى شاهدتها والموسيقا التى استمعت إليها سوف تظهر آثارها حتماً فى الجنس الفنى الذى تمتهنه. وبقدر ما تطور اهتمامك وإحساسك، بالمعرفة والمتابعة، بهذه الفنون تجد نفسك أكثر تلقائية باستخدام تقنياتها فى جنسك الفنى. ولعل كتابتى الشعر فترة طويلة قبل أن أتجه إلى الرواية وكذلك عملى كممثل فى المسرح وقراءاتى المعمقة فى تاريخه ومشاهدتى الكثير جداً من عروض المسارح الروسية فى موسكو واهتمامى بالفن التشكيلى فى وقت مبكر قد جعل من كتابتى الرواية مسرحاً لكل ميولى الفنية بدرايتى المسبقة وبدونها أيضاً.
- فى الرواية لم يكن أركادى كوزميتش يحب الحرب ولا يرى فيها إلا عملا جنونيا وإجراميا لكنه اضطر رغم ذلك إلى توظيفها فى روايته.. إلى أى حد تتشابه رؤيته مع رؤيتك؟ هل كنت مضطرا للكتابة عن المأساة السورية؟ هل كان بإمكانك تجاهلها؟!
الفرق بينى وبين أركادى كوزميتش هو أنه استطاع أن يكتفى بالإشارة إلى الحرب ببضعة سطور فقط فى مطلع روايته، فيما تجرى معظم مشاهد روايتى على خلفية الحرب. لكننى أتفق معه فى أنها عمل جنونى. أما المأساة فى سورية فما كان بوسعى أن أتجاهلها، لا لأننى سورى وأن عليّ أن أقوم بواجبى حيال وطنى، أبداً، بل لأننى عشت تجربة حياتية خاصة فى ظروفها فأصبحتْ جزءاً من ذاكرتى، وأنا أستمد عادةً مادتى الروائية الخام من ما عشت وعرفت بشكل جيد. كنت أستطيع أن لا أكتب عنها لو لم أعشها بضع سنوات. لكنْ تجمع لدى كم هائل من التفاصيل والانطباعات القابلة للاستثمار، على طريقتى، فى رواية جديدة، فوجدتنى أكتبها، لا أكثر من ذلك.
-قًتل عصام، والزرافة، وضرب الحى الذى كان حريصا على عدم التورط من البداية.. السوداوية تسيطر على الرواية بالكامل..
إذا كنت تجد فعلًا أن السوداوية تسيطر على الرواية بالكامل فأنت محق على الأغلب، لكنْ صدّقنى لم أتقصّد ذلك. ما سعيتُ إليه، بكل قواى، هو أن أكتب عملاً متماسكاً جميلاً فقط. لو أن عصام لم يقتل فى الغوطة على أيدى المتشدّدين ولو نجت الزرافة من مدفع الدبابة فى ساحة الأمويين لخسرت الرواية الكثير من مبررات كتابتها، كان عليهما أن يُقتلا لضرورات فنية على الأقل.
-حققت المتعة، والتجديد على مستوى السرد فى الوقت نفسه، وهى معادلة صعبة لكنها ربما تكون خطرة أيضا، فالرواية ليست سهله على مستوى القراءة، تحتاج التأنى والصبر لجمع شتاتها وربط أفكارها.. كيف تنظر للقارئ؟ هل تفكر فيه أثناء الكتابة؟
القارئ أحد أهم مبررات كتابة الكتب. لكنْ إذا كانت إحصائيات القراءة، بالنسبة لعدد السكان فى بلداننا، تبعث غالبًا على الخيبة، فإننى لا أشعر أبدًا بالأسف لأننى أنتج سلعةً ليست من أولويات الناس من حولى. أنا أكتب لأن الكتابة عمل أحبه. وقد تعلمت، مع مرور الوقت، أن لا أبالغ بإحساسى بوجود القارئ. لكننى، مع ذلك، أحسن الظن بقارئى، الواقعى النادر أو المتخيل، لذلك أحاول، دون كلل، أن آخذه بعيداً عن الذائقة الدارجة التى كرّسها كتاب محترفون يتصدّرون المشهد الروائى العربى. ولعل ذلك ما يجعله يشعر بضرورة التأنّى الذى أشرت إليه، فهو، حين يقرأ رواياتى، إنما يقاوم مزاجًا عامًا اعتاد عليه فى القراءة. إنه لا يستطيع مثلاً أن يقرأ روايتى قبل النوم مباشرة، فهى لا تتملّق تصوراته الشائعة عن الكتابة ولا تحاول أن ترضيها من أقصر طريق، بل تقترح عليه مزاجًا جديدًا سيكتشف معه متعاً غير مألوفة جديرة بالتوقف عندها.
-قلت من قبل إن الجوائز فرصة للإشارة للعمل وكاتبه.. ألا تحمل هذه العبارة إدانة ما لطبيعة القراءة فى عالمنا العربى؟ هل تشعر أن قراءتك تأخرت، أنك مظلوم على مستوى التعامل النقدى؟ وبشكل عام كيف تنظر للجوائز العربية التى أصبحت ترسم وتحدد ملامح الأدب فى منطقتنا؟
أهم ما فى الجوائز أنها تسلط الضوء على أعمال مهمة تستحق الضوء وأسوأ ما فيها أنها تحجب الضوء عن أعمال مهمة أخرى لم تفز بها مع أنها تستحق الضوء أيضًا. وبرغم أن الجوائز لا تقدم دائمًا أعمالًا مهمة إلا أنها سحبت الكثير من سلطة دور النشر الكبيرة على فرض المزاج السائد للكتابة تبعًا لمصالحها المادية فقط لا غير بغض النظر عن مهمات التنوير التى تتبجح بها أحيانًا. الذائقة الروائية الدارجة المترهلة، التى أشرتُ إليها فى جوابى السابق، هى، إلى حد كبير، من صناعة دور النشر الكبيرة على وجه الخصوص. وبرغم كل ما يثار سنويًا عن لجان التحكيم وقراراتهم فإن الجوائز استطاعت أن تقدم، فى بعض الأحيان، أعمالًا مميزة بعيدة تمامًا عن تلك الذائقة ومروّجيها. أما قراءتى، فقد تأخرت عربيًا، نعم. لم أفكر بما إذا كنت مظلومًا نقديًا. معظم القراءات التى تناولت أعمإلى كانت قراءات صحفية. لكننى لا أجد مبرراً أبداً للشعور بالغبن أو بالحاجة إلى الأنين. ما يهمنى بالدرجة الأولى هو استكمال مشروعى الروائى بغض النظر عن أى شىء آخر.
-مسرحية واحدة. هل ستكرر التجربة؟ أم ستظل مخلص للرواية؟
لا أعرف ما إذا كنت سأكتب مسرحية أخرى أو أكثر. لا توجد عندى مبدئيًا أفكار أولية لكتابتها فى هذه الفترة. لكننى لا أستثنى أن أقوم بذلك، فأنا أحب المسرح. ربما كانت الرواية تستنفد شغفى به إذ تمنحنى فرصة أن أفيد من تقنياته فى أعمإلى الروائية التى لا يخلو أى منها من تأثيره. الرواية فن مطواع قابل لاستيعاب وانتحال أدوات تعبير الفنون الأخرى.
-من أول من يقرأ مسودات أعمالك؟ وكيف تتقبل التعديلات ووجهات النظر؟
لا أحد يقرأ أعمإلى قبل نشرها، لكننى لا أستعجل فى نشر عملى الجديد بعد انتهائى من كتابته، أتركه فى درجى فترة طويلة ريثما يغيب عنى الكثير من تفاصيله، ثم أعود إليه لأعمل به من جديد فترة تطول أحيانًا عدة شهور. ولذلك تطرأ عليه، فى الكتابة الثانية، تعديلات كثيرة تكون أحيانًا جوهرية تمامًا.
-هل تتابع المشهد الإبداعى فى العالم العربى الآن؟ كيف تراه؟
ما أقرؤه الآن هو ما أعتقد أنه الكتاب الذى سأتعلم منه شيئًا جديدًا فى مهارات الفن الروائى، وهو الأهم بالنسبة لى، أو فى الحصول على معلومات محددة من أجل الإفادة منها فى الرواية التى أعمل عليها. منذ مدة طويلة لا أقرأ من أجل أن أقوّم أعمال الآخرين. لا يهمنى أبداً أن أكتشف عيوبهم وأثرثر بها، لأننى، كما قلت، مهتم بأشياء محددة لا أعرفها بشكل جيد. فى أحيان غير قليلة أعيد قراءة أعمال اعتقدت، عندما قرأتها لأول مرة، أنها أعمال شديدة الأهمية. وقراءاتى متنوعة، تبعًا لحاجتى الآنية منها، فى الروايات أو فى علوم مختلفة. ربما لهذا السبب أشعر أحيانًا بالتقصير حيال أعمال عربية يمكن أن تفوتنى قراءتها ببساطة. لكننى أعتقد، بناءً على ما أتيح لى الاطلاع عليه، أن هناك روايات عربية جديدة تبتعد، بشكل ملموس، عن إرث الرواية العربية المحمّلة بالأيديولوجيات وبالقضايا الاجتماعية والسياسية الرنانة الكبرى وبالأبطال اليابسين من شدة مبدئيتهم ومن شدة معاناتهم بسبب الهزائم الوطنية والقومية.
-هناك قفزة ملحوظة فى مجال الترجمة مؤخرا من الصعب وصفها بـ «النهضة» لكنها حركة كبيرة على أى حال، الرواج الكبير للترجمات جعل البعض يتخوف من سيطرتها على سوق القراءة وتأثيرها بشكل سلبى على حركة الكتاب العربى غير المترجم. كيف ترى المسألة؟
أعتقد أن هنالك تقصيرًا كبيرًا فى حجم ونوعية الأعمال المترجمة إلى العربية. ما يخص الفن الروائى فقط نجد أن اللغات الحية الرئيسية فى العالم تبادلت منذ زمن بعيد جداً، باستثناء اللغة العربية، ترجمة كل الأعمال الكاملة لأهم كتابها فى كل العصور. هناك الكثير الكثير الذى لم يترجم بعد، وينبغى أن يترجم، إلى العربية. وإذا كان الرواج الكبير للترجمات سوف يسيطر على سوق القراءة فهذا يعنى أن الكتب التى تؤلف بالعربية ما زالت تحتوى الكثير من الهراء وقد آن الأوان للتخلص منه. لا تخيفنى الترجمات، بل تضعنى وجهاً لوجه أمام مسؤولية تطوير أعمإلى بالمقارنة مع أهم تقنيات الفن الروائى الذى راكمته الرواية العالمية عبر تاريخها بغض النظر عن موضوعاتها. كما سيرفع رواج الترجمات من سقف التلقى لدى القارئ نفسه ليكتشف أخيرًا الترهل والكسل والاستسهال التى ربته عليها الذائقة الدراجة. هذا لا يعنى أن كل ما يترجم من الروايات جيد فثمة تجارب روائية مترجمة متواضعة، مثل تجربة باولو كويلو وايزابيل ألليندى وحتى باتريك موديانو الذى نال جائزة نوبل، بالمقارنة مع تجارب عالمية أخرى.
-ما الجديد لديك؟
أكتب رواية جديدة الآن. لا أفضل عادةً الحديث عن أعمال لم أنته منها بعد. يمكننى فقط أن أقول إنها لا تجرى على خلفية ما جرى ويجرى فى سورية، وإنها ليست رواية تاريخية بطبيعة الحال.
تعريف
خليل الرز روائى ومترجم سورى من مواليد 1956. صدر له مسرحية وتسع روايات: «سلاويسى» 1994، و«يوم آخر» 1995، و «وسواس الهواء» 1997، و «غيمة بيضاء فى شباك الجدة» 1998، و «سلمون إرلندى» 2004، و «أين تقع صفد يا يوسف» 2008 و «بالتساوى» 2014، و «البدل» 2016، و «الحى الروسى» 2019 التى وصلت للقائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية، بالإضافة لمسرحية واحدة «إثنان» وفى الترجمة عن اللغة الروسية صدر له «حكايات الزمن الضائع» ليفغينى شفارتس 2004، «مختارات من القصة الروسية» 2005 و «مختارات من قصص أنطون تشيخوف» فى مجلدين 2007.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز