
للفنان: فرج حسين
الرواية ترسم عالم ما بعد الوباء
خراب ووحدة فى مواجهة المعرفة والذكريات
الأحد، 27 ديسمبر 2020 - 03:06 م
إعداد وترجمة:
رفيدة جمال ثابت
قبل اجتياح كوفيد 19 وُصفت الوحدة بأنها وباء. والآن ونحن فى خضم أزمة صحية عالمية تغيرت اللغة. والفرق بين العزلة والوحدة حديث، يعود تاريخه إلى أواخر القرن التاسع عشر. فى عام 1621 لخص روبرت بيرتون فى كتابه «تشريح الكآبة» قرونًا من التفكير حينما وصف العزلة بأنها «تأمل وتفكر مربح» و«اكتئاب موهن». هذا التناقض بين العبارتين لم يكن عرضيًا، فأكثر حالات العزلة نجاحًا ومنفعة تحمل معها مخاطر فادحة. رجال الدين المعتكفون كانوا عرضة للفتور الروحى (مزيج من السأم والاكتئاب)، والعلماء والشعراء المعتزلون كانوا يتصارعون مع «خيالات محمومة». عزلة روبنسون كروزو تميزت بنشاط رواقى وتنوير روحانى، وكذلك بالبؤس الغامر لكونه وحيدًا.
فى عام 1951 وصفت هانا آرنت العزلة فى كتابها «منابع الشمولية» بأنها «الانفراد بالنفس»؛ رفقة الذات المتأصلة فى عملية التفكير والتى أطلقت عليها الحوار الداخلى. حل انتشار الشمولية محل هذه العزلة والوحدة، إذ أصبح الناس المروعون «معزولين عن بعضهم بعضًا»، تخلت عنهم الأنا الأخرى فأفسح التفكير العقلانى الطريق للمنطق الشمولى الوحشي: خسارة الذات والعالم فى آن واحد. الشمولية بالنسبة لـ آرنت تعزز الوحدة التامة «وتدمر جميع البشر». تكتب ماشا جيسن فى صحيفة ذا نيويوركر أن كلام آرنت ينطبق بوضوح على وضعنا الحالى. ترى جيسن أن العزلة التى يفرضها الحجر الصحى مخيفة من الناحية السياسية، إذ إنها تفصل المرء عن ذاته المفكرة، وتتركه فى حالة أليمة وبليدة من السلبية الموحشة.
بالنسبة لـ آرنت وجيسن تأتى الوحدة حينما يفقد الناس تواصلهم مع ذواتهم المفكرة، ويحل الرعب والهلع محل الفكر المنفرد. غير أن ثمة رأيًا يقول إن العزلة التى يمكن التعايش معها تعززها الرعاية ويوطدها الاهتمام. فى عام 1958 وصف عالم النفس البريطانى دونالد وينكوت القدرة على تحمل العزلة، أو التمتع بها، بأنها إنجاز تطورى يحدث فى مرحلة الطفولة المبكرة، ويكتسبه الطفل عبر اهتمام الوالدين، غالبًا الأم. ومع النمو يتحول الشخص المهتم إلى رفقة ذاتية داخلية حينما يكون الطفل وحيدًا. فى ظل الوباء وما استتبعه من قيود وإجراءات احترازية يعانى الكثيرون؛ فبعضهم لم يتلق الاهتمام الذى يجعل الوحدة محتملة، وآخرون وجدوا الرعاية تتداعى تحت وطأة العزلة الإجبارية. من ناحية أخرى، يحذر المؤرخ فريد كوبر من أن كوفيد 19 يمثل للعديد من الناس «تهديدًا وجوديًا»، ملقياً بهم فى عزلة مميتة. فحينما يكون الناس بعيدين عن الأصدقاء والعائلة وأى شخص يشعرهم بأنهم جزء من الإنسانية، يفقدون طوق النجاة.
فى ظل الظروف الراهنة الصعبة المفعمة بالخوف والارتياب، يفتح لنا الأدب بابًا للهروب والغوث والرفقة. ومن العجيب تزايد الإقبال على قراءة أدب الأوبئة؛ حيث تقدم روايات كثيرة تسلسلًا زمنيًا واقعيًا، بداية من العلامات الأولى مرورًا بالأوقات الحالكة، ووصولًا إلى عودة الحياة إلى مجراها الطبيعى. تكشف هذه الروايات أننا خضنا هذه المحنة من قبل، وأن البشرية نجت من أسوأ الظروف. فى كتابه «يوميات عام الطاعون» يؤرخ الكاتب الإنجليزى دانيال ديفو للطاعون الدملى الذى اجتاح لندن فى عام 1665، مسهبًا بتفاصيل مخيفة عن الأحداث تذكرنا بردود أفعالنا تجاه الصدمة الأولية وتفشى الفيروس الحالى. يبدأ ديفو سرده بشهر سبتمبر 1664، حينما انتشرت الشائعات بعودة الطاعون إلى هولندا، ثم قدومه إلى لندن فى ديسمبر. يصف ديفو كيف أن إشعارات الوفيات المعلقة فى الكنائس المحلية ارتفعت بشكل مشئوم. بحلول يوليو، فرضت مدينة لندن قواعد جديدة مثل «إيقاف جميع الاحتفالات العامة والولائم وغلق الحانات وأماكن الترفيه الأخرى حتى إشعار آخر». وبرغم ذلك لم يرتدع الناس فيكتب ديفو «لا شيء كان أكثر إهلاكاً لسكان هذه المدينة سوى إهمالهم المتبلد». وفى أغسطس كتب أن الطاعون «كان عنيفًا ومرعبًا». وبحلول مستهل سبتمبر وصل إلى ذروته البشعة حيث «حصد أرواح عائلات بأكملها». وفى ديسمبر «تلاشت العدوى، وحل فصل الشتاء بسرعة، وصار الهواء صحوًا وباردًا، واستعاد معظم المرضى صحتهم، وشرعت المدينة تتعافى».
الأوبئة التى اجتاحت القرن الـ 21 مثل سارس فى 2002، وإيبولا فى 2014، ألهمت روايات كثيرة وتنبأت بالانهيار والخراب والوحشة والوحدة بعد الوباء. فى رواية «عام الطوفان» تصور الكاتبة مرجريت أتوود عالم ما بعد الوباء حيث انقرض البشر تقريبًا، وانمحى معظم السكان من على وجه الأرض منذ 25 عامًا مضت بسبب طوفان جاف، وباء فتاك «حمله الهواء كأنه أجنحة، وانتشر فى المدن كالنار فى الهشيم». تنقل لنا أتوود العزلة التامة التى شعر بها الناجون القلائل. تنظر توبى البستانية إلى الأفق من سقف حديقة تقتات منها فى منتجع مهجور. «لابد وأن أحدهم هناك... بالتأكيد ليست الإنسانة الوحيدة على سطح الكوكب. لابد وأن هناك آخرين. ولكن هل هم أصدقاء أم أعداء؟ كيف تعرف إن رأت أحدهم؟». عبر استحضار الذكريات تصف أتوود كيف دمرت الهندسة الحيوية، التى كانت تدعمها الشركات المهيمنة، التوازن بين عالم الطبيعة وعالم البشر، وكيف قاوم الناشطون.
فى رواية «البتر» ترسم الكاتبة لينج ما صورة مدينة نيويورك بعدما «انهارت البنية التحتية، وانقطعت شبكة الانترنت وتعطلت الكهرباء». البطلة كانديس تشين، أحد الناجين التسعة الذين فروا من المدينة بسبب حمى معدية اجتاحت العالم عام 2011، تلتحق بمجموعة ناجين يتجهون إلى مركز تسوق تجارى بشيكاجو. تستكشف لينج أسوأ سيناريو، لا نواجهه لحسن الحظ، ما الذى سيحدث بعدما يتلاشى الوباء؟ من سيكون مسئولًا عن بناء المجتمع والثقافة؟ من سيمتلك مقاليد السلطة بين مجموعة عشوائية من الناجين؟ فى رواية (المحطة الحادية عشرة) للكاتبة إيميلى سانت جون مانديل، يتفشى فيروس أنفلونزا شرس «ينفجر كقنبلة نيوترونية»، ويبيد 99 % من سكان الأرض. تتساءل مانديل فى الرواية كيف سيتغير الفن والثقافة؟ وما الذى يحدد الفن ومن؟ وكيف سنعيد البناء بعدما حاصرنا الفيروس الخفي؟
إن الأوبئة تلهمنا للكتابة عن مآسينا ومخاوفنا المستقبلية. ومثلما قال كامو: «كل ما يمكن للإنسان كسبه فى الصراع بين الوباء والحياة هو المعرفة والذكريات». التاريخ يكرر نفسه، ولا أحد يزداد حكمة. وحده الأدب يقاتل من أجل عالم أكثر عدلًا ومساواة. وربما تمنحنا العزلة التى تفرضها علينا الأوبئة الهدوء والاستقرار كى نتأمل علاقة جديدة مثمرة مع أنفسنا والآخرين والعالم.
المصادر: 1) مواطنون منعزلون: سياسات الوحدة، باربرا تايلور، الجارديان، يناير 2020. 2) كُتّاب تنبأوا بالوباء الراهن، جين شيباتورى، بى بى سى، إبريل 2020.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
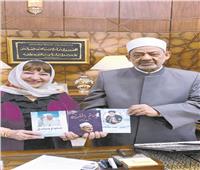 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز





















