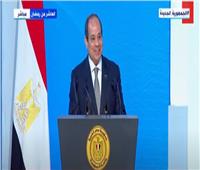مى التلمسانى
بعد تسلمها الوسام الفرنسي للفنون والآداب برتبة فارس.. مي التلمساني: «الزمن رهاني الأول»
الأحد، 20 مارس 2022 - 04:29 م
حوار: أسامة فاروق
تسلمت الكاتبة مى التلمسانى الثلاثاء الماضى الوسام الفرنسى للفنون والآداب برتبة فارس من السفير مارك باريتى الذى أثنى فى كلمته على التجربة الطويلة لمى التلمسانى فى الكتابة والترجمة والتدريس وعلاقتها الممتدة مع الأدب والثقافة الفرنسية بشكل عام.
كانت كلمة السفير فى الحفل الذى أقيم بمقر السفارة الفرنسية بالقاهرة بمثابة حيثيات منح الوسام لمى التلمسانى، حيث تحدث عن دراستها المتعمقة للأدب الفرنسى، وحضور أعمالها بين الجمهور هناك، مشيراً إلى رواياتها الثلاث المنشورة فى فرنسا «دنيا زاد، هليوبوليس، أكابيللا»، إضافة إلى ترجمتها لعدد من الأعمال من الفرنسية إلى العربية، من بينها عدة كتب عن السينما، مشيراً بشكل خاص إلى كتاب الفيلسوف الفرنسى جيل دولوز عن كافكا حيث أكد سعادته الشخصية بترجمة هذا الكتاب الفلسفى الصعب، مثمناً اهتمام مى بالفلسفة رغم أنها تكتب فى مجال الميديا والأدب.
تحدث السفير أيضاً عن الدور الأكاديمى البارز الذى تلعبه التلمسانى فى خلق جسور بين الثقافات واهتمامها بالدراسات البينية، وخروج أبحاثها ودراساتها عن الأنماط الشائعة والسائدة، بشكل يجعل دورها عابر للحدود والبلدان والثقافات.
كما أبدى إعجابه الشديد بمبادرة بيت التلمسانى كعمل ثقافى فريد من نوعه فى مصر. ولم يخف اندهاشه الشخصى من الاهتمامات والإنجازات المتعددة لشخص واحد فى كل هذه المجالات المتنوعة بين الأدب والسينما والترجمة والأدب.
أخيرا ربط السفير الفرنسى بين هذا كله وبين الفرانكفونية باعتبارها الحصن الأخير للعناية الثقافية فى العالم.
كانت مى التلمسانى قد أعلنت فى نوفمبر الماضى خبر حصولها على الوسام، حيث وصلتها رسالة من وزيرة الثقافة الفرنسية عن طريق سفير باريس بالقاهرة. وقتها قالت إن أول من خطر ببالها عقب تلقيها الخبر هو والدها عبد القادر التلمسانى ورحلته الشاقة لدراسة السينما فى فرنسا فى معهد الايديك الشهير ثم فى السوربون من 1948 وحتى 1953 وتشجيعه لها على دراسة الأدب الفرنسى بالجامعة «تذكرت كم أنا مدينة له بكل جميل فى حياتى». وهى المعانى نفسها التى أكدت عليها فى كلمتها المرتجلة عقب تسلمها للوسام، وأول ما تبادر إلى ذهنها فى الحديث الذى أجريته معها بعدها.
قالت فى البداية إنها تلقت الخبر بغبطة شديدة وباندهاش تخالطه مشاعر الفرح والامتنان، خصوصاً أنه جاء فى لحظة عصيبة على المستوى الشخصى كما تقول: «لكن بشكل عام كان الاعتراف بقيمة ما أنجزته حتى الآن فى المجال الثقافى وخاصة فى مجال الكتابة الروائية مصدر سعادة بلا شك».
لكنها لا تتوقف طويلاً عند هذه النقطة، تقفز على الفور للحديث عن أصحاب الفضل، تقول: «حين وصلنى خطاب وزيرة الثقافة الفرنسية فكرت أول ما فكرت فى أبى المخرج التسجيلى عبد القادر التلمسانى، وهو درس السينما فى فرنسا فى الأربعينيات وبداية الخمسينيات. تذكرت أنه أهدانى كتاب ذات الرداء الأحمر بالفرنسية وأنا بعد لم أتعلم القراءة وشجعنى منذ ذلك اليوم على الاهتمام بالأدب والإبداع، وأهدانى بعد ذلك بسنوات كتاب ألف ليلة وليلة ولم أكن بعد قد تجاوزت الخامسة عشرة من العمر، ثم أهدانى مكتبته بالكامل وهى أثمن ما يمكن أن يهديه أب محب لابنته. وعلاقتى أيضاً بعمى الأكبر كامل وعمى حسن (وكلاهما له بصمة على تاريخ الفن التشكيلى والسينما فى مصر) علاقة وطيدة، فيها قدر كبير من المحبة والعرفان. نشأتى فى بيت يهتم بالفنون على تنوعها، وينتمى لليسار الاشتراكى والماركسى، جعلنى أنظر لنفسى كجزء لا يتجزأ من العالم، سواء بانتماءاتى الفكرية والروحية والسياسية أو بعملى فى مجال الإبداع والبحث العلمى».
وهى النظرة التى تجعلها تبحث عن النجاح فى مكان آخر فلا تدعها تنشغل بموقعها أو ترتيبها بين الكتاب، أو تقف فى طابور انتظاراً لمنحة أو جائزة، أو تغازل قارئاً طمعاً فى رواج زائف «الرواج والموضة مسألتان تشغلاننى من الناحية النقدية والأكاديمية» قالت من قبل، وتؤكد مجدداً أنها أرادت منذ البداية أن تبتعد عن التكرار فى مجال القصة والرواية، أن تكون لكل رواية خصوصية من حيث السياق والأسلوب والقضايا المطروحة: «وأعتقد أنى حققت ذلك بشكل لا بأس به. كما يعنينى كثيراً الاقتصاد والحفر فى المشاعر ورسم شخصيات قوية لا ينساها القارئ، وهذا أيضاً تحقق بقدر لا بأس به من النجاح. البعض يعود الآن مثلاً لرواية «هليوبوليس» ويعيد اكتشافها بعد ما يزيد عن عشرين عاما من نشرها». وهو ما يعنى أن الكتابة الطموح التى تسعى للتجديد والمغامرة لا تموت، وأنها بالتأكيد أيضاً متابعة ومقدرة.
ما الاختلاف بين هذا الوسام والجوائز الأدبية الأخرى؟
الوسام ليس جائزة بالمعنى المتعارف عليه، هو وسام شرفى تمنحه دولة فرنسا لمن تراهم أهلاً للتقدير فى مجالات الآداب والفنون على المستوى الدولى. هو واحد من أربعة أوسمة رفيعة يعود تاريخ بعضها لنابوليون بونابرت والبعض الآخر للرئيس شارل دوجول، ويُمنح للفرنسيين ولغير الفرنسيين. على العكس من جوائز كثيرة، لا يمكن التقدم للحصول على الوسام، فالسفارات الفرنسية هى من تقوم بترشيح الأسماء حيث تتقدم الملحقيات الثقافية الفرنسية بملف عن المرشحين لوزارة الثقافة الفرنسية وعلى ما أعتقد أيضاً لوزارة الخارجية، ويقوم فريق من المحكمين بتقييم الترشيحات ومنح الأوسمة. وقد علمت من الملحقية الثقافية بالقاهرة أنى الوحيدة من مصر هذا العام التى تحصل على الوسام برتبة فارس.
بشكل عام، هل غير جدل السنوات الماضية من نظرتك لفكرة الجوائز؟
ليست لدى فكرة واضحة عن نظام وتوقعات الجوائز الأدبية فى العالم العربى، ولا فى فرنسا. أعرف أن بعضها أكثر بريقاً من البعض الآخر، وهى فى ظنى مهمة لتقدير الجهد الذى يبذله الجميع سواء الكاتبات والكتاب أو الناشرين أو الموزعين أو حتى قنوات التواصل الاجتماعى وما يسمى بظاهرة الأنفلونسر. فى النهاية الجوائز تُسعد بلا شك من يحصلون عليها، لما فيها من تقدير أدبى أو مادى أو ترجمة أو اعتراف بالقيمة، وأنا فى كل هذه الأحوال أسعد بسعادة من يحصل عليها ولا أجادل فى قيمة العمل الأدبية.. تلك مسألة خلافية والجدل المثار حولها يثير دهشتى فى أحيان كثيرة، لأن ما قيل ويُقال عن اختيارات لجان التحكيم مكرر ولا يخلو من انتهازية أو شماتة أو عنجهية أو حتى اغتباط واحتفاء فى غير محله. الكل فى مؤسسة الأدب على تنوع العاملين فيها يعلم أن الجوائز لا تصنع قيمة، تصنع فقط نجوماً سرعان ما يخبو بريق بعضها، أو تتفتح طاقات بعضها الآخر الإبداعية. الأمر برمته خاضع فى كافة الأحوال للمصادفة والتحول والنسيان. رهان الزمن هو الرهان الأدبى الأول بالنسبة لى، وهو ما أعتقد فى قوته وسطوته وتغلبه على كل بريق زائف أو زائل.
تقدير من هذا النوع يشير بوضوح إلى الدور المنوط بالمبدع حتى خارج عملية الإبداع نفسها، إلى دوره المجتمعى والإنسانى أيضاً، كيف ترين هذه المسألة؟ وهل المبدع العربى مقصر أم مظلوم فى هذا الجانب؟
بحكم عملى الأكاديمى أعتقد أن لى دوراً يختلف عن صورتى كروائية والدور المتوقع منى كروائية. وأتصور أنى حافظت على هذين العالمين وكأنهما متوازيان. خارج عملية الإبداع الروائى أحاول أن أبدع فى النقد، وكل ما نشر لى من دراسات أكاديمية فى مصر وخارجها يسعى للتجويد والتجديد على هذا المستوى. اهتمامى مثلاً بقضية المواطنة المرتحلة، وبدور عرب الشتات فى جهود التغيير أثناء وما بعد الربيع العربى، والتأصيل للفنون سواء فى مجال السينما أو الأغنية أو الأدب فى علاقتها بالسياسة، ومؤخراً الاهتمام بالتيارات الطليعية مثل السوريالية المصرية ودورها فى خلخلة موازين القوى فى العالم ونقد الحداثة الأوروبية، كل هذا بلا شك يؤكد على أن المبدع العربى حين تُتاح له فرصة الكتابة بحرية يستطيع أن يؤثر إيجابياً فى تغيير بعض المفاهيم الراسخة عن العرب ويتشابك مع تيارات الفكر الغربى من منطلق الندية لا التبعية. أما العموم فيعانى من ظلم وتجهيل شديدين، والأمل يكون دائماً فى الخروج من شرنقة القوميات والهويات القاتلة ومجابهة العالم بصدر رحب وبإنسانية تتسع لمساحات أكبر من التسامح والتواصل.
رغم الحضور الكبير للثقافة الفرنسية فى فترات سابقة فى مصر لكن يبدو الأمر الآن كما لو كان قد حُسم لصالح هيمنة الثقافة الأمريكية والإنجليزية. هل هذه الرؤية صحيحة؟
رؤية صحيحة تماماً، والوضع الحالى يأتى جزئياً نتيجة لانحسار الدور الثقافى الذى تلعبه فرنسا فى العالم، وتراجع الاهتمام فى السنوات العشرين الماضية تحديداً بدعم مدارس اللغات الفرنسية خارج فرنسا. ولكن بالرغم من ذلك، تظل فرنسا قبلة الثقافة الطليعية على مستوى النشر والترجمة من العربية وكذلك فى السياق الأكاديمى، خاصة فى مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية. الهوى الفرنسى لا يخفى على أحد فى كل ما يخص تلك المجالات، فى الأدب والشعر والفلسفة والفكر وعلوم الاجتماع والعلوم السياسية، ثمة اهتمام كبير بتجاوز المقولات الثابتة وإعمال النقد والاحتفاء بالتجديد لا تجده متحققاً بالضرورة فى الثقافة الأمريكية أو الأنجلوسكسونية التى تتسم أحياناً بالمحافظة أو البطء فى استيعاب حركات التجريب والتجديد. لكنى لا أريد أن أعمم. المسألة شائكة لأنى أكتب أبحاثى باللغات الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية، لكنى أعتقد أن روحاً فرنسية أساسها إنسانى عابر للحدود تعم وتؤثر فى كل ما أكتب.
-فى فترات سابقة كان هناك تركيز واهتمام بفكرة الحضور والتأثير العربى فى الغرب، بهت الأمر الآن وعاد لخموده القديم خاصة فى أعقاب الانشغال الداخلى بعد موجات الثورات العربية. بعد أكثر من 20 عاماً من المراقبة والتحليل والتعايش أيضاً كيف ترين التأثير العربى فى الغرب حالياً؟ وكيف يؤثر ذلك على عرب المهجر؟
التأثير فردى لا جماعى، والجماعات العربية فى الخارج إما تذوب فى المجتمعات الكبرى التى احتضنتها أو تنزوى فى جيتوهات أيديولوجية ومجتمعية انعزالية بالضرورة، وغاضبة فى معظم الأحيان وشوفينية فى تجلياتها القصوى. لكن العرب كأفراد يبرزون فى مجالات شتى، اجتماعية وسياسية وفنية وعلمية ولهم إنجازات كبرى تُحسب لهم كأفراد، ويتم الاحتفاء بهم فى مجتمعاتهم الأم وكأنهم ممثلون لها، وهم فى الغرب يمثلون أنفسهم فى الحقيقة. لكنى أرصد أن عرب الشتات فى الغالب الأعم، وكما أشرت فى روايتى الأخيرة «الكل يقول أحبك»، يحرصون على العلاقة بأوطانهم الأم ويعيشون مسألة الهوية الثنائية بقدر كبير من التشتت، ولا أقول الوجع، خاصة وهم يشهدون تساقط أحلام التغيير التى لوحت بها الثورات العربية منذ 2010 وحتى اليوم.
بمناسبة «الكل يقول أحبك»، بعد أول رواياتك التى تدور فى فلك الهجرة بدأت تتحدثين عن العودة؟!
العودة هى قدر المهاجر، وحلمه الوردى. نعم أجهز للعودة إلى مصر نهائياً، ربما فى غضون أشهر، وربما فى غضون سنوات، لكن الحلم يخايلنى منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، أردت أن أعود نهائياً فى 2011، وتراجعت. اليوم أعتقد أن الحلم سيتحقق قريباً جداً. لكن الروايات القادمة ستتناول أيضاً مسألة الهجرة، لدىَّ فى جعبتى رواية جديدة أتناول فيها قضية البيت باعتباره معادلاً للوطن فى حياة نساء الشتات المصرى فى كندا.
كتبت مؤخراً «مؤسف جداً أن تشبه كتابة جديدة كتابة قديمة، والمؤسف أكثر أن يحتفظ القديم بطزاجته وعنفوانه وسحره وأن يبدو الجديد بجواره ذابلاً وباهتاً ومصطنعاً رغم ادعاء الجدة». كانت تلك بمثابة صرخة اعتراض مكثفة ربما تحتاج لمزيد من التوضيح؟
أراقب عن كثب ما يكتب فى مصر، وكثير منه مهدر لأنه تكرار لوصفات كلاسيكية فى الكتابة، مع الإفراط فى استخدام بهارات تبدو لوهلة كأنها جديدة لكنها منقولة رأساً من كتابات سابقة أو مشاهد سينمائية مكررة وساذجة، أو منقولة من ترجمات. طموح مثل هذه الكتابة محدود جداً، ولحظى، قد تجد بها مغالاة فى الإبهار اللغوى، أو مبالغة فى استدعاء الغموض (وهو مفضوح ومكرر) وتراكم الأحداث الغرائبية (وهى غالباً مثيرة للشفقة لفرط سذاجتها). كلها أدوات تضعف النصوص المكتوبة وتفضح ترهلها رغم محاولة محاكاة النص الكلاسيكى، الذى حين نعود لقراءته نكتشف أنه فعلياً أكثر رسوخاً وعنفواناً. ناهيك عن أن بعض الكاتبات والكتاب يصدّر للقارئ وجهاً أشبه بوجه نجوم الفن والغناء والإعلام ويسعى لتأمين مكانة بين القراء من خلال الماركتنج أو التسويق والتواجد المستمر والتأثير عبر وسائل التواصل الاجتماعى إلخ. لا بأس فى ذلك وليست لدىَّ رغبة فى إدانة أى من تلك الممارسات، لكن اعتقادى أن طموح الكتابة القوية فى منطقة أخرى، تتطلب قدراً من التفرغ والوعى والتخلى ومراجعة النفس والصبر على النشر.
قلت إن الوسام جاء فى لحظة صعبة على المستوى الشخصى، بشكل عام لدىَّ انطباع بأن لديك تصالحاً مع الأسى والوجع فى حياتك ملازماً للاحتفال بالإنجاز والفرح به كيف تفعلين ذلك؟
ربما لأنى قرأت فى مرحلة من مراحل دراستى الجامعية فلاسفة مثل سبينوزا وفولتير ومن قبلهما مونتانى، ثم قرأت وأفدت من فلسفة جيل دولوز وإدوارد سعيد، وكلها فلسفات حياة وتفاؤل تعتمد سياسات الأمل فى مواجهة سياسات اليأس ولا تخضع لمخاوف الموت وتعتبره جزءاً لا يتجزأ من الوجود، تحيا معه وتتحايل عليه. الموت الذى أصابنى بذعر هو موت ابنتى يوم ولادتها، لكنى أحيا معه ومعها، وهى تعيننى على الاستمرار والمشاعر التى تصورت آنذاك أنها ستميتُنى ظلت حية بداخلى وظللت حية بها. هاجس الموت لا يقلقنى، فقط يجعلنى أكثر صلابة فى مواجهة الحياة نفسها. أما الفرح والبهجة والسعى للحصول على السعادة فقدر مثلها فى ذلك مثل الموت.
لو أنك من تختارين من ينال الوسام بعدك فعلى من يقع اختيارك وما حيثيات هذا الاختيار؟
الوسام يُمنح لمن يستحقه فى مجالات الفنون والآداب ولدينا فى مصر أسماء كثيرة لديها منجز كبير فى تلك المجالات. أتمنى أن يحصل عليه (فى كل رتبة من رتبه الثلاثة) كتاب وكاتبات من طليعة الأدباء والسينمائيين فى العالم العربى، وأن يلتفت القائمون على الاختيار والترشيح لفئات أخرى مثل الفنانين التشكيليين والموسيقيين.
أخيرا ما الجديد لديك على مستوى الكتابة والعمل الثقافى بشكل عام؟
الجديد رواية قيد الكتابة، الثانية بعد «الكل يقول أحبك» التى أتناول فيها قضايا المهاجرين العرب فى شمال أمريكا، ومشروع بيت التلمسانى الذى أتمنى أن يستقبل أول ضيوفه للإقامة والتفرغ فى فصل الربيع. البيت حالياً مغلق للتجديدات وأملى أن يصبح متاحاً للزيارة فى شهر أبريل. أما الجديد فى الترجمة فهو قيامى حالياً بترجمة كتاب الفيلسوف الفرنسى جيل دولوز عن كافكا إلى اللغة العربية ويصدر عن دار صفصافة بالقاهرة. وفى مجال البحث الأكاديمى أبدأ فى الشهور القادمة دراسة عن نتفلكس والمنصات الشبيهة فى العالم العربى وعلاقتها بالرقابة وبصناعة الميديا وشركات الإنتاج المحلية.

الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز