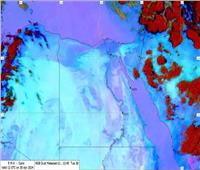حاتم حافظ يكتب : نصوص فترة التعافى إلى أحمد عبداللطيف
حاتم حافظ يكتب: نصوص فترة التعافى إلى أحمد عبداللطيف
السبت، 17 سبتمبر 2022 - 03:40 م
احتفال
حين دخلتُ غرفتى بالفندق لم أكتشف فحسب أنها تطل على النهر ولكن أيضا أن بإمكانى اعتلاء قارب متاخم لشرفتها، وهو الأمر الذى لم أكن لأفوّته. قفزتُ فى القارب الذى تحرّك فور ركوبى وبدأ فى مغادرة الممرات التى تفصل كل غرفة عن الأخرى، ففيما يبدو كانت غرف الفندق كلها طافية على سطح النهر. القارب لم يكن له سائق ولم تكن ثمة أداة لتوجيهه لكن زال خوفى بعد أن تفادى الاصطدام بعدة غرف فى طريقه. بعدها تحوّل القارب إلى ما يشبه الغوّاصة الصغيرة فقد أوغل فى عمق النهر وكان بإمكانى رؤية الكائنات العجيبة التى تسكن الأعماق.
انتهت الرحلة فجأة فوجدتنى أسير فى شوارع مدينة نصف غارقة. كان الماء فيها يغطى سيقان العابرين وأبواب السيارات لكن أحدًا من سكانها لم يكن يشكو أو يتذمر. تجولت فى المدينة المائية وحين حل الليل فيها وجدت ناسها يحتفلون بشيء ما، ففى كل ركن كان الموسيقيون يعزفون ألحانا جميلة. مررت بكشك وكان الجوع قد عصرنى فوقفت أتطلع للمأكولات والتى كانت مغلفة بأغلفة لها ألوان مدهشة. ألوان لم أصادفها من قبل فى حياتى. حينها خطر لى أنى أحلم فتذكرت أن هاتفى كان معى حين سقطت فى النوم فخطر لى أن ألتقط صورا للحلم. وجدت الهاتف بالفعل وبدأت فى التقاط صور لكل شيء وكنت مبتهجا للغاية لكنى فجأة فكرت فى أنى لن أتمكن من الفرار بالصور فمن يضمن أن يكون هاتفى حقيقيًا؟!
كنت وسط احتفال مبهج فى مدينة نصف غارقة وفى كفى هاتف وفى عقلى سؤال مخيف.

موعد
يبدو أننى كنت على موعد ما لا أذكره. أقف أسفل شجرة اتقاء لحرارة الشمس وأنقل نظرى بين الساعة التى تتوسط الميدان وفتحة المترو. طال انتظارى ولم يظهر أى شخص أعرفه. كل عدة دقائق تلفظ فتحة المترو أشخاصا ينطلقون فى مسارات متعارضة دون أن يصطدم أحدهم بالآخر. قررت تسلية انتظارى بعدّ الذكور والإناث، والذين يخرجون فى جماعات والوحيدين وعدّ العاشقين الذين كانوا مُعرَّضين أكثر للاصطدام؛ لأنهم يخرجون غافلين عن الدنيا، الأطفال والكبار، الصبية والمراهقين والشباب والعجائز، الأصحاء والمرضى والمتعبين، المتباهين والخجولين، السعداء والمفطورة قلوبهم، المنتشين والباحثين عن مغامرة، القتلة والمقتولين المحتملين.
مر وقت طويل فلا هدأت حرارة الشمس ولا وصل شخص أعرفه، أما لعبتى فمللتها. ارتبت فى الأمر كله وحينها انتبهت لشخص يقف أسفل شجرة وكان - مثلى - ينقل نظراته بين فتحة المترو والساعة. هممت بسؤاله فأشار لى أن أصمت بغرور فقررت إضافته لقائمة المتباهين. لاحظت أنه كان مشغولا بعدّ الخارجين من فتحة المترو. كان يشير بإصبعه ذات اليمين والشمال ويتمتم بأرقام وفجأة وجدته يشير نحوى ويتمتم برقم. تساءلت بينى وبين نفسى دون أن أتجرأ على سؤاله: ماذا أكون أنا فى قوائمه.
ظلان
رأيتنى أجلس فى حديقة أسفل شجرة لا ظل لها، وكان مدهشا أن يكون لى ظلان. وكان عن يمينى كتاب وعن يسارى كتاب. حاولت أن أتلهى عن دهشتى بقراءة كتاب من الكتابين لكنى وجدتهما خاليين من الكتابة. حتى أنى لم أجد عنوانا على غلافيهما. مددت يدى أفتش عن قلم فى جيبى فاكتشفت أنى نسيته فى مكان ما؛ فقد خطر لى أن ملأ الصفحات مهمة أُسندت إلى فى زمن آخر. فتشت فى الجوار عن أى شيء يمكننى من الكتابة دون جدوى وكنت منزعجا للغاية لأن ظليّ تبعانى فى كل مكان. حين عدت لمكانى أسفل الشجرة التى لا ظل لها زحف ظليّ على غلافى الكتابين فاكتشفت أنهما مكتوبان بألوان سرية لا يمكن قراءتها إلا فى امتداد الظل. لحظتئذ التقطت كتابا وبدأت فى قراءته مستعينا بظل من الظلين عازما على قراءة الكتاب الآخر بمعونة ظلى الآخر.
أغنية
رأيتنى أقف فى وسط ميدان أتمتم لحنا لأغنية لعمرو دياب لا أذكر من كلماتها إلا: قول لى إزاى أعيش. أحاول تذكر الكلمات فتختلط الأغنيات معا. يذكرنى اللحن بألحان أخرى من المقام نفسه. تختلط الأغانى أكثر فأكتشف أن الجملة الوحيدة التى أتذكرها يمكن أن تندس فى كل الأغنيات التى تذكرتها دون مشقة. تعجبنى اللعبة فأقرر تجربة الجملة مع ألحان أخرى من مقامات مختلفة فاكتشف أن الأغنيات كلها يمكن لجملة واحدة مثل هذه أن تناسبها بل وأن تختصرها. اكتشف أن كل الموسيقى كانت تنويعا على جملة واحدة أو بالأحرى سؤال واحد: قول لى إزاى أعيش.
شك
رأيتنى أعمل فى ما يشبه السفارة الأجنبية. أثناء مرورى لاحظت وجود لوحة لم تكن موجودة من قبل، ما أدهشنى أكثر أنها كانت مقلوبة. رفعت اللوحة من على الحائط لأقوم بضبطها فقرأت عبارة غريبة طُرّزت بخط غير ميسورة قراءته. الجملة كانت تقول: شعب الهوجا بناة الأهرامات يرغبون فى زيارة بلدهم. شعرت بوجود مؤامرة تحاك من خلف ظهرى. أعدت اللوحة كما كانت وبدأت أفتش فى باقى اللوحات عن الرسائل المدسوسة فيها بارتياب مفرط.

الجار
رأيتنى أذهب لجار لى بدعوة منه. كان شخصا بدينا وغريب الأطوار ولم تكن بيننا المعرفة الكافية لكى يدعو أحدنا الآخر لكنى فكرت فى أنه من قلة الذوق ألا ألبى دعوته. ما أن فتح الباب حتى دعانى للدخول للبلكونة. عبرنا بغرفة نومه فى طريقنا وكانت زوجته فيما يبدو متعبة وجالسة فى سريرها تدلك قدميها المتعبتين. فكرت أن ألقى تحية عابرة لكنه كان قد سبقنى للبلكونة من جهة ولم تكن زوجته منتبهة أو حتى مهتمة من جهة فدخلت خلفه دون توجيه إشارة.
فى البلكونة أطلعنى على اختراعه الجديد بحماس شديد وشرح تفاصيله لكنى لم أفهم شيئا مما قاله ولا لأى غرض قد اخترعه. ظل يشير لبلكونات جيران شارعنا ويحكى حكايات عن كل جار ولم أفهم إن كان يحكى ما يحكيه لتسليتى أم لأن اختراعه ساعده فى معرفة كل هذه الحكايات والأسرار.
كنت ضجرا لدرجة أن شيئا مما قاله لم يثر فضولى بدرجة كافية لأجاريه أو لأسأله عن شيء. أثناء سماعى لثرثرته نظرت للبلكونة المجاورة فرأيت شابين غارقين فى قبلة وكانا ساهيين عنا وعن العالم. نظرت نحوه استطلع إن كان يراهما فوجدته غير مهتم. سألته عنهما فنظر نحوهما وكانا ما زالا سادرين فى قبلتهما فهز كتفيه وقال إنه لا يعرفهما. فخطر لى سؤال: كيف يعرف كل هذه الحكايات عن كل سكان الشارع ولا يعرف شيئا عن الجارين اللذين يسكنان الشقة المجاورة.
المقام
رأيتنى أدخل مقاما اكتشفته بالصدفة وأنا أتجول فى شوارع مدينة لا أعرفها. سألت أحد المارة عنه فقال مندهشا من جهلى هذا مقام يقصده الحائرون. خلعت حذائى ودخلت فوجدت ضريحا أعلاه كتبت عبارة واحدة: لا يدخله إلا مدعو.
فكرت فى أن وجودى بالمقام يعنى أنه تمت دعوتى، لكنى تساءلت من مَن؟! ولأن شخصا لم يدعنى نكزنى الخوف من أن أكون متطفلا على المقام. تلفت حولى خوفا من أن يكون وجودى المتطفل قد لفت انتباه أحد فاكتشفت أن كل الموجودين يتلفتون دون أن تستقر نظراتهم على أحد. فجأة ظهر شيخ له هيبة ووقار وعليه عباءة خضراء بادل الجميع التحية ثم اقترب منى فخفت أن يكون قد كشفنى. اقترب وربت على كتفى قائلا: كنا فى انتظارك يا جميل.
احتفال
رأيتنى أذهب لاستلام جائزة ما. كان كل شيء معدا لكن الجميع كانوا بانتظار شخص مهم والذى تأخر فيما يبدو لانشغاله بتوديع ضيف أجنبى فى المطار. أجلسونى فى الصف الأول أنا وزوجتى التى ارتدت فستانا جديدا خصيصا للمناسبة. ما أن جلسنا حتى مال رجل وهمس لى مستأذنا بتأدب شديد أن ينقلنا للصف الثالث. الرجل كان محرجا لأنه - كما قال لى بود - من قرائى.
وفى الطريق للصف الثالث فسّر لى محرجا أن الصف الأول مخصص للشخص المهم وبعض رجالات الحكومة. حين وصلنا للصف الثالث وجدنا ملصقا على كل مقعد ففيما يبدو خصص منظمو الحفل المقاعد لشخصيات عامة. اقترحت أن نجلس فى الصف الثانى لكنه اعتذر بتأدب حقيقى لأن الدواعى الأمنية تمنع ذلك. كان ودودا ومحرجا لدرجة أنى أخبرته بأن يتابع عمله ويترك لى أمر التصرف.
وفى نهاية القاعة كانت ثمة مقاعد غير مخصصة لأحد فاقترحت على زوجتى مترددا الجلوس فى الصف الأخير. خشيت أن تشعر بالضيق لكنها أيدت الفكرة بقوة. بعد أن جلسنا قالت إنها تفضل أن أمُر بالقاعة كلها حين ينادون اسمى لأحصل على تصفيق متصل وطلبت منى ألا أهرول حينها. بهدوء وثقة.. هكذا قالت بحسم.
بعد ساعتين وصل الشخص المهم وحين مر بنا هممت بالقيام لكن زوجتى شدت ذراعى لأبقى مكانى. انت العريس.. هكذا برّرت فعلها. لحظات وبدأ الحفل الذى بدأ بكلمة من منظم الحفل ثم دعى الشخص المهم ليلقى كلمة وكانت كلمة موفقة فيما يبدو لأن الحاضرين ضجوا بالتصفيق عدة مرات.
وبعدها ألقى وزير الثقافة كلمته ثم أمين المجلس الأعلى للثقافة ثم راعى الحفل وكان رجلا أنيقا من رجال الأعمال، ثم الفائز بالجائزة فى دورتها السابقة، ثم عاد منظم الحفل ليدعونا لمتابعة فيلم تسجيلى عن انجازات الحكومة فى تنمية ثروتنا من الدواجن. وبعد الفيلم دعى نجما سينمائيا ليقدم فقرة ارتجالية كانت مضحكة لدرجة أن الحاضرين لاحظوا الشخص المهم وهو يبتسم مرتين.

وبعدها نهض الرجل مغادرا لالتزامه بموعد على درجة كبيرة من الأهمية. خرج فى إثره رجالات الحكومة وبعض الشخصيات العامة ورجل الأعمال وحتى النجم السينمائى. بعدها قام بعض الحضور وخرجوا متلمسين الطريق للبوفيه. بعضهم بدأ فى فك أربطة عنقه استعدادا للانقضاض على الطعام الذى سمعت أحدهم يخبر رفيقه بأنه فاخر جدا. سألت زوجتى إذا ما كانت ترغب فى فنجان شاى فابتسمت وقالت: هو فيه شاى زى الشاى أبو نعناع اللى بنشربه فى بلكونتا فابتسمت أنا أيضا فما كان أى شيء يعادل مثل هذا الشاى أبو نعناع.
بعد ساعة صعد منظم الحفل وقرأ فقرتين معدتين من قِبل مساعده لتقديمى وتعداد مآثرى الأدبية ومبررات حصولى على الجائزة ثم نادى اسمى وصفّق بعض الذين لم يغادروا القاعة بكسل لكن أحدا لم يصعد المسرح فقد كنت وزوجتى فى تلك اللحظة نجلس فى شرفتنا نشرب الشاى بالنعناع احتفالا بالجائزة.
الاختيار
رأيتنى أقف على ضفة نهر ذات غروب، وفيما يبدو كانت لديّ مهمةٌ محددة لم يمكننى تذكرها. ظللت ثابتًا فى مكانى وظل النهر ينساب فى مساره بهدوء سرمدى. مرت ساعة دون أن يطرأ جديدٌ على المشهد. أقف حيث أنا والنهر يمضى بوجهته. فجأة خطرت لى فكرة: لا شيء هنا غير رجل ونهر وشمس غاربة، فإما أن يكون عليّ القفز فى النهر أو اجتيازه.
الخطر
رأيتنى أقف عند رأس قتيل. اتطلع إليه وإلى عينيه المفتوحتين باتجاهى. كانت حدقتاه مصوبتين إلى فارتبكت؛ فقد شككت للحظات أنه يتطلع إلى بقدر ما أفعل. كان يشبهنى لدرجة أنى ظننتنى فى وسط كابوس. بدأ بعض الأشخاص يتوافدون على المكان ويقتربون بحذر. أحدهم - وكان يبدو أنه زعيمهم - سألنى بفضول: س.. مَن قتلك؟ استغربت السؤال فأشرت إلى القتيل رغم أن اقتراحى بدا لى سخيفا؛ فمن السخف بالطبع توجيه سؤال لقتيل. تجاهل الرجل إشارتى تماما وأعاد السؤال، هذه المرة سأل بنبرة اتهام. الآخرون بدأوا فى الإحاطة بى كما لو أنهم يخططون لمنعى من هروب متوقع. شكلوا حولى دائرة، أو بالأحرى حولنا أنا والقتيل، وصوبوا نحوى نظرات مرتابة وتهيأوا لمهاجمتى. شعرت بأنى على حافة خطر مؤكد ففكرت أن على - فى هذه اللحظة - الاختيار بين أن أكون القتيل لأنجو من الاتهام أم أن أكون القاتل لأنجو من الموت!
اتهام
رأيتنى أودع الأصدقاء بعد سهرة طويلة فى بيت أستاذتنا. خرجت قرب الفجر تقريبا. حين وصلت لمكان سيارتى لم أجدها، وفى القرب وجدت عسكرى مرور فسألته فأخبرنى بأن سيارتى قد نُقلت إلى مستودع للسيارات لأن المكان غير مسموح فيه بالانتظار. اندهشت فقد كان الشارع من الشوارع الجانبية الهادئة وكان مزدحما بالسيارات على الجانبين.
وصلت المستودع فوجدت شرطيين على بابه وما أن لمحانى حتى بدآ فى مهاجمتى بلغة عنيفة. رددت عنفهما بعنف فطلبا رخصتى وبطاقتى فاكتشفت أنى نسيت أوراقى فى مكان ما. سألانى عن سبب خروجى فى مثل هذه الساعة فأخبرتهما، وأكدت أن أستاذتى يمكنها تأكيد كلامى. أتيا معى إلى بيت أستاذتى التى وجدناها مقتولة ولم يكن ثمة أحد من الأصدقاء فى البيت.
أصدقاء
رأيتنى أسرع للوصول إلى المطعم الذى دعوت فيه بعض الأصدقاء. كان على الوصول فى موعدى حتى لا يستاءوا. حين وصلت اكتشفت أنى نسيت سحب فلوس من ماكينة السحب فسألت إن كان المطعم يقبل الدفع بكارت البنك فأخبرنى الجرسون بأسف بأنهم لا يقبلون إلا الكاش، ثم أشار باتجاه الشارع الذى يقع فيه المطعم وأخبرنى بأنه بإمكانى السحب من ماكينة موجودة أسفل عقار على بعد مائة متر. أسرعت للذهاب فكنت أخشى أن يصل المدعوين قبلى؛ لأن هذا لا يصح. حين وصلت لحيث أخبرنى وجدت ماكينة عملاقة بارتفاع طابق تقريبا.
وكان على للوصول إلى مكان إيداع الكارت أن أصعد عدة درجات حجرية كما لو أنى أصعد لأعلى الهرم. أودعت الكارت رغم أن الفتحة كانت تشبه هوة حتى أنه كان بمقدورى دس رأسى فيها بيسر. لاحظت أن شاشتها معطلة فانتظرت أن تتبدل أو أن تعيد الماكينة العملاقة الكارت لكنها لم تفعل. اضطررت أخيرا للمغادرة بسبب إلحاح الواقفين فى الطابور خلفى والذين لم يقتنعوا بأن الماكينة معطلة. سلطوا على نظرات لائمة كما لو أنى السبب فى تعطل الماكينة. بعضهم سخر منى معتقدا بأنى لا أعرف كيف أتعامل مع مثل هذه الماكينات.
ذهبت للبحث عن ماكينة أخرى لكن انتهى الشارع دون جدوى. حين قررت العودة للمطعم للحاق بالأصدقاء اكتشفت أن محفظتى قد وقعت منى. ظللت أبحث فى كل مكان بداية من الماكينة العملاقة وحتى نهاية الشارع دون أن أعثر عليها. حين بدت على الخيبة أوقفنى شخص وأخبرنى أن المفقودات فى هذا الشارع تودع لدى رجل مجذوب وطمأننى أن ما من أحد يمكنه اجتراء سرقة فى هذا الشارع. ذهبت للبحث عن المجذوب حتى وجدته.
سألته عن محفظتى فطلب وصفها فوصفتها له بدقة. ذهب لمدخل عمارة وعاد بجوال كبير الحجم لم أر مثله أبدا. أخلى الجوال أمامى وطلب منى أن أبحث عن محفظتى. فجأة وجدتنى أقف أمام تل كبير من المفقودات.. آلاف المحافظ والحقائب وكروت المعايدة والأوراق النقدية والعملات والأقلام وحتى الرسائل البريدية. بدا البحث عن محفظتى وسط كل هذه الأشياء مستحيلا لكنى بدأت فى البحث وقد تسرب لى اليأس من إيجاد محفظتى واللحاق بموعدى. تطوع العابرون للبحث معى بإخلاص أمتننت له. فى النهاية بدا أننا لن نصل إلى شيء فاعتذرت لهم وشكرتهم.
قررت العودة للمطعم والاعتذار للأصدقاء وفى يقينى أنهم سوف يغفرون لى تأخرى حين أشرح لهم مبرره. حين وصلت لم أجد أحدا منهم فقدرت أنهم قد ملوا الانتظار ومضوا. وكان الوقت الذى تغيبته يسمح بأن يتناولوا عشاءهم والمغادرة، ففكرت أن أسألهم عمن تولى دفع حساب الطعام لأعيده إليه فى أقرب فرصة لكنى بسؤال الجرسون اكتشفت أن أحدا لم يأت.
النوة
رأيتنى أُودع فى السجن بتهمةٍ لم أرتكبها. زنزانتى كانت انفرادية. غرفة ضيقة لا تحوى سريرًا وكنت لا أعرف إذا ما طال بقائى هنا كيف سيتسنى لى النوم. فور إيداعى الغرفة لاحظت أن بها بابًا سريّا يمكننى الهرب منه إن شئت، ومع هذا فقد استبعدت فكرة الهرب. كان المكان ضيقًا وخانقّا حتى أنى بدأت فى الشعور بالرغبة بالبكاء لكنى فكرت أن هروبى قد يُفسر بأنى مذنب.
لم يطل بقائى.. فلسبب ما جاءوا ليخرجونى من سجنى دون أن يوجهوا لى كلمة، والغريب أنهم أخرجونى من الباب الذى كنت أظنهم لا يعرفونه. فى الخارج وجدت أشخاصًا كثيرين جاءوا ليقلونى خارج منطقة الاعتقال. كانت سياراتهم كلها مزدحمة عدا واحدة لاحظت أن بها مكانًا شاغرًا، لكن قبل أن أركب دفعنى رجل واندسّ فى السيارة التى تحركت فور ركوبه. وبسبب تأكدى من أنهم جاءوا من أجلى اندهشت من رحيلهم سيارة خلف الأخرى دون حتى إلقاء تحية وداع.
لا أعرف كيف غادرت المكان؛ فقد وجدتنى فى شارع من شوارع الأسكندرية فجأة. الشارع كان مزدحمًا بالمارة الذين كانوا يهرولون للاختباء من نوّة محتملة. ظللت أتابعهم حتى اختفوا تمامًا. فجأة بدأت السماء تمطر بغزارة. وحدى كنت فى الشارع أحاول طلب سيارة ركوب لكن كل السائقين ألغوا رحلاتهم ربما بسبب النوة التى داهمت المدينة فجأة. كان الماء من حولى يرتفع رويدا رويدا فآويت إلى بيت يحمينى.
لم أعرف أى من سكانه لكنهم لم يسألونى من أنا. بدأت أتجول فى البيت كمن يفتش عن شيء لا يعرفه. فى ركن من البيت اكتشفت وجود ما يشبه الممر السرى وكان على اجتيازه رغم أنى لم أكن أعرف إلام يفضى. سقف الممر كان منخفضًا للغاية لدرجة أنى كنت مضطرًا لأن أحبو. حين وصلت لنهاية الممر وجدته مغلقًا بكتاب قديم غلافه سميك. نحّيت الكتاب لأمُر فوجدتنى فى بيت آخر. خفت فى البداية من أن يظننى سكانه لصًا لكنى لم أجد أحدًا بالبيت. فلا كان البيت بيتى ولا كان هناك أحد ليرشدنى إلى باب الخروج.
تواصل
اشتقت لخالى فطلبت رقمه فجاءنى صوت آلي: هذا الرقم قد تم تغييره. خجلت ولُمت نفسى لأنى لم أطلبه منذ سنوات لأتمكن من معرفة الرقم الجديد. ربما أضافت الشركة رقمًا كما يحدث كل فترة. فكرت بالاتصال بابنته لأسألها لكنى خجلت، وكان يكفينى خجلٌ واحد. كانت حجة شراء موبايل جديد مخجلة أيضًا رغم أنى أبدًا لن أستعملها، فبالنسبة لى فإن الشخص المُحب يحفظ أرقام أحبته.
وقررت أن أختبر ذاكرة القلب فراجعت بينى وبين نفسى أرقامهم.. جدتى عِين وكانت تستخدم التليفون الأرضى.. أنكل نبيل زوج خالتى.. أصدقائى.. أساتذتى.. أبى الروحى.. وأخيرا حبيبتى.. كان مخجلًا أن ذاكرتى لا تحتفظ غير برقمٍ واحد.. ربما أفشل فى تذكره مرّة حين تزداد ذاكرتى رخاوة. تمنيت فى هذه اللحظة أن أكون هناك.. معهم.. حيث لا تهم الأرقام ولا حاجة لوسيلةٍ للتلاقى. تذكرتُ حينها عبارة عم خيري: القلوب مِسَلِّمة، فلَاح لى أنى أرى خالى.. هنا.. إلى جوارى.. مبتسمًا.. وقد زال عنه المرض والموت. فتهيأت للقاء الأحبة بقلبٍ شغوف.
نجاة
كنا نجلس فى الشرفة. مقعد جوار مقعد جوار مقعد. سقط سور الشرفة فجأة وكان يمكن لأى منا أن يمد ساقه فى الفضاء. شعرت بالخوف لأنى مصاب بفوبيا المرتفعات. كنت أجلس فى نهاية الشرفة وكان على للفرار المرور بالجالسين جوارى لكن أحدا منهم لم يبادر بالمغادرة ولم يبد أحد منهم أى بادرة اهتمام بسقوط سور الشرفة وتعرينا بهذا الشكل. كان على أن أقاوم ارتعابى وأتجنب النظر لأسفل وفى الوقت نفسه أن أشاركهم الحديث لمغالبة توحدى الذى فررت منه إليهم. ثم خطر لى أن سقوطى سوف يجنبنى الأمرين معا.
وصول
لم يتحرك القطار فى موعده فانزعجت. كان لدى موعد أخشى أن يفوتنى. ساد الصمت لبرهة ثم بدأ الهمس بين الركاب المتساءلين عن السبب. مر الكمسارى فالتفت الركاب إليه لكن أسفر وجهه عن جهله بالسبب. دلف إلى العربة الأمامية فأدركنا أنه فى طريقه لكابينة السائق. ظل القطار متوقفا فبدأ الركاب يتبارون فى تخمين الأسباب المحتملة لدرجة أن مشادات كادت أن تدب بين البعض.
وأحدهم سب زوجته لأنها عارضته فأدارت وجهها نحو النافذة كاتمة غضبها. طالت مدة توقف القطار فأغلق الجميع فمه والبعض عينيه. انتظرنا عودة الكمسارى لكنه لم يعد. تأكدت من إخلافى موعدى فقمت أدخن سيجارة ما بين عربتى القطار. وجدت هناك رجلا يدخن لم أكن لاحظته فخمنت أنه من ركاب العربة الأمامية. فتشت عن ولاعتى فلم أجدها. مد لى سيجارته لأشعل سيجارتى فالتقطتها وشكرته بإيماءة.
وسع لى مكانا إلى جواره بقرب النافذة. قلت بأسى: طال توقف القطار أكثر من اللازم، لا حل لفوضى القطارات أبدا. عقد حاجبيه دهشة وقال: لكن القطار تحرك فى موعده. لوّحت إلى خارج النافذة ساخرا. يبدو أنه شعر بالإهانة فقد ألقى عقب سيجارته من النافذة بغضب ثم عاد إلى عربته. شعرت بالأسف فقررت أن ألحق به لأعتذر عن فظاظتى.
وحين فتحت باب العربة ودخلت ارتجت العربة فأوشكت على السقوط ففهمت أن القطار بدأ المسير. بحثت عن الرجل من مكانى فلم أجده فصرفت النظر عن الاعتذار فعلى أية حال لن ألتقيه مرة أخرى. عدت إلى عربتى فاكتشفت أن القطار مازال متوقفا وكان أغلب الركاب قد استسلموا للنوم.
وخطرت لى فكرة مزعجة فجأة فعدت أدراجى إلى العربة الأمامية فصدمنى أنها تتحرك. وكان مدهشا اكتشاف أن العربتين الموصولتين ببعضهما إحداهما متوقفة والأخرى تتحرك وبالرغم من هذا لم يفترقا للحظة فأدركت أننا سوف نصل فى الموعد نفسه فشعرت بالرضا.
سعادة
وضعت قدمى فى الطائرة فغمرتنى السعادة. كنت أحب المطارات والفنادق الصغيرة لكن حبى الأكبر كان للطائرات. لا أحب وحدتى إلا فى الطائرات. وحدتى تكون مساوية لكل وحدة حتى الذين يسافرون معا لا يمكنهم الإفلات من الوحدة التى يفرضها الطيران. كأن فى تماثلها إلغاءً لوجودها. كالحزن كالفرح كالحب كالكراهية. لا يمكن الوقوع فى حب عدو إن لم تتساوى كراهيتان. ولا تنمو الكراهية إلا حين تكون المحبتان متكافئتين. أحب الطائرات لأنها تلغى الوحدة وحين تُلغى يستسلم المرء لوجوده كطائر يفلت من السرب لدقائق قبل أن يعود ليلحق به. يتوهم لدقائق أنه حر. توهمه المغامرة بالحرية والحرية بالتفرد والتفرد بالكمال والكمال بالألوهية.
وضعت قدمى فى الطائرة فغمرتنى السعادة والنسيان.
استدلال
كنت فى طريقي للقاء الأصدقاء حين شعرت بلزوجة حول قدمى اليمنى. اكتشفت أن الدم ينزف من إصبعها لكن يبدو أنى كنت معتادا على ذلك لأنى أكملت مسيرى بلا اهتمام. كان الدم يسيل من إصبعى يترك بقعا على الشوارع والأرصفة وأحذية الذين أمر بهم ومع هذا مضيت فى طريقى دون إثارة اهتمام أحد حتى الذين لُوثت أحذيتهم. جلست مع أصدقائى فى المقهى، تبادلنا الأخبار والنكات ثم ساد الصمت لبرهة فانتبهت لبركة الدم التى خلفتها حول قدمى أسفل المنضدة.
ونادى أحدنا القهوجى ودفعنا الحساب وتبادلنا السلامات والوعود بلقاء قريب ثم مضى كل فى طريقه. حين وصلت للباب كان القهوجى يلم الأكواب الفارغة وإحدى قدميه فى البركة التى تركتها خلفى دون أن يعيرها أية أهمية. فى طريق العودة ظل الدم ينساب من إصبعى باشما خطا طوال مسيرى فخطر لى أنه يمكن لمن أراد تعقبى أن يستدل به.
هيبة
انتبهت إلى وجوده فجأة إلى جوارى فى المترو. طائر رقيق ظل ينظف جناحيه بمنقاره الدقيق. قرأت كثيرا عن الطيور لأنى كنت مشغولا بأنواع زقزقاتها. كل نوع من الطيور له طريقته ومقاماته الصوتية التى تختلف عن باقى عائلته. حزرت أنه عصفور القبرة، وهو عصفور يتطفل على أعشاش العصافير الأخرى.
ورغم تطفله له سمت كبرياء لا يمكن إلا أن تعجب بها. كما لو أن كبرياءه مبرر استحقاقه. حين انتهى من تنظيف جناحيه وقف ينظر للمحيطين بنظرة استهجان كما لو أنهم يتطفلون على مساحته رغم أن أحدا لم يزحه مثلا للجلوس، وهو ما كان يثير استغرابى. فكيف استطاع هذا العصفور الضئيل الحصول على مقعد لا يشاركه فيه أحد.
وكانت له مشية رجل شاب وعلى عكس أقربائه لم يكن يقفز من مكان لآخر كالأطفال. ظل يتمشى بطول المقعد وعرضه كما لو كان يقيس مساحته من العالم. توقف المترو فغادر من غادر وصعد من صعد لكن أحدا لم يقترب من المقعد الذى يشغله. بدأ وجوده المهيب يزعجنى.
ولكنى لم أجد الشجاعة لإزاحته رغم أنى لم أكن فى حاجة إلا لحركة بسيطة لإخافته. انتظرت أن يبادر أحد الواقفين المتأهبين لاقتناص أى مقعد بهشِّه لكن أحدا لم يفعل. خمّنت أن أحدا لم يلحظه كما لو أن رؤيته عصية إلا عليّ. لكن فكرت إن كان عصيا على الرؤية فهل كان المقعد نفسه عصى على الرؤية؟ ما إن خطر السؤال حتى اختفى الراكبون جميعا كما اختفى المترو نفسه، وفجأة وجدتنى أطير فى السماء مرتعبا من السقوط وعلى مقربة منى مقعدين يشغل أحدهما طائر ذو كبرياء وهيبة.
بيت العائلة
فى بيت كبير وجميل كانت عائلتى كلها تعيش. ويبدو أننا كنا جميعا فى المصيف وقد عدت لسبب ما قبل وصول الآخرين. قضيت بعض الوقت مع أصدقاء فى الحديقة المحيطة بالبيت وكانت واسعة حتى أنى لم أحط بنهايتها. ثم تذكرت أن عليّ تبديل مصباح الغرفة لأنى عدت فوجدته معطلا. طلبت منهم مساعدتى، فعلى الأقل يمكنهم تثبيت السلم حتى لا يقع بى. سبقتهم إلى الداخل.
ودخلت للبحث عن لمبة جديدة فى دولاب بالبلكونة فوجدت بجعة فاندهشت وتساءلت من أين أتت وكيف. حين رأتنى خافت وحاولتْ الطيران خارج البلكونة لكنها فشلت. ظننت فى البداية أنها لم تستطع لكن فطنتُ إلى أنها لم تكن جادة.
وتحركتُ بحذر حتى اطمأنت لوجودى وعرفتْ أن لا نية لدى لإيذائها. دخلتُ لصرف أصدقائى بحجة أنى لم أجد لمبة مناسبة فقد خفت أن يفزعوها فتقاوم رغبتها فى البقاء وتطير خارجا. وكنت متشوقا للعودة إليها وتأمل أجنحتها الملونة وعنقها الطويل.
المدينة
استوقفنى ليسأل عن شارع فى وسط المدينة. كنت أحفظ خريطة وسط المدينة بأسماء شوارعها الرسمية وبأسمائها الشعبية وحتى الأسماء التاريخية التى كانت لها فى أزمنة أقدم، لكنى أبدًا لم أسمع بهذا الاسم. سألته إن كان يقصد الشارع نفسه أو مكانًا فيه.
فلعله أخطأ فى اسم الشارع. أخرج من جيبه ورقة صغيرة مكتوب فيها اسم المقهى واسم الشارع. الاسم الذى نطقه صحيحًا إذن. ولأنى تعرفت على وسط المدينة ووعيت خرائطها من تتبعى لمقاهيها بدا الأمر غريبًا. وأكثر ما أدهشنى هو كتابة العنوان فى ورقة رغم أنه كان طوال وقوفه معى يمسك بموبايل حديث. اقترحت أن يبحث عن المكان على تطبيقات الخرائط فبدا مترددًا ثم شكرنى وانصرف. تابعته وهو يعبر الطريق ثم يمضى فى الاتجاه الذى قدم منه فخطر لى أنه يئس من الوصول وقرر عدم الوفاء بموعده.
سرت خطوات فى طريقى قبل أن يداهمنى شعور بالذنب لا أعرف مصدره. لقد حاولت مساعدته ولست مسئولًا عن استسلامه بهذه السرعة. ثم ما أدرانى إن كان الشارع الذى كان يقصد مقهاه فى هذا الحى أم فى حى آخر. وما أدرانى إن كنت أول من طلب مساعدته أم الأخير.
وما أدرانى إن كان قد انصرف يأسًا أم أنه لم يكن جادًا فى الوصول من البداية. حاولت التغلب على شعورى غير المفهوم بالذنب ونجحت لكن فضولًا أكثر إرغامًا دعس حواسى. كان من السخيف أن أجهل مقهى وشارع فى مدينة عشت فيها سنوات طفولتى وصبايا وشبابى.
وقفت قبل الهبوط إلى نفق المترو. أخرجت هاتفى وبحثت عن اسم المقهى وفوجئت أن المقهى والشارع موجودان، بل إنهما على مسافة قصيرة من مكانى. اندهشت كما لو كانا قد نبتا فجأة فى هذا الحى. عدّلت خططى وقررت تجاهل الموعد الذى كنت على وشك اللحاق به.
وسرت متتبعًا الطريق على تطبيق جوجول وكان المكان على بُعد دقائق. أسرعت الخطو بدافع الفضول وبدافع الخوف من أن تتبدل الأماكن مجددًا. فكرت أن شارعًا ومقهى ظهرا فجأة على خريطة المدينة يمكنهما الاختفاء فجأة أيضًا.
بعد دقيقتين وصلت للشارع وكانت لافتة المقهى تظهر منتصبة فى منتصفه. أسرعت أكثر مرتعبًا من تلاشيها المحتمل. عندما وصلت كنت قد بدأت أتعرّق من التعب. على باب المقهى وعلى منضدة قريبة فوجئت بصديق طفولة لم أكن رأيته منذ سنوات طويلة وحين رآنى نظر لى نظرة من كان ينتظرنى وابتسم ثم نظر فى ساعته وقال: كعادتك جئت فى موعدك. اندهشت؛ لكن فرحة لقائى به جعلتنى أتجاهل عبارته. جلسنا حتى حل المساء.
وحكينا كل ما مر بنا طوال سنوات الغياب، عددنا مرات إخفاقنا ومرات الانتصار القليلة، الأصدقاء الذين فقدناهم، الحبيبات اللاتى خذلننا، واللاتى خذلناهن، وحتى التجاعيد التى ارتسمت على وجوهنا، وعدد الشعرات التى خسرناها والشعرات التى صبغها المشيب.
حين هدّنا التذكر اتفقنا على الانصراف مع وعد بإعادة اللقاء. أشرت للقهوجى طالبًا الحساب وحين مددت يدى فى جيبى لأخرج المحفظة فوجئت بورقة صغيرة مكتوب فيها اسم المقهى والشارع.
غُرف
ما أن وصلت الفندق حتى نزعت مفتاح غرفتى من يد موظف الاستقبال. كنت متعبًا من الطريق فطلبت إرجاء اجراءات تسجيل الدخول لحين استيقاظى من النوم وتركت له كل أوراقى. ارتميت على السرير بملابسى وحذائى وحتى نظارتى لم أجد قوةً لخلعها.
ولم تمر دقائق حتى اقتحم عامل الفندق الغرفة ليخبرنى معتذرًا عن حدوث خطأ غير مقصود، فالغرفة محجوزة لنزيلٍ آخر وقد وصل لتوه. طلب منى إخلاء الغرفة سريعًا لأن النزيل فى طريقه إليها ولن يفيد أحدًا أن يجدنى فى غرفته. تحاملت لمغادرة الفراش بوهن.
وكان العامل قد أخرج حقيبتى وغادر المكان. ما أن خرجت من الغرفة حتى انغلق بابها فجأة كما لو أن الغرفة تلفظنى لكنى شعرت بالخجل لأنى لم أرتب الفراش قبل خروجى. قلت لا بأس فالأخطاء دائما ما تحدث ولابد أنهم سوف يمنحونى غرفةً أخرى.
بسبب التعب وجدت صعوبةً فى معاودة النزول للاستقبال ففكرت فى البحث بنفسى عن غرفة خالية. فى طريقى لهنا لم ألتق بنزلاء كثيرين فلابد أنى سأجد غرفة بطريقةٍ ما. لم يكن معى مفتاح لكنى لسبب ما كنت قادرًا على فتح أية غرفة. صدق ظنى فعلا فقد وجدت كل الغرف خالية لكنى فى كل غرفة كنت أجد أثرًا لأصحابها. فى الغرفة الأولى وجدت منشفة مهملة على الفراش.
وفى الثانية كانت حمالة صدر معلقة جوار باب الحمام. فى الثالثة كانت هناك جثة امرأة شابة مغطاة بملاءة. وفى الرابعة كتاب مفتوح قرب الشرفة أطراف بعض صفحاته مثناة. وفى الخامسة موسيقى لهنرى مانشينى من فيلم «اثنان من أجل الطريق». وفى السادسة رائحة خذلان. السابعة غادر أصحابها مخلفين شعورًا مريرًا بالوحدة.
شعرت لحظتها بأن غرفة واحدة لا تكفى، وبأنى - على نحو ما - أنتمى للغرف كلها. وانتابنى فضول أيقظ حواسى كلها عن الشىء الذى خلفته ورائى حين أخرجنى العامل من الغرفة فجأة.
محطة
كان الطريق للمحطة مربكًا. لم أكن أعرف مكانها بالضبط، وحتى الذين سألتهم فى الطريق أظهروا حيرةً وتشتتًا. فى النهاية وصلت وكان القطار قد رحل بالطبع. بحثت عن مكتب لأسأل عن موعد القطار التالى فلاحظت أن الموظفيْن اللذين كانا فى المكتب يحاولان تضليلى دون سبب مفهوم. اتخذت قرارى فور انصرافى عنهما: لن أنتظر القطار. غادرت المحطة نفسها.
كانت المدينة خارج المحطة قد صارت أجمل بعد أن خفّت حرارة الشمس وبدأ الناس فى الخروج للميادين للاحتفال بمناسبةٍ ما. وامتلأت الساحات بالطيور التى هبطت للتريض حول النوافير. جلست على حافة نافورة رغم تبللها فتقدم طائرٌ ببطء منى وسألنى عن البلد الذى قدمت منه، فيبدو أنه لاحظ اغترابى. أخبرته عن وطنى ولما لم يسألنى عن وجهتى ذكّرته فأشاح عنى وهو يقول: لا وجهةٌ لغريب.
غريب الأطوار
كان شخصًا غريب الأطوار، يسكن فى الشقة المجاورة، ولم يبادلنى حتى تحيةً واحدة طوال جيرتنا التى امتدت لسنوات. كنت أكره صلفه وانعدام ذوقه. لهذا كان غريبًا أن أراه ممددًا على شيزلونج أمام باب جارتنا فى الدور الأرضى. كانت بخلافه مرحة وودودة، رغم نظرة انكسار كانت تجاهد لإخفائها خلف ابتسامة لها سحر ملفت.
كان بابها مفتوحًا وحين رأتنى مارًا خرجت لتسلم عليّ أما هو فلم يلتفت حتى. كنت أعرف أن لها زوجًا وكان نادرًا ما أراه فى الحى. قالت إنها كانت بانتظارى لأنها تحتاج رأيى فى مشكلة بدا أنها تتألم بسببها. أشارت نحوه فظننت أنه يسبب لها المتاعب وكانت لدى رغبة فى إزاحته عن طريقها بأية طريقة لو أرادت.
و لكنها قالت إنه صديقها فلم أفهم كيف يمكن لشخص متعجرف أن يصادق امرأة جميلة مثلها، كما لم أفهم المدى الذى حلّقت فيه صداقتهما. قالت إن ابنتها هى المشكلة فمنذ تصادقا بدأت ابنتها فى معاملتها بقسوة، وتحيّنت كل فرصة للإساءة لأمها. كانت ابنتها غاضبة وكانت تنفس عن غضبها بعنف. فوجدُتنى راغبًا فى مساعدتها مقاومًا الكراهية التى تمددت فى قلبى تجاهه.
خديعة
كنت خارجا من العمل وطلب منى زملائى أن أحمل شخصا قعيدا لم أكن أعرفه ولا رأيته من قبل. وضعوه فوق ظهرى كحقيبة دون أن أراه. سرت به مسافة طويلة ثم انزلقت قدمى عند حافة فسقطنا واضطررت أن أسقط على بطنى حتى لا يصاب بأذى. حين سقطنا انفك الرباط الذى ربطوه به فوق ظهرى فتمكنت من رؤيته للمرة الأولى فاكتشفت أنه لم يكن قعيدا وكان أصغر منى بدرجة ملحوظة. حينها بدأوا فى الضحك مستمتعين بالخديعة التى نصبوها لى.
اقرأ ايضا | خليل صويلح يكتب : شهوة الكتابة وشهوة الحواس
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز