
صورة موضوعية
فخ اصطياد الشعراء إلى أرض أخرى غير الشعر والمجاز
الجمعة، 28 يونيو 2024 - 02:56 م
ممدوح فرّاج النّابى
ماذا تبقى من جيل التسعينيات؟
وما الذى أسفر عنه مشروعه الشعري؟ هل سقط أم ما زال له تأثيره؟
وهى أسئلة مهمّة لاستقراء الظاهرة الكتابيّة التى كشفت عن مغايرة شكليّة وفنيّة لهذه الكتابة، وميّزت إنتاجهم الشعرى ونصوصهم النثرية على حدّ سواء، وإن كان رأها البعض أسئلة مفخّخة تنصب مشانق ومقاصل للشعراء.
بداية تحية لـ «أخبار الأدب» على هذا الملف الذى يميط اللثام عن تجربة ثرية، لها خصوصيتها على مستوى السياق السياسى الذى اُنْتجت فيها نصوص هؤلاء الشعراء، وأيضًا على مستوى بنية خطاباتهم بتمردها على أشكال الكتابة المعروفة وقتها، وعلى الوصايا الأبوية بصفة عامة، وتحية مضاعفة لمعدّ الملف الكاتب حسن عبد الموجود لفتح هذا الملف كنوع من المراجعة لنتاجنا الأدبي، واستكشاف جمالياته، واختبار مدى صموده مع الزمن ومتغيراته، وبعد التحيّة فليسمح لى لو اتّسع صدر مُعدّ الملف (وإن كنت أخشى أن يلقى عليّ الأحجار التى عبّأ به جيوبه ليصطاد بها محمود خير الله) أن أذكر بعض ملاحظاتى على ما جاء فى الملف، بدءًا بمقدمته الاستهلاليّة (الهجوميّة الفتاكّة) للملف، فى الحقيقة بقدر الجهد الذى بذله فى استقصاء الظاهرة، بتواصله مع الكتاب أولاً، ثم رصده لبعض ملامحها، واستثناء بعض الكتابات التى لا تنتمى إليها، لغياب البكّارة والدهشة التى تُميّز الشعر الذى يُعدُّ أصعب الفنون على الإطلاق على حدّ وصفه، إلا أن المهنيّة فى إعداده للملف جانبه فيها الصواب، فالمعدّ كان متحفزًا وهو يطرح أسئلته التى كانت تحمل إجاباتٍ مبطّنة، وقد رأها البعض استفزازًا، وفى عدم صبره على مَن تجاوز فى الردّ، أو لم تكن لديه الصحافة الأدبية فى إجاباتٍ مقنعة، وأطلق شظاياه على من حوله.
وبصفة عامة لم يتسم الملف بالحيادية التى تجعل مُعدِّه على مسافة واحدة متساوية مع كافة الأجيال، فهو ليس هنا فى موضع الناقد الذى يقيّم، ويحكم على التجربة بالفشل أو الموت أو عدم الاكتمال، وإنما هنا وظيفته (مع احترامى وتقديرى لكونه قاصًا ماهرًا، وصحفيًّا ذكيًّا) هو إعداد ملف ثقافى (أو بالأحرى تحقيق صحفى) عن ظاهرة تستحق الدراسة، وهو ما يُحمد عليه، لالتقاطه الفكرة، لكن أسئلته كانت مفخّخة، ومقدمته كانت هجوميّة وتحمل اتهاماتٍ وسخرية، فكان أَوْلى به التزام الحِيدة، وأن ينأى بنفسه فى أن يكون حَكمًا لصالح جماعة على حساب الآخرين، كما انساق لغضب واندفاع كتابة أحد أصحاب الشهادات، ومثلما اتهمه بأنه «لا يسير فى الشارع إلا بعد أن يملأ جيوبه بالأحجار»، فهو الآخر انزوى فى ركن أعلى الصفحة، والتقفَ أحجار الشاعر التى ملأ بها الطريق، وبدلاً من أن يميطها عن أذى الآخرين، راح يصوّبها هنا وهناك، لا للتهويش وإنما ليفجّ الرءوس وأولها رأس هذا الذى تجرأ وهمز ولمز فى شهادته، فكالَ له الاتهامات، وجرّده من شاعريته هكذا: «أما الشعر، ففى مكان آخر أبعد ما يكون عنه»، فيا أخى إذا كنتَ لا تعترف بشاعريته، فلماذا طلبت منه شهادة من الأصل؟!
انحيازه المفرط إلى جيل التسعينيات الذى ينتمى إليه، أوقعه فى معاداة صريحة للأجيال السابقة عليهم، فصوّب حجارته عليهم جميعًا بلا استثناء، ساخرًا من منُجزهم، ومتهكمًا على كتاباتهم ولغتهم الشعرية، بل غضّ الطرف وصوّب حجرًا كبيرًا على جيل السبعينيات أو جيل الخسائر المتراكمة (كما يصفون أنفسهم)، واتهمهم بأنهم كانوا عبئًا على القصيدة؛ حيث «القصيدة صارت على أيديهم طريقًا مسدودًا»، كما أحالوا القصيدة - حسب وجهة نظره - إلى «ألاعيب لغوية، وأيديولوجيّة تستقى مرجعيتها الكاملة من تنظيرات أدونيس». السخرية لم تتوقف عند هذا الاتهام الخطير، الذى ينبغى أن يردَّ عليه مَن تبقى من جيل السبعينيات، وأبرزهم من الشعراء: عبد المنعم رمضان، وحسن طلب وجمال القصاص، وهم على قيد الحياة، فهم أولى بالرد والدفاع عن منجزهم الشعري، وتجربتهم الإبداعيّة التى فى وقتها كانت لها فرادتها على مستوى التشكيل أو التنظير بما أصدروه من مجلات مثل «شعر، وإضاءة 77، ومجموعة أصوات وغيرها»، فهم انطلقوا من مرجعيات فلسفية وقراءات فى مدونة الشعر العربى والغربي. أو من قبل النقاد الذين اعتنوا فى دراساتهم الأكاديمية بتجربة جيل.
السبعينيات وقدموا لنا أطروحات أكاديمية تتغنى بنتاج السبعينيين الشعري، أين هم الآن؟ لماذا أغمضوا عيونهم، وهم يرون الحجارة تتساقط على إبداعهم، وتهوى به فى حفرة سحيقة ثم تهيل عليهم التراب؟ أليس من العيب ونحن نحتفى بتجربة كتابية لها خصوصيتها وسياقاتها (السياسية والاجتماعية والثقافية) التى أُنتجت فيها، نهيل التراب على تجارب أخرى سابقة قد تختلف معها أو تغايرها تمامًا؟
أقرّ مُعِدّ الملف (ومعه بعض أصحاب الشهادات) بأن هذا الجيل اتّسم بالتمرد وأسقط فكرة الأبوية بعدم الاعتراف بها، ومالوا فى كتاباتهم إلى التجريب والمغامرة، وبصفة عامّة صارت كتاباتهم تتسمّ بالمغامرة. فى الحقيقة ليست هذه سمّة تخصهم وحدهم، فجيل الستينيات قبلهم أعلنوها بوضوح «نحن جيل بلا أساتذة»، واتسمت كتاباتهم بالتمرد على كافة الأشكال الكتابيّة التى سبقتهم، وقدّموا مُنجزًا فريدًا، وأظن أن الكل يعترف بهذه الفرادة سواء فى الكتابة عن موضوعاتٍ جديدة بالمزج بين الذاتى والموضوعي، وتماهى الهمّ الذاتى فى الهمّ الجمعى (المحلى والعربي) أو باستعارة أشكال كتابية غير مطروقة فى السرديّة العربيّة، حتى الشعراء خاضوا تجربة فريدة من الكتابة حيث شهدوا تحولاتٍ متعددة على المستوى السياسى والاجتماعى انعكست بالضرورة على الوعى العام للمجتمع وبشكل خاص على جيل عاش تلك الفترة وما قبلها ليبرزوا فيما بعد على شكل موجة جديدة من الكتابة. ومن ناحية ثانية بعض أصحاب الشهادات يعترفون بامتداد الظاهرة، وهذا الامتداد ظاهر فى جيلين أو ثلاثة لاحقين لهم، فكيف الذين تمردوا على أبوية سابقيهم، مارسوها على غيرهم، أى صاروا بمثابة السلف الشعرى للاحقين من الأحفاد الشعريين، أليس فى هذا تناقض؟ فى ظنى لا، لأن فكرة الأبوية ليست بالتأثير المُباشر، وإنما تنتقل عبر مسارب مختلفة، والأهم أن هذه الأبوة ليست عائقًا للفرادة والخصوصيّة، فإذا امتلكَ الشاعر الجديد، الصاعد (كما يقول بلوم) موهبة فذّة وأصالة تضاهى أو تتفوّق على نص أسلافه، فإنه يستطيع، من دون شك خطف السبق من سلفه، والتأثير عليه، وتغيير طريقة تلقّينا وتأويلنا له، بحيث يُجبرنا على قراءته من منطور السمو الجديد الذى ابتكره تمامًا».

ويشير مُعدّ الملف إلى أن بعضًا من شعراء السبعينيات تأثروا بمنجز التسعينيين، فتخلّوا عن «طلاسمهم، وقرروا إذابة الثلوج عن لغتهم، والمخاطرة أو سمِّها المغامرة بتذوق تلك القصيدة العادية واللذيذة» كما فعل حلمى سالم، وجمال القصاص، وفريد أبو سعدة، أو حتى اصطياد الشعر فى أرض أخرى غير مزروعة بقنابل المجاز، كما فعل عبد المنعم رمضان ... فى حين بقى حسن طلب بمفرده محاصرًا بالأسلاك الشائكة فى سجن الخازباز، واستمر رفعت سلام يطارد التنانين المجنحة حتى آخر لحظة من حياته»، لماذا لم يرجع التحوّل فى الكتابة عند البعض إلى طبيعة المرحلة وتحولاتها التى انعكست على الكتابة، وأيضًا إلى جدليّة قلق التأثر التى ليست فقط كما يفهم البعض أن الأخلاف يتأثرون بالأسلاف، وإنما هى ديمومة مستمرة، فاللاحق يتأثّر بالسابق، والسابق قد يتأثر باللاحق على نحو ما وصف هارولد بلوم هذه العملية بقوله “إن السلف الشعري، رغم جبروته وقوته، يصبح نفسه عرضة لتأثير حفيده القادم، فى عملية قلب سريالية لجدلية قلق التأثر”.
وبالنسبة لعنوان الملف “ماذا تبقى من شعراء التسعينيات”، فأميل إلى ما طرحه وليد الخشاب وعلاء خالد من تسمية “كتابة التسعينيات، أو جيل كتابة” حيث إن الملف حوى أسماء أسهمت بنتاج شعرى سابق لفترة الزخم (التسعينيات) على نحو إبراهيم داود، وإبراهيم عبد الفتاح، وفتحى عبد السميع وعزمى عبد الوهاب وكريم عبد السلام، وعيد عبد الحليم، وفاطمة قنديل، وبهية طلب، وغيرهم، فهم ينتمون إلى مرحلة سابقة. وقد سبق لـمجلة “أدب ونقد” العام الماضى فى مثل هذا التوقيت أن خصّصت ملفًا بعنوان “شعراء الثمانينيات” وتمثّلت لتجارب بعض مَن شملهم ملف شعراء التسعينيات، وإن كان ملف مجلة “أدب ونقد” لم يكن بالقدر المطلوب لقراءة تجربة جيل هو الآخر ما زال يُسهم بعطائه الشعري، أضف إلى ذلك أن الدراسة النقدية التى قُدمت مع الملف فى أصلها دراسة قديمة أُعيد نشرها من جديد، دون إضافة كى تستوعب ما استجدّ من متغيرات، وما طرأ على القصيدة من تحولات على مستوى اللغة والتشكيل.
احتوى ملف «أخبار الأدب» على شهادات كثيرة لشعراء من التسعينيات، وإن غابت أسماء مهمّة مثل إيمان مرسال، وياسر عبد اللطيف وأحمد يماني، وعماد أبو صالح. وهى تجارب مهمّة ولها إسهاماتها المؤثرة فى كتابة التسعينيات، وغيابهم عن الملف على الرغم من أن الغياب ليس تقصيرًا من المُعدّ الذى فى ظنى أرسل إلى الجميع، ولم يستجب له إلا القليل، وهذا القليل هو مَن شملهم الملف؛ بمثابة شهادات ناقصة تتحدث عن جيل، غاب عنه ممثلوه الرئيسيون، وإن كان ثمة سؤال يراودني، عن أسباب غياب اسمى إيهاب البشبيشى وأحمد بخيت، وغياب الأخير هل لالتزامه بالقصيدة العمودية / الكلاسيكية علاقة بهذا الاستبعاد على الرغم من ثراء تجربته، وقوة شاعريته؟

لكن وهو المهم أن الشهادات التى احتواها الملف وقعت أغلبها فى ذكريات رومانسيّة مفرطة بعيدة عن الحديث عن التجربة الشعرية ومخاضاتها ومآلاتها (أشرف يوسف وسيد محمود، وعبير عبد العزيز، وياسر شعبان وغيرهم)، فكلٌّ على حدّة ذهب بعيدًا عن محور الملف والأسئلة التى وضُعت كمحور أساسى له، فلم نقرأ إجابات إلا قليلاً (خالد أبو بكر على سبيل المثال لا الحصر)، وإنما مجرد تعميمات لإثبات وجود تجربة الجيل وفاعليتها بتأثيرها فى الشعراء الكبار (كمال أبو النور) والأجيال اللاحقة (فارس خضر)، وانتقال تأثيرها على امتداد ثلاثة أجيال متتالية، أو أنها أسهمت فى تغيير خريطة الأدب العربى برمته (يا الله!) (محمود خير الله)، أو الشكوى لما تعرّض له هذا الجيل من انتقادات وحروب (محمد الكفراوي)، أو استعراض سريع لملامح مميزة لهذا الجيل (باستثناء شهادتى علاء خالد، وعزمى عبد الوهاب) تكشف لنا واقع التسعينيين الآن، أو مآلات قصيدتهم، أو التحولات التى أصابت القصيدة بعد التغيرات التى حلّت بالواقع السياسى والاجتماعي، وهل ما زالوا منهمكين فى العادى واليومي، أو أن القصيدة نحت مسارًا مختلفًا فى ظل المتغيرات المحيطة بنا (على المستوى السياسي، والاجتماعى وكذلك الثقافى بظهور متغيّر مهمّ هو منصات وسائل التواصل الاجتماعى وما أفرزته من منصات القراءة)، وظهور أشكالٍ كتابية جديدة متأثرة بثورة الاتصالات وتأثيرات قصيدة الهايكو وغيرها من متغيرات لا بدّ أن تُوضع فى الحسبان، فلم نعرف هل تخلّى هؤلاء الشعراء عن مشاريعهم التى شهدت انطلاقاتهم الشعرية؟ وهل استجابوا للواقع الآنى على نحو ما فعل محمد بدوى ومحمد صالح ومحمد سليمان تأثرًا بما فعلت كتابات التسعينيات على حد قول حسن عبد الموجود فى مقدمته، أم ظلوا فى منأى عن كل جديد مترفعين برفضهم الأبوة وما تحمله من تأثر وتأثير الأسلاف فى الأخلاف، أو تأثّر الأسلاف بالأخلاف كما يقول هارولد بلوم؟ وإنما رأينا مَن ينفى صلته بهم (جيهان عمر) أو ما ينفى فكرة الجيل أصلاً (أشرف يوسف، والبهاء حسين)، أو هدمها واعتبارها «تقليعة نقدية تبدأ لتنتهي، ولا يبقى منها سوى تجارب أفراد» بعبارة عماد فؤاد، أو الحديث عن انسراب قصيدة النثر فى شعراء وأجيال أخرى (أمل جمال، وكمال أبو النور)، فلم تتوقف عندهم «بل مارست سحرها مع أجيال سابقة ولاحقة، وهناك مَن أكّد استقلاليته عن فكرة القولبة والانخراط فى جيل معين، والانتماء إلى الكتابة وجمالياتها (أمل جمال، وجيهان عمر)، فكما تقول جيهان عمر «إننى هذا القط الشارد الذى لا يتبع سوى رائحة القصيدة» فهى تنتمى للشعر فحسب.
مثلما أغفل الملف شعراء بحجم البشبيشى وأحمد بخيت، فإنه أغفل أيضًا شعراء الصعيد، وكأن الصديق حسن عبد الموجود ابن مدينة نجع حمادي، نسى أن هناك شعراء ينتمون إلى ذات الإقليم؟ وسؤالي: لماذا أغفل شعراء الجنوب؟ وهل المؤثرات التى أثّرت فى كتابة التسعينيات لم تركب القطار المتجه إلى الصعيد كى تصل إلى أبنائه، أم أنها تمركزت فى المركز ولم يصب سهمها سوى الجالسين على مقاهى وسط البلد؟ أين شعراء الجنوب لماذا لم يذكرهم باستثناء فتحى عبد السميع ومؤمن سمير، وقد جاء ذكرهما عابرًا. بكل تأكيد مات عبد الناصر علام، ومحمود مغربى، وعبد الجواد خفاجى، وآخرون، لكن بقى أشرف البولاقى وعبيد عباس، ومصطفى جوهر، وعبده الشنهورى، وأحمد المريخى، ومحمود الحبكى، وجمال العدوى، ومحمد طاهر البرعى وغيرهم الكثير والكثير.
وقد غاب عن الملف أيضًا نقاد الشعر! لماذا لم يحتوِ الملف على قراءتهم للتجربة وتقييم لها؟ فالتجربة الكتابية بما لها وما عليها كانت تستوجب تقييمًا نقديًّا، لتقديم أهم الملامح والسّمات التى وسمت التجربة وكانت علامة فارقة ميزتهم عن سابقيهم ولاحقيهم، وكذلك رصد التقنيات الشكليّة ومصادر استعارتهم لها خاصّة وأنهم كانوا مخاض لتجارب سابقة سواء السبعينيات أو الثمانينيات، وإن لم يعترفوا بذلك، فالتمرد على السابقين فى حد ذاته عامل مؤثر ومهم، جعلهم يضعون تجربة سابقيهم أمامهم، ويتجنبون السقوط فى فخ التكرار والتقليد، فلولا أنهم قرأوا التجارب السابقة، ورفضوا أن يكون مثلهم، لما أسسوا تجربتهم الجديدة فقد تخلصوا كما يقول محمود شرف من «جلّ عيوب النص السبعيني»، فالجديد لا يعنى قطع أواصر الصلة بالقديم، فالقديم قد يكون بمثابة المحفّز على المغايرة. كما أن الأسئلة المحورية التى وضعها الملف إطارًا له، كان يجب أن تُوجه للنقاد، فهم أَوْلى بتقييم التجربة، ومن ثمّ الإجابة عن ماذا بقى من منجزهم الشعري، بدلاً من ترك المجال لنرجسية الشعراء أنفسهم؟ نسى الشعراء أنفسهم فى حديثهم عن تجربتهم، أهم عنصر للمغايرة ألا وهو المعجم الشعري. ففى ظل حالة من الميوعة والتشابه بين مفردات الشعراء، وهو ما يجعل كثيرًا من التجارب تكرارًا أو تقليدًا لتجارب سابقين أو معاصرين، ومن ثمّ ضاع عنصر التمايز، لذا وجب على المقاربة النقدية أن ترصد لنا هذا المعجم، وفرادة استعمالهم للعادى والمهمّش مقارنة بغيرهم، وأسباب اللجوء إلى هذا المعجم الشعرى دون غيره؟ وهل ما زال هذا المعجم صالحًا فى ظل سطوة متغيرات جديدة انعكست على لغة الخطاب اليومى المتُداول، وبالتالى انعكست على الخطاب الشعرى؟

بقيت ملاحظة شكليّة متعلّقة بالإخراج الفنّى، الذى يستوجب تحية المخرج الفنى للجريدة (وللعدد على وجه الخصوص) بحُسن اختياره صورة الغلاف التى تحمل صورة شريط كاسيت، بما عكسته من حالة نوستالجيا لزمن مضى، وبصورة عامة للسياق السياسى والاجتماعى والثقافى الذى زامن الكتابة وها نحن نتأسى ونترحم عليه، وإضافة إلى تميّز الملف الداخلى بتنسيق جمالى، وتوزيع للمقالات بصورة رائقة تبهر العين، مع جمال توزيع اللوحات الفنية المبهرة للفنانة سلوى رشاد، وهو ما كوّن لوحة تشكيليّة متناغمة جمعت بين التشكيل الطباعى والبصرى باللوحات، وإن كنت أرى أنه كان يجب توزيع الشهادات على أساس موضوعاتها، وتشابه الأفكار، لا كما ظهرت بها، كما لاحظت أن هناك خطأ فى شهادة وليد الخشاب، حيث تكرّرت بعض فقرات الشهادة، ربما سهوًا.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 توجيهات رئاسية بتطوير ملفات الثقافة: مطالب المثقفين من الحكومة الجديدة
توجيهات رئاسية بتطوير ملفات الثقافة: مطالب المثقفين من الحكومة الجديدة
 جائزة كنفانى تعلن قائمتها القصيرة
جائزة كنفانى تعلن قائمتها القصيرة
 «بيت الحكمة» تتوسع فى صناعة النشر
«بيت الحكمة» تتوسع فى صناعة النشر
 ما وراء استقالة يوسف زيدان!
ما وراء استقالة يوسف زيدان!
 الكاتبة الليبية عائشة إبراهيم: أنا مع الالتزام فى الأدب وضد استخدام التاريخ للوعظ
الكاتبة الليبية عائشة إبراهيم: أنا مع الالتزام فى الأدب وضد استخدام التاريخ للوعظ
 وفاء المصرى:أكتب للمبتدئين فى الحب!
وفاء المصرى:أكتب للمبتدئين فى الحب!
 تأثيرنا امتد لكل شىء.. حتى للشعراء الكبار!
تأثيرنا امتد لكل شىء.. حتى للشعراء الكبار!
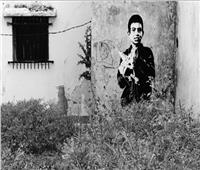 لماذا أحب فرناندو بيسوا وأكره القصائد المستعملة؟
لماذا أحب فرناندو بيسوا وأكره القصائد المستعملة؟
 للشعر رب يحميه
للشعر رب يحميه
























