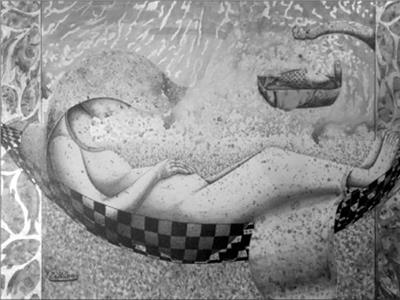
أقفاص فارغة
أقفاص فارغة
الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 02:17 م
(١)
فى ليلة بعيدة، بعيدة جدًا، أيقظنى «رمزى» من نومى. كان يحمل فى يده شيئًا ملفوفًا بملاءة ممزقة، أيقنت من ملامح وجهه المتجهمة أنه لا يحمل لى قطعة شوكولاته، وبصوت تغالبه الدموع قال لى:
«كان لازم أصحيكِ علشان ندفن ميشو».
كان «ميشو» مريضًا جدًا فى الأيام الأخيرة، لدغه ثعبان، وهو يتجول، مغامرًا، فى الصحراء المتاخمة لبيتنا، ولم تفلح العقاقير فى شفائه. فى الحديقة الخلفية للبيت، وتحت شباك غرفة النوم - التى سنتناوب الحياة فيها بعد ذلك - أخذ «رمزى» يحفر، ثم أودعنا، سويًا، الجسد الثقيل الحفرة، وغطيناها بالتراب، وأمام شاهد خشبى مكتوب عليه اسمه، (اقتلعته الريح بعدها بأيام، ولم نفكر فى البحث عنه) قرأنا له، بجدية بالغة - الفاتحة.
تحت الشباك، فيما بعد، وفى البقعة نفسها، نبتت شجرة خشخاش، ذعرت أمى، وقطعتها، خوفًا من ملاحقة قانونية، حذرها منها جارنا الضابط الشاب، متفهما جهلنا بالكارثة، التى تنمو فى غفلة منا، لكنها نبتت فى العام التالى، كان الأخوان قد رحلا منذ زمن طويل، ضحكتُ حين رأيت زهورها البديعة تطل من جديد، فى العام التالى، قلت لأمى: «يرزق من يشاء بغير حساب!» لكنها ذات صباح رمت على جذورها زجاجة كيروسين كبيرة، وأشعلت فيها النار. لم تنبت، أبدًا، بعد ذلك، انتهت تماما، كأية جذور تُطعن فى عمقها.. هكذا.. إلى الأبد.
(٢)
هل ماتت فعلاً؟! تحولتْ إلى حكاية أتندر بها مع أصدقائى، وبخاصة المولعون بتدخين الحشيش، وبعد أن كففت عن حكيها، بأعوام طويلة، وتحديدًا بعد موت أمى بأيام، كانت الضمادة المُغطى بها جرحها مرمية فى «البانيو»، مع جلبابها، الذى انتزعناه عنها، كنت أتأمل الضمادة، كآخر ما تبقى منها، امتلكت الجرأة، ذات صباح، وقررت دفنها فى البقعة ذاتها، التى نبتت فيها شجرة الخشخاش، والتى دفنتُ فيها «ميشو»، أيام الصبا، كأن البقعة اكتسبت حضورها، منذ الموت الأول، كقبر، فى الحديقة! حين حملتها بحنان يليق بضمادة جرح أمى، وجدت أشياء بيضاء تتحرك، حدقت فيها، وكأن مسًا كهربيًا ضرب جسدى، كنت أصرخ صراخًا هستيريًا، وأنا أرى الدود ينهش ما تبقى من لحم الجرح على الضمادة، لكننى تمالكت نفسى فى النهاية، وحفرت الحفرة ذاتها، وألقيت بها فى جوفها، ثم ردمتها على عجل، وقرأتُ - وحدى هذه المرة - الفاتحة.
(٣)
نعم كان «الزهو»، الزهو، الذى استعدته فى ذلك المساء، زهو الطفلة، التى كان مدرسوها يضعون فى يدها - خلسة - التمارين الرياضية الصعبة عليهم، لتسلمها إلى أبيها، ينظر إليها باستهانة: «مش عارفين يحلوا دى؟! قال مدرسين أوائل قال!» ثم تعود إليهم، فى الصباح التالى، بالحل، لم يكن زهو من تتباهى بأبيها، لا، كان زهو تلك الطفلة: «حاملة السر».
«تعرفى الراجل السكران ده؟!»
«ما أعرفوش».
«ده بينده عليكِ!»
«ما أعرفوش».
كان سكران «طينة»، هابطًا يتطوح من المترو، ينادى عليّ فعلًا، بصوت ممطوط، لكننى أسرعت فى خطواتى، وتجاهلته تمامًا، لتبقى تلك اللحظة، عمرًا بكامله، وحتى الآن، لا يمكننى نسيانها، أو تجاهلها، حتى وأنا أصب لنفسى قدح البيرة من جديد، وأحاول أن أتفهم كل دوافعه، حتى وأنا أرقب نفسى سكرانة «طينة»، وأفرغ ما بجوفى، كأنها اللحظة الأبدية للعار، العار، الذى يقطن أمعائى من يومها، ولم يكن باستطاعتى، أبدًا، أن أفرغه.
(٤)
ماذا لو أننى غافلت البنات وعدت إليه؟ ظل وقتًا طويلاً يتسكع، مخمورًا، على محطة المترو، فى قلب الظهيرة! ماذا لو أننى واجهته، ونظرت فى عينيه مباشرة، فقط، نظرت فى عينيه باحتقار وغضب؟! لكننى لم أفعل، تركته ينجو بما فعل، حتى أنه تجاهل الأمر تمامًا، وهو يتجول أمامي، فى اليوم التالى، فى البيت، بسرواله الداخلى الواسع من «التافتاه»، الذى يصل إلى أعلى ركبتيه،
وقد أدخل فيه «الفانله»، ويخرج ليسقى الزرع فى الحديقة الأمامية، المواجهة لشرفات الجيران، كل ما فعلته أننى انفجرت غضبًا فى أمى: "إحنا مش اتفقنا أنه مايخرجش الجنينه «باللباس» ؟ يلبس بنطلون بيجاما طيب.. حنفضل فى القرف ده لإمتى؟! ربنا ياخده».
ماذا، أيضًا، لو أننى ناديت الممرضة، كل ثلاث دقائق، فى المستشفى الخاص، لتغير لأمى سروالها؟! لكننى لم أفعل، أجلستها على الكرسى المتحرك، ونزعت عنها سروالها، وجذبت قميص نومها لأعلى، ونزعت وعاء البول من الكرسى، وقلت لها: «على راحتك خالص، ما تتكسفيش، يا ماما، أنا اللى حأنضف»، كان البول يغطى أرض الغرفة، وكانت أمى مطمئنة، وممتنة لى، وكانت رائحة الجلوكوز تنضح من الماء المتدفق، بينما أمسك بممسحة، وأمسح الغرفة كلما غمرها الماء، كنا وحيدتين، وحين أتت الممرضة - بعد ساعات - لتتسلم «الشيفت»، وتقيس الحرارة، لم تلحظ؛ لا الأرض اللامعة للتو، ولا المريضة النظيفة، بسروال ناشف، وقميص نوم برائحة منظف هادئة، وقد أعدنا كل الأشياء، بعناية، كما كانت، (أمى على السرير، والكرسى المتحرك خاويًا، ووعاء البول نظيفًا، فى مكانه) لم تلحظ، أيضًا، تلك المرأة المنهكة، شبه النائمة، على كرسى المرافق، وهى تنتفض من كرسيها لترحب بها.
(٥)
تقول أمى إن الحديقة ماتت بعد موت أبى، ومعها حق، كان يرعاها بدأب، رغم أنها لم تكن سوى حوض صغير مستطيل، لا يكفى إلا لزراعة بعض النباتات المتسلقة على جدران السور، بخلاف الحديقة الخلفية الأكثر اتساعًا. لم نشم رائحة الياسمين، أبدًا، بعد موته، وظل الحوض المستطيل مجرد حوض طينى، ناشف. وبعد سنوات صار مطفأة سجائر، يتحرج الضيوف فى البداية من إلقاء السجائر فيه، وهم جالسون معى فى الشرفة، فألقى بسجائرى واحدة تلو الأخرى، وسرعان ما يمتلئ.
بعد أن ماتت أمى، لم أعد أجلس فى الشرفة كثيرًا، وذات صباح فوجئت بالحوض وقد صار مخزنًا لأقفاص دجاج فارغة، حملها أحدهم، كغنيمة، ليخبئها هناك؛ عشرات من الأقفاص، المكدسة فوق بعضها، احتلت كل المساحات بين الشرفة الصغيرة، وسور البيت، حين رأيتها جن جنوني، وأدركت أن البيت صار مستباحًا تماما، كأنه «مهجور»، وكأن لا وجود لى فيه! ظللت أنتظر صاحب الأقفاص أيامًا بطولها، لكنه لم يظهر، كان المزيد من الأقفاص يتراكم فى غفلة منى، أو فى نومى النهارى المعتاد، أمضيت ليالى أمنع نفسى، بصعوبة، من إشعال الحريق فيها، وليحترق البيت معها، وليكن ما يكون، وذات ليلة قررت أن أحملها كلها إلى السطح، كان غضبى عارمًا، وكفيلاً بأن يمنحنى القوة لأن أصعد ببضعة أقفاص تلو الأخرى، حتى أنهيت المهمة، خبأت الأقفاص كلها فوق السطح، الذى يمكن أن نصعد إليه ببضع سلمات، وإمعانًا فى تكدير صاحبها، غطيتها بملاءات قديمة، ورغم التعب شعرت بالسعادة،
وبالزهو، وأنا أتخيل من أودعها حديقتى مرعوبًا من اختفائها المفاجئ. نمت بعد الفجر، نمت حتى ليل اليوم التالى، وحين صحوت، صعدت متلصصة إلى السطح، فلم أجد الأقفاص، ذهبت كلها، ولم يُعدها صاحبها، أبدًا، إلى الحديقة، بعد هذا اليوم.
( ٦)
زيارة أخى لأمي، فى ذلك النهار، آتيًا من المطار مباشرة، وأنا أرقب خطواته الصاعدة تل مستشفى «المقاولون العرب»، وأتنفس من الأعماق، كانت متعجلة، على غير ما اتفقنا عليه، فى مكالمتنا التليفونية، قبيل مجيئه، أخبرنى أنه لن يستطيع المكوث إلا ليومين، على الأكثر، سيجلس مع أمى بالنهار، وسأتولى وردية الليل، تركته معها، وعدت إلى البيت، أخذت حمامًا ساخنًا، ودخلت إلى الفراش، بدا فراشى غريبًا، لكننى شممت عطر وسادتى الأثيرة، فنمت، حتى أيقظنى تليفونه بعد ساعتين:
«أنتِ جايه امتى؟!»
«هو أنت مش قاعد لبليل؟»
«قاعد.. بس تعالى بدرى قد ما تقدرى».
لم أستطع النوم بعدها، شعرت بأن أمى فى خطر، نهضت متوترة، وارتديت ثيابى على عجل، وحملت حقيبة المبيت. حين وصلت، وجدت أمى هادئة، ومبتسمة، فى فراشها، فهدأتُ، قال لى إن زوجته اتصلت به قبل قليل، وإنه مضطر إلى اختصار الزيارة ليوم واحد، لأنها أخبرته أن ابنته الصغرى مصابة ببرد شديد. كان مرتبكًا كأنه يريد الفرار، قال لى إنه سيبيت الليلة عند أهل زوجته، وسيمر غدًا صباحًا على المستشفى، فى طريقه للمطار. حين دخلت الممرضة ابتسمت فى وجهه بأدب جم، لكنه تجاهلها، حرصتْ على أن تلفت انتباهه بتعليق لطيف، وبنبرة مرحة، وصاخبة، عن مدى عنايتها بالأم، لكنه أسكتها بنظرة حادة، فانسحبت بهدوء. لما دس فى يدها ورقة نقدية أخذتها بعين منكسرة: «أى أوامر يا دكتور»، حين أخذتُ أمى، بعد انصرافه، إلى الحمام سقطت منى على الأرض، فاضطررت لأن أستدعى الممرضة، أتت مسرعة، وحملتها، هممت بمساعدتها، لكنها دفعتنى بيدها، وزعقت فى وجهى: «دى مسئولية، كان لازم تنادى علىّ»، حين دسست فى يدها ورقة نقدية نظرت فيها، وابتسمت: «ماشى.. عشان الحاجة، ابقى اندهيلى لو عوزتى».
(٧)
فكرة وجود «قارئ» لهذه الأوراق ترعبنى.. أكثر من الرعب، كأنه العجز الكامل عن أن أواصل، القارئ، الذى طالما سعيت إليه، وكان يجلس على حافة مكتبى وأنا أكتب، أزيحه الآن بعنف، لا أريد أن يقرأ هذه الأوراق، لا أريد أن يتلصص على حياتي، لكننى أكذب أيضًا، لا يمكن أن يكتب أحد دون أحد، دون أن يشاركه شخص ما هذا الضجيج السارى فى روحه، أقول لنفسى سيكون انتحارًا، وأقول لنفسى؛ ليس انتحارًا، أنا أريد أن أكشط قشرة جرح، كى يندمل فى الهواء، أو لا يندمل، ويظل ينزّ دما، وأرقبه، وأمسح الدم «بقطنة مبتلة».
أصدقائى الأقرب إلىّ يقولون لى: واصلى الكتابة
واليوم أخبرت زملاء لى فى العمل يدرّسون النقد الأدبى، ويكتبون روايات تجارية: «أنا أكتب مذكراتى»، نظر لى أحدهم مستنكرًا: «لا.. لا.. حاسبى». والآخر؛ صاحب الرواية التجارية، قال لى: «اكتبيها بضمير الغائب!» ظللت طول اليوم أضحك من النصيحة الأخيرة، بضمير الغائب؟! أنا أريد أن «أحضر» كما لو أننى كنت غائبة دائمًا، الحضور الكامل هو كل ما أحلم به، اليقظة، التى لا تفوت ضوءًا واحدًا فى جوفى إلا حدقت فيه، حدقت فيه حتى يتلاشى، كعيون الميدوزا، لا أريد سوى أن أمسخ كل الذكريات إلى أصنام، ثم أكسرها، ثم أكنس التراب المتبقى منها، حتى ولو كنت، أنا نفسي، صنمًا من بين كل تلك الأصنام.
«ضمير الغائب يا راجل؟!»
(٨)
أفكر بشراء صينية جديدة آكل عليها، الصينية البلاستيكية الصغيرة، التى أضع فيها الأطباق أصغر مما يجب، ولا بد أن يظل طبق من الأطباق مائلًا، نصفه داخلها، ونصفه الآخر فى الفراغ، مهددًا دائمًا بالسقوط، أيضًا؛ الورود - السخيفة أصلاً- التى لم أتأملها، وأنا أشتريها على عجل، بهتت ألوانها، وبدت كما لو أنها متسخة طوال الوقت، مهما غسلتها، صحيح أنها من النوع الرخيص، لكننى من الممكن أن أشترى واحدة جديدة رخيصة، مثلها، ولن ترهق الميزانية؛ بسعر علبتى سجائر، أو ثلاث زجاجات من البيرة، المهم أن تكون جديدة، وأن تظل جديدة، ولو لشهر.
لست أستخدم الصينية لأننى أعيش بمفردى، أعرف أناسًا كثيرين، يعيشون بمفردهم، ولديهم منضدة صغيرة للطعام، يمسحونها كل يوم، وأحيانًا، يضعون عليها الورود، وقنينتى؛ الكاتشاب،
والمسطردة، وقنينتى؛ الملح، والفلفل. لم أفعل هذا أبدًا، ولم نفعل، كذلك، فى بيتنا القديم، كأنه «طقس» مقدس، أن يضع أحدنا الطعام على الصينية، ويمضى وحيدًا، ومنفردًا بها، «رمزى» فى غرفته يستمع إلى الموسيقى، أو يقرأ كتابًا، ماما بعد عمل اليوم الشاق، تحمل صينيتها، أو تحمل الصينية لـ«راجى»، المنعزل دائمًا فى غرفته، بابا يحمل صينيته ويجلس فى السرير، إلى جواره الراديو، يقلب إذاعات العالم، وإلى جواره، بالطبع، زجاجة البراندى - غالبًا، يقرأ فى رواية بوليسية بالإنجليزية، بعد أن سمحت له أمى بالشراب داخل البيت، «تجنبًا للفضائح»، كما قالت.
لم تكن المسألة مجرد تضارب مواعيد، كلنا كنا موجودين، فى الوقت نفسه، والصينية تتنقل من يد إلى أخرى. المتمرد الوحيد كان «راجى»، رغم عزلته الدائمة، أو ربما بسبب عزلته الدائمة، حين تأتيه «الفورة» كما كنا نسميها، كان يصر على أن نجتمع على المائدة، «مرة واحدة عايز أحس إنى فى عيلة»! لكنه كان يتصرف بسخافته المعهودة، يقرر لنا ميعادًا، ويرتب الأطباق،
وخلافه، ولا يسمح لنا بالتأخر لدقيقة، وسط سخريتنا جميعا، واستعارتنا لقفشات مشهد فؤاد المهندس «الأخ الأكبر» فى فيلم «عائلة زيزى»! ثم ننصاع له - إلا بابا طبعًا- ونجلس على المائدة، ونحن ندارى ضيقنا بالضحكات، نزدرد اللقيمات، لنتعجل الهروب، لكن الأمر كان يعود، بعدها، لسابق عهده. لم نكن نتحمل هذا الطقس العائلى، إلا مرة كل شهور، إرضاءً له فحسب، ولكى نريح رؤوسنا من إلحاحه، ثم يعود كل منا يبحث عن الصينية المعلقة، من طرفها، فى مسمار، إلى جانب حوض المطبخ.
(٩)
«أنا مش حأفضل أصرف عليك طول عمرى يا سى راجى، أنا مش حأفضل أصرف على (شحط) زيك».
كان يزرر قميصه أمام المرآة، ويدخله فى البنطلون، حين رد عليه بهدوء:
«وأنا مش حأسامحك على الكلمة دى، أبدًا، يا بابا».

كان هذا غالبًا فى أواخر الستينيات، ولا أعرف، ولم أعرف أبدًا، لماذا ظل ذهنى محتفظًا بهذا الحوار الجارح المقتضب حتى اليوم، لم يغب عن بالى أبدًا، كأنه الافتتاح المهيب للإلياذة! ظل هذا الحوار «أسطورة»، لا تنقضى، ولا تنمحى، ولا تُنسى، كأنه جرم أبدى تسطره يد القدر أمامى، أنا الطفلة فى الحادية عشرة، بين الكبيرين؛ أبى، وأخى الأكبر، جرم ستتحول به المصائر، «راجى» إلى ألمانيا، وأبى إلى الموت.
( ١٠)
مؤقتًا.. استأجرت ماما لراجى غرفة، فى عمارة تحت الإنشاء، بيننا وبينها شوارع قليلة، وكذبنا كلنا على بابا، وأخبرناه أن «راجي» ألتحق بكلية التربية فى أسيوط، قسم الرياضيات. كانت السنة الوحيدة، التى نجا فيها من الثانوية العامة، بعد خمس سنوات متتالية من الرسوب، بسبب عدم دخوله الامتحان، يخرج فى الصباح، ثم يجلس على المقهى، حتى ينتهى الامتحان، ويعود إلى البيت، لتتلقى أمى الفاجعة المتوقعة فى نهاية كل عام.
فى السنة الوحيدة التى دخل فيها الامتحان، وقبل فى كلية التربية، استراح أبى، فابنه سيكون مدرسًا، مثله، على أية حال، بل أفضل منه، فأبى، بعد ضياع حلم الالتحاق بكلية الهندسة، اضطر إلى الاستسلام للواقع، وبأن يعمل ويعول جدى وإخوته، التحق بمعهد معلمين متوسط، متخليًا عن حلمه، دون تردد، بينما ابنه «الفاشل» لا يريد أن يقبل بمؤهل عال، يفوقه، ويجنبه كل التضحيات، والدأب، اللذين جعلا من أبى، رغم المؤهل المتوسط، أهم مدرس رياضيات فى مصر الجديدة، لأن «راجى» ورث عنه الحلم، الحلم فقط، أن يكون «مهندسًا»، دون أن يبذل أى جهد من أجله. كان أبى يحمل حلمه كجثة فى أعماقه، بينما حمله «راجى»، برعونة من يتناول طفلًا حديث الولادة، من يد أمه، ويؤرجحه، بعنف، أمام عينى أبى المكلوم.
(١١)
السير فى شوارع مصر الجديدة فى الظهيرة، بعد العودة من المدرسة، ولم أزل «بالمريلة»، أحمل «عمود» الأكل لراجى، وأتجنب - حسب توصيات أمى- الشوارع التى قد يمشى فيها بابا، عائدًا من مدرسته، مغامرة لطيفة. فى جيبى نقود سأعطى «راجى» منها الجزء الأكبر، لكننى سآخذ مكافأتى أيضًا، عن الرحلة المحفوفة بالمخاطر، وعن «كتمانى» السر، وسيستقبلنى «راجى» بابتسامة عند الباب (كان قد ترك الكلية فى أسيوط، وقرر أن يعيد الثانوية العامة للمرة السادسة! مصرًا على تحقيق حلم الهندسة!) أحيانًا، كان يسمح لى أن أتقافز على سلم العمارة، الذى لا سور له، بشرط أن أحترس ولا أقع. سأمر فى عودتى «بكشك» السجائر على الناصية، لأقف مع أصدقائى؛ أولاد البواب فيه، كى يستريحوا قليلاً، أو يلعبوا، لا أتذكر، وسيمدح أبوهم قدرتى على التعامل مع زبائن الكشك، حتى العمال، الذين يشترون «سيجارتين فرط»، كنت أعاملهم بلطف، (مبالغ فيه، لإثبات مهارتى فى التجارة، كأجدادى) فيشكروننى، بمودة، ثم أذهب إليه، وأعطيه «العهدة» مع المكسب، فيقول لى: «وشك حلو علينا قوى، ياريت تيجى كل يوم». وكنت أرجع إلى البيت - بعد إتمام المهام كلها - طائرة من السعادة.
أقرا ايضا | 6 نصائح تجعل «شاي الياسمين» مفيدًا لك
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز






















