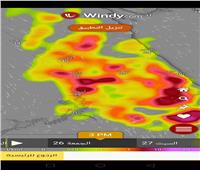رفاعة الطهطاوى
رفاعة الطهطاوى إلى باريس: طالب ترجمة لا إمام بعثة
الإثنين، 01 فبراير 2021 - 02:25 م
عبدالرحمن طارق الشرقاوى
رفاعة رافع الطهطاوى (1801-1873) اسم لمع ورسخ فى ذاكرتنا منذ الربع الثانى من القرن التاسع عشر وحتى اليوم. تستطيع ذاكرتنا استدعاء اسمه وسيرته فى كثير من المناسبات التى تتصل بما أنجزه أو دعا إليه خلال مسيرة حياته الحافلة بالعمل وبطرح الرؤى الداعية للتحديث والتنوير. الطريف أننا نستدعى الاسم وسيرة صاحبه فى مواقف كثيرة لا تتصل بعمله بل ببعض مشاهداته أو ما مر به فى حياته. ويكفى أن نشير هنا إلى تذكر كتاب رفاعة ورحلته إلى فرنسا عندما عانى العالم من وباء كورونا، فقد سارع كثيرون إلى إعادة نشر ما كتبه رفاعة عن أيام الكرانتينة. وقد بقى رفاعة وزملاؤه المبعوثون إلى فرنسا فى حجر صحى فى مدينة مرسيليا قبل السماح لهم بالدخول إلى فرنسا. تذكر الكثيرون أيام الكرانتينة لكنهم لم يتذكروا ذلك الوباء الذى ضرب القاهرة فى ثلاثينيات القرن التاسع عشر ودفع رفاعة إلى الفرار من القاهرة إلى الصعيد عامًا كاملاً. هنا نلاحظ ذاكرة انتقائية تبقى أشياء وتستدعيها مرارًا وتتجاهل أشياء أخرى. وهذه الانتقائية أثرت كثيرًا على معلوماتنا عن رفاعة كما سنذكر فى السطور التالية.
هناك عناصر فى حياة الطهطاوى نتذكرها أكثر من غيرها، بداية من اسمه وانتهاءً بإنجازاته: فقد اشتهر باسم الطهطاوى رغم أنه لقب متصل بمسقط رأسه وليس بنسبه. لكن هذا اللقب استقر فى الأذهان حتى أن محاولة تغييره قد تمثل تهديدًا لقدرتنا على استدعاء ما تحفظه ذاكرتنا عنه. قد ينسى بعضنا إنجازاته فى ترجمة الكتب العلمية أو فى تدريس اللغات أو دوره فى الإشراف على المدرسة الحربية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. لكننا لا ننسى أبدًا أن رفاعة الطهطاوى وُلد فى طهطا بصعيد مصر فى نفس شهر خروج الجيش الفرنسى المحتل من مصر؛ ولا ننسى أنه تلقى تعليمًا تقليديًا فى البداية على يد أفراد من أسرته قبل أن ينتقل إلى الأزهر. وأقوى ما يبقى فى ذاكرتنا هو سفر هذا الشاب الأزهرى إلى فرنسا فى مستهل الربع الثانى من القرن التاسع عشر ضمن أكبر البعثات الدراسية التى أرسلها محمد على إلى الخارج، ثم نتذكر ما كتبه عن فرنسا ورحلته إليها فى كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز». نتذكر أيضًا دوره فى إنشاء مدرسة الألسن التى نعتبرها واحدًا من أكبر إنجازاته وأهمها خصوصًا مع استمرار هذه المدرسة حتى اليوم وانضوائها تحت مؤسسة تعليمية أحدث منها بأكثر من قرن وهى جامعة عين شمس.
ويمكن أن نتذكر أيضًا دور رفاعة فى النهوض بالتعليم المصرى ودعواته لنشر التعليم ولتعليم البنات ، وغير ذلك من التفاصيل الكثيرة حول التعليم المصرى فى القرن التاسع. ومن التعليم إلى الصحافة، ومن الصحافة إلى التنشئة السياسية وطرح مفاهيم اجتماعية وسياسية جديدة على المجتمع عمومًا وعلى الناشئة بوجه خاص. وتمتد السلسلة بعيدًا لكننى سأكبح جماح ذاكرتى ويدى حتى لا أضيع السطور التالية فى تكرار ما نعرفه جميعًا عن رفاعة الطهطاوي.
هذا السيرة التى امتدت منذ مطلع القرن التاسع عشر وحتى سبعينياته لم تكن مكتوبة بشكل مباشر أو موثقة على نحو دقيق. فرفاعة لم يتناول حياته بالتفصيل فى سيرة ذاتية فبقيت سيرة الطهطاوى مبعثرة بين بعض كتبه وبين ما نشرته الصحف والدوريات عنه فى حياته ، وبين ما كتبه من عاصروه عنه فى مناسبات مختلفة منها مناسبة رثائه. لكن ما كتبه رفاعة عن نفسه أو كُتب عنه فى حياته قد يتناقض مع ما شاع عنه بعد وفاته. الطريف والغريب أن ما شاع عنه بعد وفاته بدا أكثر رسوخًا فى ذاكرتنا دون سبب واضح. وسأكتفى هنا بالوقوف عند معلومتين مستقرتين جدًا هما: أولاً أن رفاعة سافر إلى فرنسا إمامًا للبعثة التى سافر معها وأنه لم يكن مطلوبًا منه أن يدرس خلال سفره، وأن دراسته كانت بقرار ودافع شخصيين منه؛ وثانيًا أنه مؤسس مدرسة الألسن وصاحب فكرتها.
رفاعة الإمام الذى تاقت نفسه لعلوم الغرب:
لنتوقف أولاً مع صورة الإمام الذى سافر إلى باريس ولم يكن مطلوبًا منه أن يدرس. فرفاعة لم يقل إبدًا أنه سافر إلى فرنسا ليكون إمامًا. فى بداية كتابه «تخليص الإبريز» ذكر رفاعة أن العلم الذى تعلمه فى الأزهر «... سهل لى الدخول فى خدمة صاحب السعادة أولاً فى وظيفة واعظ فى العساكر الجهادية، ثم منها إلى رتبة مبعوث إلى باريس صحبة الأفندية المبعوثين؛ لتعلم العلوم والفنون الموجودة بهذه المدينة البهية». إذن هو لم يقل إنه سافر إلى فرنسا للوعظ والإمامة. كما أن الكتاب كله يخلو من أية إشارة تتصل بعمل إمام أو واعظ للمبعوثين الآخرين. لا نجد ذكرًا لأية مسائل تتصل بحياة طلاب مسلمين فى فرنسا، ولا أسئلة ولا مسائل فقهية ولا صعوبات تتصل بالصلاة والصيام وممارسة الشعائر والفرائض. ليس هذا فحسب، بل إن ما ذكره رفاعة عن حياة الطلاب المبعوثين فى فرنسا يبين لنا أن الطلاب تفرقوا فى المدارس الخاصة والأكاديميات المتخصصة منذ نهاية العام الأول من وجودهم فى البعثة، ولم يكن لهم حق الخروج إلا بعد ظهر الخميس بالإضافة إلى يوم الأحد بكامله من كل أسبوع. ويبدو أن رفاعة ورفاقه لم تتوافر لهم فرصة حتى لصلاة الجمعة فى معظم الأسابيع منذ منتصف 1827 أو قبل ذلك بقليل. وكيف يمكن أن يسافر الإمام مع زملائه ثم يعود قبل بعضهم إلى مصر؟ نحن نعرف أن رفاعة عاد إلى مصر – أو غادر فرنسا – فى الربع الأول من عام 1831 بينما استمر بعض الطلاب فى الدراسة لأكثر من عام بعد رفاعة.
لو كان رفاعة مختصًا بالإمامة والوعظ لقال شيئًا عن ذلك فى رحلة كتبها فى سِفر ليس بالصغير ولا المقتضب. ولكن هذا لم يحدث، فمن أين جاءت صورة الإمام؟ جاءت أول مرة فى الكتيب الصغير الذى كتبه عنه أحد خريجى مدرسة الترجمة وهو السيد صالح مجدي. أصدر صالح مجدى كتابًا عن رفاعة بعد عام من وفاته بعنوان «حلية الزمن بمناقب خادم الوطن”. كانت هذه الإشارة الأولى لرفاعة على أنه إمام. انتقلت هذه الصورة من مجدى إلى على مبارك ثم إلى جرجى زيدان ثم مؤرخى الترجمة: جاك تاجر وجمال الدين الشيال، ثم إلى من كتبوا عن رفاعة وأرخوا له أو من درسوه ضمن دراساتهم المتعددة: أحمد بدوى وحسين فوزى النجار وعبد المحسن بدر وأحمد درويش واستمرت المعلومة فى الانتقال حتى القرن الحادى والعشرين. وكما انتقلت من صالح مجدى إلى معظم الكتاب العرب من بعده انتقلت كذلك إلى العالم كله. يظهر اسم الطهطاوى فى عشرات الكتب والمقالات والدوريات العربية والعالمية، وتقترن صفة الإمام باسمه اقترانًا عجيبًا سببه ما أورده صالح مجدى عنه.
وثق الجميع فى صالح مجدى ظنًا منهم أنه تلميذه بالمعنى المتعارف عليه من الصلة الوثيقة بين الأستاذ والتلميذ. لكن الحقيقة أن صالح مجدى كان واحدًا من الذين درسوا مع رفاعة ولم يكن تلميذه الأثير الذى يعرفه ويعرف عنه كل شيء. بل إن مجدى لم يعمل مع الطهطاوى بعد انتهاء الدراسة فى مدرسة الترجمة وإنما اتصل أكثر بعلى مبارك وكان قريبًا منه.
وجدت صفة الإمام دعمًا لها فى استمرار تلقيب رفاعة بلقب «الشيخ» حتى فى المصادر الفرنسية التى صدرت وقت وجوده فى باريس وفى الشهادات والتقارير التى صدرت عنه خلال بعثته وبعد عودته إلى مصر. وكان لقب «الشيخ» سببًا فى تصور البعض أن البعثة كان لها أكثر من إمام لأن قائمة المبعوثين تضمنت خمسة أسماء مسبوقة بلقب «الشيخ» لكنهم فى الحقيقة كانوا طلابًا. وبعد عام من بداية البعثة تبين أن اثنين منهم لا يتقدمان فى الدراسة فأعيدا إلى مصر، بينما بقى ثلاثة هم الشيخ أحمد العطار والشيخ رفاعة والشيخ محمد الدشطوطي. ولكننا نعرف أن الأول كان يدرس الميكانيكا بينما تخصص الأخير فى دراسة الطب والتشريح. وقد ظن البعض ان الثلاثة كانوا أئمة لبعثة قوامها 44 طالبًا وبعضهم غير مسلمين.
فإن لم يكن رفاعة إمامًا فماذا فعل ولماذا سافر إلى فرنسا؟ من المعروف أن البعثة لم يكن فيها إداريون ولا مسئولون، فحتى رؤساء البعثة كانوا ثلاثة من المبعوثين أنفسهم وكانت مسئولياتهم الإدارية موازية لواجباتهم الدراسية. أما المشرف على البعثة فلم يكن مصريًا ولا سافر من مصر، وإنما كان فرنسيًا معروفًا من أعضاء الأكاديمية الفرنسية ومستشرقًا بارزًا هو «مسيو جومار». كان جومار قد صحب الحملة الفرنسية على مصر والشام قبل أقل من ثلاثة عقود، وغادر مصر قبل ربع قرن من وصول البعثة المصرية إلى باريس. وكان جومار نفسه هو من أوحى بفكرة إرسال بعثة للدراسة فى فرنسا لمبعوث سابق سافر منفردًا هو عثمان نور الدين. فإذا كانت البعثة قد خلت من أى فرد يقوم بعمل غير الدراسة فإننا نفترض أن رفاعة نفسه لم يكن إمامًا. وربما كانت وظيفة الواعظ والإمام دورًا ثانويًا عليه أن يقوم به لكن له دورًا آخر.
ولكننا – كما ذكرنا قبل قليل – لا نجد ما يفيد أنه مارس أى عمل وعظي، وبالتالى فلا يبقى أمامنا إلا أنه كان طالبًا. هذا ما نفهمه من حديث رفاعة نفسه منذ المقدمة عندما قال إنه كان مبعوثًا رفقة الأفندية الآخرين. وفى المقالة الرابعة من مقالات «تخليص الإبريز» نراه يستعرض التجربة الدراسية لأعضاء البعثة مستخدمة ضمير جماعة المتكلمين فهو يعرف المقالة الرابعة بأنها مقالة «فيما كنا عليه من الاجتهاد والانشغال بالفنون المطلوبة لتحصيل غرض الوالي...وفى عدة مراسلات بينى وبين بعض خواص الإفرنج تتعلق بالتعليم ، وفى ذكر ما قرأته من الفنون والكتب بمدينة باريس». ثم يضيف فى الفصل الأول أنه «لما كانت آمال الوالى متعلقة بتعلمنا عاجلاً ورجوعنا إلى أوطاننا ابتدأنا فى مرسيليا قبل وصولنا إلى باريس وتعلمنا فى نحو ثلاثين يومًا التهجى ثم لما ذهبنا إلى باريس مكثنا جميعًا فى بيت واحد وابتدأنا فى القراءة» فهو هنا لا يفصل نفسه عن غيره من الطلاب.
يختم رفاعة الفصل الأول بقوله: «ولكثرة هذه المصاريف فى تعليمنا وغيره ... كان ناظر التعليم أو الضابط علينا يذكرنا به فى أغلب الأوقات لنجتهد
ويصف رفاعة أيام الطلاب فى باريس خلال السنة الأولى على النحو التالى: «حين اجتماعنا فى بيت الأفندية كنا لا نخرج منه ليلاً ولا نهارًا إلا يوم الأحد الذى هو عيد الإفرنج بورقة إذن للبواب من الضابط الذى نظره علينا الوالي. ثم بعد تفرقنا فى المدارس المسماة البانسيونات كنا نخرج أيام البطالة وهى يوم الأحد بتمامه ويوم الخميس بعد الدروس وأيام أعياد الفرنساوية...» وكان على الطلاب أن يكتبوا تقاريرهم بناء على طلب محمد على ولهذا فقد أورد رفاعة أوامر محمد على إلى الطلاب ثم أورد نص رسالة فردية وصلته من جومار يطالبه فيها بالمواظبة على كتابة تقاريره الشهرية حسب أوامر الوالي. وهذه الرسائل –بالإضافة إلى ضمير جماعة المتكلمين – تؤكد أن رفاعة كان واحدًا من الطلاب.
وهكذا يصف لنا رفاعة بدقة تجربة الطلاب وهو منهم فى التعلم بداية من اللغة الفرنسية والحساب والمعارف العامة قبل أن يُعقد لهم امتحان فى عام 1827 ثم فى عام 1828. وقد تميز رفاعة فى الامتحانين ضمن بعض الطلاب فاستحق الجوائز والتكريم من جومار المشرف على البعثة ومن الممتحنين الآخرين. وهذه الامتحانات تؤكد أنه كان من الطلاب أيضًا وإلا لما كان عليه أن يدرس ويكتب التقارير ويؤدى الامتحانات مع الطلاب الآخرين. وهى امتحانات قال رفاعة إنها كانت تُصنع معهم سنويًا، على عادة الفرنسيين مع طلابهم .
نحب أن نتوقف مع الامتحان الأخير الذى يبين لنا بوضوح أن رفاعة كان طالبًا ويحدد تخصصه الذى درسه فى باريس: «وأما صورة الامتحان الأخير الذى به رجعت إلى مصر أن مسيو جومار جمع مجلسًا فيه عدة أناس مشاهير ومن جملتهم وزير التعليمات الموسقوبى رئيس الامتحان . وكان القصد بها المجلس معرفة قوة الفقير فى صناعة الترجمة التى اشتغلت بها مدة مكثى فى فرنسا» . وقد شهد له أستاذه شيفاليه بأنه نال استحسان المجلس: «فتفرق أهل المجلس جازمين بتقدم التلميذ المذكور ومجمعين على أنه يمكنه أن ينفع فى دولته، بأن يترجم الكتب المهمة المحتاج إليها فى نشر العلوم ، والمرغوب فى تكثيرها فى البلاد المتمدنة».
وذكر مسيو شيفاليه الذى عرف نفسه بأنه وكيل مسيو جومار والنظار المشرفين على البعثة أن رفاعة «صرف جهده مع غاية الغيرة فى الترجمة التى هى صنعته المختارة له ». وهذا نص قاطع فى تحديد مجال دراسة رفاعة وتخصصه.
كل النصوص السابقة أوردها رفاعة بنفسه وهى كلها تؤكد أنه طالب، ولو كان غير ذلك لعلق عليها بشكل من الأشكال. ولكنه لم يفعل، كما أنه لم يقل إنه سافر للوعظ والإمامة. ما قاله وما نقله رفاعة هو أنه سافر مبعوثًا وأنه تخصص فى الترجمة. وهذا ما قاله عنه جومار فى مقال له بالمجلة الآسيوية عام 1828 عندما كان رفاعة فى باريس فى منتصف فترة دراسته تقريببًا. قال إن رفاعة طالب يتخصص فى الترجمة، وهو الوحيد الذى تخصص فى الترجمة. وعاد جومار فنشر مقتطفًا من رسالة بعثها إليه رفاعة بعد عودته إلى مصر، وعرَّف رفاعة بأنه تلميذ سابق فى المدرسة المصرية بباريس.
رفاعة مؤسس مدرسة الألسن:
هذا التلميذ السابق عاد إلى مصر وانخرط فى العمل مترجمًا لسنوات قبل أن يقرر محمد على إنشاء مدرسة للترجمة فى منتصف ثلاثينيات القرن التاسع عشر. قال كثيرون إن اسمها مدرسة الألسن. لكن ما جاء فى وثائق الديوان يقول إنها مدرسة للترجمة من اللسان الفرنساوي. وهذا ما أكدته جريدة الوقائع المصرية فى عددها رقم 590 حيث قالت إنها مدرسة للمترجمين من اللسان الفرنساوى إلى اللسان العربى برئاسة الشيخ رفاعة رافع «الذى ذهب فيما تقدم إلى باريس وحصل الفنون وتعلمها على وفق المطلوب» وكان رفاعة فى هذا الوقع يقوم بعدد من الأعمال منها تحرير الوقائع المصرية، فلو أن اسمها كان مدرسة الألسن لعدل نص الخبر، ولكنه لم يفعل مرة أخرى.
الطريف أن رفاعة نفسه لا يذكر مدرسة الألسن ولا مدرسة الترجمة، ولكنه أشار مرة واحدة فى كتابه «مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية» إلى أن هناك مدرسة فى مصر اسمها «مدرسة الألسن الأهلية والأجنبية» وأظنها غير مدرسة الترجمة التى كانت تركز على تعليم الفرنسية والعربية وفنون الترجمة من الأولى إلى الثانية. وبقيت مدرسة الترجمة فترة ثم توقفت ثم ظهرت مدرسة الألسن فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر لتفتح طريقًا للترجمة على أساس علمى وتواصل مسارًا بدأ من فترة حكم محمد على واستمر حتى اليوم بلا انقطاع.
ويبدو أن رفاعة كان شاهدًا على مسارين لم ينقطعا تقريبًا خلال القرنين الماضيين : الترجمة وإيفاد البعثات. صحيح أن الأهداف لم تبق نفسها طوال الوقت، وربما كانت الوظيفة النفعية المباشرة قد غابت عن كلا المسارين، لكنهما استمرا ولم يتوقفا.
مدرس الأدب المقارن بآداب القاهرة والأستاذ الزائر بجامعة أوساكا اليابانية منذ ٢٠١٤
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
 الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني
الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني