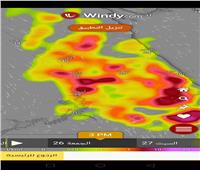ايمان مرسال
في الذاكرة والوعي والصدف السعيدة
الإثنين، 09 أغسطس 2021 - 11:45 ص
كتب - حسن عبدالموجود
ظل الحوار مع إيمان مرسال فكرة مؤجلة، لمدة عشر سنوات. لم ترفض إجراءه بشكل قاطع، وأبقت الباب مفتوحاً. كان إيجاد الوقت المناسب للكلام هو العنوان البارز - فى كل مرة - لتبرير التأجيل. وخلال هذه السنوات العشر أجريت معها ما يشبه بروفة لهذا الحوار، فقد أخبرتها بأننى أكتب عنها «بورتريه»، ويجب أن أحاورها فى بعض الأمور والأفكار، كالحياة بين بلدين: كندا ومصر، ومدينتين: القاهرة وإدمونتون، معنى الصداقة، هواجسها فى الكتابة، وساوسها فى المرض. وجاءت إجاباتها مقتضبة، فبدا البورتريه كأنه صورة لعالم إيمان مرسال، لكنها التُقِطت على ضوء أباجورة. صورة تنقصها الإضاءة المناسبة لمعرفة أعمق عن آرائها فى الكتابة والحياة.

مع ياسر عبد اللطيف وأسامة الدناصورى. القاهرة، ٢٠٠٤
في هذا الوقت فكَّرت دوماً أن كتَّاب التسعينيات يتقدمون فى السن، لدرجة أنهم – وقد كان الناس بالأمس القريب يتحدثون عنهم باعتبارهم شباباً – على مشارف الخمسينيات. سألتها - بشكل مباشر - عن إحساسها بتقدمها فى العمر. ضحكت، وسخرت منى. ثم طلبت أن أوجه نفس السؤال للكتَّاب الرجال. وهذه هى إيمان مرسال. شخصية شديدة الجدية كما يليق بأستاذة جامعية، لكن أسفل وجهها الرصين وجهٌ مختلف لفتاة تشعر بجمالها الفريد. شخصية تكبرُ، وأخرى ما زالت تعيش لحظة الطفولة، حينما كان أبوها يحملها إلى ساحة قريتها «ميت عدلان» فى المنصورة، لتشاهد فيلماً أو لتستمع إلى المنشدين، شخصية رقيقة للغاية، وأخرى شرسة لا تترك حقها فيما يخص المواقف والأفكار، ولديها القاموس المناسب فى الحالتين. شخصية هادئة وأخرى مناكفة وساخرة.
لكن إيمان مرسال في الأدب شخصٌ واحدٌ مهما تعددت أقنعة الكتابة، من الشعر إلى السرد إلى الترجمة. شخص لا يكف عن التعلم، لا يملك يقيناً ولا يفرح كثيراً بما تحقق. تفكر - بعد كل خطوة لها - فى الخطوة التالية، وكى تفعل ذلك عليها أن تتابع جيداً كل ما يصدر فى العالم. بلا مبالغات تعرف إيمان الشعر أينما يُزهر. لو سألتها عن الشعر في أمريكا اللاتينية مثلاً، ستعدد أمامك أسماء الشعراء فى البرازيل وكولومبيا والمكسيك وكوبا وغيرها، بمن فيهم الشعراء الشباب، الجيدون والسيئون، وهى تفعل ذلك لتعرف موضع قدميها، وكيف يتطور الشعر حولها فى العالم.

مع هيثم الوردانى. برلين ٢٠٠٠
إيمان ابنة الثقافة المصرية، لكنها أيضاً ابنة للثقافة الإنسانية العالمية، ولا تعارض بين الأمرين، بل إن جزءاً من اهتمامها بالترجمة ينبع من رغبة فى نقل تجارب عظيمة قرأتها فى لغات أخرى إلى لغتها العربية، كأنها مدينة لثقافتها بمعروف، وها هى تقدمه. صارت إيمان بمرور الوقت علامة على نجاح مذهل، لا حدود له. أصدرت خمسة دواوين فقط، «اتصافات، ممر معتم يصلح لتعلم الرقص، المشى أطول وقت ممكن، جغرافيا بديلة، حتى أتخلى عن فكرة البيوت» أصبحت بها أهم شاعرة مصرية، وفى الكتابة المفتوحة قدمت عملين صارا من العلامات، «كيف تلتئم: عن الأمومة وأشباحها» و«فى أثر عنايات الزيات»، وفى الترجمة أتاحت لنا قراءة الرواية المذهلة لوجيه غالي «بيرة فى نادى البلياردو» وسيرة الشاعر الأمريكى تشارلز سيميك «ذبابة فى الحساء».
وقد سنحت الفرصة لإجراء الحوار مع إيمان مرسال - سنة 2016 - أثناء زيارة إلى بيتها فى المنيل. كانت فرحة كطفل، وتحمل صندوقاً بحذر كأنه صندوق الكنز. قالت لى إن أحد الاصدقاء عثر على أوراق ديوانها الأول، وفى مكتبها جلستُ معها على الأرض، وراقبتها وهى تُخرِج الأوراق من الصندوق واحدة واحدة. تقرأ قليلاً وتضحك، ثم تمررها إلىَّ. أوراق قديمة بها قصائد الديوان، مكتوبة على الآلة الكاتبة، بعضها بالأسود وبعضها الآخر بالأزرق الباهت. كان صاحب مكتبة فى دكرنس يطبع أكثر من نسخة، ويضع بين الأوراق «الكربون الأزرق». آمن ذلك الرجل بموهبتها، وطلب منها أن يكون ناشرها وهى فى الصف الثانى الثانوى. وقبلت إيمان. وزع صاحب المكتبة أكثر من نسخة ومنحها بضع جنيهات. كان أول نشر فى حياتها، ولم يتبق من تلك النسخ سوى هذه النسخة فى أيدينا، ومع هذا سمحت لى إيمان بأن أحتفظ بها لعدة سنوات.
كتب صاحب المكتبة فى الورقة الأولى من الديوان «تم بحمد الله طباعة هذه القصائد العشرين المصغَّرة من الديوان الأول للمبتدئة إيمان السيد على مرسال. نتمنى أن تصل إليكم كما خرجت من الأعماق، والله ولى التوفيق. المؤلفة. مع أطيب التمنيات وبالتوفيق أ. أ. ع». كان صاحب المكتبة على ما يبدو يريد أن يكتب أى شىء على الغلاف ليمنح الأمر نوعاً من المصداقية والرسمية، كأنه مثلاً صاحب مطبعة كبرى. كتب هذه العبارات على لسانه ووصف إيمان بـ«المبتدئة» ومع هذا وضع توقيعها فى النهاية.

مع مايكل فريشكوف. القاهرة ٢٠٠٤
قصائد الديوان تقول بوضوح إن موهبة إيمان ليست عادية. انفجرت فى هذا الزمن البعيد، انفجاراً عظيماً، منح صاحبته قوة دفع لا نهائية جعلتها تسبح باستمرار فى الزمن، حتى وصلت إلينا بنفس القوة. كنت أحمل ديوان إيمان، ومعها كذلك مجلات ماستر أفردت لقصائدها مساحات ضخمة، لم تتحْها لأقرانها، وفى هذه اللحظة قررت تتبع أثر إيمان من ميت عدلان إلى كندا. كانت معى قصة، أو قل: خيط، أو مصباح سحرى يمكن من خلاله العودة إلى ماضى إيمان ورؤية منابع الشعر: شعرها، والحياة: حياتها، لكن الأمر تعطَّل على الدوام، حتى حينما سار بشكل جيد، وتحدثنا عبر أحد التطبيقات لساعات متقطعة طويلة، ظهرت إيمان فى القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد عن كتابها «فى أثر عنايات الزيات». طلبت منى بقلق وإصرار تأجيل نشر الحوار، إذ أن ظهوره فى هذا التوقيت يعنى أننا أجريناه خصيصاً فى مناسبة، وهى لا تحب المناسبات. أخبرتها أن الأمر عادى وباستطاعتنا التأجيل، فبدا كأننى أزيح عنها هماً ثقيلاً، وضحكت لأول مرة.
هواية جمع «غطيان الكوكاكولا»
لم يسر الأمر على نحو منظم. انطلق الحوار من طفولتها لكنه تشعَّب إلى عشرات الأمور، كما أن كل حكاية تخللتها حكايات أخرى، بدت أشبه بالدوائر المتقاطعة، ومع شخصية وشاعرة ليست عادية كإيمان مرسال لن تجد أن أول حكاية ستبدأ من كتاب غيَّر حياتها إلى الأبد، وإنما من غطاء زجاجة كوكاكولا.
لم يكن مطروحاً أن يهديها أحدهم كتاباً. تخيلوا إيمان مرسال طفلة فى الرابعة – خلال السبعينيات - والعالم يفتقر حولها إلى كثير من البهجات، حتى أنه لم يساعدها على ممارسة هوايات جمع الأشياء الصغيرة، مثل «غطيان الكازوزة». كان كل شىء شحيحاً، حتى تلك «الغطيان». الأهل غالباً لا يحضرون زجاجات الكوكاكولا والبيبسى والشويبس إلا فى الأفراح، أو حينما يشكو أحدهم من المغص، وبالتالى توفر لها سفرية إلى رأس البر لمدة أسبوع متعة جمع «الغطيان»، إذ أن المصطافين لا يتوقفون عن شرب «الكازوزة».
تقول: «حينما أفكر فى تفاصيل الماضى، وما يتوفر لأطفال الزمن الحالى، أجد المسافة مرعبة. إحدى خالاتى عادت ذات يوم بمناديل ورقية، ولكنها للغرابة ليست مناديل بيضاء كالعادة، وإنما حمراء، فانبهرت بها، وسرقت واحدة منها، واحتفظت بها لمدة سنين، كأننى أحتفظ بكنز. كان هناك شوق طوال الوقت، فى زمننا، إلى أشياء غير متوفرة، وأولها الكتب مع الأسف».
كان هناك كتابان فى بيتها، أحدهما المصحف، وهذا عادى فى كل بيت، وكتاب عن تربية الطيور الرومية، وهذا غريب قليلاً. وقد بدا لها مثل لعبة غامضة، تخص شخصاً كبيراً بلغته غير المفهومة. تسرد حكايتها معه فى مقالة منشورة فى «عالم الكتاب» عام 2015: «حدث أن قرر جدّى طلاء جدران الغرفة. بدأت فوضى توزيع أثاثها على الغرف الأخرى. ظهر كتابٌ ربما كان مخفيّاً خلف القرآن أو تحته. بدا للوهلة الأولى مقدّساً أيضاً، لولا أن هناك رسومات لطيور روميّة بأنواعها المختلفة وبيوتها وحقولها. لم يكن باستطاعتى قراءته بسهولة بعد، ولكنى أخذته لنفسى ولم يفتقده أحد».

في قراءة مع الشاعرة تشوس باتو، جاليسيا، إسبانيا، ٢٠١٢
«احتوى بيت جدّى إذن على كتابين فقط، تجاورا فى أعلى الخزانة لسنوات. أحدهما مقدّس والآخر دنيوىّ، أحدهما روحى ومركزىّ، والآخر علمى ومُهمَل. وجود القرآن فى البيت بركة، أما كتاب عملى عن كيف تربى الطيور الروميّة فلابد أن وراءه حكاية. هل أعطى المؤلف نفسه الكتاب هدية لجدى على أمل أن فلاحاً مصريّاً سيُنشئ مشروعاً إنتاجيّاً يعود عليه بالخير الوفير، كما يقول فى مقدّمته القصيرة؟ إذا كان ذلك ما حدث، فلا بد أن المؤلف شعر بسعادة وهو يرى جهده يصل لمن يحتاجه».
«لم يكن كتاب تربية الطيور الروميّة موجهاً لى، أقصد، لم أكن أنا القارئ الذى توقّعه صبّاح أفندى، ولذلك ربما ظل هذا الكتاب مُلغزاً وطازجاً وملهماً بالنسبة لى. إنه أقدم كتاب أتوجّس منه وأحتفظ به فى حياتى، معى منذ أكثر من أربعين عاماً، من بيت جدى إلى بيت أبى، ومن القرية للمنصورة ثم شقق عديدة فى القاهرة، كما أنه سافر معى ضمن كتب قليلة إلى قارة أخرى. أظن أننى أستطيع أن أؤرخ لحياتى بأين كنت أضعه كل مرة يصل معى سالماً إلى بيت جديد. عندما تقرأ كتاباً لست أنت المقصود به وأنت طفل، يصبح الكتاب وكأنه رسالة لم تصل لصاحبها ووقعت فى يدك بالصدفة. إنها لا تخصّك ولكن كأن القدر استأمنك عليها».
الكتاب بهذا المعنى كان مجازاً فى حياتها. وضعها الطبيعى كبنتٍ مولودة فى قرية لن يجعلها كاتبة، أو امرأة متحررة، لكنْ هناك مجازٌ له علاقة بالقدر، أن تجد هذا الكتاب، وأن يظل معها كل هذه السنوات ليذكِّرها ببداياتها، وقدرها. إيمان أحبت القراءة من أول لحظة أمسكت فيها كتاباً، كأنها اكتشفت عالماً مسحوراً، أو كأن القراءة أصبحت طريقها إلى حيوات أخرى أكثر جمالاً. كانت أمها تجلس معها يومياً لتعلمها الألف باء، وتعاملت إيمان مع الأمر بكثير من الدهشة، مع الأخذ فى الاعتبار أن أمها علمتها بعض القواعد النحوية الخاطئة، كأن تنطق الأسماء الممنوعة من الصرف منوَّنةً. تهتف الأم، وتردد إيمان وراءها: «ذهب أسامتن» (أسامةُ).. «قال حمزتن» (حمزةُ)، وهكذا. تقول بلهجة مغلفة بالأسى: «يا ليتها عاشت حتى أفهم وأصحح لها الأمر».
وتضيف: «الأهم من القراءة كان لحظة موت أمى، فهى كانت أشبه بنافذتى على العالم، وعلى الفن، حتى أنها حينما رحلت ودعتنى بدرس جديد، إذ انتبهت إلى العديد - الذى يشيعها - كنوع من الفنٍ. أحببت سماع الراديو معها على الدوام. كان هنالك شىء مبهر فى حكايات الراديو. مثلاً صفية المهندس قرأت فى إحدى حلقات برنامجها «ربات البيوت» تقريراً يصف الناس عام 2000، وكان هذا هو المستقبل البعيد جداً، وقالت إن الناس وقتها لن يأكلوا، لكن سيكون بمقدورهم تناول الكبسولات بدلاً من الطعام. هناك أمور علمت فىّ، مثل برنامج «حديث الأربعاء»، والأغانى، والمسلسلات القديمة. تتبعت قصة حياة أم كلثوم فى إذاعة الشرق الأوسط. من أكثر الشخصيات التى ألهمتنى. صوتها انساب دوماً بعد آذان المغرب. جدتى كانت تعشقها وتنتظرها فى نفس الموعد يومياً. من أول وعيى كنت متأكدة أن حياتى فى القرية مؤقتة، وأننى سأرحل إلى أماكن بعيدة وكثيرة كالقاهرة، وكان النموذج الملهم طه حسين. تخيلت أننى سأذهب مثله إلى باريس. لم يكن هناك سبب موضوعى أو واقعى لتفكيرى على هذا النحو، ويقينى بأننى لن أستقر فى مكانى، ولحسن الحظ أن الأمور سارت على ما هى عليه، أو كما حلمت بها».

بعد موت أمها واظبت إيمان على المذاكرة بشكل جيد، وكانت طالبة متفوقة، كما بدأت فى استعارة كتيبات من سلسلة أعمال إسلامية من مكتبة المدرسة، وأثَّرت فيها قصة عمر بن عبد العزيز وعدله وحياته ومعاناته، لدرجة أنها حكت لقريبها، وكان طالباً فى طب المنصورة، وشيوعياً، اسمه مجدى، أن عمر بن عبد العزيز كان أحسن من جميع الصحابة والأنبياء، فأعجبه ذلك.
بدأ مجدى يهتم بها، ويعيرها كتباً أدبية تُصدرها دار «التقدم»، ومن بينها ملخصات مترجمة من الأدب الروسى للأطفال. قرأت إيمان كثيراً من هذه الأعمال، لكنها واجهت صعوبات فى فهم بعض المفردات بسبب حداثة سنها، إذ كانت فى الصف الرابع الابتدائى: «لا زالت تلك الكتب عندى، ومنها عمل لتولستوى ترجمه العراقى غائب طعمة فرمان. عندما زارتنى صديقتى مارجريت ليتفن من جامعة بوسطن قالت لى بالصدفة، إنها تعمل على كتاب عن قصص الأطفال الخاصة بتولستوى. أخبرتُها أننى أمتلكُ بعضها فاندهشتْ. بحثنا سوياً عنها ووجدناها مع كتاب لفلاديمير مايكافوسكي صادر عن دار «رادوغا» فى غرفة أطفالى. ولم تصدق مارجريت الأمر فى البداية، لكنها فرحت كثيراً، وتعاملت مع القصص كأنها مخطوطات نادرة».
طفلة الاشتراكية
لم تقرأ إيمان مثل جميع الأطفال فى سنها كتب الألغاز، وكانت هناك صدف، أقرب إلى هدايا سماوية، كأن تعثر على كتاب صغير عنوانه «الاشتراكية الفابية» فى غرفة قريبها مجدى. عرفت الكثير من خلاله عن برنارد شو، والاشتراكية فى انجلترا: «حينما كان اسم برنارد شو يُذكر فى الراديو أمامى أشعر بفخر غير طبيعى، وكأننى مثقفة العالم الأولى».
بعد موت أمها بدأت تنغمس أكثر فى القراءة، ولم يكن الأب قارئاً شغوفاً، لكن لسبب ما، لا تعرفه إيمان على وجه التحديد، ولا تستطيع تفسيره إلى الآن، كان يُحضِر لأختها هدايا عينية، «غويشة» أو «سلسلة دهب»، ويمنحها هى - على وجه التحديد - المال، فتتحرك مباشرة إلى دار المعارف، أو الهيئة العامة للكتاب فى المنصورة. تطالع الكتب قبل أن تقتنيها، وتشعر أنها مع أقرب أصدقائها.
فى الصف الخامس الابتدائى أصاب إيمان صداع نصفى مزمن. نوبات متلاحقة ومتكررة حتى أصبح الأمر أشبه بكابوس، وقد فكروا فى البيت أن الصداع سببه سوء حالتها النفسية بعد موت أمها، واقترح أحدهم الذهاب بها إلى شيخ. لكن الصداع استمر فى مهاجمتها، حتى اكتشفوا أنها مصابة بقصر النظر، وتحتاج إلى «تفصيل نضارة»: «كانت أقبح نظارة يمكن أن يرتديها طفل. سميكة جداً وذات إطار من الألمونيوم الشنيع. أبى كان متعاطفاً معى، وانتبه إلى اهتمامى بالقراءة أكثر من حبى للعب، وشعر أن هناك مشكلة ما، لكنه لم يجبرنى على شىء. كنت قارئة، لا أقرأ بتنظيم، وإنما بعشوائية، أى كتاب تقع عليه يدى، أو يتوفر لى فى مناخ صعب، كتاب تاريخ، أو ترجمة. كنت قارئة على طريقتى، فى مجتمع لا يمنحك كطفلٍ رفاهية بدء حياتك وقراءاتك بكتب الألغاز والمغامرات».
ثم جاء الدور على شخص مثَّل نافذة أوسع على عالم القراءة والكتابة..

مع الشاعر ديريك والكوت. جامعة ألبرتا، ٢٠١١
قادتها سلسلة من المصادفات إلى فؤاد حجازى فى مكتبه بـ«النقل البطىء». سميرة البغدادى معلمة الفرنسية فى مدرسة «دكرنس الثانوية للبنات» طلبت منها - ذات يوم - أن تذهب إلى موظف تعرفه، فى قصر ثقافة المنصورة، وتقرأ له قصائدها. كان المشهد عبثياً، بطلته فتاة صغيرة تجلس أمام موظف لتقرأ عليه قصيدتها، وهو يهز رأسه استحساناً ولا يقول شيئاً، بينما دخلت موظفة «عرقانة» من الحر، تشكو أن أسعار معرض المنسوجات نار، فتوقف الموظف عن سماع قصيدة إيمان.
شاهد الكاتب وجيه عبد الهادى المشهد كاملاً، وقال لها: «تعالى أعرَّفك على كاتب كبير». سارت معه عدة دقائق بحذاء الكورنيش، وبعد كوبرى طلخا دخلا يساراً بجانب مسرح المنصورة، حيث ظهر مكتب «النقل البطىء». صعدت خلفه ثلاث سلمات، شاهدت فؤاد حجازى يجلس خلف مكتبه، وأمامه كرسيان خاليان: «من خلاله تعرفتُ على المشهد الثقافى فى المنصورة، وسمعت عن إبراهيم رضوان واكتشفت أنه كتب أغانى محمد نوح التى أحبها، وكذلك سمعت اسم محمد المخزنجى للمرة الأولى، وكان أبى مندهشاً جداً من استمرارى فى هذا الاتجاه، وحماسى له، لكنه آمن بى فى النهاية».
إن كانت إيمان قد حظيت بفرصة كهذه، فهناك أشخاص كثيرون – فى رأيها – يستحقون فرصاً مثلها: «لا أتحدث عن الكتّاب، لكنى أتحدث عن أفراد عاديين. يجب أن يحظى الجميع بفرصة القراءة، بدون أن يكونوا كتّاباً أو ينتظروا حظاً سعيداً يقودهم إلى أشخاص مثل فؤاد حجازى. لا توجد عدالة فى الحصول على المعرفة، لأن المعرفة ما زالت مشروطة بالطبقة الاجتماعية، لكنى كنت محظوظة. ربما كان بداخلى قلقٌ دفعنى طوال الوقت للبحث، وكانت القراءة هى ما أنقذنى من اختيارات أخرى كثيرة، قد تكون فى غالبيتها غبية، وفى أفضل الأحوال مملة».
لم يتنمر أحد على إيمان مرسال بسبب نظارتها، كانت تلميذة متفوقة وذكية وجميلة، تتذكر نفسها فى هذه الفترة وتعتقد أنها هى من كان يتنمر أحياناً على الزملاء. كانت تعبر ببساطة عن رفضها لدلع البنات، أى فتاة تظهر عليها علامات الأنوثة المبالغ فيها تحصل على تكشيرة مناسبة منها.
انفجرت إيمان ذات الأعوام الثلاثة عشرة فى البكاء، وطلبت تغيير النظارة البشعة. كانت فى دكان «سيد أبو محمد» فى وسط البلد، بالقرب من الجامع الكبير، وجذب مظهرها الملائكى كهلاً وامرأة. كان الكهل يسأل المرأة وهو يتمعن فى وجه إيمان: «هىّ دى بنت مين؟ً» والمرأة تجيبه: «بنت سيد أبو مرسال»، فيسألها مجدداً: «يا حرام وملبسينها نضارة من دلوقتى؟!». شعرت إيمان بالغضب. اعتبرت أن ذلك الحديث إهانة. بكت كثيراً حينما عادت إلى البيت، وفهموا منها أنها لا تريد ارتداء النظارة مجدداً، لكنهم أقنعوها بتغييرها، واشتروا لها واحدة جديدة، شكلها إنسانى، وإطارها جميل.
عندما قرأت إيمان للمفكر الإيطالى أنطونيو جرامشى، وتعرفت على مفهوم المثقف العضوى، فكرت أنها قابلت هناك كثيرين منه، بامتداد مصر، يحبون الفن والسياسة، ولديهم رغبة فى تغيير العالم. هؤلاء الأفراد لعبوا دوراً مهماً ومؤثراً للغاية دون أن ينتبهوا: «فؤاد حجازى يمثل بالنسبة لى هذه الحالة، أهدانى كتابه «الأسرى يقيمون المتاريس» و«نافذة على بحر طناح»، وبعض كتب الأدب العالمى. كنت محظوظة بمقابلة شخص مثله، شخص يريد توصيل الأدب والفكر للجميع لدرجة أنه نشر سلسلة سمَّاها «أدب الجماهير» حتى يشجع الناس على القراءة والفهم والتغيير. هذه الحالة مؤثرة جداً. لم يكن حجازى مهتماً بقصائدى فقط، وإنما بحالة الغضب عندى. كنت غاضبة من أمور كثيرة، ولا أجيد التعبير عما أفكر فيه، وقال لى إن المسافة كبيرة بين قصائدى وأفكارى».
كان حجازى مهتماً بهذه الفتاة الصغيرة الموهوبة. ويراها زهرة تحتاج إلى رعاية لتتفتح. تضحك: «ربما أراد أن أصبح كاتبة يسارية محترمة وأنا أحبطته». تقول إيمان هذه العبارة على سبيل الضحك، إذ كان مهتماً فعلاً بنقل المعرفة إليها، رأى فيها شيئاً كبيراً، كاتبة مهمة: «آخر لقاء جمعنى به قبل وفاته بقليل. كان يوم وقفة. قررت قضاء العيد فى المنصورة، واتصلت به فحدد لى موعداً فى بيته، وهناك وجدت ابنه رفعت، الذى يعيش خارج مصر وجاء للاطمئنان عليه. بدا حجازى قريباً للغاية من الموت، وسألنى - رغم ذلك – عما أكتبه الآن وعن أحوالى، وقد مثَّل هذا معنى كبيراً بالنسبة لى. سرت فى سكة ربما لم يرنى فيها، لكن هناك درجة من التواصل ظلت تربطنا حتى آخر لحظة من حياته. حكى لى عن فجيعة وفاة زوجته فى المستشفى وكيف رآها لآخر مرة وهى جثة، وقد شعرتُ بامتنان غير عادى له، لكنه مع الأسف كان على بُعد خطوة واحدة من الرحيل».
مغناطيس المختلفين
ترى إيمان أن هناك أموراً كثيرة تجعل الشخص مختلفاً فى بيئته، كأن يكون قلقاً، أو مكتئباً، أو محباً للقراءة، أو متورطاً فى تبادل الأفكار. فى الثمانينيات، فى القرى والمدن الصغيرة البعيدة عن القاهرة، كان الاختلاف هو أن تكون يساريّاً. بمجرد أن يكون الشخص مختلفاً يبحث عن مختلفين مثله ليشعر بالأمان. إيمان ترى نفسها في فترة الجامعة بالمنصورة وهى تبحث عن آخرين يشبهونها. كانت تجذبهم كالمغناطيس.
أول شخص أصبح صديقها هو نبيل القط، ثم عبد المنعم الباز، ثم عبد الحكم سليمان وعبد الحفيظ سليمان. كانوا جميعاً طلبة فى كلية الطب. تعرّفت إيمان على هالة إسماعيل فى ندوة لمناصرة الشعب الفلسطينى، انضمت لجمعية «بنت الأرض»، وقرأت مع أعضائها الكثير من الكتابات عن حقوق المرأة والنسويّة. ثم جاء الشخص الأكثر أهمية، محمد المخزنجي، الذى غيّر مسارها من فتاة تائهة بين السياسة والأدب والنسويّة، وجعلها تقرر أن تكون كاتبة. كتبت عنه فى نص «أيّام المنصورة» عن القراءات التى عرفها عليها، وكيف وقعت فى غرامه، غرام من طرف واحد.
تعود إيمان مجدداً للحديث عن الحظ فى حياتها، الحظ باهظ الثمن الذى أبعدها عن صديقة طفولتها: «كانت زميلتى وصديقتى فى ابتدائى طفلة اسمها لطيفة. لم تكن أقل ذكاء أو اهتماماً بالقراءة منى. كنت أمنحها كتبى فتقرأها بلهفة. تأثير تلك الكتب عصف بنا سوياً. ظلت صديقتى حتى بلغتُ الثالثة عشرة من عمرى. مات والدا لطيفة فى نفس السنة. لم يكن أمامها سوى الرضى بالحياة مع أخيها وزوجته، وأخبرها ذلك الأخ أن آخرها الدبلوم والزواج والقعاد فى البيت».
انقطعت الصلة بين لطيفة وإيمان، ومع مرور السنوات كانت صورتها تمر بذهنها فتبتسم، وتتذكر أن ما جمعهما هو حب القراءة، والرغبة فى كتابة الشعر، لكن الحياة منحت الفرصة لواحدة وحجبتها عن الأخرى. فوجئت إيمان ذات يوم برسالة من فتاة على الفيسبوك، تخبرها بأنها ابنة لطيفة، وأنها تدرس الإعلام وتحب القراءة. قررت إيمان فى زيارتها التالية للمنصورة أن تذهب إلى صديقة طفولتها. لطيفة لم تعرف بيتاً غير بيتها ولا شوارع غير شوارع قريتها الصغيرة: «بالتالى لو أنت محظوظ فلا بد أن تقتنع أو تفهم أو تؤمن أو تعترف بأن الحظ لعب دوراً ما معك، وليس اجتهادك فقط، وبالتالى كذلك لا بد أن تقتنع بأن هناك انعدام عدالة بشكل أو بآخر، وليس بالضرورة أننا كنا أبطالاً لمسرحية ما، وإنما كنا موضوعاً لانعدام العدالة. حينما تتحدث عن حياتك تكون أنت بطلها، لكن مجرد القدرة على الحكى، يجعلك تقف مطمئناً، وتنسى أن هناك صدفاً كثيرة ساعدتك على ذلك. لا يوجد شخص لا يمتلك قصة حياة، ومرة أخرى: هذا لا يجعلك بطلاً، وإنما العلاقات مع الأفراد والمجموعات، واختياراتك والصدف التى مررت بها، والعثرات التى تغلبت عليها، أو عطلتك قليلاً، كلها اختبارات تدل على عمق صبرك، لكنها كذلك تؤكد ضرورة أن تقتنع أنك شخص عادى، أو على الأقل: لست بطلاً. أحب استعادة لطيفة صاحبتى دائماً. كانت تحب الأفلام جداً، وبالصدفة كان جارهم يمتلك تلفزيوناً فى وقت كان كثير من الأُسر لا يمتلك تلك الرفاهية. تذهب إليهم لتشاهد فيلماً يعرضه التلفزيون، ثم تحكى لى بحماس ما شاهدته، ولا تترك بيتنا سوى بعد أن تشاهد معنا فيلماً جديداً. تذهب لتحكيه لأخريات فى قريتنا. كان الموسم المفضل لها هو موسم العيد، إذ يعرض التلفزيون مجموعة من الأفلام المحببة وربما الجديدة، وأعتبر أن لطيفة هى نموذج للإمكانية المهدرة. كانت تملك ما يمكن تقديمه للعالم، وكان من حقها أن تختار، لكن الحياة وضعت حائطاً أمامها».
قصيدة فى هجاء عيد الأم
كيف بدأ الشعر؟ هناك صعوبة فى تذكر المرة الأولى، لكن إيمان تسرد حكاية دالة جرت وهى فى الصف الخامس الابتدائى. أخبروها أن المدرسة ستقيم احتفالاً بعيد الأم، وكان الاحتفال ذكرى مبهجة للجميع، المدرسين، والتلاميذ، والأهالى الذين يستمعون إلى حكايات أبنائهم عن تفاصيل ذلك اليوم، لكن الأمر كان بالنسبة لإيمان مختلفاً قليلاً. اختاروها لتلقى قصيدة، وهى كتبت قصيدة خصيصاً للمناسبة، أو بشكل أدق – يا للدهشة – ضد المناسبة. كتبت إيمان فى سطرها الأول ما معناه: لماذا تتركنا أمهاتنا؟ والقصيدة - بشكل عام - تتحدث عن مأساة عيد الأم بالنسبة لكثير من الأولاد والبنات اليتامى، وأنه مناسبة قاسية. تحولت إيمان خلال هذا اليوم والأيام التى تلتها إلى نجمة يشير إليها الجميع. كان هناك عدد من الأمهات والآباء يقفون فى الجرن ويستمعون إليها من خلال مكبر الصوت، وبدت لهم مختلفة ومدهشة وعجيبة. أبوها أبدى استغرابه الشديد وسألها ضاحكاً ومتحمساً: «انتى جبتى الكلام ده منين؟!» كما مالت صديقتها جيهان جودة على أذنها هامسة: «كان نفسى اقول الكلام ده من زمان بس معرفتش»، وأدركت إيمان أنها كتبت شيئاً أثر - على الأقل - فى صديقتها اليتيمة: «تعلمتُ أن الكلمات قد تنير عتمة شخص ما، أو تلمسه، وما زال ذلك اكتشافاً مدهشاً بالنسبة لى».
كتبت إيمان كثيراً، وتراكمت لديها قصائد، ومع هذا لم تفكر أنها أنهت ديواناً، وإنما تعاملت مع نفسها باعتبارها «شخصاً يكتب»، ووجدت من يشجعها على إصدار ديوان. كانت معلمة الفرنسية فى مدرستها سميرة البغدادى تحب الشعر جداً، لكنها على ما يبدو تحب الشعر الردىء، وأحضرت لها عدداً من الدواوين التى كان يمكن أن تتسبب فى هجرتها للشعر والأدب مبكراً، لكنها للأمانة دلتها على أسماء شعراء مهمين مثل محمود درويش، فاشترت ما توفر من أعماله.
وكبر الموضوع فى دماغ إيمان، لدرجة أنها اصطحبت زميلتها أمل الشاعر إلى الأستاذ فودة رئيس مجلس محلى دكرنس، وقالت له: «عايزين شقة عشان نعمل فيها جمعية أدبية للمرأة»، وظهرت الصدمة على وجه الموظف القديم من ذلك الطلب الجرىء من فتاة فى الثانوية، لم يطردهما وإنما تهرَّب بطريقة لطيفة، إذ طلب إمهاله وقتاً، ورفض مقابلتهما بعد ذلك. وفكرت إيمان مع زميلاتها من هواة الكتابة أن الجمعية لا يجب أن تكون للشاعرات فقط، لكن يمكنها أن تضم الأولاد كذلك، فشاركن فى إصدار مجلات ماستر، مثل «الزهراء» و«الحصاد». جمعت إيمان قصائدها على آلة كاتبة عند صاحب مكتبة «النجاح»، وفاجأها ذات مرة أنه معجب هو وبعض زبائنه بتلك القصائد، وعرض عليها أن يصدر لها ديواناً، مؤكداً أنه سيتكفل بكل شىء، وسيمنحها نصف سعر النسخ المبيعة. كان الأمر بدائياً طبعاً، لكنها قصة شديدة الإدهاش. إيمان وافقت وفى ذهنها أن هناك من سيقرأ لها. أحضرت كراسة وكتبت فيها القصائد بخط واضح وجميل، ومنحتها للرجل الذى كانت تراه بسبب فارق السن كهلاً، مع أنه فى مقتبل الشباب. نقل القصائد على الآلة الكاتبة، وكان يضع الكربون بين الأوراق ليحصل على عدة نسخ، ثم يرتب القصائد ويشبكها بدبوس، وهكذا صار لإيمان ديوان أول لا يعرف عنه أحد شيئاً حتى الآن. بيعت منه عشر نسخ أو أكثر بنسخة أو اثنتين. كانت تذهب إلى المكتبة فيخبرها الرجل بالمبيعات، ثم منحها ثلاثة جنيهات كاملة مقابل النشر، وكان هذا أول مال تربحه إيمان من الكتابة، ومن الشعر.
اختفى الديوان، وأصبح فى حكم الضائع منذ عام 90، عبد الحكم سليمان وجده فى صندوق مع مجموعة من مجلات الحائط، التى كانت تشارك فيها إيمان بقوة كشاعرة ومحررة صحفية. فى فترة مجلتى «الحصاد» و«الزهراء» كان هناك رسام اسمه محمد النادى يرسم تخطيطات مصاحبة للقصائد. كتبت إيمان قصيدة «غروبى» فرسم فتاة تبكى وفى خلفيتها مشهد للغروب: «أبى كان متحمساً للتجربة، وشجعنى باستمرار. أثناء إعدادنا لعدد من الحصاد جاء الأولاد إلى بيتنا فعزمهم على شاى وفاكهة».
كسر وصاية الخال
الجامعة لم تكن مجرد أفكار تنفتح عليها وأشخاص تتعرف عليهم وتدخل معهم فى علاقات. الجامعة كانت هى المدينة، والمدينة هى الحرية. وهذا لا يعنى أن إيمان كانت موضوعة تحت الإقامة الجبرية فى «ميت عدلان»، لكن الحركة هناك كانت بحساب، وفى مساحات ضيقة، من بيت إلى بيت ومن شارع إلى شارع، ثم إن وجوه الناس المعروفة من الأهل والأقرباء والجيران كانت تمنحها إحساساً بأنها تعيش فى بيت واحد، لكن فى المنصورة كانت تعيش فى شقة بمفردها، صحيح تحت وصاية خال وخالة يسكنان فى نفس العمارة، لكنها استطاعت أن تحصل على هامش حرية. أن تسير فى شوارع لا يعرفها أحد. كانت متعتها فى التمشية، وفى الحلم، وفى ممارسة ألاعيب صغيرة لكسر الوصاية. تلقف حجراً أو طوبة من الأرض وتلقيها باتجاه نافذة ابنة الخال، فتفتح لها الباب إن تأخرت: «المدينة كانت الأكبر تأثيراً فىّ، ليس أقل من القراءات. أحببت المدينة طوال عمرى، وشعرت بالاختناق دائماً فى القرية، إذ أن العالم فيها والعلاقات محددة سلفاً، لم أشعر فيها بأى نوع من الأمان، بعكس المدينة، كل شىء فيها مُلهِم تماماً، التمشية أو اكتشاف أماكن جديدة بالصدفة، وكذلك الشعور بالأمان، وبأنك تمتلك خطوتك القادمة».
ربما تفسر هذه النظرة سخرية إيمان الدائمة من أغراض الشعر، إن جاز التعبير، عن قسوة المدينة ووحشيتها، وضحكها على رثائيات الريف والطبيعة. فى شهادتها «أيام المنصورة» كتبت إيمان عن صراعات وحروب صغيرة خاضتها مع الأشباه والأنداد والمختلفين. كان لديها مثل أغلب زملائها وأصدقائها فى هذا التوقيت، وربما لحداثة سنها وخبرتها بالحياة إحساس بأنها ستغير العالم، بفكرة، أو بقصيدة، أو بمجلة. المنصورة كما تحكى كانت ثرية، ولو أنك فكرت جيداً فى أن مدينة مثلها كانت فيها جمعية نسوية مثل «بنت الأرض» فهذا أمر كبير. تحكى: «تعلمت من فترة الجامعة أن الحوار الأيديولوجى مع أشخاص يقفون على أرضية أخرى غير أرضيتك لا يمكن أن يساعدك على تطوير أفكارك، وإنما يثبتها، أفكارك لها منطق ما، وأنت إن ذهبت إلى الإسلاميين مثلاً لتناقشهم فسوف تصبح علمانيتك أكثر منطقية وثباتاً. هذه خبرة أثرت فىّ كثيراً فى التسعينيات، لم أكن أدافع عن قصيدة النثر، ورأيت الصراع حولها صراعاً على الهواء، كنت مهتمة أكثر بما أكتبه، وإن كان له معنى أم لا».
كانت إيمان تدخل فى نقاشات سياسية مع بعض زملائها، وكانت تتخيل أن ذلك أمر جيد فى وقتها، لكن نظرتها تغيرت الآن. لو كانت مهتمة بالسياسة لربما كان النقاش مقبولاً، لكنها كاتبة، وهم مناضلون، أو أشباه مناضلين، ولا توجد أرضية للحوار: «بالعكس هذا الحوار يسحلك، ويؤجل قلقك تجاه قناعاتك، ولا يطور وعيك، ولا يحولك إلى شخص أكثر انفتاحاً واستنارة كما تظن». كان لإيمان صديقة اسمها مسعدة فى فترة الجامعة، وهى شقيقة لثلاثة أطباء، عياداتهم تقع فى برج طلخا، وكانت تسكن مع شقيقها الرابع وهو طالب فى رابعة طب. بعض أشقائها هؤلاء كانوا ينتمون إلى الجماعات الإسلامية، وأختهم مسعدة منتقبة، ومع هذا كانت أقرب الناس إلى إيمان فى تذوق الأدب. أقرب حتى من أعضاء جمعية «بنت الأرض».
خصلة من شعر الأم لعروسة إيمان
لا تنسى إيمان كثيراً من مشاهد طفولتها. أبوها أحضر ذات يوم ثلاجة. كان حدثاً مهماً وسعيداً، بعد دخول الكهرباء مباشرة إلى ميت عدلان، ليس لأهل البيت فقط ولكن للجيران. طرقوا باب السيد مرسال، خلال رمضان، فى عز الحر، فى مشهد يومى متكرر، وهم يحملون زجاجات المياه ويطلبون وضعها فى الثلاجة، ويعودون قبل المغرب ليأخذوها. لم يكن أهل إيمان يمتلكون كثيراً من الأشياء فى هذا الوقت مثل أغلب البيوت المصرية. تفاجئك إيمان بتفاصيل مدهشة أثناء الحديث، وهى فى الأغلب تقفز من المناطق المعتمة فى ذاكرتها فجأة بينما تستدعى كثيراً من مشاهد الطفولة. كانت تمتلك مثلاً «براية» صغيرة لم تتخلص منها أبداً، واصطحبتها معها حين ذهبت لتستقر فى القاهرة، لا لأنها غالية الثمن مثلاً، ولا لأنها أنتيكة، أو هدية من شخص عزيز، لكن إيمان مثلها مثل أبناء جيلها تعرف قيمة الأشياء الصغيرة، فى وقت لم يكن الجميع يمتلكون أشياء كبيرة، أو ثروات ضخمة. كان الاحتفاظ بالأشياء البسيطة مهما بدت عادية أمراً طبيعياً وإنسانياً، وتجربة الأمومة جعلت إيمان ترى الفارق الشاسع بين ما كان متاحاً لها، وما هو متاح لابنيها مراد ويوسف. الكتب والألعاب بالمئات. تضحك إيمان حينما تتذكر قصة أخرى تتعلق بعروسة صنعتها لها أمها. عروسة فى غاية الجمال اجتهدت الأم لتجعلها مقنعة بالنسبة لطفلتها إيمان، وكانت عيناها من الترتر الأخضر، أما أغلى شىء فى هذه العروسة فكان خصلة من شعر الأم.
تعود إيمان إلى اللحظة التى ألقت فيها قصيدتها عن الأمومة أمام الطلبة والمدرسين. كانت تكرر كلمة «ضد الأمومة» كل سطرين أو ثلاثة تقريباً، لكن هذا لم يستوقف مدرس اللغة العربية، محب الشعر الأستاذ محمود عبد الرحمن، وإنما استوقفه شىء آخر. ناداها فى اليوم التالى وقرأ عليها أبياتاً لشاعر يحبه، بصوته الجميل. ربما: على محمود طه، أو أحمد شوقى، ثم توقف وأخبرها أنه أنصت إليها بإعجاب، وأنها ستكون شاعرة عظيمة فى المستقبل، مثل ذلك الشاعر الذى قرأ أبياته للتو، لكن الشاعر لا يصح أن يخطئ فى اللغة العربية أو يكون غير عارفٍ بها، ثم طلب منها إضافة نون النسوة إلى كل الكلمات التى تحتاجها فى قصيدتها. شكرته إيمان، وعادت إلى البيت. صححت القصيدة، ثم بدأت فى قراءتها بصوت عال، ولم تعجبها، خاصة مع تكرار نطقها لأفعال نون النسوة. شعرت أنها أضافت جرس عصافير إلى قصيدتها، وفكرت كثيراً، واكتشفت أن هناك حلاً آخر، أن تعيد كتابة القصيدة بالكامل لتتلافى أفعال نون النسوة، وكانت هذه اللحظة من أعظم الاكتشافات فى علاقتها بالشعر، ليس فى علاقتها بما تقول، وإنما بالطريقة التى تقوله بها: «كان أول درس فى كتابة الشعر على الإطلاق، فقد وضعتنى التجربة وجهاً لوجه مع القيود، وكيف أصل إلى الصوت الخاص، وسواء كان هذا فى خامسة ابتدائى، أو بعد خمسين عاماً فالتفاوض يظل موجوداً دائماً مع القصيدة».
كتبت إيمان فى فترة ثانوى قصائد فيها «جزء شخصى»، تفاصيل عن نفسها، وعن حياتها، وعائلتها، لكن الناس حولها اعتبروا ذلك عيباً، مفهومهم للقصيدة أنها يجب أن تكون غيرية، وتكررت النصيحة على مسامعها دائماً: «اكتبى قصائد بعيدة عنك، اكتبى عن الوطن»، لكنها استمدت فهمها للقصيدة من صلاح عبد الصبور، مهما تحدثت عن العالم، ومهما كتبت عن الحياة وعلاقاتها وقضاياها فإنها تمسك بشىء شخصى أو تنطلق منه مثلما كان يفعل. لم تفهم أبداً ذلك الشعر الذى يخاطب غرائز الجمهور، شعر الحماسة والتصفيق. كان هناك شاعر موهوب جداً من دكرنس اسمه أحمد الخضرى، فى فترة الجامعة، كتب قصيدة جماهيرية لم يقرأها إلا فى المناسبات الضخمة وأمام الحشود الغفيرة. يقرأ والناس يستمعون حتى يصل إلى اللحظة التى ينتظرها هو، وينتظرونها هم، لحظة أن يقول رافعاً صوته: «إن الجنود إذا دخلوا قرية أفسدوها»، فترتج القاعة بهيستريا التصفيق الحماسى. يصمت الشاعر مستمتعاً بوصوله إلى ذروة الأداء. كان الخضرى شخصاً بالغ الرقة والرهافة. قالت له إيمان ذات يوم وهما يتناقشان حول الشعر فى حضور زميلهما محمد عبد الوهاب السعيد: «هتبقى شاعر أفضل لو بطلت تقول إن الجنود إذا دخلوا قرية أفسدوها»، كانت فى الصف الثانى بالجامعة، وانقطعت العلاقة بعد التخرج. مات الخضرى ميتة الفقراء، بمضاعفات التهاب الكبد الوبائى. لم تكن الفكرة التى تحاول إيمان نقلها إليه واضحة، حتى بالنسبة لها.
تتذكر جيداً علاقتها الإنسانية بالخضرى، وتصفه بأنه «مود على بعضه» كما تصف مدينته دكرنس بأنها مثل كثير من المدن الريفية تجد فيها مساوئ القرية والمدينة. أجمل مكان فيها كان الكنيسة، التى تحيط بها أشجار وزهور حمراء، لكن دكرنس «قد تكون الصورة البصرية للقبح الخاص بالحداثة المصرية، الريف المتمدن». ومع ذلك فهى كانت مثل كل المدن الصغيرة مركز استوديو التصوير، الذى تذهب إليه العائلات، سواء قبل التقديم للمدارس والجامعات والجهات الحكومية، أو فى الأعياد، والمناسبات المختلفة، وفيها كذلك مدرسة على مبارك للبنين، وأطباء مشهورون، ومستشفى يذهب إليها الناس من ميت عدلان والقرى المجاورة ليموتوا فيها.
على مشارف ملامسة السحاب
كثير من المشاهد الجميلة القديمة فى ذهن إيمان ترتبط بحالة جماعية. فى ميت عدلان كان أبوها يحملها على كتفيه ويسير بها حتى الساحة، فتشعر أن رأسها على مشارف ملامسة السحاب، كان الجميع يذهب إلى هناك، لمشاهدة الأفلام المعروضة على ملاءة بيضاء معلقة إلى حائط، أو للاستماع إلى المنشدين وحكايات مثل «ناعسة وأيوب» فى الأفراح والموالد: «حينما يأتى النقاش عن دور وزارة الثقافة أقول ببساطة ليس مطلوباً منها نشر كتاب، وإنما شراء الكتب وإنشاء المكتبات فى القرى، جيلى حضر آخر مظاهر الصناعة الثقيلة للوزارة. أتذكر مثلاً فتاة من العائلة كانت تذهب إلى قصر ثقافة المنصورة لتتعلم الرسم. الآن صارت جدة. كانت هناك مشاريع مجانية رائعة لأولاد الفقراء، وبالتالى ليس بالضرورة أن يكون من ضمن وظائف الوزارة تبنّى مشروع إيديولوجى، لكن عليها أن تمنح الناس فرصة ليتعرفوا على الأدب والفنون».
هاجرت إيمان إلى كندا، وهى تتعامل فى الجامعة باللغة الإنجليزية وتكتب بها بعض الأبحاث والدراسات، لكنها فيما يتعلق بالأدب لم تغادر ثقافتها: «الكاتب ابن لغته أكثر من أى شىء آخر، ولهذا السبب هناك أشخاص هاجروا من بلدانهم إلى أماكن أخرى، منذ عشرين عاماً وأكثر، وما زال عندهم نوع من التواصل والمتابعة مع ثقافة بلدهم. هناك كتَّاب يقررون منذ البداية الكتابة بلغة أخرى، وهذا موجود بشكل كبير فى أمريكا وكندا، على الأقل فى نطاق خبرتى. الكاتب منهم يترك بلده وهو فى سن عشرين إلى ثلاثين عاماً، ثم يسأل نفسه: لمن أكتب فى هذا البلد الجديد؟ فيبدأ الكتابة بالإنجليزية أو الفرنسية مثلاً فى شرق كندا، ويشارك فى ورش كتابة ويحتك بمراجعين ومحررين يحسِّنون من لغته وأدائه. بعضهم يكتب لغة رائعة وبعضهم لغته سيئة للغاية، لكن الأمر يشبه الصناعة فى أمريكا وكندا، إذ أن هناك تشجيعاً على الكتابة بلغتهما، لكن الكتَّاب الذين لم يسلكوا هذا الطريق قد يكون قرارهم واعياً كذلك. أسئلتهم وطموحهم يخص لغتهم وثقافتهم الأم».
بحسب إيمان الكتابة بلغتك الأم لا تعنى أنك لست متورطاً فى ثقافات أخرى: «أنا بنت الثقافة العربية، كل تطور يحدث لى، أو أسئلة أو هواجس يتم من خلالها. الصلة موجودة طوال الوقت معها، ولو افترضنا أننى لن أزور مصر إلا كل عشر سنوات سيظل اتصالى باللغة موجوداً. أنا أحد المشاركين فى إنتاج الثقافة المكتوبة بها، وهذا ليست له علاقة بوجودى فى مكان آخر. فى النهاية كتابى يصدر باللغة العربية».
وتضيف: «سؤالى عن كتابتى له علاقة بى كفرد، لكن الفرد نتاج ثقافات كثيرة، حتى لو كان يعيش فى بلد لم يغادره أبداً. أستمتع بأى شعر جيد فى الدنيا، لأن الشعر الجيد نادر. هناك أشخاص مولودون فى مصر يتحدثون اللغة الفرنسية فى البيت، والإنجليزية فى المدرسة. وعيى تكوَّن فى العربية، ونشرت ثلاثة دواوين قبل أن أغادر مصر، لم أطرح على نفسى أبداً فكرة أن أكتب شعراً بلغة أخرى».
لم تشعر إيمان أبداً بأن كتابتها ظُلمت، حتى عندما كانت تسمع فى التسعينيات أن ما تكتبه ليس شعراً: «عندى ثقة فى وجود قارئ ما، فى مكان ما، تعنى له كتابتى شيئاً. عندى أيضاً ثقة فى التعدد الذى تتسع له الثقافة العربية الآن، رغم كل أمراضها الأزلية. ربما هناك مشاكل تستحق النقاش، كالوصاية على النوع الأدبى. منذ مائة سنة ونحن نناقش قصيدة النثر، وهل هى شعر أم ماذا؟ مع أن الحوار كان سيصبح حقيقياً إن انطلق من داخل القصائد نفسها، والآن نناقش «الننفكشن»، وهل هو أدب أم لا؟ هناك فكرة المظلومية كذلك، عمرى ما فهمتها، وهى فكرة غامضة جداً بالنسبة لى. لماذا؟ لأن الكتابة اختيار، وهى أيضاً مكافأة فى حد ذاتها. أنت تطور نفسك وتتصل بالعالم وتحاول فهمه من خلال اللغة».
الأصل فى التعدد
حينما تنظر إيمان للكتابة المصرية حالياً ترى تعدداً، لم يكن موجوداً منذ عشرين عاماً، حتى وإن كان نصف ما تقرأه أو أكثر لا يعجبها: «يجب أن نقبل بالتعدد، التعدد هو المنقذ. أنا ضد أن تكون هناك قصيدة نثر واحدة. رواية واحدة، قصة واحدة، أنا مع التنوع، إتاحة المجال للكتب غير الخاضعة للتصنيف (الننفشكن). ولا يهم أن تكون كل الأعمال بذات الجودة، المهم أن يكون هناك تعدد بدون وصاية، من قال إننا الأكثر وعياً حتى نقوم بدور الحكم والتقييم؟».
ترى إيمان بهذا المعنى أن المجال ينبغى أن يكون مفتوحاً طوال الوقت للتجريب، ولوجود الأصوات المختلفة، وعندما تسألها عن الكتّاب الذين تحبهم يقفز إلى ذهنها عدد محدود من الأسماء، دون غيرهم، ليس لأنهم أصحاب ذائقة واحدة أو يكتبون بنفس الشكل الذى تفضله، لكن لأن كل فرد فيهم لا يشبه الآخر وله بصمته الخاصة «آخر شاعر تفعيلة كبير بالنسبة لى على الإطلاق هو الشاعر اليمنى عبد الله البردونى، لماذا؟ لأن شعر التفعيلة بعده فيه اجترار لكل ما كُتب فى هذا النوع على مدار عقود طويلة، لكن ربما يظهر شاعر تفعيلة فذ، ولا أستطيع المصادرة على المستقبل. أقرأ أحياناً قصائد نثر على الفيسبوك وبعضها لا يترك انطباعاً فى ذهنى، أو بشكل أدق يترك انطباعاً سيئاً، ذلك أنها إعادة إنتاج لوصفة يتم تعميمها، وهى لا تختلف فى ذلك عن إعادة الإنتاج فى الشعر العمودى أو الشعر الحر، أو أى نوع أدبى آخر: «أنا لست مهتمة بالدفاع عن قصيدة النثر. لا يوجد دكان أصلاً، ولا أنا صاحبته».
فى عام 95 نشرت «أخبار الأدب» حواراً أجراه محمود الوردانى مع إيمان مرسال، وأصابت أراؤها الحياة الثقافية المستقرة بالغضب. كان كل جيتو راضياً بما يحققه وبما يدعو له فجاءت إيمان وألقت على الجميع قنبلة مسامير. كان الشعراء الجدد يصكون مصطلح اليومى والعابر وشعرية التفاصيل فخرجت عليهم لتقول إن «التفاصيل ليست تقنية ولا اختياراً أبدياً فى الكتابة» وإن هناك «قصائد مليئة بالتفاصيل الميتة، العمومية، ليس لها رائحة خاصة، بانوراما مجانية وكوميدية من ذات عامة، ذات ليس لديها القدرة على رؤية الحياة عبر تفاصيلها، بل لديها منظومات متماسكة من الأفكار والتصورات، لا يعاد اختبارها، ولا يُشك فيها، مع ذلك تملأ نصها بتفاصيل كثيرة كبرهان على حداثة تعيسة ومضحكة. هناك كتابة، وهناك كتابة تنتحل مكاناً رائجاً ليس مكانها الحقيقى»، و«من يرد أن يختبر ذلك فليقرأ مجموعة النصوص الجديدة، وهو يبحث عن الاختلاف بينها لا عن وجوه الشبه الظاهرية، فسلة الشعر ممتلئة بالمتعدد لا بالمتشابه».
تتذكر إيمان هذه التفاصيل والمعركة التى اندلعت وقتها، ودفعت كتَّاباً لم تقصدهم بكلامها إلى مهاجمتها. إذا قرأت كلام إيمان الآن لن ترى فيه تجنياً، لكنه بدا آنذاك جارحاً بالنسبة لشعراء اعتقدوا أنهم أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. تقول على سبيل الضحك: «الناس اتخانقوا فى البارات تقريباً ساعتها»، ثم تقول بجدية: «مر أكثر من ربع قرن وما زالت قصيدة النثر الجيدة توصف بأنها تهتم باليومى والعابر والتفاصيل، كأنه لم يحدث تطور للأفكار والقناعات. لم تحدث مراجعات، أو مقارنات مع ما يُكتب حولنا فى العالم. يكتب مجموعة من الشباب الصغار فى بداية التسعينيات قصيدة نثر فيؤيدها البعض ويمدحونها بأنها تهتم بالتفاصيل، ويرفضها آخرون لأنها ضد أخلاق الشعر العربى العظيم. أن تستمر هذه الخطابات إلى الآن فهذه كارثة».
الشعراء فى بلادى
يعانى الشعراء أصحاب التجربة المهمة من اختزالهم فى مجموعة عبارات، بحسب إيمان مرسال، كما حدث مع صلاح عبد الصبور، منذ ديوانه «الناس فى بلادى»، كأن هذه العبارات هى كل تجربته: «صلاح عبد الصبور نفسه تطور وأصبح يمتلك حساً وجودياً، وملامح جديدة لا تشبه ملامحه الأولى. هو فريد فى الشعر العربى الحديث. عنده بصيرة مكَّنته من كتابة لحظات إنسانية عابرة».
وكما قصر النقد الأدبى شعر صلاح عبد الصبور على «الناس فى بلادى» لم يتجاوز ذلك النقد فى قراءاته لقصيدة النثر العربية الاحتفاء بتيمات العادى واليومى والتفاصيل: «عندما كتب طارق إمام مقالاً عن ديوانى «حتى أتخلى عن فكرة البيوت»، فرحت به بشكل خاص، مع أن مقالات كثيرة كُتبت حول هذا الديوان ودواوين أخرى. ميزة هذا المقال أنه ينير لك مناطق لم تنتبه إليها. كتابة ممتعة تحاول أن تضع يدها على مصادر الشعر، من أين يأتى، وما ملامحه. كتابة لا تحتفى بالكليشيهات، وتجعل لديك أملاً ما فى النقد. وقد قرأت لطارق مقالات أخرى عن دواوين هامة، وشعرت ببصيرته فى القراءة. كتابته عن أحمد يمانى مثلاً فى منتهى الجمال».
عندما سألت إيمان عن تأثير الاحتكاك بثقافات أخرى عليها قالت: «لا توجد ضمانة بالنسبة لى على شىء. رأيت كثيراً من الكتّاب يعيشون فى مجتمعات أخرى، وينغمسون فى ثقافات غير ثقافتهم الأم، ومع هذا لم يحدث لهم شىء. تخيُّل أن مجرد العيش داخل ثقافة أخرى من شأنه تغيير الفرد هو توقع رومانتيكى».
انتقل الحديث إلى سؤال عن صورة الكاتب التى لم تتطور كثيراً، فقالت: «هناك صورة مستقرة للكاتب الثورى المناضل ضد الاحتلال والديكتاتوريات والفساد. هناك صورة للكاتب المعتزل، لدرجة أن يوصف كاتبٌ بالتميز لأنه لا يملك حساباً على الفيسبوك، أو أنه متعال ولا يخرج من بيته. أشياء عجيبة حقاً!».
وتضيف: «صورة الكاتب أمر قاتل. عندى تصور أنها قديمة، بدأت مع رحلة رفاعة الطهطاوى إلى فرنسا فى كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز». أصبح للكاتب العربى بعدها سلطة رمزية، فهو من يذهب للغرب، حين كان هذا الغرب هو مصدر الحداثة. يذهب ويرى ويحكم، وبالتالى فهو القادر على السفر والمعرفة والانتقاء من حداثة الغرب. ثم تراكمت سلطة المثقف من وقوفه فى وجه الاحتلال. أصبح صوت الشعب، كما أصبح صوت الطبقة المطحونة فى الصراع مع الإقطاع. ظل الكاتب لأكثر من قرن ونصف صوتاً لآخرين ونافذة على الأمل، لكنه فى هذه اللحظة التاريخية لا يقوم بهذا الدور، ولذلك أنا أسأل نفسى: لماذا يحتفظ المثقف بهذه الصورة؟ بأمارة إيه؟! أنت لست لويس عوض، أو طه حسين، أو يعقوب صنوع. أنت لا تقوم بأدوارهم، نحن جميعاً ليس لنا دور، وفى هذه الحالة فإن هذه الصورة تُعطِّل شيئاً صادقاً، فهى على الأقل تحجب وجهاً حقيقياً لمصلحةِ وجهٍ مصنوع، كما أنها تُعطِّل الشخص عن ممارسة حياته بشكل بسيط».
بالنسبة لإيمان فإن ديوان «أماكن خاطئة» نقلة فى الشعر العربى «لو فيه ناس بيفهموا» وهو بتعبيرها «لا يقل جمالاً عن أجمل دواوين العالم» وهو «المستر بيس» الخاص بيمانى. تقول إن هناك «خط إنتاج لشعر حلو» تستمتع به طوال الوقت، لكنك يجب أن تبحث عنه فى ركام يصل إلى آلاف القصائد المكتوبة وفق «وصفة قصيدة النثر». تضيف: «أنا أحب الشعراء الذين يتطورون باستمرار. ستجد فى بداياتهم شيئاً قوياً للغاية، مع أن فيها شيئاً نيئاً كذلك، لكن أصحابها مثل أسامة الدناصوري وعلاء خالد وعماد أبو صالح وأحمد يماني، وفاطمة قنديل، وياسر عبد اللطيف، وهدى حسين، بنوا على هذه البدايات، ووصلوا إلى حالات شعرية فريدة». تعود مرة أخرى إلى يمانى: «أنا أحب تجربته لأنها تتطور باستمرار، حتى لو كتب قصائد غنائية. يمانى لا يكترث، ليست لديه وصفة. فتح أبواباً فى الكتابة». إيمان حينما تتحدث عن تجربتها هى نفسها فإنها تستدعى كلامها ضد الوصفة فى الشعر: «مثلاً فى ديوان «حتى أتخلى عن فكرة البيوت» كنت أريد التحرر من كل شىء، حتى من صوتى نفسه، لدرجة اللعب مع شكل المقالة أحياناً، والحوارية الكاملة، وأن يكون هناك انتباه فى بناء القصيدة. كانت مجازفة. البقاء فى المناطق الآمنة يجعل الحياة نفسها مملة».
شعر وبسطرمة فى شارع 26 يوليو
لم تشعر إيمان بالثقة فى شعرها إلا مرة واحدة، كان ذلك فى نهايات عام 89.
أوقفت شخصاً فى شارع 26 يوليو وسألته عن مكان دار «الغد»، فأشار إلى المبنى المواجه لسينما على بابا. كانت أفيشات الأفلام الثلاثة المعروضة «مناظر»، ورأت دكاناً صغيراً إلى جوارها لم تنسه أبداً، وفوقه لافتة مكتوب عليها «مستشفى الحيوان». اجتازت المدخل وصعدت على قدميها حتى الدور الثالث، ووجدت باب الدار مفتوحاً. رأت طاولة ضخمة، مليئة بالكراكيب والقصاصات والأوراق والأقلام ولوازم الطباعة، والدوسيهات، وآلة كاتبة، وثلاثة رجال. كهلان هما كمال عبد الحليم، وعبد المنعم سعودى، ومساعدهما الشاب، يجلسون حول الطاولة لتناول جبنة وبسطرمة. كان لديها تصور - وهى تقف فى مواجهة الثلاثة الذين بدأوا يتفحصونها - أن أى دار نشر كبيرة فى العالم ستعتبر ديوانها الأول «اتصافات» لًقطة. وضعت الديوان «كراسة صغيرة» أمامهم وتركته – مع أنها لا تملك نسخة ثانية منه - عائدة إلى بيت معيدات جامعة القاهرة فى شارع المساحة بالدقى حيث تسكن. انتظرت أياماً قبل أن يتصل بها عبد المنعم سعودى ليخبرها بأن الديوان أعجبهم وسيصدرونه قريباً، وقد صدر بالفعل فى 30 يناير 1990: «هذه الثقة فيها حاجة بريئة وساذجة، كلما زادت معرفتك بالشعر وطموحك فيه قلت ثقتك فى القدرة على تحقيق حلمك. البراءة والسذاجة يخلقان ثقة غير عادية، لكنك بعد ذلك تحفر فى منطقة صغيرة، ويصبح طموحك مختلفاً، تبحث عن الشعر دون أن يكون لديك قناعة بأنك وجدته. يحل القلق مكان الثقة، وكلما أنهيت ديواناً يحتلك الفراغ والخواء».
ترى إيمان أن هويتها كشاعرة ظهرت فى ديوانها «ممر معتم يصلح لتعلم الرقص»: «كان بلورة لقصيدتى ولى ككاتبة». شعرت بـ«الخضة» من نجاحه الكبير فى هذا التوقيت، وانتابها نفس الشعور - بعدها بعامين - ولكن بشكل عكسى هذه المرة، من عدم نجاح «المشى أطول وقت ممكن». تعلمت أن هذه الأمور تتعلق بشىء قدرى بحت. على الشخص أن يجتهد ولا يرضى بالوقوف عند النقطة المستقرة الساكنة ويطور نفسه، وألا ينتظر شيئاً: «أن ينجح كتاب فهذا شىء رائع، وألا يُقرأُ كتاب فهذا ليس معناه نهاية العالم». تعتقد إيمان أن اللغة فى ديوانها «جغرافيا بديلة» مرتبكة: «كأنى كنت أبحث عبرها عن وضعى الجديد خارج مصر، لكن فى ديوان «حتى أتخلى عن فكرة البيوت» تجاوزت هذا الارتباك. استمتعتُ بحريتى».
بالنسبة لإيمان ما تقدمه الشاعرات المصريات من أجيال أحدث مهم ومتميز وذو حضور كبير: «ليس لدىَّ تفسير؛ ربما أن النساء لا يصلحن كأنبياء، وذلك يحررهن من صوت النبوّة الذى سيطر على الشعر العربى طويلاً. ربما أيضاً، أن أصواتاً مهمة مثل أسماء ياسين أو هدى عمران على سبيل المثال، لسن مشغولات بعالم الذكورة المأزومة ـ وهو الوجه الآخر لصورة النبى ـ التى تسيطر على شعراء مجايلين».
السخرية فى قصيدة إيمان جزء من عالمها. ببساطة لا يوجد فى درج مكتبها علبة سخرية تضيف القليل منها إلى ما تكتبه. تتذكر شاباً من «ميت عدلان» قرأ ديوانها «حتى أتخلى عن فكرة البيوت» ثم سألها: «انتى بتسخرى من القرية بتاعتك؟!». فكرت إيمان فى سؤاله بجدية ووجدت أنها لم تسخر وإنما عكست قصيدتها نوعاً من المرارة والأحزان الخاصة: «حين تحاول التعبير عن هذه الأحزان فإن السخرية هى نبرة الصوت التى تكسر الحس المأساوى وتفتحه أمام محاولة الفهم لا البكاء. هى باب تستطيع أن تدخل منه إلى ما تريد».
علاقة إيمان بالمثقف المصرى التنويرى بشكل عام تلخصها اللحظة المكتوبة فى «جغرافيا بديلة» لكنها استعادة للحظة أخرى وهى أصغر سناً: «حاولت أن أفهم صورة المثقف الكبير التنويرى، الرجل العصامى. صحيح أن بعضهم أثَّر فى حياتك لكن العلاقة معهم كانت مبنية على فكرة الوصاية والأبوية. وأسأل ذلك الشخص الذى يحاول أن يفرض نفسه كأب: انت تعرفنى؟! وللعلم ليس التحرش أو استغلال السلطة أو عدم الاعتراف بالموهبة هى أكبر مشاكل تواجه الكاتبة الشابة فى بلادنا. أنا عانيت من مشاكل أخرى، مثل فرض الوصاية أو الأبوة. أنت تُعجب بكتب الشخص منهم لكن لا تستطيع التواصل معه، لأن وعيه يأتى من منطقة أخرى. هو يتصور أنه يعرفك جيداً، لكن هذا غير حقيقى. كلامى نابع من رفض الأبوة والأمومة التى يمنحها المثقفون الكبار. لا يجب أن نبحث عن آباء أو أمهات أو حتى أبناء. يكفى أن يكون هناك أصدقاء وشركاء فى اللحظة التى نحياها».

الكتابة ليست علاقة زواج
لم تُصدر إيمان سوى خمسة دواوين فى ثلاثين عاماً، فكيف ترى الشعراء غزيرى الإنتاج؟ تقول: «لا أستطيع التحدث عن الشعر الغزير. هناك شعراء غزيرون ورائعون، لكن لا الندرة شرط ولا الغزارة شرط. ما يحدث معى أننى أنشغل بقصائد تمثل تجربة فى كل كتاب. أوجه إلى نفسى السؤال فى كل مرة: هل تستحق تلك القصائد النشر أم لا؟ هناك كذلك أوقات تتعطل فيها، ولذلك لا أعتبر الندرة ميزة أو عيباً. الشعر ليس مهنة ولا وظيفة. الكتابة عموماً ليست علاقة زواج، لا يوجد شىء مقدس. هى علاقة اختيارية، بمعنى أن كل مشروع هو اختيار جديد. الموضوع إنسانى وبسيط، وبعيد عن المبالغات. الكاتب يتعامل مع اللغة كما يتعامل النجار مع أدواته وأخشابه. كل كاتب له طقوسه وإيقاعه وقانونه الداخلى».
أخيراً ما طموح إيمان فى الكتابة؟ تقول: «لا يتعدى طموحى فى هذه اللحظة مراجعة مسودة قصيدة كتبتها منذ فترة، وعدتُ لها أمس. إنها عن القرن التاسع عشر. لا أعرف بعدُ كيف أجد نبرة الصوت داخلها. يبدو أن أقصى طموح الشاعر هو أن يعيش لينهى قصيدة يكتبها».
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
 الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني
الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني