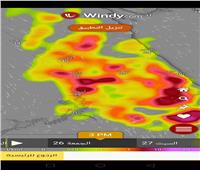الفكرية والثقافية والفنية
شعبان يوسف يكتب : من الذى يدافع عن الثقافة؟
السبت، 27 نوفمبر 2021 - 05:06 م
هناك ظواهر تكاد تكون تاريخية وحادة فى حياتنا الفكرية والثقافية والفنية، فى الماضى والحاضر، فى الأدب والشعر والنقد والفكر والعلوم الاجتماعية والفنون التشكيلية والسمعية والمرئية، ومنذ كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ على عبد الرازق، و «فى الشعر الجاهلى» للدكتور طه حسين، مرورا بكتاب «من هنا نبدأ» لخالد محمد خالد، وصولا إلى كتابات نصر حامد أبوزيد وفرج فودة، وألف ليلة وليلة، ورواية «مسافة فى عقل رجل» لعلاء حامد، ورواية «وليمة لأعشاب البحر» للسورى حيدر حيدر، وبعد ذلك أزمة «الروايات الثلاث» لمحمود حامد وياسر شعبان وتوفيق عبد الرحمن، وصولا إلى رواية «استخدام الحياة» لأحمد ناجى، إلى أغانى المهرجانات، وقضية حجبها ومنع منتجيها من الغناء، ثم مسرحية «المومس الفاضلة» لجان بول سارتر، والتداعيات الساخنة والمتواترة، تشعل الحياة الفنية والثقافية.
فى كل هذه القضايا أو الأزمات، من الذى كان يشغل الفضاء العام بالأسئلة والإجابات، وهل هناك أسئلة حاسمة أو إجابات نهائية فى هذه الأزمات؟ أعتقد أن الإجابات النهائية أو الأسئلة المطروحة، مشروعة أو غير منطقية، تظل مفتوحة طوال الوقت، فلو تأملنا -على سبيل المثال- أزمة رواية «وليمة لأعشاب البحر»، لحيدر حيدر، التى صدرت طبعتها الثانية فى نوفمبر 1999، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، ورغم أن الرواية كانت قد صدرت طبعتها الأولى عام 1983، وتم إعادة نشرها عدة مرات بعد ذلك، وكان النقاد والباحثون يعدونها رواية سياسية بشكل أساسى، إلا أنها فور صدورها فى القاهرة، بدأت التيارات الدينية المتطرفة تثير بضعه أفكار عنها، حتى كتب الدكتور محمد عباس مقالا ناريا وتحريضيا فى جريدة الشعب بتاريخ 28 إبريل 2000، وجاءت المانشتات مثيرة للغاية تحت عناوين شديدة الخطورة مثل: «لا إله إلا الله.. من يبايعنى على الموت.. تبت أيديكم.. لم يبق إلا القرآن..» إلى آخر مثل هذه العناوين والمانشيتات التى تتذرع بالدين لإثارة البلبلة والتوتر المجتمعى الذى حدث.
لم يمر المقال الذى استغرق عدة صفحات فى الجريدة مرور الكرام، بل تلقفته كافة الجماعات المتطرفة، ومن يتبعها، وبالطبع فى مثل هذه الحالات، لا وقت للقراءة والمراجعة والفحص، فكما حدث فى واقعة اغتيال فرج فودة عام 1992، ومحاولة اغتيال نجيب محفوظ عام 1994 القاتل لم يقرأ حرفا لهذين الكاتبين، ولكنه دائما كان يقتفى آثار سيده ومولاه وكفيله بالمعنى الدينى، وهذا ما حدث مع ناشرى رواية «وليمة لأعشاب البحر»، والناشر هنا الدولة نفسها، ومن ثم دخلت الدولة بكافة هيئاتها الثقافية فى الدفاع عن نفسها، وبالطبع جرت مياه كثيرة فى النهر.
كتب ليبراليون وعلمانيون وإسلاميون معتدلون وإسلاميون متطرفون وآخرون، وشغلت القضية الرأى العام بشكل كان فريدا، ولم تكن الجماعات المتطرفة إلا اللاعب الأول بالنار، ولا يشغلها تلك الفتنة التى أثارتها، وتحولت القضية من الساحة الأدبية والدينية والفكرية، إلى الساحة الدينية واللعب على المشاعر العميقة والمتأصلة الدينية لدى الجموع من فئات وطبقات الشعب البسيطة، للدرجة التى تحركت فيها بضعة تجمعات طلابية من جامعة الأزهر، وفى ذلك الوقت كان صوت الشيخ أعلى من صوت الناقد، لكن اتحاد كتاب مصر أصدر بيانا تاريخيا برئاسة الشاعر فاروق شوشة، وكانت الرسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية، ليعرب فيها اتحاد الكتاب عن رفضه «لأية وصاية غير دستورية على عقول المفكرين وأقلامهم، تشل حركة الإبداع، وتسىء لسمعة مصر، وتعوق دورها الثقافى والحضارى الرائد».
وبيان اتحاد الكتاب هنا، لا يعبر عن موقف مبدأئى عام لديه، لأن هذا التحرك الذى أبداه الاتحاد لم يحدث إلا قليلا للغاية، ولكنه فى هذه القضية على وجه الخصوص، كان الموقف إجباريا، خاصة أن المطلوب كان رأس الدولة، ولا بد أن الاتحاد يتخذ موقفا إزاء ما يحدث، ولكن هذا الاتحاد ذاته كان يتنصل من كتاب آخرين مثل علاء حامد وصلاح الدين محسن وسمير غريب على عندما أصدروا روايات نالت هجوما من جماعات التطرف، بل كان بعض أعضاء مجلس إدارته يدينون هؤلاء الكتاب، ولا ننسى مقالات الكاتب الروائى ثروت أباظة الذى كان رئيسا للاتحاد فى التسعينيات، والتى كتبها مهاجما شعراء كتبوا قصائد، وتم تكفيرهم من الجماعات المتطرفة.
وفى ظل التراشق الثقافى والفكرى والمجتمعى الذى أحدثته رواية «وليمة لأعشاب البحر»، أصدر الكاتب نفسه حيدر حيدر بيانا طويلا نقتبس منه هذه الفقرة التى يقول فيها: «فى دعوة المهووس محمد عباس: «لا إله إلا الله من يبايعنى على الموت..»، وعبر شتيمته ونعتى بالفاجر الفاسق الكافر ابن الكافر، لم يرهبنى أو يقلل عزيمتى، لكننى تساءلت بهدوء: هل يبيح الإسلام هذا الانحطاط والتسفيل اللأخلاقى، الإسلام الذى دعا إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر».
كما أن الكاتب إبراهيم أصلان، والذى كان رئيسا لتحرير سلسلة «آفاق عربية»، التى أصدرت الرواية قال فى بيانه: «..ورواية وليمة لأعشاب البحر.. هى واحدة من أهم الروايات العربية على وجه الإطلاق، ليس رأينا، ولكنه رأى استقر عليه الواقع الثقافى العربى، وليس أدل على ذلك من عشرات الطبعات التى صدرت لها فى مختلف البلدان العربية منذ صدورها أول مرة..».
كما أن الناقد السينمائى على أبو شادى، والذى كان رئيسا لمجلس إدارة الهيئة، أصدر بيانا مطولا جاء فيه: «.. الكاتب الروائى فى العمل الإبداعى ليس ملزما بتقديم عظات جمالية أو خطب منبرية، إنما هو يصور جميع طبقات المجتمع فى أوج سموقها أو انحطاطها، كفرها أو إيمانها، وهو فى ذلك إنما يعبر عن واقع الشخصيات نفسها، لا عن رأيه الخاص..».
اخترنا مثالا واضحا أثار جدلا لا شبيه له فى تاريخنا الثقافى والأدبى والفنى فى العقود الخمسة السابقة، وخروج القضية من حيزها الضيق، إلى الجامعة والصحف والبرلمان والحكومة نفسها ممثلة فى وزير الثقافة، لكى نقول بأن المتحدث عن جوهر القضية ليس شخصا بعينه، وليس اتجاها واحدا على وجه الدقة، ولا مؤسسة رسمية فقط، بل شاركت كل الطوائف فى تظاهرة واسعة ومثيرة فى تشكيل المشهد ككل، المتطرف والمعتدل والرسمى وغير الرسمى، وفى هذا المثال بالتحديد، كان المثقفون الطليعيون على وجه الخصوص، مشاركين بقسط واسع فى الدفاع عن الدولة، التى اتخذت موقفا صارما تجاه البلبلة التى أثارتها الأقلام المتطرفة، وأشهد أن كل المسئولين الكبار، وعلى رأسهم فاروق حسنى وزير الثقافة، كانوا على قدم واحدة فى مواجهة تيار الظلام الدامس الذى يريد إغراق البلاد فى رجعيته وتخلفه وحروبه الكارثية.
واقعة أو أزمة «وليمة لأعشاب البحر» تتكرر بأشكال مختلفة، فما حدث مع تلك الرواية، حدث بعد ما لا يزيد على عام، فى واقعة الروايات الثلاث، وكان موقف الدولة قد اتخذ مسارا آخر، إذ تمت الإطاحة برئيس التحرير الذى صدرت عن سلسلته «أصوات أدبية» تلك الروايات، وكان آنذاك الروائى محمد البساطى هو الذى يشغل ذلك الموقع، كما تمت الإطاحة بالناقد السينمائى على أبو شادى من منصبه، ولم تقف الدولة موقفها الثابت، وهذا الأمر يحتاج إلى قدر من التأمل والدراسة ورصد كافة الملابسات التى كانت تحيط بذلك الظرف التاريخى، وفى ظل التصاعد المضطرد الذى كانت تشهده الجماعات المتطرفة، وكانت كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية قد بدأت تنتبه لذلك التصاعد وتخشاه، أكثر من مقاومته، إلا قليلا.
ولا ننسى هنا أزمة قصيدة «شرفة ليلى مراد» للشاعر الراحل حلمى سالم، والتى نُشرت فى مجلة «إبداع» بتاريخ إبريل 2007، وعندما تقدم بعض المتطرفين بشكاوى كيدية إلى الدكتور ناصر الأنصارى بما تحتوى عليه القصيدة -من وجهات نظرهم- على قدر من الخروج الدينى، صادر الدكتور المجلة، والتى كان يرأس تحريرها الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى، وكان يرى هؤلاء الشاكون أن المجلة تسىء للذات الإلهية، بعدها تقدم الشيخ يوسف البدرى الذى كان متخصصا فى مطاردة الكتاب والفنانين ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه القصيدة وشاعرها بالإساءة إلى الذات الإلهية وازدراء الأديان، ويطالب بمعاقبة رئيس التحرير وكاتب القصيدة، وبعدها تحولت كذلك القضية من قضية أدبية إلى قضية دينية بشكل أساسى، وأصبح صوت الناقد الأدبى لا وجود له، والأكثر دقة، لا يستمع إليه أحد من كافة جموع القراء والمتلقين.
الأمثلة جد كثيرة، ولا تتسع تلك المساحة لاستيعابها، ولكننا نصل إلى اللحظة الحالية التى أثيرت فيها الضجة الخاصة بمسرحية «المومس العمياء»، تلك المسرحية التى أشيع أن الفنانة الكبيرة سميحة أيوب سوف تخرجها، وسوف تقوم ببطولتها الفنانة إلهام شاهين، وهنا تقدم أحد البرلمانيين بتقديم طلب إحاطة حول من المسئول عن إجازة تلك المسرحية الإباحية، ومن ثم قامت الدنيا ولم تقعد، وتكلّم كثيرون دون أن يدركوا أى معنى للمسرحية، فالعنوان يوحى ويثير تلك الغرائز العمياء التى تكتفى بالعناوين فقط، دون الدخول فى أى تفاصيل فكرية أو فنية تخص النص أو العرض، ولكن المطلوب كان إثارة جدل فارغ لا طائل منه، ولكن المفيد فى الأمر هو استثمار تلك الواقعة فى الإضاءة حول المسرحية وكاتبها والفلسفة التى تعبر عنها، وكذلك الهدف الذى كتبت من أجله المسرحية فى عقد الأربعينيات، وتم عرض المسرحية على خشبة المسرح القومى فى نوفمبر 1958.
والمدهش أن المسرحية فى عرضها الأول، والذى قام ببطولته سميحة أيوب وعمر الحريرى وتوفيق الدقن وحسين رياض، وكانت اللجنة التى أجازت النص تتكون من نقاد كبار وأفضل ومتخصصين، ويكفى ذكر اسمى د. محمد مندور ود. عبد القادر القط، لنعرف الجدية التى كانت تدار بها الأمور الثقافية، خاصة أن نقادا كثيرين تناولوا المسرحية بشكل نقدى واسع وعميق، ومنهم من اعترض على العنوان، ولكنه لم يحتج على عرض المسرحية، أو مصادرتها، ومنهم من ناقش المسرحية بشكل تفصيلى وعميق مثل الدكتور محمد مندور، واتخذها فرصة مواتية لكى يتحدث عن المنطق الفلسفى الذى انطلقت منه المسرحية، ومن ثم كتب مقالا مباشرا عن المسرحية، والمنطلقات التى انبنت عليها، ليتضح لنا أن المسرحية جاءت لفضح الازدواجية التى يعيشها المجتمع الأمريكى، تلك الازدواجية التى تصور المجتمع والسلطة فى وقت واحد يناديان بالحرية، وفى الوقت نفسه يعملان على اضطهاد الزنوج بشكل واضح، وعندما تجد تلك السيدة التى وصفها العنوان بالمومس أنها أمام تقديم شهادة زور، تصرخ أمام طالبى تلك الشهادة بالرفض والعصيان، قائلة: «رغم أننى عاهرة وبغى، إلا أننى أشرف منكم جميعا»، هنا تحاول المسرحية كشف تلك الغلالة الكثيفة حول موقف زائف، وهو الموقف من الحريات.
المشكلة أننا فى كل أزمة نجد أن الصراخ والتشدد والتعصب، كان اللافتة التى يختفى تحتها ذلك الصراع، وأيضاً هو الصوت الذى يتصدر كل المنصات، ونجد الذين يدافعون عن المواقف الصحيحة والمبدئية يتوارون فى ظل ارتفاع ذلك الصراخ الذى يفسد عمليات التلقى الطبيعية.
الضجة كلها حول إشاعة، ومعظم منتجى تلك الضجة لا يعرفون كثيرا عن أصل المسألة، ولكن صوت العقل يظل هو الأقوى بعد انقشاع كل تلك الحجارة الصغيرة التى تناثرت فى معركة شبه وهمية، بين أناس شبه فرسان، وما هم إلا مجرد بالونات لإحداث فرقعات وأصوات لا تعمل إلا على إثارة الدهشة والبلبة والفوضى.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
 الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني
الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني