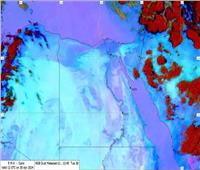أحمد عبد اللطيف يكتب :د. وائل فاروق:السرد العربى يقيم علاقة مع زائف
أحمد عبد اللطيف يكتب : د. وائل فاروق:السرد العربى يقيم علاقة مع زائف
الأحد، 17 يوليه 2022 - 01:40 م
ذهب البعض فى محاولة إرضائه للقارئ الغربى إلى العودة بصورة الثقافة العربية إلى سجن الغرائبى الذى كادت تتحرر منه
قارئ الأدب كثيرًا ما يكون ضحية للصورة النمطية عن الأدب العربى المنتشرة فى الأكاديميا الغربية وفى وسائل الإعلام
منذ سنوات، يعمل الدكتور وائل فاروق مدرسًا للغة والأدب العربى بالجامعة الكاثوليكية بميلانو، سبقتها سنوات عمل فى الولايات المتحدة فى تعليم العربية للأجانب وإعداد المناهج لهذه الدراسة، وهو العمل الذى ساعد محبى لغتنا والمستعربين على قراءة الكتب من مصادرها الأولى. بين عالم اللغة وعالم الأدب تتنوع أبحاث فاروق، ويتخصص بالتحديد فى ما بعد الحداثة، التيار الذى بدأ يتكوّن عقب الحرب العالمية الثانية، وهز الثوابت التى خلّفتها الحداثة. فاروق هنا، رغم حياته فى الغرب، له عينان لا تغيبان عن متابعة الأدب العربى والثقافة وحركة المجتمع. عن موقعه من إيطاليا ومشاهدته لتطور السرد العربى، وعن الكتاب الذى شارك فيه بدراسة قيّمة يرصد فيها مفهوم ما بعد الحداثة بتطبيقه على الواقع العربى، وعن الصراع المكتوم بين الشرق والغرب، يدور هذا الحوار.
منذ سنوات عديدة وأنت تعمل كبروفسور للغة والأدب العربى بالجامعة الكاثوليكية بميلانو، ولك العديد من الأبحاث بالإيطالية والإنجليزية حول الأدب العربى المعاصر. بدايةً، كيف يتلقى القارئ الإيطالى العالم الذى يقع على الضفة الأخرى؟ ما مدى اهتمامه وشغفه بالأدب المكتوب بالعربية؟
القارئ نوعان؛ القارئ العام وهو القاريء الذى يبحث عن الترفيه، أو عن معلومات وحكايات تملأ حوارات المقاهى أو الصالونات التى يشارك فيها، وهذا القارئ عادة ما يكون دافعه لقراءة الأدب العربى هو الفضول الناتج عن متابعة حدث ملأ نشرات الأخبار وشغل الناس بالعالم الذى يقع على الضفة الأخرى.
وهو غالبًا ما يبحث فى هذا الأدب عما يبقيه ضفة مقابلة لعالمه، وللأسف يمثل هذا القارئ الجزء الأكبر من قراء الأدب العربي. أما النوع الثانى وهو قاريء الأدب فنادرًا ما يقرأ الأدب العربى لأسباب عديدة تتعلق بجودة الترجمة، والطبيعة الموسمية –العشوائية- لنشر النصوص العربية وربطها بانتفاضة شعبية أو هجوم إرهابى أو حتى قتل امرأة.
لكل أدب من آداب لغات العالم سمات جمالية تغلب عليه وتميزه عن غيره ويعرف بها إلا الأدب العربى حيث ارتهانه بنشرات الأخبار جعل السمات الجمالية المميزة له آخر ما يبحث عنه الناشر والقارئ، أما قارئ الأدب فهو كثيرًا ما يكون ضحية للصورة النمطية عن الأدب العربى المنتشرة فى الأكاديميا الغربية.
وفى وسائل الإعلام التى إذا أرادت الإطراء على كاتب منحته اسم كاتب غربى مضاف إلى «الشرق» مثل «موليير الشرق»، وللأسف كثيرًا ما نفعل الجريمة نفسها فى حق الكاتب العربى.
ومما يؤسف أكثر أن هناك من الكتاب من يسعده أن يكون ماركيز العرب أو ديستوفسكى الشرق. قارئ الأدب بسبب هذا السياق ينظر إلى الأدب العربى على أنه نسخة متبلة ببهارات الشرق، تعافها ذائقته أو تتعاطاها مرة على سبيل الفضول.
ولا يعود إليها مرة أخرى حيث ليس من السهل الوصول إلى النصوص الأدبية الجيدة المترجمة للغة العربية فدور النشر الكبيرة المسيطرة على توزيع الكتب تتوجه لاعتبارات السوق إلى القارئ العام الذى يبحث عن الصورة النمطية للضفة الأخرى.
بشكل منتظم، تشرف على تنظيم مؤتمر عن الأدب العربى كل عام بالجامعة الكاثوليكية. حدثنا عن أهمية هذا المؤتمر كجسر للتواصل، وهل ترى بعد سنوات من تنظيمه أنه قد آتى ثماره؟
الجامعة الكاثوليكية لا تنظّم مؤتمرًا عن الأدب العربى وإنما تظاهرة كبيرة للثقافة العربية شعرا ونثرا ومسرحاً وسينما ولغة وموسيقى وفنّاً تشكيلياً. وهى بذلك تُنظّم الحدث الثقافى العربى الأكبر فى القارّة الأوروبية ، هذا العام مثلاً شارك فى المهرجان 56 محاضراً وفناناً وكاتباً وباحثاً من 19 دولة مختلفة.
وإذا أردنا الحقيقة فإنّ الدور الذى تلعبه الجامعة هامٌ جداً لأنّ هناك تيار شعبوى يتزايد ويتعاظم باطراد، وهو يتغذى بشكلٍ أساسى على الجهل بهذه الثقافة وفنونها، وأعتقد بأنّ الآلاف الذين يتابعون هذا الحدث سنويا يخرجون بعد الحفلات الموسيقية والعروض السينمائية والندوات الفكرية والقراءات الشعرية بفكرةٍ مختلفة تماما عن العالم العربى.

وعن الثقافة العربية وتتغير وجهات نظرهم تماما فى من جاءوا مهاجرين، تحت أيّة ظروف، إلى إيطاليا من تلك البلاد فالقوة الناعمة الحقيقية لأية ثقافة تكمن فى حضور لغتها وثقافتها فى الفضاءات الثقافيّة المختلفة فى العالم. نحرص كذلك على عقد لقاء ثقافى كل شهر يناقش كتابًا عربيًا فى حضور مؤلفه، كما نحرص على دعوة محاضرين عرب يقومون بالتدريس فى الجامعة لمدة أسبوع أو أسبوعين.
مما يساعد على خلق بيئة ثقافية تجعل من دراسة العربية فى بيئة أجنبية أقرب لقلوب الطلاب وعقولهم. كما تم أيضًا تأسيس معهد اللغة العربية ليشجع الباحثين الأوروبيين على دراسة الأدب والثقافة العربية، ويوفر لهم كل ما يسهل عملهم ويشجعهم على الاستمرار.
وقد عقد المعهد عشرات السيمينارات العلمية، التى تناولت قضايا الأدب العربى المعاصر، وتطور اللغة العربية ومصطلحاتها، كما يهتم بتطوير مناهج دراسة اللغة العربية وتعلمها.
وقد أدى هذا إلى زيادة عدد طلاب الماجستير والدكتوراه الذين يدرسون قضايا العربية خاصة فى المجال المعجمى، وعلم المصطلحات، وتحقيق المخطوطات. كما يقوم المعهد أيضًا بالدعم العلمى لترجمة الكتب العلمية المهمة إلى اللغة العربية.
وهنا يجب أن أشير إلى دعم الصديق خالد الناصرى ودار نشر المتوسط فى نشر هذه الترجمات وفى المساهمة الفعالة فى تنظيم تلك التظاهرة الثقافية فى ميلانو التى يمكننى فعلًا أن أصفها بجسر تواصل متين بين الثقافتين لا سيما بعد دخول مؤسسة ثقافية عربية كبرى كهيئة الشارقة للكتاب شريكًا فى تنظيم فعاليات المهرجان، فالمهرجان لم يعد اليوم مجرد مبادرة فردية لى تبنتها الجامعة ونجحت بفضل دعم أساتذتى وأصدقائى الذين شاركوا فى الدورات الأولى على نفقتهم الخاصة، المهرجان اليوم فضاء تتفاعل فيه مؤسسات ثقافية وأكاديمية أصبحت تجمعها مشاريع ثقافية كبرى لخدمة اللغة العربية.
وآخرها تعاون هيئة الشارقة للكتاب مع الجامعة الكاثوليكية و مكتبة أمبروزيانا العريقة التى تأسست فى القرن ١٦ لترميم ورقمنة ٢٥٠٠ مخطوطة عربية نادرة وطرحها للباحثين والمهتمين. هذه الثمار التى مازالت قليلة بالنسبة لطموحنا أتمنى أن تشجع المؤسسات الثقافية والعلمية فى العالم العربى على الاستثمار فى المستقبل الذى لا شك سيكون أفضل إذا اتسعت رقعة حضور اللغة والثقافة العربية فى الغرب.
رغم العلاقة المصرية الإيطالية القديمة، إلا أن ثمة فجوة اتسعت فى القرن الأخير، لم تخص إيطاليا وحدها ولا مصر وحدها، بل شملت علاقة الغرب بالشرق. فى حوار حديث تحدث المستعرب الإسبانى الكبير بدرو مارتينيث مونتابيث عن النظرة الاستعلائية الغربية اتجاه العرب. كيف ترى هذه الفجوة، وكيف تقيّم هذا الاستعلاء؟
الفجوة بين الحضارتين تتسع باطراد منذ القرن الماضى، حيث يهرب الأوروبيون من ماضيهم بشكل دائم، بينما يهرب المسلمون إلى ماضيهم بشكل دائم، فأى حاضر يمكن أن يجمعهم؟
تركت حربان عالميتان جرحاً غائراً فى الوعى الأوروبى جعلته يرى فى كل محاولة لتوليد أو تحديد معنى للحياة، للإنسان، للمجتمع، للتاريخ؛ استبعادا لما هو خارج هذا المعنى، وهو ما يؤدى إلى تهديد التعددية والسقوط فى هوة جحيم الحرب والتدمير مرة أخرى، هكذا سقطت الحكايات الكبرى؛ سقط الدين، سقطت الأيديولوجيا، وأخيرا سقط العلم، خارج إطار الحكايات الكبرى أصبح على كل منا أن يصنع حكايته الصغيرة.
ولكنها تولد ميتة لأنها لا تتسع- ولا ينبغى لها- لآخر، لأنها إذا ارتبطت بآخر ستفقد ما يكسبها شرعية وجودها وهى أنها زائلة عابرة، لا أثر لها إلا عدد أيقونات الإعجاب والضحك والحزن على الفيسبوك، فكل ما هو «كيف إنساني» قد تشيَّأ وتحول إلى «كم» من العلامات لا تسمح للمعنى أن يحول حكايتنا الصغيرة إلى حكاية كبرى.
وإنما يبقيها أسيرة لنمط يتكرر إلى مالا نهاية. على الجانب الآخر ترك الاستعمار وما تلاه من تبعية سياسية واقتصادية وثقافية جرحا غائرا فى الوعى العربى، جعله يرى فى كل محاولة لتوليد معنى للحياة أو للإنسان أو للمجتمع ترسيخا للذل والمهانة وتهديدا لصفاء الأصل الذى أصبح الإمكانية الوحيدة لغسل عار محبة الجلاد والتشبه به، هكذا أصبح الأصل هو الحكاية الكبرى التى تلتهم الحكايات الصغرى وتحرمها من أى إمكانية لتوليد المعنى.
وكيف نولد معنى وكل ما نمارسه ليس إلا تكرار أبدى لأصل مثالى فوق الواقع والتاريخ. تبدو الحضارة الغربية اليوم كرجل اختار أن يخصى نفسه لأنه لا يريد أن ينجب طفلا شريرا، بينما تبدو الحضارة العربية كرجل يقتل أبناءه الذين لا يشبهون أباه الذى لم يره. يكذب الأول على نفسه بأنه ليس فى حاجة إلى أبناء ولا يكترث للمستقبل.
ويكذب الثانى على نفسه بأن تشبُّه الأبناء بالأب الغائب سيعكس اتجاه الزمن، يكذب الأول على الآخرين حين يحاول أن يقنعهم أن قيمه النبيلة لا أصل لها ولا تاريخ، ويكذب الثانى على الآخرين حين يحاول أن يقنعهم أن قيمه النبيلة مازالت حية وأنها ليست مجرد قناع يخفى تفسخه الأخلاقى وانحداره الإنسانى.
ويتفاقم الأمر مع دخول الحضارتين عصر المعلومات وثورة الاتصال فلا سبيل لرؤية الآخر اليوم إلا عبر الصور النمطية التى فى إطار قيم التنوع والتعددية المسيطرة على ثقافة اليوم تحول «الصدام» بينها إلى «حوار»، وهو تحول خطير لأنه فى النهاية نوع من التطبيع مع الصور النمطية التى تكرس هذه الفجوة وهذا الانفصال، ما يؤكد مصداقية عبارة مارتينيث عن الاستعلاء الغربى الذى أضيف إليه كلمة «الخفى»، فالأثر الذى تركه كتاب الاستشراق لإدوارد سعيد.
والنفوذ الذى مازال يمارسه جعل عددًا لا بأس به من الأكاديميين الغربيين يقومون بكل ما ينفى عنهم شبهة الاستشراق، وذلك عبر الانتقال من التعالى على الصور النمطية إلى الاحتفاء بها، ولعل هذا يفسر لنا الرواج لأعمال أدبية عربية محدودة القيمة جماليًا لا لشيء إلا لأنها تكرس هذه الصور النمطية مثل روايات علاء الأسوانى ونوال السعداوى.
حيث لا يتطلب تلقيها إلا استدعاء المقولات النمطية عن الاستبداد الشرقى واضطهاد المرأة، فى مواجهة أعمال تشتبك مع نفس المقولات على مستوى أكثر تعقيدًا وأغنى جماليًا مثل أعمال بهاء طاهر.
ولا يختلف الأمر على مستوى البحث العلمى، وأتحدث هنا عن خبرة شخصية، حيث لظروف عملى فى الأكاديميا الغربية أنشر أبحاثى فى مجلات علمية محكمة باللغتين الإنجليزية والإيطالية، وعادة ما تأتى تقارير المحكمين، التى تثنى على أصالة البحث ومنهجية التناول، سلبية بسبب قائمة المراجع التى اعتمدت عليها، فى بحث لى مثلًا عن خصوصية علاقة الحضارة العربية بالزمن كما يتجلى ذلك فى الشعر الجاهلى كان الانتقاد الأساسى هو اعتمادى على مقولات مصطفى ناصف ولطفى عبد البديع وغيرهما كنقطة انطلاق للبحث، لأنهما مجهولان بالنسبة للمحكم. فى النهاية.
وباستثناءات محدودة، لا يجب أن يتجاوز المكتوب باللغة العربية دوره كمصدر وموضوع للدراسة إلى أن يكون مرجع للفكر والنظرية، ولعل هذا أيضًا يفسر الانعدام التام لترجمة نصوص نقدية عربية إلى اللغات الأوروبية.
بمناسبة الترجمة، فى الوقت الذى نلوم فيه أنفسنا على قلة الترجمة من اللغات الأوروبية إلى العربية، لم نلتفت إلى الغياب شبه التام للوجود العربى فى الغرب. كيف تفسر ذلك من منظورك ومتابعتك؟
الوجود العربى فى الغرب حاضر وبقوة، فهناك حركة ترجمة قوية للمصادر الأساسية للثقافة العربية، لا يقتصر على ألف ليلة وليلة، فقد ترجم ابن خلدون والشافعى والجاحظ وإخوان الصفا وغيرها من الأعمال الكبرى التى يتطلب نقلها إلى اللغات الأوروبية تكريس موارد مادية وبشرية كبيرة.
ولكن رغم ذلك يظل شعورنا «بالغياب شبه التام للوجود العربى فى الغرب» صحيحًا، لأنه غياب للعقل العربى المفكر المبدع فى اللحظة الراهنة، مما يكرس شعورنا أننا لا ننتمى لعالمنا المعاصر ولا نساهم فى بنائه، وهذا نتيجة ذلك الاستعلاء الخفى الذى تحدثت عنه فى السؤال السابق.
يبدو الغرب فى مرمى الكاتب العربى بشكل مبالغ فيه، كأن الغرب من يمنح صك الاعتراف، ما يؤدى فى بعض الحالات إلى الاستشراق الذاتى وتنميط أنفسنا لنوافق الذوق الغربى وتوقعاته. حدثنى عن ذلك.
فوز محفوظ بنوبل فتح أعين أبناء لغته من الكتاب العرب على العالم الغربى، وأصبح القارئ الغربى يشكل حيزًا معتبرًا فى أفق التلقى الذى تعتبره النظرية النقدية المعاصرة من أهم الفاعلين فى تشكيل النص الروائى، وأصبحت درجة حضور هذا القارئ – أو المؤلف المشارك كما يدعوه بارت – تتناسب عكسيا مع أصالة الكاتب، فقد ذهب البعض فى محاولة إرضائه للقارئ الغربى إلى العودة بصورة الثقافة العربية إلى سجن الغرائبى الذى كادت تتحرر منه.
وصارت موضوعات النصوص الروائية تتحدد بما تشغل به وسائل الإعلام العالم من أخبار ترسخ الصورة النمطية للثقافة العربية، من التطرف الدينى والإرهاب وقمع واضطهاد النساء، إلى عوالم الحريم السرية كما رسمتها ريشة الاستشراق.
وبالطبع فى مواجهة هؤلاء يوجد كثير من المبدعين الذين يمتلكون أدوات التواصل الجمالى العابرة للثقافات، والقادرين على تناول القضايا نفسها من دون تبنى المنظور الاستشراقى السطحى لها. ولعل مصدر هذه الأصالة هو انغماسهم فى قضايا مجتمعاتهم إنسانيًا ما يجعل من صياغتها جماليًا فى نص روائى طرحًا لرؤية جديدة لها. لا أعتقد أن الثقافة العربية فى أى لحظة من تاريخها غاب عن أفقها الحضارى والثقافى الآخر الغربى، إلا أنه فى كثير من الأحيان كان أسير صورة نمطية.
ولعل أهم ما قام به رجال عظام مثل رفاعة الطهطاوى وطه حسين ومحمد عبده وغيرهم كان تحرير الآخر من صورته النمطية ورؤيته على حقيقته بعيدًا عن شيطنته أو الانبهار به. ولعلى لا أبالغ إذا ادعيت أن جيلاً ِمن الروائيين الشباب يمضون فى الطريق الذى خطه رفاعة الطهطاوى.
وهو ربط المعلومات بالخبرة الإنسانية المباشرة، والذى يمضى فى اتجاه معاكس لما وصفه ليوتار بأنه من أهم ملامح عملية الانتقال من الحداثة إلى ما بعدها، وهى عملية الانتقال من المعرفة إلى المعلومات. فالمعرفة هى المعلومات دون الخبرة الإنسانية، والمعلومات تتحول إلى معرفة فقط فى إطار خبرة إنسانية.
والخبرة المعنّية هنا هى العملية النابعة من الإحاطة بأسباب الحياة، والقابلة لأن تتجلى من خلال الحكاية، كنصيحة ومشورة وحكمة، هى الخبرة التى تتناقلها الأفواه من جيل الى جيل ومن مكان الى آخر. لم يعد ثمة مكان لخبرة كهذه فى عالمنا المعاصر، طالما أن قصارى ما يظفر به المرء إزاء ما يشهده ويعانيه، هو المرور بخبرة ما وليس حيازتها، بمعنى عدم الإحاطة بها على وجه يمكنه من إعادة إنتاجها فى حكاية تنطوى على معرفة.
وهل هذا النوع من عدم الإحاطة كصفة عامة فى العالم المعاصر يجمع الأدب العربى بالعالمى وينتج أدبًا ما بعد حداثيًا؟
فى ثقافة ما بعد الحداثة، منذ صك إيهاب حسن مصطلح »اللا تحديد فى كتابه المنعطف ما بعد الحداثي» وهو يمارس سيطرة مطلقة على الوعى لا تسمح بوجود حقيقى للعالم أو للذات حيث يشير المصطلح إلى طراز معّقد مؤّلف من مفاهيم متنوعة ومختلفة، حيث تمثل مفاهيم :الغموض–اللااستمرارية–الابتداع، التعددية، العشوائية، الثورة، الانحراف والشذوذ والتشويه، إرادة ما بعد الحداثيين الكونية، فى التخلى عن كل شيء. لا يسعى السرد العربى اليوم فى معظمه إلى التخلى عن العالم.
وإنما إلى القبض عليه ولا يعنى كون هذا العالم مراوغًا ولا يعنى كون الرغبات فيه ملتبسة أننا فقدنا علاقتنا به، أو أنه فقد وجوده بعد أن انداحت حدوده واختفت ملامحه. فالسرد العربى المعاصر ليس قطيعة مع المستقبل وهو لا يعادى الحدود إلا لأن العالم لا يسعه، لأن طموحه الجمالى لا يرضى بالحدود. يجب ألا ننسى أن ما يحرك هذا الطموح هو قناعته أنه ما زال هناك المزيد؛ المزيد من كل شىء من العالم ومن الذات ومن الحدود.
فى كتاب صدر حديثًا عن دار المتوسط بعنوان «مقالات فى الرواية العربية»، تتناول فى دراسة موسعة مصطلح ما بعد الحداثة فى الرواية العربية. حدثنا عن الأصل الغربى للمصطلح وهل تحقق فى الرواية العربية، رغم ما تعانيه المجتمعات نفسها من عدم دخول الحداثة.
بدأت فصول هذا الكتاب انطلاقًا من حماس شديد لما بعد الحداثة، فقد كان الشائع عنها وما زال أنها تجلٍ لوعى إنسانى مؤرق بذاته، متمرد على كل الثوابت التى يمكن أن تحد من حريته فى اكتشاف آفاق الذات وعالمها.
وعى ثائر على كل الحكايات الأيديولوجية الكبرى التى يمكن أن تعرقل قدرته على الاستجابة لعالم يتغير بسرعة فائقة، ويخلق شروطا فيزيائية واقتصادية واجتماعية وسياسية تفرض علينا يوميا أن نعيد اكتشاف الإنسان والإنسانية. لقد ترددت هذه الفكرة بصيغ مختلفة فى شهادات المبدعين وقراءات النقاد الذين ينتسبون إلى ما بعد الحداثة.
ولعلى لا أبالغ إذا قلت إنها حكمت بشكل أو بآخر اختيار النصوص الأصلية التى تترجم إلى اللغة العربية من أدبيات مابعد الحداثة، وجد اليسار بشكل عام فى مابعد الحداثة صيغة للتمرد على الرأسمالية المتأخرة وثقافتها الاستهلاكية، فى حين وجد فيها الليبراليون المسمار الأخير فى نعش فكرة السلطة وبنياتها المختلفة.

وبينما وجد فيها مثقفو العالم النامى طريقا للتحرر من المركزية والهيمنة الثقافية الغربية، وجد فيها مثقفو الغرب نهاية للأيديولوجيا السياسية والدينية التى لم تعد حية إلا فى مجتمعات العالم النامى تغذى نيران صراعاته التى تلتهم حاضره ومستقبله. تتعدد المفارقات وتتسع الهوة بين أطرافها فبينما نجد أن كتابات ما بعد الحداثة العربية على تنوعها تعلن سعيها وبحثها الدائم عن المعنى.
وتؤكد على محاولاتها الدائبة للقبض على الحضور الإنسانى الذى تدفعه الحداثة إلى هامش الثقافة والسياسة والمجتمع؛ نجد أن كتابات ما بعد الحداثة فى أصولها الغربية تقدم حالة هروب دائم من المعنى وانكار شديد لأية إمكانية لامتلاكه.
وبينما نجد كثيرا من الكتابات العربية تؤكد ما بعد حداثيتها برفضها القاطع للحكايات الكبرى الدينية والسياسية ووضعها ثقتها فى العلم ومناهجه وحياديته وموضوعيته نجد أن كتابات ما بعد الحداثة الغربية تعتبر أن سقوط العلم كحكاية كبرى مفسرة للعالم هو أكبر إنجازاتها، فنجد فيزياء الكوانتم مثلا تتحدث هى الأخرى عن استحالة المعرفة اليقينية، حيث لم يعد الوعى الإنسانى مشروطا بالعالم وانما يظل العالم، أو بتعبير أدق ما يمكن أن نعرفه عن العالم، مشروطا بالوعى الإنسانى.لا أسوق هذه المفارقات للادعاء بأى شكل من الأشكال أن ثمة سوء- أو إساءة- فهم لما بعد الحداثة.
وانما للتدليل على السمة الرئيسية لما بعد الحداثة والتى جعلتها دون أى مبالغة فضاءا يجد فيه كل من شاء ما شاء؛ وهذه السمة هى «اللاتحديد» التى تمثل فى رأيى المنطق الحاكم لفكرها وفلسفتها وجمالياتها. لقد وصِفَت ما بعد الحداثة بأنها «حالة» و «وضع» و«توجهات» و«تحول ثقافى»، ما بعد الحداثة إذن ليست نظرية؛ فليس ثمة «نظرية» لما يطلق عليه «ما بعد الحداثة» هذا بالإضافة إلى أنها لا تعبر عن توجه واحد أو تيار متجانس فى أى من الحقول المعرفية التى اقتحمتها.
ولعل هذا يفسر لنا اقترانها الشائع والمثير بصفة «المرونة»، كما يشرح لنا ما تدل عليه عبارة «ما بعد» من غياب القدرة على إضفاء المعنى على الحالة الإنسانية الراهنة، كما أنها لا تشرح لنا هل ما بعد الحداثة حالة جديدة أم استمرار لحالة سابقة ، ففرانسوا ليوتار أحد كبار منظرى ما بعد الحداثة ينتهى فى مقال يبدأ بعنوان «الرد على سؤال ما معنى ما بعد الحداثة» إلى أنه:« قد لايصبح عمل فنى ما حديثا إلا إذا كان ينتمى إلى ما بعد الحديث أولاً، وبالتالى فإن ما بعد الحداثة ليست الحداثة فى منتهاها؛ بل فى حالتها الوليدة وهى حالة مستمرة».
إذا كان الأمر كذلك، فلماذا هذا الحضور الطاغى لما بعد الحداثة على مستوى العالم وعلى مستوى الأدب والفنون؟ ألا ترى أن فكر إتاحة كل شيء هو التعبير الديمقراطى عن الواقع، وتعبير عن اتساع الذائقة؟ كما أن ما بعد الحداثة تعبير عن تشظى الذات وضياع الهوية؟
ما بعد الحداثة لها حضور طاغٍ مسيطر إلا أنه غير واضح المعالم لأنه يتجاوز الزمان والمكان، فهو لا هوية له ولا ذاكرة، ما جعل من السهل تبنيها- أو استهلاكها- وهذا هو ما نراه اليوم حيث لا يجحد أيٌ مهتم بالشأن الثقافى بشكل عام وبالإبداع الأدبى بشكل خاص وبفنون السرد بشكل أخص ذلك الحضور الطاغى لمصطلح ما بعد الحداثة وما يدور فى فلكه من أفكار ومقولات تُنسب إلى «حالة» ما بعد الحداثة، لا يدل على ذلك فقط العدد الكبير من الكتب المترجمة التى تتناول ما بعد الحداثة أو العدد الكبير من الدراسات النقدية التى وظفت مقولاتها فى قراءة النصوص السردية المعاصرة، أو ما نجده فى الصحف والدوريات الثقافية من شيوع لهذا المصطلح، بل الأمر يتجاوز ذلك كله إلى حضور ما بعد الحداثة فى شهادات المبدعين بل وفى نصوصهم الإبداعية ذاتها. لعل كون ما بعد الحداثة شرطا ثقافيا وإنسانيا وتاريخيا عاما هو ما يفسر لنا ذلك الحضور الطاغى إلا أنه أيضا ما يدفعنا للتحرز من وصف الأدب العربى بأنه مابعد حداثى إلا من باب نسبة الأدب إلى الشرط الذى ينتمى إليه وليس الوعى الجمالى الذى يصدر عنه أو القيم الفنية التى ينتهى إليها. لذلك لا أحبذ الانطلاق من فرضية وجود رواية عربية ما بعد حداثية وإنما أسعى لدراسة سياقات التفاعل بين الرواية العربية المعاصرة.
وما تزخر به من ظواهر جمالية - حيث كانت ومازالت الفن اللغوى الأكثر ارتباطا وتعبيرا عن مشروع الحداثة العربية – والشرط الثقافى والبيئة الجمالية التى تصدر عنها، حيث تبدو الرواية كالواجهات الزجاجية التى تسيطر على العمارة المعاصرة ، فهى ليست «سطح» يتوفر على «عمق» يحتاج كشفه إلى عمليات حفر وغوص فيما وراء السطح من أجل العودة بلؤلؤة المستحيل :المعنى.
وهى كذلك ليست مرآة تعكس الواقع الماثل أمامها، إنها حاجز شفاف بين وجودين أو بين مستويين للوجود، بين الوجود والوعى بالوجود، إن العلاقة بين الوجود والوعى بالوجود الذى تطرحه الرواية المعاصرة تستحق التأمل حيث لم يعد الوعى بالوجود يمثل عمقا للوجود يقتضى حضوره الإطلاق أو التجريد الجدير بمقولة تنبع من أعماق العالم، الوعى بالوجود كما تقدمه الرواية هو وجود آخر، حياة أخرى. هذه الرغبة فى التحرر من ثنائية العمق/ السطح.
وقراءة النصوص الروائية بعيدا عن فكرة المرايا المقعرة والمحدبة هى التى دفعتنى لقراءة ما بعد الحداثة فى سياق المسافة الملتبسة غالبا بين الوجود والكينونة، فمنذ عصور الترجمة الأولى اختارت اللغة العربية خاصة فى مجال الفلسفة ترجمة « الكينونة» بـ «الوجود»، مثل الوجود بالقوة والوجود بالفعل.
وهى فى الأصل الكينونة بالقوة والكينونة بالفعل، ومثل أنا أفكر إذن أنا موجود، هى فى الأصل أنا أفكر إذن أنا أكون. فمفهوم الوجود كمفهوم مغاير ومنفصل عن الكينونة لم يظهر فى الفلسفة اليونانية، فالوجود بالمعنى الحديث أصبحت مفهوماً مركزياً فى الفلسفة تحت تأثير ميتافيزيقا الخلق فى الكتاب المقدس والتراث الإسلامي.
هل يمكن أن توضح لى هذه النقطة ، وكيف لم تميز الترجمة الفرق بين الوجود والكينونة؟
فى الفلسفة والفكر النقدى المعاصر نجد بين الوجود والكينونة فارق ضئيل دفع الكثير من المترجمين إلى استبدال إحدى الكلمتين بالأخرى خاصة عند ترجمة أعمال مفكرى ما بعد الحداثة ومنظريها، ولا يعود هذا الالتباس إلى قصور فى الترجمة عن اللغات الأخرى وإنما إلى المراوحة بين الكلمتين للدلالة على نفس المعنى فى هذه اللغات.
وعلى الرغم من محاولات ربط الوجود )الموجود( بسياق زماني/مكانى، أو ربط الكينونة بالذات، أو تحديد موضع الوعى المتأمل للوجود من الوجود؛ يظل ذلك التداخل بين الكلمتين عند المفكر الواحد وأحيانا فى النص الواحد ظاهرة تثير الانتباه والتساؤل حيث لم يحاول أحد- فيما أعلم –التمييز بين المصطلحين فى إطار التمايزات الكثيرة التى أقامتها أو- قامت عليها- مابعد الحداثة، فمعظم ما يميز ما بعد الحداثة من قيم ومفاهيم تعرفنا عليه فى إطار انتقال من/ أو مقابلة مع/ أو تمايز عن قيمة حداثية.
تحاول فى دراستك الموسعة صياغة مقولة نظرية تشرح منطلقات السرد العربى المعاصر جماليًا ومعرفيًا، برأيك، كيف يمكن للناقد العربى أن يفعل ذلك؟
لتحقيق هذا الطموح يجب بناء مقدمات لنظرية جمالية جديدة، وتحديد السياقات المعرفية للظاهرة الجمالية موضع الدراسة وأخيرًا اختبار مصداقيتها من خلال تطبيقها على أكبر عدد ممكن من التجارب الروائية المعاصرة. لذلك بدأت بمناقشة علمية وموضوعية منهج الدراسة فى إطار نظرية العلم المعاصرة.
وقد انتهيت إلى أنه إذا كان الناقد فى المذاهب النقدية التقليدية يبحث عن قصدية الروائى، أى غايته من كتابة النص وموقفه من الحياة ورؤيته لها، من منطلق أنه يعبر عن الواقع وعن اتجاهات المجتمع، واذا كان الناقد فى المناهج الحداثية بشكل عام لا سيما فى « النقد البنيوى» يبحث عن القصدية ولكنها ليست قصدية المبدع.
وانما قصدية البناء الشكلى، إذ أن الشكل هو الذى يقصد، أما المبدع فهو غائب، أو «ميت» بتعبير رولان بارت ؛ فإن الناقد فى نقد « ما بعد الحداثة « لا يبحث عن قصدية المبدع أو النص وانما يعمل على ضمان تعدد القصديات حيث المتلقى هو الذى يحدد «القصدية « إن وجدت، فوجود القصدية يتوقف على تصور المتلقى للشكل وعلى تفاعله معه.
وهكذا لا يقوم النقد على دراسة بناء الشكل للعمل الفنى وانما على الرغبات والأهواء التى تنطلق من المتلقى، وهو لذلك لا يقوم بربط دلالة الأشكال فى العمل الفنى رجوعا إلى الطبيعة أو الواقع.
وانما يحصل على مدلولها من خلال علاقتها بالأشكال الأخرى فى إطار تركيب لا قيمة بنائية حاكمة له إلا قيمة التجاور. القراءة النقدية بوصفها ضمانة لتعدد القصديات – وهى الفرضية التى حاولت اختبارها –هى المخرج من معضلة الاختيار بين عدمية اللامعنى واللاحقيقة واللاغاية فيما يُعدُّ مناهج مابعد حداثية.
وبين التناقض الذى لا شك فى وقوعه بين المنهج المكتمل بوصفه سردية مفسرة أو ميتا سرد من ناحية وموضوعه وسياقه الثقافى الذى يرى فى موت الحكايات الكبرى أو السرديات الفوقية المفسرة مبررا لوجوده من ناحية أخرى، فكما لا ينال تعدد الذوات الإنسانية وفرادتها غير القابلة للتكرر من الإنسانية؛ لاينال تعدد القصديات أو حتى تشوشها من حضور المعنى.
إن قراءة المبدأ الجامع لسمات ما بعد الحداثة فى نصوص روادها الأوائل كما قدمها عدد كبير من الباحثين العرب ينتهى إلى أن « فقدان المركزية» ليست «حالة» ما بعد حداثية ، إنها غاية ومنتهى ما حاول أن يصل إليه إيهاب حسن.
ومن دار فى فلكه ممن حاولوا «تعريفها» ، وهى محاولات تكشف عن أنه ليس هناك عجز عن صك المصطلح وتعيين مدلوله، وإنما- كما يقول العنوان البليغ لكتاب هيبدايج- محاولة «الاختباء فى النور» إنه اختيار واستراتيجية معرفية تم تبنيها والتأكيد عليها من خلال آلية « الجمع دون المنع».
وكأن الهدف من كل محاولة للتعريف هو أن يترسخ فى الذهن أن التعريف وبالتالى الحدود وبالتالى ثنائية المركز والهامش وكذلك تعددية المراكز لم تعد تليق بعالم مابعد الحداثية، فالسعى ما بعد الحداثى للخروج من الهامش لا يتوقف عند تدمير المركز المسيطر وانما يمتد لتدمير أى إمكانية لظهور مركز جديد، الغياب التام للمركز هو الضمانة الوحيدة لعدم العودة للهامش.
وهل ساهمت التكنولوجيا الجديدة فى تفتيت هذا المركز وخلق مراكز كثيرة لم تعد هامشًا؟
يرى جان بودريارد إن أهم ملامح الانتقال من عالم الحداثة إلى عالم ما بعدها هو الانتقال من المعرفة إلى المعلومات، فالمعلومات على عكس المعرفة يمكن أن توجد مستقلة عن الخبرة الإنسانية، ونحن نشهد اليوم تحولًا جديدًا من تحولات المعرفة.
وهو تحول المعلومات إلى محتوى يمكنه الوجود مستقلا عن الواقع، إذا وضعنا فى الاعتبار أن 20% من البشرية تتفاعل وتتواصل من خلال الفيسبوك ومادة التواصل عبارة عن 41 ألف بوست فى الثانية، يعتبرها 71% من الشباب بين 18- 24 سنة المصدر الرئيسى للمعلومات والفن والأدب، فإن أى حديث عن انتاج الثقافة واستهلاكها وقيمتها لا يجد مكانا داخل هذا النشاط الثقافى الإنسانى الرئيس لا محل له من الإعراب، نعم قد تكون الهوية فى العالم الافتراضى غير حقيقية ولكنها هوية مختارة، هى إحدى حقائق الذات التى يصفها الجرجانى فى كتابه الذائع الصيت «التعريفات» يقول عنها: بأنها الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على الشجرة فى الغيب».
لك بحث حدثتنى عنه يتناول فكرة الفتوى من وجهة نظر السائلين، وتراه تمثيلًا للمجتمع المابعد حداثي. هل يمكن أن تحدثنى عن هذه الفكرة؟
لا شىء يكشف عن عمق التداخل والانسجام وليس التناقض بين الأبنية التراثية التقليدية ونظامها الفكرى والمعرفى من ناحية وبين الأبنية الحداثية ومؤسساتها وأدوات الحداثة ومصطلحاتها من ناحية أخرى، مثل ظاهرة الفتوى، التى أراها ظاهرة سردية ما بعد حداثية بامتياز، فلنأخذ مثلًا فتوى إرضاع الكبير، فقد جرت أحداث ومناقشات إرضاع المرأة لزميلها فى العمل خوفا من الفتنة الجنسية فى البنك والجامعة والبرلمان والحكومة والمحكمة الإدارية ووسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى.
وهى لم تقتصر على رجال الدين فقد شارك فيها السياسيون ورجال القانون وأساتذة الجامعة والمثقفون، واذا نظرنا إلى قائمة الفتاوى الأخرى حول الانترنت والفيسبوك وحضور المرأة فى الفضاء العام الذى يفرضه البناء الاجتماعى الحديث وبعض مظاهره كالعنوسة سنجد أنها كلها وليدة ذلك التعايش والانسجام بين ما قد يبدو أنه متناقضات وأنها فى محاولتها سد الثغرات التى أحدثتها الحياة المعاصرة فى النسيج الأخلاقى التقليدى تحاول أن تحفظ لهذا الانسجام استمراريته.
فى ظل عدم توفر وسائل الاتصال فى الماضى كانت الفتوى تتميز بالعمومية، وكان على الناس ممارسة التفكير والاجتهاد للربط بين فتوى مشهورة والظرف الشخصى، اليوم وفرت وسائل الاتصال الحديثة لكل شخص إمكانية أن يحصل على فتوى تخص حالته هو دون غيره.
وبالتالى لم يعد عليه التفكير أو القياس أو المناقشة، لقد وفرت الحداثة تكنولوجيا قامت بفض الاشتباك نهائيا بين التدين والعقلنة، فقد يسر الله للناس بما يتوفر من وسائل الاتصال الحديثة الحصول على الفتوى فى أى وقت وفى أى مكان وفى أى موضوع مهما كان شخصيا وشديد الخصوصية بالنسبة لطالب الفتوى.
وهو ما يتناقض مع ما يعتبره الإسلام أهم مميزاته وهو مبدأ لا كهنوت فى الإسلام ومبدأ استفت قلبك وان أفتاك الناس.تقودنا قراءة هذه الفتوى وما دار حولها من جدل شغل كل مؤسسات الحداثة فى مجتمعات عربية مختلفة ما أعتقد أنه يمثل أهم سمات الظرف مابعد الحداثى العربى وهو تعايش المتناقضات.
هل ينفصل هذا عن تلك الظاهرة الممتدة فى الرواية المصرية منذ نهاية التسعينيا،ت وهو بناء شخصيات روائية تعيش وفق معايير عالمين مختلفين فى اللحظة نفسها، عالمان يسعى السرد إلى محو تمايزاتهما؟
نجد هذا فى نصوص روائية على الرغم من أنها شديدة التباين جماليا، إلا أنها تجتمع فى خلق فجوة فى عالم الشخصيات تسمح لها بالتحرر من أسر الوجود والتحليق فى فضاء الكينونة، نجد هذا فى رواية «أن ترى الآن» لمنتصر القفاش حيث يمثل نسيان ابراهيم تلك النافذة المفتوحة على الذات.
وفى «الخوف يأكل الروح» لمصطفى ذكرى حيث الكابوس أقصر الطرق للحقيقة، فى «قانون الوراثة» لياسر عبد اللطيف و «الحالة صفر» لعماد فؤاد حيث المخدرات تصل بالشخصية إلى «المنطقة التى نعثر فيها على ذواتنا».
وإلى «التوحد مع الذات فى وجود الآخر» كما يقول عماد فؤاد، وأحيانا تكون النافذة عقيدة شعبية كما فى «عين القط» لحسن عبد الموجود، أو ضريح لولى كما فى «ضريح أبي» لطارق إمام، أو فى نص أصلى لم ينقطع حضوره مثل ألف ليلة وليلة كما فى «جبل الزمرد» لمنصورة عز الدين أو «مدينة اللذة» لعزت القمحاوى، أو نوع من الهوس المرضى كما فى «قشرة زائلة» لمحمد هاشم أو «ليلى أنطون» لنائل الطوخى، الأمثلة كثيرة وممتدة فى الزمن ومتنوعة ما يجعلنى لا أطمئن لاختزال كل هذا التباين والتنوع فى المواجهة الزائفة التى شاعت مؤخراً بين العادى والغرائبى كسمة لمابعد الحداثى الذى أصبح بشكل من الأشكال يعنى الراهن، وربما لهذا لا نتحدث كثيرا عن غرائبية تكايا نجيب محفوظ ودراويشه التى ظلت نبعا غامضا لحكمة تسرى فى وجدان المجتمع الواقعي.
استكمالًا لهذه الفكرة، وبالاقتراب إلى الرواية المصرية الجديدة، هل يمكن تطبيق سمات ما بعد الحداثة عليها؟
اللاتحديد هى السمة الرئيسية لما بعد الحداثة، اللا تحديد فى اللغة: مع الوضع فى الاعتبار وضعية اللغة كلعبة فى ما بعد الحداثة، ما بعد الحداثيون يهدفون إلى تبديد الواقع وابتداع عالم جديد بواسطة أداة وحيدة هى اللغة، يرفضون تحمل مسئولية تقديم انعكاس لعالم واقعى فبدلا من ذلك ينظرون إلى الإبداع الروائى نفسه بوصفه واقعاً.
ويبنون عالما مضطربا من الكلمات، كذلك اللا تحديد فى اَلْحَبْكَة : الروائيون ما بعد الحداثيون يسعون إلى تدمير أى منطق أو اتساق أو ترابط فى تركيب حبكة الرواية حيث يهجرون المنطق والاتساق خلال عملية كتابة الرواية لا لشيء إلا لاستنفاد كل الامكانيات التبادلية للزمن التاريخى والمعاصر والمستقبلى فالماضى والحاضر والمستقبل تنقلب حركتهم إلى عملية ارتداد عشوائية بينما المكان منقسم باستمرار.
ومبتور أو مبتسر هذه الصيغة للمكان والزمان تجعل من إمكانيات الحبكة لا نهائية فى الأعمال الروائية لما بعد الحداثة وأخيرًا اللا تحديد فى الشخصية: بما أن ما بعد الحداثيين يعتقدون فى موت المؤلف والموضوع فالشخصيات الروائية بالتالى تموت معهم.
وهكذا فى الأعمال الأدبية ما بعد الحداثية، الشخصيات تكون أشباح غامضة أو حتى صور بلا روح. الشخصيات فى الروايات ما بعد الحداثية تتميز فى الغالب بغياب الأصول» فهى ليست مصطنعة بشكل كامل ولكنها تفتقد خلفية طبيعية وكأنها خرجت من العدم.
وفى بعض النصوص ما بعد الحداثية تخرج الشخصيات من النصوص لتقابل مؤلفها، فهم لا جذر لهم على أى مستوى إلا اللغة التى ابتدعتهم، لغة لا تكشف عن جوهرهم ولا تبنى الحدث السردى.
يبدو لى السرد العربى المعاصر بعيدًا تمامًا عن هذه السمة، مازال السرد العربى، فى زمن ما بعد الحقيقة، يراهن على الحقيقة ويبحث عنها، حتى لو كان الوعى بالحقيقة قد انتقل، فى بحثه الجمالى هذا، من الموضوع إلى خبرة العلاقة معه، فلو كان الشرط الثقافى الذى نعيشه يدفعنا دفعا إلى التخلى عن التمسك بواقعية ما نعيشه فى حياتنا اليومية، فإن السرد العربى المعاصر يقول لنا ربما يكون كل شىء فى واقعنا اليوم خارج خبرة اليقين ولكن علاقتنا مع هذا الواقع حقيقية، يمكن أن تكون هناك علاقة حقيقية مع زائف.
يمكن أن يكون عالم النص مصطنعًا زائفًا، ولكن الزيف وليس الحقيقة محل شك دائم، لأن الشخصيات والخبرات الإنسانية تظل حقيقية حتى داخل عالم من الزيف. بالنسبة لى هذا مدخل آخر- بجانب تلك المسافة التى تقطعها شخصيات نصوص روائية أخرى من الوجود إلى الكينونة- لقراءة السرد العربى المعاصر.
اقرأ ايضا | الكاتب مجدي صابر يناقش مؤلفاته عن الأسرة المصرية بملتقى السرد العربي
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز