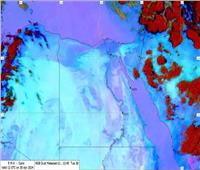هدى حمد تكتب :الكتابة ليست سباقاً بين الرجال والنساء
ترى أن أهمية الأدب فى أثره
هدى حمد: الكتابة ليست سباقاً بين الرجال والنساء
الأحد، 31 يوليه 2022 - 01:30 م
حوار: حسن عبدالموجود
لو قدّم الروائى الحكايات كما تُدار على ألسنة الناس فقد خسر رهانه
الكاتبة العمانية لديها مشروع رصين ولا أفضل مصطلح «أدب المرأة»
زوجى هو أكثر شخص يقول رأيه فيما أكتب بتجرد
كلما قرأتُ عملاً من أعمال الواقعية السحرية العالمية أكلتنى الحسرة
كنتُ مسحورة بجملة من الحكايات سردتها الجدات على مسامعى
تحدثت إلى كبار السن لأنجز روايتى وظن البعض أننى أكتب حياتهم
تعد هدى حمد واحدة من أبرز الكاتبات العمانيات، وقد راكمت فى سنوات عدداً من الأعمال فاز بعضها بجوائز، وترجم إلى لغات متعددة، وحظى بتقدير نقدى، وحضور إعلامى.
هدى لديها عدد من المجموعات القصصية والروايات: «نميمة مالحة»، و«ليس بالضبط كما أريد» ، و«الإشارة برتقالية الآن» ، و«الأشياء ليست فى أماكنها»، و«التى تعد السلالم»، و«سندريلات مسقط» ، و«أسامينا».
تؤمن هدى حمد بضرورة النظر إلى الكتابة ذاتها لا إلى جندر صاحبها، وبهذا المعنى فهى تكره الأعمال النسوية وتراها تخنق نفسها فى مساحة ضيقة، لا تضيف الكثير إلى الإنسانية.
فى روايتها الأحدث «لا يُذكرون فى مجاز» حكايات تشبه دوائر ألف ليلة وليلة، كل حكاية لها بطلها أو بطلتها، تجمع بينهم قصص الحب، أو الخوف من الفقد، والنفى إلى جبل بعيد، ليصبحوا طعاماً للخوف والسحرة. تسرد هدى فى هذا الحوار كيف قررت البدء فى هذه الرواية وكيف استفادت من التراث العمانى فى كتابتها، وما نظرتها إلى الأدب عموماً، وما المعوقات التى تواجهها كامرأة وكاتبة عربية.
نبدأ من روايتك «لا يُذكرون فى مجاز». لماذا صدَّرتها بهذه العبارة: «أى تشابه بين شخصيات الرواية وتلك التى قابلتك يوماً أو سمعت عنها مقصودة تماماً»؟
بقدر ما اخترعتُ الشخصيات وركبتُ مصائرها بقدر ما كنتُ أنهل من معين لا ينضب من الحكايات المهددة بالنسيان. فلكل شخصية من شخصيات هذه الرواية جذر يتصل بمخيلة شعبية خصبة. قصص سمعتها من جداتى وأخرى قرأتها فى الكتب الشحيحة التى دونت تراثنا الشفهى. كنتُ على يقين أنّ أحدهم سيشهر سبابته ويقول: «لقد سمعتُ شيئاً من هذه الحكايات. بالتأكيد سمعتها».. فهذا التراث يسيل بيننا بآلية غامضة، بل إنّ بعض القصص شديدة المحلية قد تتقاطع مع إرث عالمى.
أنا لا أستطيع امتلاك أصل الحكاية فى مجتمع ارتبطت حياته الاجتماعية بالحكى مثل عُمان، ولكن تلك الالتماعة الأولى للحكاية دخلت معترك الكتابة. طُحنت بذورها وعُجنت لتصير ما هى عليه الآن.
وقد رُجمت تلك الحكايات الغرائبية والمعتقدات بكلمات قاسية من قبيل: الجهل والخرافة، وبالتأكيد نحن لسنا من أنصارهما، ولكننا مولعون بالسحر وبإمكانية انفتاحه على تأويلات لا نهائية، مولعون بإعادة استقراء تلك المخيلة والظروف التى تكثفت لتعطى تلك الحيوات منطقاً وشكَّاً ويقيناً مُغايرا لما نظنه نحن الآن الحقيقة المطلقة.
إنّها المرة الأولى فى كتابتى للرواية التى أشتغل فيها على رصد كم هائل من الحكايات موغلة القدم، المرة الأولى التى أجرؤ على الخروج والتحدث إلى كبار السن مصطحبة أوراقى ومسجلتى - رغم تحفظ البعض وقلقهم ظنا منهم أننى أكتب قصصهم الشخصية- لقد تكثف هذا العمل فى سنتى كورونا، لقد كانوا ضجرين من البقاء فى البيت، ومن روتين يتكرر كل يوم، ولذا أزعم أنّ ذلك كان توقيتا جيدا لدخول امرأة مثلى رفقة أسئلتها وأوراقها، ربما أحدثتُ بعضا من التسلية.. أقول ربما!

لقد فاجأنى أولئك القابضون على أسرار دهرهم، فاجأنى تدفق بعضهم وتكتم البعض الآخر، فاجأنى ما أضافه بعضهم لحكايات الآخرين وما محاه البعض الآخر، وكنتُ أجد متعة لا مثيل لها.
لطالما كنتُ مؤمنة بأن الرواية هى أكثر الأجناس الكتابية قدرة على صهر كل هذه الغرائبية فى المعتقد والأفكار والعادات فى منطق جديد.
وما الخط الذى يفصل بين التراث الشفهى وبين حكايتك؟
الفكرة التى ظلت تلح علىّ سنوات طويلة دون أن أجد لها مخرجا فنيا، كانت فكرة البلاد المسورة التى تمنع الدخول إليها والخروج منها، البلاد التى تخشى من الكتب وتراها فعلا شيطانيا، البلاد التى تحكمها قبضة فولاذية من الغيبيات.
وبواسطتها تُخمد رغبة الناس فى إحداث أى تغيير فى نسيج حياتهم. لقد كانت هذه البلاد هى الفكرة التى ترن فى رأسى حتى تكاد تثقبه، إلى جوار فكرة أخرى لم تكن أقل تأثيرا عليّ وهى فكرة الذنوب التى مهما تبدت تفاهتها إلا أنّ السُلطة تجعلها سببا أصيلا لتخفى بواسطتها من يُرعبها وجوده، وأمام الفكرتين الجامحتين كنتُ بحاجة إلى شخصيات، إلى منسيين!
ومن هنا بدأت رحلة تشبيك العوالم بعضها ببعض. كان الأمر مُضنيا فى البداية، لأن القصص الشعبية غالبا ما تكون التماعة صغيرة تُحدث دهشة سريعة ثم تمضى للاختفاء، فلا تقوم الحكاية الشعبية على رسم دقيق لنفسية الشخصيات وغالبا لا تتطور إلا ضمن حدث المفارقة ذاك، لذا توجب عليّ تغذية هذه الشخصيات لإعطائها أسبابا كافية لدخول متن الحكاية.
لقد قرأتُ مرّة ما كتبه الشاعر سماء عيسى حول أن منشأ هذه المخيلة الكثيفة بالمعتقدات والأوهام هو منطق «الندرة» فى الأماكن التى تُهدد بالزوال لمجرد اختفاء الأمطار، منطق الندرة حيث أنك معرض للموت جوعا لأن غلة حقلك لم تينع هذا الموسم!
ففى لحظة العجز عن تفسير الموت والأوبئة الغامضة والطبيعة الغاضبة، ينحاز الإنسان لتصورات فانتازية تبرر المبهم، وكذلك الأمر بالنسبة للظواهر الأخرى من قبيل المحل والجدب، فقد يميل الإنسان لتفسيرها بأسباب تتعلق بانهيار القيم الأخلاقية أيضا.
كل ما يفعله أهل «مجاز» - كقطعة منسية من الأرض- أنهم يتضرعون لإلههم أسفل جبل الغائب، متشبثين بشجرتهم المباركة حاملة النذور المقدسة تلك التى تحمى أمانيهم وأوجاعهم، ولكن ما إن يظهر بينهم منْسى، فينبغى استبعاده قبل أن يحل الغضب.
لماذا اخترتِ قرية «مجاز» لتصبح مكان الحدث الرئيسى، وهو مقابلة البطلة للجدة، ومن ثم عودتها إلى الماضى لتعرف حكايات جدتها الثالثة والثمانين «بثنة الثائبة» وحكايات مجاز الغرائبية؟ هل الاسم نفسه له دلالة فى الأحداث؟
فى البداية كنتُ مشدودة لجرس الكلمة، ثم وجدتُ أنّ مفردة «مجاز» تخلق التباسا يخدم مقاصدى. فالمجاز اللغوى هو: «صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى ليس له علاقة مباشرة بالمعنى الحرفى».
كنتُ ألعب على المعنيين الظاهر والخفى لهذه المفردة.. فهل مجاز هو اسم لمكان حقيقى؟ هل المقصود من مجاز هو «التجاوز والتعدى؟»، لقد تبدى لى أنّ هذه المفردة تُضمرُ معانى أعمق من جرسها الأولى، خصوصا فيما لو ذهب القارئ إلى طبقات الحكى، فبمجرد دخوله إلى هذه القرية، يجد أنّ المجاز يطال حياتهم وملامحهم، المجاز يطال نظرتهم للحياة والموت والغياب والحزن والأفراح القليلة.
امرأة تحمل من جنى، امرأة تأكل من طعام النذور فتنادى النداهة إحدى بناتها وتغرقها فى بئر، امرأتان تستحمان فى قِدر اللبن الضخم، امرأة تتحكم فى كائنات «الرَمَّة» الصغيرة، نجمة تهوى من السماء وتتحول إلى امرأة ثم تعود إلى مكانها.. هل كان لديك تخطيط بأن يكون عملك منذ البداية أقرب إلى عوالم الواقعية السحرية؟
كنتُ مسحورة بجملة من الحكايات التى سردتها الجدات والأجداد فى أوقاتٍ مختلفة من حياتى، بعضها يعود إلى طفولة بعيدة، فكلما قرأتُ عملا من أعمال الواقعية السحرية من الأدب المترجم أكلتنى الحسرة والندم على تفويت كتابة ما سُرد ت على مسامعى.
لقد عاصرتُ جدتين، أمّ أمّى وأمّ أبى، سكنتا معنا فى بيت واحد، وكانت لى جدة ثالثة هى فى الحقيقة جدّة بنات عمّى، لكننى لم أعتبرها يوما إلا جدة حقيقية لى، فقد عاملتنى تماما كما تفعل مع أحفادها الحقيقيين. لا أعرف على وجه الدقة كيف كان يتسع حضنها لنا جميعا، ينتابنى شعور أنّ حضنها لا يقل سحرية وغرائبية عن مروياتها. تتطاول يداها لتشملنا دون استثناء، وكل من ينظر فى عينيها يقع أسيرا لفتنة مخيلتها.
كانت كل واحدة من الجدات الثلاث نهرا متدفقا يغذى حياتى، فإزاء أى حدث يعبر حياتنا الهادئة، كانت ثمّة قصّة تروى.
فى طفولتى كنت أقرأ قصصا مترجمة من خيال شعوب تبعد عنا آلاف الكيلومترات، فأجد ارتدادا عجيبا لحكايات جداتى فى خيال شعوب أخرى، رغم أنّهن لا يقرأن ولا يكتبن وأبعد مكان سافرن إليه كان لأداء فريضة الحج، فأصابُ بدهشة ووجع خفى.. فمن سيحكى قصص جداتى والجدات الأخريات؟ من سيحولها لأفلام؟ لقد كنتُ أظن نفسى أكثر ضآلة من التصدى لتلك المهمة!
إنّها ذاكرتنا الجمعية التى شكلتها ظروف قاسية ومعتقدات مختلفة، ولذا فالمذهب السحرى هو القالب الأشد مناسبة لاستدراج هذه الحكايات من مخابئها السرية.

أتذكر حتى الآن قصّة «السندريلا» العُمانية، التى طلبت منها زوجة الأب أن تذهب لتحتطب وهى تشترط عليها أن يكون الحطب: «لا من الشمس ولا من الظلة، ولا عوجة ولا مستقلة»، وأمام هذا التعجيز تعثر على أمير حولته ساحرة إلى «غول»، لتنقلب حياة بؤسها رأسا على عقب.
ظل عقلى الصغير عاجزا عن تفسير التلاقى المدهش بين ثقافات العالم، وظل السؤال يكبر بداخلى: ما الذى يجعل هذه الجغرافيا المعزولة قبل التلفاز والإذاعة تتلاقى مع سرديات شعوب أخرى؟ هل كانت القصص تطير على غرار ما قالت جدتى: «أن الأحجار والأشجار والجمادات كان بوسعها أن تتكلم فى سالف الأزمان»؟!
الجذور التراثية العربية، قدّمت «ألف ليلة وليلة»، كما قدّمت السير الشعبية قبل أن يصوغ الناقد الألمانى فرانس رواه مصطلح الواقعية السحرية.
ربما يكون مذهب الواقعية السحرية شكلا أخاذا لمواجهة الحياة المتوحشة الآن والتى لا سبيل لإيقاف تسارعها إلا عبر الفن والحكى.
لكن الأمر الذى ينبغى أن نعيه بدقة، هو أنّ الحكايات التى تُستمدُ من الفولكلور والرموز، يمكن أيضا أن نجد فيها ارتداد صورتنا إلى اليوم، فالروايات تنهض على تفكيك هذا الموروث الثقافى والاجتماعى وتنزع لخلق اشتباكات أصيلة مع الواقع، عبر خلق صور جديدة،وليس تقديمها كما هى بإخلاص ميت، فلو قدّم الروائى الحكايات كما تدار على ألسنة الناس فقد خسر رهانه الأهم الذى يجعله كاتبا.
لقد كتبتُ مرّة عن تصورى لتلك الجدّة العُمانية -الشهرزادية- منذ مئات السنين وهى تجلسُ لتنسج حكاية ما، تتناقلها الأجيال وتضيف إليها كما تمحو. تلك الأفكار الميتافيزيقية التى تعيد رسم حياة الإنسان ومآربه وحاجاته وفلسفته.
«أن تؤلف كتاباً، أن يقتنيه غريب، فى مدينة غريبة، أن يقرأه ليلاً، أن يختلج قلبه لسطرٍ يشبه حياته، ذلك هو مجد الكتابة»، هذا ما قاله الكاتب يوسف إدريس، ووجدتُ أنّه يعبر بصورة دقيقة عن علاقتى بالكتابة، فليست هى الأشكال والقوالب التى تحدد مدى جدية العمل وإنّما الأثر الذى تتركه.
من يقرأ الكتب يُحكم عليه فى «مجاز» بالنفى إلى جبل الغائب وتم تفسير الأمر فى النهاية بما فعله الشرير «ألْماس». لماذا اخترتِ الكتب تحديداً لتجعليها لعنة مجاز؟ هل تقول الرواية إن المعرفة قاتلة؟
الأمر على نقيض ذلك تماما حتى وإن تبدى ظاهريا أنّها تُلقى بهم إلى مصائر مجهولة، فالكتب كما أتصور تُعطى دلالة مختلفة فى المتن، باعتبارها سببا فى خلق كائنات مُغايرة خارج فكرة القطيع التى يؤسس لها «ألْماس»، الكتب هى المُخلص الذى يجعل لحياتهم معنى ضمن نسيج القرية المتآلف على الطاعة، حتى فى اللحظة التى يصيبهم المصير الأكثر قتامة، فإنهم يرغبون باصطحاب كتبهم معهم كزادٍ للحياة الأخرى.
الكتب كانت تصنع فرديتهم، ولأنّها كذلك فألماس يشعر بالتهديد، يمنعها لأنّه يستشعر خطرها المؤكد. الكتب بهذا المعنى كانت تهدد رجال السُلطة، ويمكننا سحب المعانى إلى أماكن أخرى أكثر شساعة، حيث لا يمكننا أن نحد من مخيلة القارئ.
داخل الرواية قصة رئيسية هى البطلة التى تعيش فى الواقع وتأتيها علامات من جدتها. تذهب إليها فتمنحها أوراقاً قديمة لا يمكن لأحد قراءتها سواها، وفى هذه الأوراق قصص أخرى لأبطال آخرين، حويضر، بشير، نجيم، شنّان وثوْره العملاق، امرأة العشب وبناتها والشاغى وأكفانه. القصص تشبه الدوائر كما هو الحال فى ألف ليلة وليلة، وقد استخدم نجيب محفوظ هذه التقنية فى روايته «ليالى ألف ليلة» فهل أردت أن تسيرى على دربه؟
قد يتذكر أحدهم شخصيات نجيب محفوظ السبع عشرة فى روايتة ليالى ألف ليلة»، تلك الشخصيات التى قد تبدو منفصلة خارجيا ولكنها متصلة ببعضها البعض بجذر عميق، وهذا ما قد يتبدى فى قصص المنسيين حيث يبدو أن لكل منسى حكايته الخاصة، لكن يشدهم جميعا جذر واحد اسمه الذنب. الذنب الذى مهما بدى مختلفا إلا أنه يقود لمصير واحد، النفى إلى جبل الغائب.
نجيب محفوظ كان أكثر منى إخلاصا لعوالم ألف ليلة وليلة ابتداء من العنوان وليس انتهاء إلى المتن واللغة وأسماء الأبطال، بينما أكاد أجزم أنى فى روايتى هذه لم أستعر من «ألف ليلة وليلة» أكثر من التكنيك والتقنيات التى تجعل النقلات الزمنية والمكانية والتحولات العجائبية أمرا مستساغا. كما أن لغتى أستطيع أن أصفها بأنها عصرية وبسيطة، فلم أشأ أن أجعلها تبدو قديمة حتى ونحن نقرأ مذكرات الجدة الثالثة الثمانين، لأننا فى حقيقة الأمر نقرأ القصة التى عثرت عليها الكاتبة البطلة بعد أن أصيبت لفترة طويلة بما قد يطلق عليه حبسة الكتابة.
ولذلك فهى تعيد رواية الأحداث فى ثلاثة مستويات من الزمان والمكان، حيث يغدو دخول هذه الكاتبة فى غيبوبة هو المتحكم فى آلية التنقل بين مستوى حياتها الواقعى، ومستوى حياتها مع الجدة الأولى، ومستوى قراءتها لمذكرات جدتها الثالثة والثمانين .
يقدم نجيب محفوظ الفانتازيا والأساطير التى يمكن أن يُعاد تأويل إسقاطاتها على حياتنا إلى اليوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهذا ما يُضفى على روايته صبغة إنسانية وهذا ما أصبو لتحقيقه.. أن تتمكن هذه الحكايات شديدة الخصوصية بالجغرافيا التى أنتمى إليها، أن تلقى الصدى فى روح كائن عاش فى ثقافة وظروف مختلفة. ذلك الذى يعنى أنك تخرج من بصمتك ومحليتك إلى فضاء المشترك الإنسانى.
«إذا تمكنت من قراءة مادة مكتوبة دون جهد يذكر، فهذا معناه أنّه تم بذل جهد كبير عند الكتابة»، هذا ما يقوله الكاتب الإسبانى إنريكى جارديل بونشيلا، وفى هذا تتجلى صورة الأدب الذى ننشده.
كان هناك حرص كذلك على أن تكون كل حكاية منفصلة بذاتها.. فهل يمكن قراءة العمل كقصص قصيرة؟
لقد أشار باختين فى أحد مقالاته إلى أنّ الرواية هى عمل غير مُنته فى تكونه، وهذا يُعيدنا لما كنا نقوله سابقا، الرواية هى من أكثر أجناس الكتابة استيعابا للتجريب فى الأشكال والتقنيات، ولطالما قرأنا روايات قد لا تبدو ضمن صورتها النمطية.. بمعنى: البداية والعقدة والخاتمة.
وإنّما تغامر لاجتراح طبقات من الحكى، تغامر فى بناء الشخصيات والأحداث والتقنيات بصورة خارج التوقع وخارج الاحتمالات.
والتجريب بطبيعة الحال لا يرتبط بجيل الشباب، لقد قرأنا ما يمكن أن نسميه حداثة الأسلاف أيضا، فوجدنا ذلك حاضرا فى كلاسيكيات الأدب العالمى والعربى أيضا. الأمر أيضا لا يقتصر على الأشكال وإنّما يتجاوز ذلك إلى الوعى الجمالى، ويتأثر بصورة لافتة بآليات التلقى التى تنظر فى ممكناته ومراميه الأبعد.
صحيح أنّ الشخصيات فى روايتى تظهر مستقلة ومنعزلة عن بعضها البعض خارجيا، ولكن آثامها وآلامها ووحشتها تشد بعضها إلى بعض، وأكاد أجزم بأننا لا يمكن أن نفهم هذه الشخصيات فى سياق الاجتزاء وإنّما فى سياق الحكاية العام.
عرفنا فى النهاية أن السحرة كانوا يأكلون لحم المحكوم عليهم بالنسيان.. هل أسوأ ما يمكن أن يحدث للإنسان هو النسيان؟
لا توجد حقيقة واحدة نهائية تقدمها الرواية بشأن الذين ذهبوا إلى جبل الغائب. لا ينبغى أن نصغى للنتيجة التى خلص إليها «الضحاك» باعتبارها الحقيقة التامة. لقد قال «ألماس» إن كل واحد منا يمكنه أن يرى الحقيقة التى يريد أن يراها.
المعنى السطحى الأولى أنّ المنسيين ذهبوا لبطون السحرة، إنّه المعنى الذى تنتجه المخيلة الشعبية، ولكن ثمّة طبقات من الحكى ينطوى أسفلها جوهر المعنى. ليس بالضرورة أنّى أملكه باعتبارى كاتبة النص.. فكل واحد منا سيعثر على المعنى الذى يظنه اليقين.
لماذا منحت المرأة دور البطولة المطلقة فى الرواية وجعلتها هى من يقوم بهدم الحصن على سيده الجبار ومساعده «ألْماس»؟
لم أخطط للأمر، وإذ بى أصل إلى هذه النتيجة بعد أن سلمتُ العمل لدار النشر. ربما لأننا نجيد التعبير عن المشاعر والأحاسيس والعذابات التى تشبهنا أكثر. إيزابيل الليندى قالت ذات مرّة: «على مرّ السنين، اكتشفتُ أن كل القصص التى رويتها، وكل القصص التى سأرويها مرتبطة بى بشكل أو بآخر»، فمن يدرى، ربما ثمّة ما يتسربل من ذواتنا ونحن نحيكُ شخصياتنا.
ثم تساءلتُ بشىء من الامتعاض: هل كان سيغدو الأمر طبيعيا لو كان المخلصون من الشرور هم رجال! أتساءل أيضا حول إن كان الكُتاب من الرجال الذين يكتبون أعمالهم ببطولة رجالية مطلقة، أتساءل إن كانوا يتعرضون لسؤال مماثل!
وعودة لبطلاتى أقول: بقدر ما تبدو بطلاتى راغبات فى التنصل من فخاخ الحياة، بقدر ما هنّ جامحات أيضا، وبقدر ما تنطوى ذواتهن على انكسارات مُركبة، بقدر ما يشبهن العجز العام الذى نعبره فى حياتنا الواقعية.
هل ترين أن أدب المرأة العمانية يُنظر إليه الآن بعين الاهتمام؟
أصدّقُ سيمون دى بفوار حين قالت فى كتابها «الجنس الآخر»: «المرأة تولدُ إنسانا، ثم يجعلها المجتمعُ امرأة»، ولذا نجابه دوما أسئلة تحاول دائما وضع أدب المرأة فى سلة منفصلة!
فى الحقيقة لا أميل لتصنيف الأدب، أدب امرأة وأدب رجل، فهى إما أن تكون كتابة جيدة أو لا.
ولكن لو سايرتك قليلا فى السؤال، سنجد أنّ المرأة فى عُمان لديها مشروع رصين، وأنها تحدث نقلة نوعية تحديدا فى الرواية، ويكفيك أن أذكر اسمين جلبا أنظار العالم والوطن العربى لهذه البقعة التى لطالما نظر إليها الآخر كهامش خارج الرهانات الكبرى.
وأعنى جوخة الحارثى وبشرى خلفان. بالإضافة إلى تجارب مهمة فى القصة والشعر والترجمة. أستطيع أن أسمى عددا جيدا ممن تبلورت تجاربهن ومشاريعهن ولديهن دأب ومثابرة واستمرار.
فى البدايات الأولى ربما نشعر بفجوة زمنية لها أسبابها بالتأكيد، فأول مجموعة قصصية «سور المنايا» عمانية صدرت فى 1981 للقاص أحمد بلال، بينما أول قاصة عُمانية ظهرت بعده بـ18 عاما، وهى القاصة خولة الظاهرى فى مجموعتها «سبأ»، وفى الرواية كانت أول رواية لعبدالله الطائى «ملائكة الجبل الأخضر» فى عام 1958، بينما أول رواية للمرأة كانت «الطواف حيث الجمر» لبدرية الشحى عام 1999.
ومرد الأمر يعود إلى شكل الحياة قبل السبعينيات من القرن الماضى، وفرص الرجل الأوفر حظا بالدراسة والعمل فى الخارج، الأمر الذى أنضج تجربته وانفتاحه على العالم بصورة أسرع، بعكس المرأة حبيسة البيت والعادات والتقاليد، لكن ما إن ظهر جيل الجامعة حتى عوضت المرأة هذا التأخر بصورة فارقة.
ما ملاحظاتك على أدب المرأة العربية بشكل عام.. وهل الكاتبات يستطعن مناهزة الأدب الذى يكتبه رجال؟
أمام النص الجيد ليس علينا أن ننظر إلى جندر كاتبه، قدر ما علينا أن ننظر إلى إمكانيات النص: عذوبته، قدرته على أن يجعلنا نقشعر لأى سبب من الأسباب.
لا أميل لاختصارنا فى مصطلح ضيق اسمه «أدب المرأة»، حتى وإن كنا معنيين- بدأبٍ شديد- بالكتابة عن النساء وتحولاتهن النفسية والحياتية. فالمرأة الكاتبة، تمتلكُ حساسية عالية تجاه تفاصيلها الصغيرة. تنشغل أكثر بالتفاصيل المنسية والمتغافل عنها فى حياة النساء.
وفى علاقات الأمومة، فكل كاتب بطبيعة الحال ينطلقُ من خبراته الفردية، مما يعى ويعرف ويتماس بشكل يومى، وبالتالى تُقدم المرأة مقترحها الجمالى الخاص والفريد، كما أن الرجل يكتب عن قضاياه وهمومه بين عميقها وتافهها، فمعيار الكتابة لا يرتهنُ بجندر.. هنالك كتابة جيدة وهنالك كتابة رديئة.
وبالمقابل لستُ من أنصار الرواية النسوية التى تُستعمل لبث الرسائل المحتقنة، عن أوضاعها وما تتعرض له من قمع، تلك التى تقدم تصورات مؤدلجة عن الرجل العدو. إنها أكثر الروايات فشلا.
على الرواية أن تمتلك منطقها الخاص وبناءها النفسى العميق للشخصيات وتحولاتها، فلا تجعلنا أمام نوايا جاهزة ومضمرة سلفا من قبل الكاتب أو الكاتبة.
الكتابة ليست سباقاً بين الرجال والنساء ليست انتصارات وهزائم. الكتابة أبعد من ذلك بأشواط.
أنت متزوجة من كاتب هو الاعلامى وكاتب المسرح هلال البادى .. فما تأثير ذلك الإيجابى والسلبى عليكما؟
نحن كأى اثنين فى الحياة يقضيان الوقت تحت سقف واحد، معرضان للحب والغضب والملل والروتين. ولكن ما يجعل الأمر يمضى على نحو جيد، يكمن فى أنّه لدينا دوما ما نقوله لبعضنا البعض. لدينا دوما ما نتحدث عنه.. الكتب والأخبار والمشاريع الجديدة والنمائم الطازجة والأفلام.
من وجهة نظرى.. العلاقات الأكثر متانة هى تلك التى تتغذى بالأحاديث التى تأتى من منابع مختلفة لتصب فى بيت ما، فيتوهج بالدفء وإلا فما الذى يجعل أحدهم يكمل الطريق قابضا على يد الآخر، ذلك الذى لا يبادله فكرة أو حلم مهما بدا ضئيلا؟!
هنالك أرضية مشتركة على الرغم من اختلافنا فى كل شىء، ابتداء من ذوقنا فى الأفلام والكتب والكُتاب المفضلين وليس انتهاء فى الطرق التى نطهو بها الطعام أو نتعامل بها مع المشكلات التى تواجه العائلة، وأبناءنا المراهقين.
نجلس فى المقاهى لساعات طويلة دون أن نتبادل كلمة لننجز أعمالنا كغرباء، ثمّ ننخرط فى أحاديثنا اللانهائية.
هلال البادى هو أكثر شخص أثق أنّه يقول رأيه الحقيقى فيما أكتب بتجرد تام من أى عاطفة، ولا أبالغ لو اعتبرته القارئ الأول والناقد الأول منذ أول مجموعة قصصية وحتى آخر رواية صدرت لى. هو الحريص على أن تظهر أعمالى كما لو كانت أعماله. أحبّ دائما أن أستعير هذه الجملة التى قالها الشاعر الأمريكى دونالد هول عن زوجته جين واصفا علاقته بها: «نبقى اللاتنافسية بيننا».
لقد شاهدتُ تجارب مزعجة من الإخفاء القسرى لكاتبات، محاولة إبقائهن فى الظل لأسباب عقيمة. محاولة تحجيم أدوارهن فى الأمومة!
صحيح لدينا أربعة أبناء، ومسؤوليات، لكن كل واحد منا يُقدر أنانية الكتابة لأنّه يخوض غمارها. لسنا مثاليين، لدينا مشاكلنا، ولكننا كثيرا ما نفككها بالحوار أو بالصمت عنها.
تجربة الأمومة ما الذى أضافته إليك ككاتبة؟
لو سألت أبنائى عن أكثر الألعاب التى لعبناها معا. ستكون لعبة تحول الأم لوحش بسمات نصف بشرية، يُضفى الأبناء على هذا الكائن الذى يُحضر لهم الطعام ويلبسهم البيجاما ويعد لهم السرير، سمات جديدة كل يوم من أخيلتهم الصغيرة. كائن يصدر أصوات عجيبة ويعبر البيت متجولا باحثا عن الأبناء المختبئين خلف الستائر والأبواب والصوفا وتحت الأسرة. ينمو الكائن العجيب فى البيت بسبب كل ما يُحكى عنه، وهذه اللحظة أتأكد حقا كم تختلط الأمومة بالكتابة.
لو طلب منى أن أعثر على تجربة مشابهة بدرجة لا يمكن إنكارها لتجربة الكتابة، فإننى دون أى تردد سأقول الأمومة. فهما تجربتان متشابهان ومتقاطعان بشكل لا يمكن تصوره، ليس من السطح وحسب، إذ لا يمكننى بأى حال اختزالهما فى فكرتى الحمل والميلاد..الحمل بطفل يعادل حمل أفكار وشخصيات.
وإنجاب كائن فى الوجود يعادل نشر كتاب. المسألة أكثر عمقا من ذلك، وقد تتجلى فى إحدى صورها فى تلك المخاوف من ترك بصمة منك سابحة فى هذا الوجود، أو عندما يملك الآخر سُلطة أن يقول رأيه وانطباعه، أو أن يدلى بأحكامه مهما تبدت قسوتها، بينما تئن أنت من الداخل. والأكثر رعبا هو اليقين أنّ كل ابتسامة أو نظرة غضب، كل كلمة أو سلوك سيُشكل ذلك الكائن القادم إلى الحياة وسيصنع مستقبله، كما أنّ كل لهاثك فى بناء شخصياتك، تحولاتها النفسية، كل ما تبنيه من أماكن وخطوط زمنية يمكن لقارئ مفترض قادم من الغيب أن يشعرك بتفاهتها، كما قد يحدث العكس تماما.
فى مكان غامض تأتى لحظة الانفصال التدريجى لابن عن أمه، كما قد ينفصل الكاتب عن كتابته فتغدو ملك القارئ ويصبح الكاتب ميتا وعدما!
فى تلك المحاكمة الأبدية تتبدى صنوفٌ لا نهائية من الأمهات، فما بالك لو كانت الأم كاتبة، تشكل عجينة أبنائها بحذر كما قد تفعل مع نصوصها، فتخشى من أثر مفردة أو تلميح!
تحاول الأم بدأب مضاعف الاقتراب من الصورة المثال للأمّ المُقدسة المُضحية والمتضائلة لأجل الكائن الجديد القادم إلى الحياة، كما قد يتضاءل أحدنا فى انكباب طويل لمشروع يضع فيه كل حياته.
وأظن أنّ الأمّهات العاملات الحالمات مثلى اللواتى يعشن ردحا من الزمن يرجمن أنفسهن بالشعور بالذنب. لطالما تعذبتُ بهذا السؤال: هل يتمزقُ نسيج الأمومة بسبب الركض وراء الأحلام الشخصية؟!
تقول إيمان مرسال: «أكثر ما يوحدنا كأمهات هو الشعور بالذنب». مع الوقت بدأت أيقن أننا سنخدش نسيج الكائن الجديد، وأننا سنزرع أفكارا ونناقضها بأخرى!
بقدر ما أنا مولعة بفكرة الأمومة، وبهذه الكائنات القادمة والممتلئة بشغفها، بقدر ما أحتفظ بحيز جيد من الأنانية. الوقت المحدد للقراءة والكتابة. مع الوقت صاروا يتفهمون أهمية هذه المسافة بيننا. يعون أنى سأعود إليهم أكثر خفة.
تقول أليس مونرو: «كنتُ أكتب بهوس أثناء الحمل ظنا منى أننى لن أستطيع أبدا أن أكتب بعد ذلك. كان كل حمل يحفزنى على إتمام شيء ضخم قبل أن يولد الطفل. وفى الحقيقة لم أتم شيئا ضخما قط». وهذا ما كان يحدث معى تماما فى كل حمل.
متى اكتشفت أنك كاتبة ومن شجعك على الاستمرار؟
فيما لو كنا نتحدث عن التأليف فقد بدأ الأمر قبل المدرسة، وقد تجلى بوضوح فى الأكاذيب والخيالات التى لم ترق لعائلتى ومعلماتى بادئ الأمر. ولا أدرى إن كان بإمكاننا أن نعد ذلك تأليفا على أى حال!
تبدى لى لاحقا أنى كنتُ أصغى إلى إيزابيل الليندى بقلبى قبل أن أكون قد قرأتُ هذه الجملة حقا: «بما أنكِ تكذبين كثيراً، لماذا لا تتجهين إلى كتابة الرواية؟ فهذه النقائص تتحول إلى فضائل فى الأدب».
فوجدتنى لا أترك صفحة فارغة فى دفاترى دون أن أعبئها بنتف الأفكار المتسارعة فى رأسى، تلك الأفكار التى سرعان ما تُعدم بين أصابعى وتذهب لأقرب سلة مهملات.
لم يكن حولى من يرى أى أهمية تذكر، لأن تحبس الفتاة نفسها فى الغرفة لتدون قصصا، أو تذهب نهاية الأسبوع برفقة والدها لزيارة المكتبات التى تندر فيها الكتب فى منتصف ثمانينيات القرن الماضى، إذ يمكننا فى الحقيقة أن نعدها دكاناً لبيع الأدوات المدرسية.
هكذا كما تقول رضوى عاشور: «الكتابة تأتى من تلقاء نفسها، فلا يتعيّن على سوى أن أقول: مرحباً، وأفسح لها المكان».
كتبتُ ذات مرة أننى عندما كنتُ صغيرة جدا ومُحبطة، ظننتُ للحظة أننى الفتاة الأكثر تعاسة فى العالم. تراودنى رغبة الكتابة بشدة وكل من حولى ينظرُ إلى الأمر بشىء من الغرابة والاستهجان. «لا يمكن لأحدنا أن يتمنى أن يكون كاتبا. ذلك على الأرجح لا يعنى شيئا ولا يمثل قيمة».
ألجأ إلى سطح بيتنا وأبقى وحيدة لساعات، أفكر فى ضرورة التخلى عن دفاترى الزرقاء ومذكرات يومياتى التى كنتُ أكتب فيها بدأبٍ شديد. حرقتُ أغلبها فى لحظات غضبى برفقة صور تعود لطفولتى الأولى. تنمرُ بعض زميلات المدرسة -دفعنى لذلك- كن ينظرن إلى أمنيتى الصغيرة التى سجلتها بتصميم فى كل كراساتى المدرسية «الكاتبة الصغيرة»، على أنها فسحة جيدة لمزاح ثقيل.
أتذكر الآن كل تلك الدموع التى سببها الدخان والحزن فى آن، وأنا أحرق كل ما كتبته فى سنوات الابتدائية والإعدادية.
ولم يُعِد إليّ الأمل سوى «جو مارش» فى المسلسل الكرتونى «نساء صغيرات» المأخوذ عن رواية لويزا ماى ألكوت، جو مارش التى كتبت وقت الحرب والفقر والحاجة. كم أنا مدينة لها حتى اللحظة. ويبدو أنى تعلمتُ شيئا مهما من هذه التجربة، وهو ألا أنتظر أحدا ليلتفت إلى أو يصفق لى، وكما تقول شارلوت برونتى: «سأقوم بالكتابة؛ لأننى لا أستطيع التوقف».
من الروائيين والشعراء على المستوى العالمى الذين تفضلين. القراءة لهم ولماذا؟
الأسماء التى أقرأ لها متغيرة. لا يوجد ثبات معين. فى كل مرحلة عمرية كان لدىّ شغف ما. فى الطفولة الأولى تأثرتُ كغيرى بالمكتبة الخضراء، وفى المراهقة بسلسلة الروايات البوليسية، وما إن انفتح الطريق أكثر حتى وجدتُ القراءات تتغير وتمضى من كلاسيكيات الأدب العالمى المترجم، انتقالا للأدب الحديث أو العكس، ويحصل أن أمقت الآن من التجارب ما ظننتُ أنى مغرمة بها وسأحبها إلى الأبد، كما أن العكس أيضا وارد.
وأخيرا لماذا تكتبين وما طموحك من الكتابة؟
تتجلى وراء الدوافع الأولى والباكرة لنزوعنا إلى الكتابة، رغبة ملحة للاختباء من الخيبات، من الحساسية المرهفة التى تجعلنا فى غاية الهشاشة، فنشعر طوال الوقت بقابليتنا للكسر.
لقد وجد كافكا فى الكتابة شكلا من أشكال الصلاة، ووجدتها تحفظ توازناتى كبهلوانٍ يقف على خيط الحياة الرقيق، تُحركه الريح من كل اتجاه.
تمكثُ الكتابة وراء التوهجُ الذى يقترحه الجمال والقبح على حد سواء، والمضى والتعثر الذى يعبر حياتنا، فالكلمات تجعلنا ننكشفُ فى المرايا اللانهائية لأرواحنا، وعند تخلى الأشخاص والأشياء عنّا تنبعثُ كلّ المؤازرة الشفافة من الكتابة وعبرها وليس من الآخرين!
الكتابة عمليّة معقدة. ليست مجرد هرولة عابرة لرص الكلمات، إنها جرح لا يبرأ، ويبدو أنّ مجرد التفكير بفقدانها يعنى فقد أى أهمية فى العيش! وسأتذكر هنا ما قاله أورهان باموق: «أكتب لأنّنى لا أستطيع تحمل الحقيقة إلّا وأنا أغيّرها»، ونحن نغير الحقيقة دوما فى ألاعيبنا السردية، نحن نمارس الخلق، فنتبدى فى أكثر صور الحياة تكثيفاً ورعباً.
لطالما قلت: أفتقدُ الشعور بالغاية. لا أملكُ إجابات مُحددة تجاه غاياتى. لكننى فى آن أتشبثُ بالمغامرة صوب أشكال من القراءات والكتابات، فاللحظة الوحيدة التى يلمع فيها أهمية وجودى على هذه البسيطة هى لحظة الكتابة واعتمالها فى الرأس كمطرقة حداد أو انفراجة ساعدى راقصة باليه.
اقرأ ايضا | إبراهيم عبدالمجيد يكتب: لا استطيع قول الوداع

الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
الدكتور علي بن تميم أمام مؤتمر الناشرين العرب : نسعى لتعزيز حضور للغة العربية
 الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد
 الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»
 مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية
 شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»
 في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى
 الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل
 صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح
 «هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز
«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز