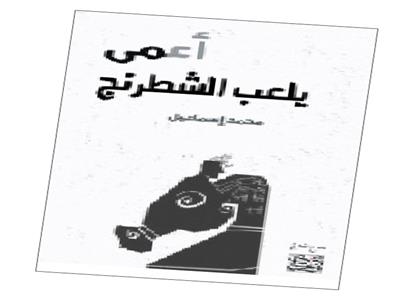
صورة موضوعية
محمد سالم عبادة ..أعمى يلعب الشطرنج:أبو العلاء يُحادثُ نفسَه
الإثنين، 24 يونيو 2024 - 02:33 م
فى نصّه المسرحى الشِّعرى «أعمى يلعب الشطرنج» الصادر عن دار موزاييك فى تركيا، والحائز على جائزة الأمير عبد الله الفيصل للمسرح الشِّعرى، يُقيم الشاعر محمد إسماعيل سويلم حوارًا عبر خمسة مَشاهدَ مسرحيةٍ، بين أبى العلاء المعرّى ونفسه فى المقام الأوّل، وبينه وبين خاصّته ثانيًا، وبينه وبين العامّة ثالثا.
ويَحدث ذلك على خلفية سيرورةٍ زمنيةٍ معكوسةٍ، إذ يبدأ النص بالمعرّى لحظة احتضاره، ثمّ نراه شيخًا يستطلع ما يَحدث خارج جدران بيته من خلال صديقه (أبى القاسم) الذى يعتبرُه عينَيه، ثم نرى أبا العلاء الشابّ يظهر لأبى العلاء الشيخ فى سوق معرّة النعمان، لحظة اكتشاف الشيخ أنّ الغوغاء قد قتلوا خادمَه مالِكًا لأنه بزَعمهم يخدم شيخًا زنديقًا، ثمّ نرى أبا العلاء الشابّ يقابل أبا العلاء الطِّفلَ وهو يلاعبُ نفسَه الشطرنج، ثمّ نعود بالزمن إلى الوراء فإذا أبو العلاء الطِّفل يحدِّث الناس فى السُّوق عن العتمة والنُّور وهم ذاهلون ممّا يتفوّه به من الحكمة ويتساءلون إن كان ابنُ القاضى (عبد الله بن سليمان) أعمى، وأخيرًا نرى الطِّفل يصارعُ آلامَ عينيه وهو يَفقِد البصر بين لوعة أمِّه وحيرة أبيه.
شخصيًّا ذكَّرَنى النصُّ عملًا أدبيًّا آخَر، موضوعُه عبقريّةٌ إنسانيةٌ تضارع عبقرية أبى العلاء، جعلَ كاتبُه بطلَ العمل يقابل نُسَخًا منه فى مَراحل عُمريّةٍ متباينةٍ، والنُّسَخ كلُّها مجتمعةٌ فى غرفةٍ واحدةٍ من غُرَف منزل البطل! كان هذا العمل هو قصّةً بعنوان «أﭘـاسيوناتا» من المجموعة القصصية «الرِّجال Y» لكريم الصيّاد، وكان موضوعها وبطلُها هو بيتهوﭬـن، الذى جعلَه القاصُّ يَفتح ثغرةً فى الزمن من خِلال تأليف السوناتا 23 المسمّاة «العاطفيّة» Appassionata، تلك التى ألّفها بعد أن أدرك أنّ فقد السمع التدريجيّ الذى كان قد بدأ يحسُّ به هو فقدٌ نهائيٌّ لا رجعة فيه.
لكن، بينما كان مُنطلَق القصّة يتماسّ مع الخيال العلميّ، كونَه مبنيًّا على فكرة أنّ الموسيقى نحتٌ فى نسيج الزمن، لا يكاد يخطر خطُّ الخيال العلميّ ببال قارئ المسرحية إلّا مِن بعيدٍ، ومرَدُّ هذا إلى اللغة الشِّعريّة المهوِّمة التى اعتمدَها شاعرُنا فى بناء نصِّه، والتى تحلِّق حول المعانى دون أن تَطرُقها مباشَرةً، فضلًا عن أنّ هاجس الخيال العلميّ ربّما لا يكون قد خطر ببال الشاعر أصلًا وهو بصدد كتابة نَصِّه، فالظاهر أنّه كان مهمومًا ببَلوَرة فكرةٍ مفاجئةٍ للمتلقّى، تكسِر نمطيّة قالَب المسرحية الشِّعرية المبنيّة على سيرةِ شخصيّةٍ تاريخيّةٍ شهيرةٍ مُثيرةٍ للجدَل.
والمفارقة التى قد تلوح للقارئ هى أنّ موقف الشيخ من الوجود لحظة احتضاره –لحظة ابتداء أحداث المسرحية- موقفٌ يرى بوضوحٍ عبثيّة الوجود، يلخّصها البيت الذى يُنطقُه به شاعرنا «لا شيءَ.. تولدُ نقطتان من الفَراغِ، وها فَمى المنسيُّ بينهما بَريدُ» فهو هنا آتٍ من العدم وصائرٌ إليه، وقد ملأ ما بين العدمَين كلاما. وأمّا موقفُه لحظة يَتِمُّ فَقدُ بصر الطفل فى المشهد الأخير فهو موقفٌ يَحتفى بإدراكٍ مُوازٍ للعالَم، محجوبٍ عن أعيُن المُبصِرين، فنراه يقول: «هذى أكوانٌ تتفتّحُ قُدّامى كالوردةِ، حمراءٌ خضراءٌ صَفراءْ/ هذى صُحُفٌ تتطايرُ قُدّامى تتزيّن بالأشجارِ وبالشُّعراءْ/..إلخ».
كما نراه يقول فى مناجاته الختامية: «النُّورَ النُّورْ/ يا ناسُ إلى النُّورْ/ فالعتمةُ سُورْ/ إلخ»، فيما يشبه التناصّ مع قول سيد حجاب فى أغنية مقدّمة مسلسل (الأيام) عن المكفوف العظيم الآخَر د. طه حسين «العتمة سور والنُّور بيتوارى/ وايش للفَقارَى فى زمان النوح/ ميتى تخطّى السور يا نوّارة/ ويهلّ عطرك ع الخلا ويفوح»، فالعتمة فى قول الطِّفل أبى العلاء هى ما يعيشه الناس من حَوله، والنُّور هو ما يبشِّرهم هو به من نُور العقل.
والشاهد أنّ شاعرنا يأخذ بيَد أبى العلاء من حكمة الشيخوخة اليائسة إلى تفاؤل الطِّفل الذى لا يخلو من عِرفانٍ، إذ يرى فى مأساة فَقده بصرَه بُشرَياتٍ بإدراكٍ محجوبٍ عن الآخَرين. وخلال هذه الرحلة يُخرج شاعرُنا من جِلد الشيخ أبى العلاء فور إسلامِه الرُّوحَ أطيافًا خمسةً تَزعمُ أنّها تناقُضاتُ كِيانِه «نحنُ أنتَ: النارُ والمَطرُ/ وكلُّ ضِدٍّ بضِدٍّ باتَ يَستترُ/ وما تناثرَ من صحراءِ أخيِلةٍ/ بها ستنمو مرايا ثُمَّ تنكسِرُ..إلخ»، وحين يسألهم عمّا يريدون منه يجيبونه «بعضَ فلسفةٍ، وحيرةً، وسؤالًا ما لهُ أثَرُ».
وقبل أن تختفى هذه الأطياف، يقول لهم الشيخ «أنا هَباءٌ» فيردُّون «ستعلو منكَ مُعجِزةٌ .. ونَبعُ شِعرٍ على كفَّيكَ يَنفجِرُ»، أى أنهم يكُفُّون عنه حكمته اليائسة، مبشِّرين بتفجُّرٍ بلاغيٍّ بيانيٍّ على يَدَيه.
لكننا لا نعرف أبدًا مسوِّغات هذه البُشرَى! أعنى أنّ حياة أبى العلاء – سواءٌ أكانت الواقعيّة أم المسرحية فى هذا النصّ- قد انتهَت بمُنجَزٍ بلاغيٍّ ضخمٍ، ورغم ذلك يشعر الشيخ بتهافُت مُنجَزه ويقرِّر أنه ليس إلا هَباء.
فهل تتمثّل مُصادرةُ شاعرنا على تلك السيرورة القدَرية فى أنه يَستدرِك على أبى العلاء حكمته اليائسة، ويَبعثُ فينا نحن القُرّاء تفاؤلًا بما قد تَفتحُه العُزلةُ (فى العمى والعُزلة الاختيارية التى مال إليها رَهينُ المَحبِسَين) من إدراكاتٍ مُفارِقةٍ للمألوف؟ لكنّ كُنهَ هذه الإدراكاتِ المُفارقةِ نفسِها يَحوم دائمًا حول مبادئ تلك الحكمة اليائسة! فحتّى الصوتُ غيرُ المعرَّف مسرحيًّا، ذلك الذى يستعين به شاعرُنا لإنشاد أبياتٍ معروفةٍ لأبى العلاء تتقاطَعُ وسَيرَ الأحداث، يَختارُ من شِعر شيخ المعَرّة أبياتًا مثل:
«تعَبٌ كلُّها الحياةُ فما أعجَبُ إلّا مِن راغبٍ فى ازديادِ»
و«غَيرُ مُجدٍ فى مِلّتى واعتقادى .. نَوحُ باكٍ ولا تَرنُّمُ شادِ»
و«خَفِّف الوَطءَ ما أظنُّ أديمَ الأرضِ إلا مِن هذه الأجسادِ»
إلى غيرها من أبياتٍ ناطقةٍ بحكمة أبى العلاء اليائسة.
ولدينا علامتان فارقتان فى أحداث المسرحية، أو لعلّهما العلامتان الواعدتان بتوجيه دفّة قراءتنا. أولاهما هى اغتيال خادم الشيخ، وثانيتُهما لَعِب أبى العلاء الطِّفل الشِّطرنجَ مع نفسه. فأمّا اغتيال الخادم فقد تلقّاه أبو العلاء متوجِّعًا، ويشاركه صديقُه أبو القاسم التوجُّع، فيقول مبالِغًا: «تعالَ نلملِم ما يتناثرُ من ضوءٍ من عينيهِ ونزرعه بعيون الجيل القادمِ حتى تتبدَّد كلُّ الظُّلمةِ من أمَّتِنا!» ويواصل أبو العلاء نغمة المبالَغة فى المشهد التالى، فيقول وهو جاثٍ إلى جوار خادمه المقتول «وأنا لستُ سِوى ظِلٍّ للجسَدِ المُلقَى فى الأرضِ، فماذا يمكنُ أن أكتُبَ؟ لُغَتى ماتت فى عينَيهْ...إلخ» وصولًا إلى قوله «يوجِعُنى أن يُسفَكَ دَمُ معنايَ بسِكِّينِ التأويلْ. هذا ليسَ قَتيلْ! هذا معنايَ وقد ملأَ الرَّملَ بحُمرتِه! هذا معنايَ وقد أصبحَ شُعلةَ ضوءٍ لن تَخفُتَ أبدا!»
فهل يبكى المعرّىّ تأوُّلَ المتلقّين شِعرَه ونثرَه، وقد جسّدَهما شاعرُنا فى صورة الخادم المقتول؟! فى فقرةٍ سابقةٍ يدافع المعرّى عن نفسِه فكرةَ أنّه تجرّأ فى «رسالة الغُفران» على الموتى من الشعراء بأن تأوَّل شِعرَهم، فيقول إنه لم يتجرأ على إنسانيتهم، بل غاص فى شِعرِهم، والشِّعر مشاعٌ وإن كان قائلُه واحدا.
فهل نعتبر اغتيالَ الخادِم تنبيهًا أرادَه شاعرُنا للمعرّى، بأنّ كُلَّ تأويلٍ هو محضُ قتل؟ لو كان هذا هو المُراد، فهو غير مقترنٍ بأية مبرِّراتٍ هنا. أمّا إن كان المراد من قول المعرّى «هذا معناى وقد ملأ الرملَ بحُمرته!» أنّ الوجه البريء من العامّة – ممثّلًا فى الخادم- هو حقيقةُ أبى العلاء الدفينةُ رغمَ نُخبويّة فَنِّه واعتزالِه الخَلقَ، فإننا لا نجد فى النصّ كذلك أيّة مبرّراتٍ يسوقها الشاعر بين يدَى هذا الافتراض. وأمّا إن كان المُراد غير ذلك، فما عسى أن يكون؟!
فإذا تركنا هذه إلى علامة لعِب أبى العلاء الطفلِ الشطرنجَ مع نفسِه، فسنجدُ الطِّفل يحادث ما قد يكون صديقَه التخيُّلىّ فى البداية «هذا فوزى العاشرُ هذا اليومَ، فما بك؟»، وسرعان ما يشتبك أبو العلاء الشابُّ مع أبى العلاء الطِّفل فى حوارٍ حول رُقعة الشطرنج، فيقول عنها الطِّفل «الرُّقعةُ مِثلُ حُروفٍ متناثرةٍ، لا تُخبرُ شيئًا، لكن لا أحدٌ يَقدرُ أن يُخبرَ شيئًا إلا باستخدامِ مَداها» كما يقول «البَيدقُ مِثلُ حُروف المَدِّ، الألف، الواو، الياء.
ما أكثرها فى الكلمات وفى الأسماء وفى الأشياءْ» وعن الحصان يقول «سَلِسٌ كالسِّينِ تمامًا، يتقافزُ فى الكلماتِ كهمسٍ ليليٍّ، يتسلَّلُ فى أذنِ السامعِ كالماءِ النَّهريِّ على رَملِ الصحراءْ»، ثمّ يعقِّب على تعجُّب الشابّ من بساطة الدنيا فى عينيه بقَوله «لا أعرفُ ما الدنيا، لا أعرفُ إلا هذى الرُّقعةْ. الدنيا فى اللفظِ مؤنَّثُ أدنَى!»
هكذا يُحيلُ شاعرُنا الوجودَ الطبيعيَّ فى وعى أبى العلاء الطِّفل إلى وجودٍ لُغويٍّ محض. وهذا الطِّفل لعبتُه الوحيدة وتسليتُه هى رُقعة الشِّطرنج التى تجسِّدُ الحُروف وأدوارَها فى بناء الكلام. ولعلّ هذا المَشهد هو أوفرُ مَشاهد النَّصّ حظًّا من التوفيق، فهو اختزالٌ غيرُ مُخِلٍّ لجَوهَر ذلك العملاق الفريد فى تاريخ الأدب، كونه شخصًا استعاضَ عن الوجود الحقيقيّ للعالَم بالوجود فى اللُّغة، فعاشَ فيها بكينونته كلِّها رهينَ مَحبِسَيه. وما أنجزَه إسماعيل سويلم فى هذا المَشهد هو أنّه عادَ باختيار أبى العلاء الواعى هذا إلى طفولته، كأنه يبحث عن جذور هذه العُزلة فى سِنِى تكوُّن وعى أبى العلاء.
وحسنًا فعل الشاعرُ إذ استعان بهذا المَشهد الثالث فى تسمية نَصِّه، فهو المَشهد الأبرَز حَقًّا، وودِدتُ لو كان قد استفاد من مفرداته فى رسم الخطّ العامّ للنَّصّ، ولو كان قد فعل هذا لكُنّا قد وجدنا مقدِّماتٍ لهذا المَشهد الذروة فى المشهدين السابقَين عليه، وأصداء له فى المشهدين التاليين له، لكنّه للأسف لم يَفعل.
وأخيرًا، فالنّصُّ يَنطق بنفَسٍ شِعريٍّ مسرحيٍّ طُلَعَةٍ، يتلمّس طريقَه فى دُروب التاريخ، المَعين المفضَّل لمُبدعى المسرح، ولاسيّما المسرح الشِّعرى، ويَعِد بمُنجَزٍ فريدٍ إذا انتبه صاحبُه - المتمكِّنُ من ناصية النَّظمِ، المحلِّقُ وراءَ قاصيةِ الصُّوَر ودانيتِها- لحركيّات الفِعل المسرحيّ وتقاليد بناء المسرحيّة، حتى ولو قرّر أن يثور عليها لاحِقا.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
 يوميات عقيمة: كيف يسرد رجلٌ حكايةً نسوية!
يوميات عقيمة: كيف يسرد رجلٌ حكايةً نسوية!
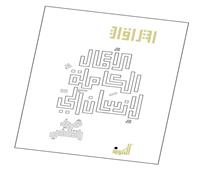 طبعة سورية من «الأعمال الكاملة لإنسان آلي»
طبعة سورية من «الأعمال الكاملة لإنسان آلي»
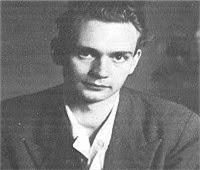 «خريف ألماني» ..داغرمان يكتب عن الأدب والمعاناة
«خريف ألماني» ..داغرمان يكتب عن الأدب والمعاناة
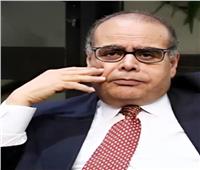 3 اختلافات بين النسخة الغربية والأخرى العربية المسكوت عنه في سيرة نصر حامد أبو زيد
3 اختلافات بين النسخة الغربية والأخرى العربية المسكوت عنه في سيرة نصر حامد أبو زيد
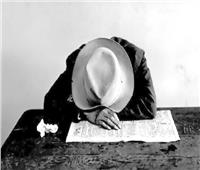 قبو مفترض يسكنه شبح كاتب ..الكتابة بوصفها ممارسة ذاتية
قبو مفترض يسكنه شبح كاتب ..الكتابة بوصفها ممارسة ذاتية
 الحياة على محمل الشعر
الحياة على محمل الشعر
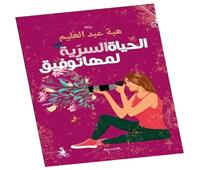 كتابى الحياة السرية لمها توفيق
كتابى الحياة السرية لمها توفيق
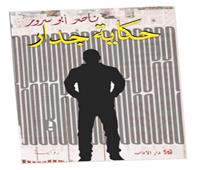 حكاية جدار: نص متخم بالبوح!
حكاية جدار: نص متخم بالبوح!
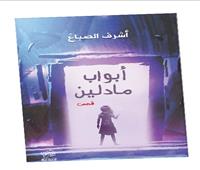 أبواب مادلين: المعادلات الموضوعية وغرائبية الصعود
أبواب مادلين: المعادلات الموضوعية وغرائبية الصعود

























