
يونان والتلمسانى وحنين واعضاء جماعة «الفن والحرية»
«رمسيس يونان».. واسطةُ العقد المُنفَرِط
الخميس، 27 يونيو 2024 - 01:41 م
د. ياسر منجى
كان قَدَرُه، من المُبتَدَأ إلى المنتهى، أن يكون همزة الوصل بين زُمرة من مجالات الإبداع التى يسعى أقطابُ كل مجالٍ منها للاستئثار بنجومية المشهد الثقافى المصرى، على امتداد العقود من ثلاثينيات القرن العشرين إلى ستِّينِيّاته. فحين اتَّسَعَت تجربته الإبداعية لتَضُمّ إلى الفنون التشكيلية مجالات النقد « بِشِقَّيه الفنى والأدبى » والتنظير الفنى، والترجمة، والممارسة السياسية، والكتابة فى الشأن العام وفى شؤون المجتمع، والاضطلاع بمسؤوليات تحرير بعض المجلات الثقافية والسياسية الطليعية، كان على «رمسيس يونان» (1913-1966م) بذلك أن يكون واسطة عقدٍ لم تلتَئِم حباتُه إلا لمامًا؛ إذ كانت فى عمومها أشتاتٌاً مُتباينة من التيارات الثقافية والتَوَجُّهات الأيديولوجية، يمثلها وينتمى إليها عددٌ كبير من المثقفين، والفنانين، والكُتّاب، وأقطاب العمل السياسى، مِمَّن ينتمون بِدَورِهم إلى شرائح اجتماعية تُلَخِّصُ بدورها تناقضات اللحظة الحضارية التى كانت تمُرّ بها مصر آنذاك. فلم يكن عجبًا، مِن ثَمّ، أن يكون الغالبُ على هذا الخليطِ الثقافي/ السياسي/ الاجتماعى المعقد أن تصير لحظاتُ التوافُق بين تياراته وأشتاتِه استثناءاتٍ معدودة فى قاعدة التدابُر والتفَرُّق التى كانت تَرينُ عليه.
كانت القاهرةُ وقتها تحاول طَيّ صفحة تحولات ما بعد الحرب العالمية الأولى، متطلعةً بأملٍ لا يخلو من حذرٍ مُتَوَجِّسٍ إلى أفق الحداثة، بصيغَتِها الأوروبيّة، بينما نُذُرُ الحرب العالمية الثانية يتوالى انعقادُ غُبارِها على عموم المشهد. وكأنما كان تدشين «جماعة الفن والحرية» مع انفجار اتون الحرب عام 1939 تكريسًا للأزمة المُستَحكِمة، على طريقة التقاء المتناقضات؛ إذ يصير الجَهرُ بالدفاع عن حرية الفن والثقافة، وتَبَنّى قِيَم الحداثة، فى مثل هذا الظرف الكابوسى، فعلًا احتجاجيًّا فى جانبٍ من جوانبِه، وفى الآنِ نفسِه رهانًا عَدَمِيًّا على المنظومة الحضارية نفسِها التى أفضَت بالعالم إلى لحظة جنونٍ مُطبِقٍ.
وإننا لنَلمَس هذا التناقض على نحوٍ جَلِيّ فى تحليلات بعض دارسى المصادر الأصلية التى ترسم معالم تلك الفترة، ومنها إشارةٌ دالّة ورَدَت فى «أوراق هنرى كورييل والحركة الشيوعية المصرية»، التى جمعها ودرسها الدكتور «رؤوف عباس» وترجمتها «عزة رياض»، والصادرة طبعتُها الأولى عام 1988؛ إذ يعلق «عباس» على مشاركة ثلاثة من أقطاب جماعة «الفن والحرية» – وهم «جورج حنين»، و«رمسيس يونان»، و«كامل التلمساني» – فى إصدار إحدى المجلات الطليعية، بمشاركة «كورييل» وأخيه «راءول»، كفعل احتجاجى على ارتفاع مَد النازية والفاشية، بقولِه: «لا وقت إذَن للعبث والمجون ونزق الشباب؛ فالخطر ماثِل للعيان، ولكن أبناء البرجوازية الكبيرة لهم أسلوبهم المترف فى النضال ضد الفاشية، فقد قرَّرَت مجموعة من الشباب إصدار مجلة فرنسية بالقاهرة للدعوة لمقاومة الفاشية، ضمَّت راءُول كورييل وريمون أجيون (قريب راءُول)، والفنان جورج حنين وزميلَيه رمسيس يونان وكامل التلمسانى (وهم من ذوى الثقافة الفرنسية). وأطلقوا على المجلة اسم «دون كيشوت»، واشترك فى تحرير المجلة هنرى كورييل وبعض شباب البرجوازية اليهودية. وأقامت المجموعة حفلًا راقصًا صاخبًا؛ احتفالًا بصدور المجلة، ولجمع التبرعات من المدعوين والمدعوات.
شباب مترف تتراوح أعمارهم بين التاسعة عشرة (ريمون أجيون)، والخامسة والعشرين (راءُول كورييل)، لا تتفتَّق أذهانهم عن سبيل لمقاومة الفاشية إلا من خلال مجلة تصدر بالفرنسية فى بلد عربي! لذلك لم تعمر المجلة أكثر من ستة شهور». هكذا كانت رؤية «رؤوف عباس» بتحليله لهذه المُقاربة الثقافية – لو جاز التعبير – لنُذُر التهديدات المُلَوِّحة فى الأفق.
بل إننا نجد الرصدَ ذاته لبواعث هذا الحراك الثقافى لدى مبدعين من المحسوبين على تيارات اليسار، ومنهم: الأديب «صُنع الله إبراهيم»، الذى أشار لظروف تأسيس مجلة «دون كيشوت» فى كتابه «يوميات الواحات»، وإن لم يتخذ منها موقفًا انتقاديًا كما هو ظاهرٌ فى خاتمة تحليل الدكتور «رءوف عباس»؛ وذلك بقوله: «كان «راءول كورييل» فى هذه الأثناء قد اقترب من النشاط اليسارى فى باريس، وعند عودته إلى القاهرة وجد البرجوازية اليهودية فى خوف من هتلر وموسولينى. أصدَر جريدةً أسبوعية مع «جورج حنين»، و«رمسيس يونان»، و«كامل التلمساني» وغيرهم باسم «دون كيشوت». وانضم «هنرى كورييل» إلى مجلس التحرير. وشاركَت الجريدة فى الحملة التى قادها الأب «عيروط» اليسوعى الشهير تحت شعار: «الحد الأدنى للفلاح المصرى حتى يمكن تمييزه عن الحيوان خمسة قروش يوميًّا» (كانت أجرة الفلاح فى اليوم ثلاثة قروش ونصف والحمار أربعة)».
غير أن هذا التناقُض الذى لَقِيَ استنكار بعض مُنتَقِدى «الفن والحرية» من منافسيها أو من خصومها الأيديولوجيين - بسبب صبغتها الفرانكوفونية – كان تناقُضًا أفضَى إلى ترسيخ مكانة «يونان»، كواسطةٍ لجَسر الهوة بين الفُرَقاء؛ إذ وقع العبء على كاهلِه، لتمكنه من اللغة العربية بقدر تمكنه من الفرنسية – بخلاف «جورج حنين» رائد جماعة «الفن والحرية» ومُنَظِّرها، الذى اقتصرت إجادته التعبيرية على الفرنسية – ومن هُنا قُيِّضَ لـ «يونان» أن يصير لسان الحال الذى أفصح عن أفكار الجماعة – ناهيكَ عن أفكاره ومواقفه الخاصة، ومعاركه التى خاضها على امتداد مسيرته الفنية والسياسية - فى مقالاتٍ وكتبٍ صيغَت بعربية طَلِيّة.
لذلك لم يكُن بالمُستَغرَبِ أن يكون الطابع العام لخطاب جماعة «الفن والحرية» طابعًا جَدَلِيّاً لا يخلو من صدامِيّة، وهو ما يفسر بدوره شطرًا لا يستهان به من بواعث السجالات الفكرية الساخنة المبثوثة فى كثرة من نصوص «يونان» ونصوص خصومه الفكريين والسياسيين. فقد استَهَلَّ فنانو تلك الجماعة نشاطهم بتوجيه انتقادات عنيفة لِمَن سبقوهم من الفنانين المحافظين على نهج الأكاديمية، وأطلقوا عليهم تهكمًا اسم «فنانى الصالونات» – ولا تخفى هنا دلالة عدم استكمال «يونان» نفسه لمراحل دراسته الأكاديمية بمدرسة الفنون الجميلة - ورأوا أن السعى نحو الإنسانية المطلقة، يستحيل تحقيقه إلا بالثورة الجذرية الدائمة على الهياكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، التى من شأنها أن تعرقل حرية الفنان، والتى رأوا أنها حرية مطلقة بالضرورة. وكانت الثورة التى يحُضّون عليها تبدو فى مقامها الأول ثورة على الهوية النمطية، أو ثورة على الموروث، وعلى كل ما من شأنه أن يفرض نفسه على الإنسان من تقاليد تحدُّ من حريته. ويتضح هذا جليًّا فيما جاء فى نص بيانهم التأسيسي؛ إذ رأوا أن أية محاولة لجعل الفن الحديث مجرد أداة فى خدمة معتقد أو جنس أو أمة بعينها يجب أن تُعَدُّ بمثابة حماقة. ورأوا كذلك أنه لا يسع الفن – بصفته عملية تبادلية شاملة للأفكار والانفعالات، تُشارك فيها الإنسانية برُمَّتِها - سوى أن يرفض هذه الحدود المصطنعة.
قد كان لهذه النزعة الأُمَمِيّة العامة ما يبررها؛ إذ كانت الصبغة الأيديولوجية التى يصدُر عنها أقطاب «الفن والحرية» صبغة تروتسكية بالأساس، فكان لزامًا أن تنطلق رؤيتهم بالضرورة من منظور دولى شامل.
لذا، كان من المنطقى أن يلتقى سورياليو «الفن والحرية» فى شطرٍ كبيرٍ من دوافعهم ومبادئهم مع الأديب المعروف «سلامة موسى» (1887 – 1957)، وأن يُفيدوا من الوجود المؤثر لمجلته، «المجلة الجديدة»، تلك المجلة السياسية الثقافية، التى كانت تصدر منذ أواخر عشرينيات القرن الماضى، والتى أعلنت عن نفسها بأنها «مجلة للكفاح والتجديد الاجتماعي». ويعاود «رمسييس يونان» إثبات جدارته بلعب دور واسطة العقد فى هذا الائتلاف الفكري؛ إذ أُسنِدَت إليه سكرتارية تحرير هذه المجلة، ثم رئاسة تحريرها فيما بعد.
وتتضح مدى أهمية الدور الذى اضطلع به «يونان»، خلال مرحلة «المجلة الجديدة»، حين نتأمل فى دلالة تحولها إلى مقر للتروتسكيين بصفةٍ عامة آنذاك. وفى الآن نفسِه يتضح جلِيًّا مدى اتساع شُقَّة الانقسام الأيديولوجى الذى دمغ حراك صفوف اليسار المصرى فى تلك الفترة. ويبدو ذلك جَلِيًّا حين نطالع شيئًا مما ورد فى كتاب «الحركة العمالية فى مصر ١٨٩٩–١٩٥٢»؛ حيث يلخص «رءوف عباس» مرةً أخرى تناقضات المشهد بقوله: «انقسم الشيوعيون المصريون إلى فريقين، أيَّد فريق منهم نظرة ليون تروتسكى إلى الثورة من ناحية التكتيك، وكان ينادى بالثورة العالمية وبأنه يجب اتحاد عمال العالم فى دولية منظمة تغذى الطبقة العاملة فى سائر أنحاء البلاد بالمنهج والبرنامج العملى حتى تثبَ بالبرجوازية وتحطم النظام الاجتماعى الحالى وتستولى على مقاليد الحكم، وحبَّذ الفريق الآخر خطة ستالين الذى كان يرى أنه يمكن قيام الاشتراكية فى بلد واحد».
واتخذ التروتسكيون من دار مجلة «المجلة الجديدة» — التى كان يُصدرها سلامة موسى — مقرًّا لجماعتهم، ولذلك عُرفت حركتهم باسم «١٠ شارع علوي» (مقر المجلة)، وكان من أبرز رجالها جورج حنين ولطف الله سليمان ورمسيس يونان. بينما كان الشيوعيون الستالينيون هم الغالبية وقد ضمتهم حلقات عدة حرصت كلٌّ منها على أن تكون دون غيرها نواة لإقامة حزب شيوعى مصري...».
ومن ذلك يتبَيَّن لنا كيف تكونت منظومة «رمسيس يونان» الإبداعية، لتنصهر فيها مجالات: الفن التشكيلى، والنقد الأدبى والفنى، والترجمة، والمقالات السياسية، وتتقاطع قضاياها فى كتاباته وتتداخل على نحوٍ نلاحظ فيه انسجامًا وتكامُلًا واضحًا بينها؛ وهو ما يتضح على نحوٍ خاص من نصوصه التى كان يجيد فيها استدعاء مصطلحات اقتصادية وسياسية، وتوظيفها بسلاسةٍ، ودون إقحام، فى سياق موضوعاتٍ وقضايا إبداعية أو نقدية بطبيعتها.
ويعاود «رمسيس يونان» إفصاحه عن تلك الرؤية الرحبة، من خلال كتاباته فى مجلة «التطور»، ليؤكد فى مقال «الحلم والحقيقة» على أن السريالية «فلسفة جامعة متكاملة للحياة». ولهذا نراه يوافق على تعبير «ماركس» «لنغير العالم»، وعلى تعبير «رامبو» «لنغير الحياة»، ويرى أن «القولين يعبران عن نداء واحد». هذه النظرية التى تبناها «رمسيس يونان» هى نفسها نظرة السرياليين، الذين دمجوا بين المفهوم الماركسى فى النضال الطبقى والمفهوم السريالى فى الفن، لأن كلًا منهما يكمل الآخر. ويقر «يونان» أن ثورة التغيير لابد أن تكون «ثورة اجتماعية»؛ فالجمع بين الالتزام السياسى والحرية فى الفن هو ما تميز به التروتسكيون بصفةٍ عامة.
وقد أدى «يونان» و«حنين» دورًا فى جعل الجماعة السريالية فى مصر تتسق مع هذا الموقف، ولعل ذلك كان أحد الأسباب التى دفعتهم للاقتراب من الجماعات السريالية اليسارية الغربية، لتعويض الفجوة التى واجهوها بين نُظَرائهم من الفنانين والسياسيين المصريين وقتها. ولعل ذلك نفسه يكون سببًا فى أن يصفهم الفنان الناقد الراحل «عز الدين نجيب» – برغم كونه فنانًا ناقدًا يساريًّا بدوره – فى كتابه «فجر التصوير المصرى الحديث» بقوله: «فقد كانت يساريتهم يسارية المتأملين لا شيوعية الكادحين، شيوعية الفكر، لا شيوعية الواقع».
غير أن أهمية الدور الذى لعبه «رمسيس يونان» فى هذا السياق الفكري/ السياسى المُلتَبِس لم تقتصر فقط على كونه واسطة الوَصل بين أطراف المشهد، ولا على كونه لسان الحال المُبين عن مجموعة من المثقفين ذوى التكوين الفرانكوفونى لمواطنيهم من ذوى التأسيس الثقافى العربى. لقد امتد دور «يونان» إلى ما هو أبعد من ذلك بأشواط – وبما لا يقل أهميةً عن دوره التجديدى فى سياقَى الفن والنقد – إذ استطاع أن يكون واحدًا مِمَّن مهدوا السبيل لأساليب الكتابة الجديدة، التى بلغت أوجها فى ستينيات القرن المُنصَرِم، والتى انطوت معها صفحة أساليب الكتابة التقليدية التى كانت سائدة فى الربع الأول من القرن ذاته.
ويتأكد هذا الدور المهم بشهادة واحد من أبرز مبدعى هذا اللون من الكتابة، هو الأديب «إدوار الخراط»؛ وذلك حالَ تأمل عددٍ من الإشارات الواردة فى كتابَيه «الحساسية الجديدة: فى الظاهرة القصصية»، و«مراودة المستحيل: حوار مع الذات والآخرين». ففيهما يذهب «الخراط» إلى أن أصول «الحساسية الجديدة» أو «الكتابة الجديدة» ترجع لأواخر ثلاثينيات القرن الماضى وأربعينياته، وأن بذورها تشكلت فى مجلات على شاكلة مجلة «التطور»، ومجلة «البشير»، و«المجلة الجديدة» برئاسة تحرير «رمسيس يونان».
ومع انفراط عقد جماعة «الفن والحرية» تدريجيًا، لأسباب التضييق السياسى، والخلافات الأيديولوجية، وارتحال بعض أعضائها أو هجرتهم أو استقلالهم فنيًا، كان ارتحال «يونان» إلى فرنسا انقطاعًا مرحليًا لدوره المحورى، غير أنه ما لبث أن استأنف هذا الدور بعودته إلى مصر عام 1956، على أثر العدوان الثلاثى. وفى يناير من عام 1959 كان عنوان معرض «نحو المجهول» عنوانًا بالغ الدلالة على آخر معرض ضم أعمال أعضاء «الفن والحرية». وسرعان ما أتى الصدى الأخير لصيحة الوداع تلك فى إبريل من العام نفسه؛ حين أصدرت الجماعة كراسًا بعنوان «المجهول لا يزال» وُزِّعَ فى معرضٍ للفنان «حامد ندا»، أحد نجوم جماعة «الفن المعاصر»، التى تصَدَّرَت المشهد بعد أفول نجم «الفن والحرية».
وبرغم هذا الانفراط، نرى «يونان» ينفض عن جناحيه رماد الماضى كطائر «فينيق»، ليُجَدِّد أسلوبه الفنى، فينضو عنه سمات المرحلة السابقة، مُفتَتِحًا مرحلةً جديدة من التجريد الصريح.
ومن جديد نرى «يونان» لا يكتفى بخوض غمار التجربة فحَسب، بل يتصدى للترويج للاتجاه التجريدى، والتنظير له والمنافحة عنه. ويكفى أن نسوق مثالًا واحدًا مما كتبه فى مجلة «المجلة»، بمناسبة معرض الفن التجريدى المقام بقاعة الفن للجميع فى يوليو 1962؛ إذ يقول بنبرةٍ جازمةٍ لا مُوارَبة فيها: «لا يخلو عمل فنى من التجريد، وإلا كان الفن منه براء، فالفنان يستخلص ويختزل ويضيف، وكل ذلك ضرب من التجريد».
وعلى كثرة ما كُتِبَ عن هذا التحول الأسلوبى والمنهجى فى مسيرة «يونان» الفنية، وعلى كثرة الأسباب التى حاول بعض النقاد تقديمها لتبرير هذا التحول، ومنها: أن ذلك أتى بفعل التوجُّه العام آنئذٍ صوب التجريد، أو أنه حدث بفعل انفراط عقد «الفن والحرية»، أو فى أعقاب أزمة «يونان» الوجودية بفعل الاغتراب والعثرات المالية. بل إن بعض التفسيرات بررت ذلك التحول بوجوده زمنًا بين صخور جبال البحر الأحمر! أقول: على كثرة ما كُتِبَ لتأويل هذا التحول فإننى أرى أن هذه التفسيرات تُغفِل حقيقة مهمة، وهى حقيقة إلمام «رمسيس يونان» إلمامًا عميقًا بأصول التيار التجريدى الفلسفية منذ بدء تجربته الفنية؛ وهو ما يصعُب تصور عكسُه فى حالة فنان ناقد مثقف واسع الاطلاع على مجريات الفنى العالمى مثله.
ولم يكن هذا الإلمام المبكر بالأصول الفلسفية للتجريد، مِن قِبَل «يونان»، مقتصرًا فحَسب على مجال التشكيل، بل كان إلمامًا واسع النطاق، يضم عموم التجربة الإبداعية، بصريًا وأدبيًا، بصرف النظر عن مجالها.
ويتأكد ذلك بوضوح حين ننتبه لدلالة الإشارة التى أوردها الدكتور «عبد الغفار مكاوي»، فى حاشية تعليقه على فقرة مهمة من فقرات كتابه «ثورة الشعر الحديث من بودلير إلى العصر الحاضر» (الجزء الأول). ففى الفقرة المذكورة يتناول «مكاوي» بالرصد مقالًا للفيلسوف الإسبانى أورتيجا أى جاسيت Ortega y Gasset، نُشِرَ فى عام 1925،عن تجريد الفن من النزعة البشرية. ويعلق «مكاوي» فى الحاشية بقوله: «هناك تلخيصٌ قيم لهذا المقال الهام قام به الكاتب الفنان الكبير المرحوم رمسيس يونان وظهر بعد وفاته فى كتابه الرائع «دراسات فى الفن» من ص٣١٩ إلى ص٣٣٨، القاهرة».
ثم يسترسل «مكاوي» فى تناوُل المقال الأصلى للفيلسوف الإسبانى بقوله: فأصبحت هذه الكلمة La déshumanizacion del arte منذ ذلك الحين اصطلاحًا شائعًا فى لغة النقد الحديث، لا يبغى إدانة الشعر بقدر ما يبغى وصف ظاهرة من ظواهره الأساسية. والفكرة الرئيسية فى هذا المقال هى أن الإحساس الإنسانى الذى يثيره العمل الفنى يصرفنا عن قيمه الفنية وخصائصه الاستطيقية. «فالأسلبة» فى الفن معناها تحوير الواقع وتغييره، والأسلبة تنطوى على «نزعة التجريد من البشرية».
وعلى هذا النحو يتضح أن «يونان» حين لخّص هذا المقال المهم لـ «جاسيت»، لم يكن فقط على دراية وافية بالأسُس الفلسفية لتيارات التجريد الأدبية والفنية، بل كان فى اختياره إيّاها كذلك، للتعبير عن ذاتِه خلال تلك المرحلة - الفارقة فى حياته وفى تكوينه الإبداعى معًا – متَّسِقًا تمام الاتساق مع طبيعة تحولات تلك المرحلة، التى كانت تقتضيه مزيدًا من التسامى فوق ظواهر الأمور، ومزيدًا من التخَلُّص من القشور للوصول برؤيته إلى مداها الأقصى.
وبذلك استطاع «رمسيس يونان» أن يصل بإرهاصات تجاربه التجريدية السابقة، والتى كانت تتخلل أعماله فى مراحل سالفة، إلى نهاية شوطها المنطقى، الذى ظل يختَمِرُ، وتتوالى تحولاته، إلى أن استَوفى مقوماته، ليظل متمسكًا بهذا النهج حتى وفاته عام 1966.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
















 الجمال بأيدينا
الجمال بأيدينا
 الأدب والمجتمع
الأدب والمجتمع
 الفن والمجتمع
الفن والمجتمع
 تفعيلات من فعل «يغطى»
تفعيلات من فعل «يغطى»
 إعادة الحرية للخيال السجين
إعادة الحرية للخيال السجين
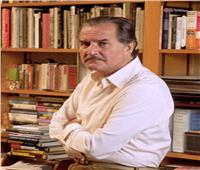 مقال يوسا عن فوينتس ..كارلوس فوينتس فى لندن
مقال يوسا عن فوينتس ..كارلوس فوينتس فى لندن
 حوار «لاتينى» مع صحيفة «ليستى» التشيكوسلافية ..«نحن دول عالم ثالث حتى فى الأدب»!
حوار «لاتينى» مع صحيفة «ليستى» التشيكوسلافية ..«نحن دول عالم ثالث حتى فى الأدب»!
 الخطابات
الخطابات
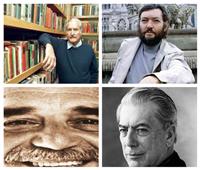 رحلة الأدباء الأربعة في خطابات البوم
رحلة الأدباء الأربعة في خطابات البوم








